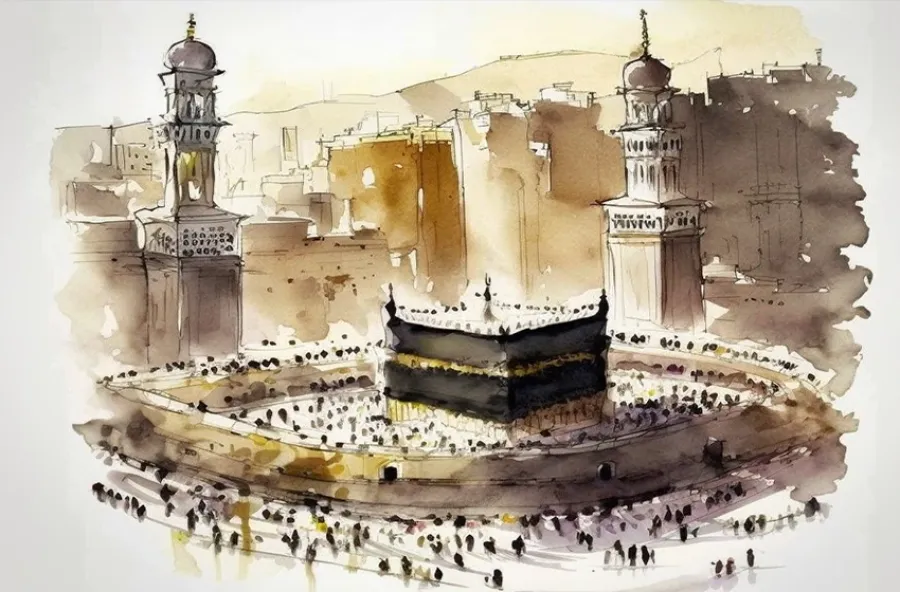يُقال بأن هذا العصر هو عصر القلق، ومن أسباب القلق ما فيه من وسائل رصد الفضائح ونشرها، فلا يكاد الإنسان ينام على فضيحة في مكان ما ومن شخص ما من هذا العالم حتى يستيقظ على فضيحة أخرى في مكان آخر ومن شخص آخر، وهي متنوعة في توجّهها، وفاعلها وضحيّتها، وكأنما الفضائح صارت صناعةً عالمية لها مختبراتها وصُنّاعها، وكأنها صارت نوعًا أدبيًّا رقميًّا تفاعليًّا، تستخدم في عرضه وفي الترويج له كل وسائل التكنولوجيا! يمكن أن نسمّيه (أدب الفضائح).
فما أدب الفضائح؟ وما جذوره؟ وما أنواعه؟ ومن أعلامه؟ وما نماذجه؟ وما مخاطره؟
مفهوم أدب الفضائح
"أدب الفضائح" - كما يقرر الذكاء الاصطناعي - ليس مصطلحًا أدبيًّا متعارفًا عليه، ولكنه يشير إلى نوع من الأدب الذي يتعامل مع الفضائح والانتهاكات الأخلاقية والاجتماعية للكشف عنها وفضحها، وغالبًا ما تكون في شكل قصص أو مقالات أو منشورات فيسيّة أو تغريدات إكسيّة، تكشف جوانب سلبية في المجتمع أو في حياة شخصيات معينة، بهدف لفت الانتباه أو إحداث تأثير إعلامي. وهو لا ينتمي إلى جنس أدبي معين، وأراه أدبًا رقميًّا، تطوّر عمّا كان يُسمّى: الأدب الهابط والأدب الماجن والأدب الرخيص والأدب التجاري، ومقالات الصحافة الصفراء، أو الصحافة الفاضحة، وهي - كما تقرر موسوعة الويكيبديا - صحافة غير مهنية تهدف إلى إثارة الرأي العام لزيادة عدد المبيعات وإشاعة الفضائح مستخدمة المبالغة أو الانحياز، وساعد على نشوئها الناشر والصحفي "ويليام راندولف هيرست" (1863- 1951)، وقد كانت له في كل ناحية من نواحي الولايات المتحدة الأمريكية صحيفة أو مجلة، وانتهج في نشر الأخبار نهجًا مثيرًا، فأظهر الفضائح والجرائم ممّا ساعد على نشوء الصحافة الصفراء. سُميت بـ "الصحافة الصفراء" نظرًا لأنها كانت تُطبَع على أوراق صفراء رخيصة الثمن، وقد تكون الصحف الصفراء يوميّة أو أسبوعية أو شهرية أو دورية.
إن "أدب الفضائح" ليس نوعًا أدبيًّا محدَّدًا، ليس نثرًا، وليس شعرًا وليس سردًا، ولكنه يستعين بتقنيات من كل هذه الأجناس الأدبية، إنه نص كتابي إلكتروني غالبًا، ذو محتوى وقالب أدبي، يركز على الفضائح والعيوب والنقائص والرذائل، سواء كانت أخلاقية، أو سياسية، أو جنسية، أو اجتماعية، أو دينية. ودوافعه عديدة؛ فقد ينبع من الجشع، أو الطمع أو الشهوة، أو إساءة استخدام السلطة، أو التحكم أو التكسب أو الدفاع عن النفس لدى المقهورين، وقد يكون صادرًا عن شواذ ومرضى نفسيين، ويهدف إلى توظيف وسائل الإعلام في بثّه والترويج له لتحقيق أهدافه. وهو ألوان: منه الانتهاك، ومنه النقد الاجتماعي، ومنه الجلد، ومنه الهدم، ومنه التشهير، ومنه السخرية، ومنه التنمّر! إن أديب الفضائح قد يكون ملتزمًا بهدف ما، ومدافعًا عن وجهة نظر معيّنة عن طريق كشف الأخطاء وفضح الانتهاكات والمعاصي من كبائر وصغائر!
وقد توسعت مضامين "أدب الفضائح" ومجالاته، فصارت تغزو كل مجالات الحياة: الإعلام والأدب والفنون والسياسة والرياضة وحتى مؤسسات التربية والتعليم، وقيادات الدعوة والإرشاد والتثقيف.. وفي الحياة اليومية للإنسان عمومًا. وقد أسهمت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في انتعاش الفضائح وسرعة انتشارها دون التثبّت من صدقيّتها. ومما يؤسَف له أن "الجهر بالسوء" صار سمة من أبرز سمات هذا العصر، وإلى وقت قريب كانت المجتمعات، العربية على الخصوص، تحتاط للفضيحة وتحتويها وتُخمدها في مهدها حتى لا يكون لها ضحايا لا ذنب لهم، لا سيما الفضائح في مجال العواطف والعلاقات بين الجنسين، وأما اليوم فكأنما هناك تسابق غير مُعلن لنشر الفضائح وتداولها..
نعم، صارت الفضائح جزءًا من ثقافة الشواذ والمنحرفين والمنحرفات فقط! في هذا العصر الهائج المائج الفاتن، ويُمكن أن نُطلق عليها "الثقافة الفضائحية الشاذة". وهي داءٌ يجب استئصاله؛ لأننا أمّة السّتر والعفو والصفح! فالفكر الفضائحي لا يُمكنه أن يُنتج أدبًا فاعلا.
إن تعبير "أدب الفضائح" فيه جمع بين لفظين متناقضين: "الأدب"، و"الفضائح"، فالأدب مروءة، والأدب احتشام، والأدب التزام، والأدب ستر، والأدب خير، والأدب احترام! والخالد من الآداب هو الآداب الهادفة البانية الشادية المعمّرة التي ترتقي بالناس وتطهّر أعماقهم وحواسّهم.
تطوّر "أدب الفضائح"
بدأ "أدب الفضائح" في قالب "الملهاة" المسرحي الساخر، وهي نوع من الكوميديا يجمع بين التهكّم والسخرية والتصوير الساخر، حيث يستخدم الضحك كأداة نقدية لتسليط الضوء على مواقف أو سلوكيات معينة بطريقة تهكمية. يمكن أن تكون محاكاة لأسلوب فني آخر بقصد السخرية منه، أو تكون هجاءً نقديًّا يهدف إلى تصحيح بعض الأخطاء في طريقة العيش والتفكير، كما يظهر في أعمال مثل أشعار "الحطيئة" والنقائض.
وهو مخترَع في المسرح اليوناني القديم، حيث اشتُهر به "أريستوفانيس" في كتابته مسرحيات ساخرة تتضمن مشاهد ساخرة من الآلهة والبطولات الأسطورية، مثل مسرحية "الضفادع" التي يفضل فيها ديونيسوس أريستوفانيس على يوربيديس. وفي الأدب العربي يُعدّ الهجاء من أقوى أنواع الأدب الساخر في الشعر العربي، وقد برع فيه شعراء مثل "الحطيئة"، حيث يبالغ في الهجاء لتصحيح أخطاء الآخرين. فشبّ محروما مظلوما، لا يجد مددًا من أهله ولا سندا من قومه فاضطر إلى قرض الشعر يجلب به القوت، ويدفع به العدوان، وينقم به لنفسه من بيئةٍ ظلمته، ولعل هذا هو السبب في أنه اشتد في هجاء الناس، ولم يكن يسلم أحدٌ من لسانه فقد هجا أمّه وأباه حتى إنّه هجا نفسه، هجا أمّه فقال:
تنحّي فاقعدي مني بعيدًا -- أراح الله منك العالمينا
ألم أوضح لك البغضاءَ مني -- ولكن لا أخالُكِ تعقلينا
أغربالاً إذا استودعت سرًّا -- وكانونًا على المتحدثينا
جزاك الله شرًّا من عجوز -- ولقاك العقوق من البنينا
حياتكِ ما علمت حياةُ سوء -- وموتُكِ قد يـسرُّ الصالحينا
هجا أبوه، فقال:
فنعم الشيخ أنت لدى المخازي -- وبئس الشيخ أنت لدى المعالي
جمعت اللؤم لا حياك ربي -- وأبواب السفاهة والضلال
هجا نفسه، فقال:
أبت شفتاي اليوم إلا تلكمًّا -- بهجوٍ فما أدري لمن أنا قائله
رأى وجهه في الماء، فقال:
أرى اليوم لي وجهاً فلله خلقه -- فقُبِّح من وجه وقُبِّح حاملهْ
وعندما مات، أوصى أن يعلق هذا على كفنه:
لا أحدٌ ألأم من حطيئهْ -- هجا البنين وهجا المريئهْ
وتطوَّر أدب الفضائح إلى شعر النقائض، وشعر السخرية، والرسائل الهزلية كرسالة التربيع والتدوير للجاحظ، والرسالة الهزلية لابن زيدون، والهجاء السياسي، والهجاء الديني...
الهجاء الخَلقي: يتناول العيوب الجسدية والعاهات البارزة كقِصَر القامة أو العرج أو طول الأنف.. إلخ، ومثالٌ على هذا بعض من هجاء "المتنبي" لـ "كافور الأخشيدي" إذ أنه تعرّض للون بشرته في بعض أبياته:
من علّم الأسود المخصي مكرمةً -- أَقَومه البيض أم أجداده الصيدُ
أم أذنيه بيد النخّاس دامية -- أم قدره وهو بالفلسَين مردودُ
هذا وإن الفحول البيض عاجزةٌ -- عن الجميل فكيف الخصيةُ السودُ
وهجاء "ابن الرومي" لأحدهم، فقد تعرّض لشكل وجهه:
وجهك يا عمرو فيه طولٌ -- وفي وجه الكلاب طولُ
مقابح الكلب فيك طرًّا -- يزول عنها وعنك لا تزولُ
ومن أمثلة الهجاء الكاريكاتوري الذي يُضخم المساوئ بأسلوب فكاهي ويسخر من الشخص المَهجو، وهذا النوع يحمل القارئ على الضحك كقول "أبي بكر اليكي" يهجو أحدهم:
أعد الوضوء إِن نطقت بهِ -- متذكرًا من قبل أَن تنسى
واحفظ ثيابك إن مررت بهِ -- فالظل منه ينجس الشمسا
وهكذا يحضر فن الهجاء في تراثنا، ويتنوّع ويتطوّر حتى نصل إلى هذا البلاء الأدبي الرقمي المُسمّى "أدب الفضائح"!
ومن أعلامه في العصر الحديث الكاتب الفرنسي "بيير كوديرلوس دو لاكلو"، والكاتبة الفرنسية "هيلين سيكسوس"، التي تشدّد في مقولاتها على ضرورة أن تنصرف الكتابة النسائية إلى الجسد، بل والاقتصار عليه، داعية الكاتبات إلى وضع أجسادهن في كتاباتهن، ويمكن أن يضاف إلى الكُتّاب الساخرون مثل يعقوب صنوع، وأحمد رجب، وأحمد مطر، وجلال عامر، ومحمود السعدني، وغيرهم.
الموقف الإسلامي من أدب الفضائح
"أدب الفضائح" ذو أثر نفسي قاسٍ، وهو سلوك لساني عدواني عنيف، وذو أضرار اجتماعيّة مدمِّرة، وهو ليس وليد البيئة المصرية، ولا العربية، ولا الإسلامية، ولا خاصًّا بها، ولكنه ظاهرة عالمية فاشية، توجد في كل مكان ومجتمع وحضارة؛ ففي كل يوم نجد حادثة أو أكثر، في غير بلد، تشير إلى كثرته! وقد زاد خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار فيروس "كورونا".
ونهى الله تعالى عن أنواع السخرية كافة، على مستوى الأفراد والوسائل، في قوله تعالى في سورة الحجرات: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (الحجرات، الآية: 11)، فهذه الآية نهيٌ صريح من الله - سبحانه وتعالى - عن احتقار الناس، والاستهزاء بهم لوجود مرض أو فقر أو أيّ صفة مختلفة أو غير مألوفة. وقد جمعت هذه الآية وسائل الفضائح الشائعة، حيث: التنمّر باللفظ (السخرية)، أو التنمّر بالإيماءات التي توحي إلى الآخرين بالاستهزاء بهم، أو بالنظر أو بالحركة أو بالكلام، وهو (التّهامز، والتّلامز)، أو التنمّر بإطلاق أسماء على بعضنا، يستاؤون منها عندما يستمعون إليها، وهو (التنابز).
وفي الهدي النبوي الشريف تقرير لهذه الأدوية القرآنية؛ فالرسول (صلى الله عليه وسلم) في غير حديث يُبيِّن أن الناس إخوة، متساوون، لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، وقد دعا في حديث جامع إلى ترك الضرر العام قائلاً: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، كما دعا إلى سلامة الناس جميعًا بلا عنصرية أو تمييز، بقوله: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم"، كما قال محبّذًا السلوك الجميل، ومنفّرًا من السلوك القبيح: "أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ حُسْنُ الخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ"؛ فالإسلام يُعلي من قيمة السلام المجتمعي، ويُرشد أتباعه إلى الاتّصاف بكل حسنٍ جميل، والانتهاء عن كل فاحش بذيء، حتى يعمَّ السلامُ البلادَ والعبادَ جميعًا، ويَسلَم كل شيء في الكون من لسان المؤمن ويده.
والتَّنَمُّر الذي وجّه الإسلام إلى إزالته، ليس الجسدي فقط، وإنما وجَّه – كذلك – إلى إزالة الفضائح وطرق التَّنَمُّر النفسي الذي قد يكون أقسى أثرًا وأشد إيلامًا، قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"، كما نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن خداع الناس المُؤدِّي إلى إخافتهم وترويعهم - ولو على سبيل المزاح - بقوله: "لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا"، وقوله: "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ - أي: وَجَّهَ نحوه سلاحًا مازحًا أو جادًا - فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ". كما دعا الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى الحِفاظ على صِحَّة المريض النَّفسية؛ فقال: "لا تُدِيمُوا النَّظرَ إلى المَجْذُومينَ"؛ أي لا تُطيلوا النَّظر إلى مَوَاطن المَرضِ؛ كي لا تتسبّبوا في إيذاء المَريضِ بنظراتكم..
والأنموذج الأعلى في علاج هذا المرض في معاملة الرسول (صلى الله عليه وسلم) التَّنَمُّر الصادر من سيدنا "أبي ذر" حينما سابَّ رجلاً فعيَّره بأمّه، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما أخرجه الإمام البخاري: "يا أبا ذر أَعَيَّرتَه بأمّه؟ إنك امرُؤٌ فيك جاهليةٌ، إخوانُكم خولُكم، جعلهم اللهُ تحت أيديكم، فمَن كان أخوه تحتَ يدِه، فلْيطعمْه مما يأكلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مما يلبسُ، ولا تُكلِّفوهم ما يغلبُهم، فإن كلَّفتُموهم فأَعِينُوهم"؛ ففي هذه المعاملة النبوية حُكمٌ على التَّنَمُّر بالجاهلية، ودعوة إلى الأخوة والمساواة بين الناس أجمعين، بلا تمييز، والإحساس بالضعيف.
الموقف النبوي الشريف من الهجاء
إن المنظور النبوي يوظّف فن الهجاء توظيفًا بنَّاءً، فيجعله جهادًا لسانيًّا، عندما يتوجّه الشاعر المسلم به إلى المشركين وأصحاب الضَّلال والمنكر. يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "اهجوا المشركين بالشعر؛ فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله، والذي نفس محمد بيده، كأنما تنضحونهم بالنبل". فالنبي الكريم لم يجد بُدًّا من الرد على هجاء المشركين الذين لم يتركوا زُورًا أو بهتانا إلا ورَمَوْا به النبي الكريم والمسلمين عامّة، مما حمل الصحابة (رضي الله عنهم) على استئذانه (صلى الله عليه وسلم) في الرد عليهم، فعن "عمار بن ياسر" قال: لما هجانا المشركون شَكَوْنَا ذلك إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فقال: "قُولُوا لَهُمْ كما يقولون لكم"، فلقد رَأَيْتُنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ أَهْلِ المدينة". وذلك لأن الهجاء الشعري يؤثّر في هؤلاء المشركين تأثيرًا شديدًا، مؤديًّا دورًا إعلاميًّا خطيرًا في الحرب النفسية معهم.
وللهجاء في المنظور النبوي حدود، حتى لا يقع أو ينال ممن لا يستحقونه؛ فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "استأذن حسان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين، فقال رسول الله: فكيف بنسبي؟ فقال: لأسلنَّك منهم كما تُسلّ الشَّعرة من العجين". وهذا ينسجم مع التحذير الشديد الذي نصّ عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْماً، إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو قَبِيلَةً مِنْ أَسْرِهَا"؛ فلم يترك الحبل على الغارِبِ، أمام الشاعر المسلم الهاجي خصومَ الإسلام، بل قنَّن له وحدَّ من مَيسمه. فلا بد من الصدق والحق وشرف المعنى وطهارة المبنى، والتركيز على الأعداء المؤذين للإسلام والمسلمين في الهجاء الجهادي. أما ما عدا ذلك من أهجاءٍ ذاتية أو قبَلية أو بين مسلمين، فهي جاهلية مذمومة، إذ "ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء".
رُوي أن "النّجاشي" الشاعر قد هجا "تميم بن أبيّ بن مقبل" وقومه "بني العجلان"، فاستعدوا عليه "عمر بن الخطاب"، فاستنشدهم ما قال فيهم، فقالوا: إنه يقول:
إذا الله عادى أهل لؤم ورقة -- فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل
فقال عمر: إنه دعا، فإن كان مظلومًا استجيب له، وإن كان ظالمًا لم يستجب له، قالوا: إنه يقول:
قُبيّلة لا يغْدِرون بذمة -- ولا يظلمون الناس حبّة خردل
فقال عمر: ليت آل الخطاب كذلك! قالوا: وقد قال:
ولا يردون الماء إلا عشية -- إذا صدر الوُرّاد عن كل منهل
قال عمر: ذلك أقل للِّكاك (الزحام)! قالوا: وقد قال أيضا:
تعافُ الكلابُ الضاريات لحومهم -- وتأكل من كعب وعوف ونهشل
فقال عمر: أجَنّ القوم موتاهم، فلم يضيعوهم! قالوا: وقد قال:
وما سُمِّي العجلان إلا لقيلهمُ -- خذ القعب واحلبْ أيها العبد واعجل
فقال عمر: خير القوم خادمهم، وكلنا عبيد الله!.
ولعلّ في هذا الحوار الذي دار بين رهط بني العجلان وعمر، ما يدلّ على مدى قدرة عمر على فهم الشّعر وتذوّقه وإدراك معانيه وعلمه بمراميه. وعلى الرغم من فقه عمر وفهمه للشعر وتذوّقه له على النحو الذي ذكرنا، إلا أنه بعث إلى حسان بن ثابت والحطيئة - وكان محبوسًا عنده - فسألهما عن شعر النجاشي في تميم بن مقبل ورهطه، فقال حسان مثل قوله في شعر الحطيئة الذي هجا به الزبرقان بن بدر، فهدّد عمر النجاشي، وقال له: إن عدت قطعت لسانك!
وفي ندب عمر الخبراء من الشعراء ما يدلّ على مدى إيمانه بالتخصّص؛ إذ لم يكن ذلك النّدب لعجزه عن البتّ فيما عُرض عليه بل كان سنًّا لقاعدة رشيدة، وهي الرجوع إلى أهل الذِّكر في كل فنٍّ من رجاله المنقطعين له قبل القضاء فيه؛ ليكون ذلك أصحّ للرأي، وآكد في صواب الحكم.
وهكذا نرى إسلامنا الجميل تعاملَ مع الفضيحة والتنمُّر والفضائحيين والمُتَنَمِّرين تعاملاً منهجيًّا شاملاً راقيًّا سديدًا، حبذا لو أحييناه بيننا الآنَ، وما أحوجنا إليه الآن وغدًا!
إن الأدب ينبغي أن يكون ذا رسالة إنسانية نبيلة تعلو به وتجعله في مصاف الكلام الطيب الذي يرفعه الله، والذي هو كالشجرة الطيبة وصدق الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي قال:" إنما الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق فيه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه". وفي رواية: "الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه". وكذا شأن الأدب في كل أشكاله الحديثة والمعاصرة!