قبل أن تقرأ هذا الملف، أدعوك عزيزي القارئ أن تقف دقيقة صمت على روح الكلام، الكلام الصادق المفيد الواضح الذي يُعبّر عن شخصية أمّة اشتهرت بشرف الكلمة تمامًا مثلما اشتهرت بالعزّة والإباء والشهامة والبطولة والنجدة، ولا تزال الذاكرة العربية تستحضر بكل فخرٍ قصة تختزل فيها كل تلك المعاني النبيلة، قصة "وا معتصماه"، رغم أن "المعتصم" تكلّس تحت غبار التاريخ، ولم يتبقّ غير "وا" وهو حَرف نداء مُختص بأسلوب النّدبة مبني على السّكون ولا محلّ له من الإعراب، وهو أيضا اسم فعل مضارع معناه "أتعجّبُ" وفاعله ضمير مُستتر وُجوبا (على ذمّة النُّحاة).
هل وقفتَ دقيقة صمتٍ؟ لا عليك عزيزي القارئ، فالدّقيقة طويلةٌ وتستنزف عمرًا من عمرك، ولعل جيلا قادمًا سيشيّد "معبدًا" خاصا يقيم فيه "صلاة الصمت"، ويقف كل يوم دقيقة صمت على روح الأمّة العربية من مائها إلى مائها! ولعل المفكر السعودي "عبد الله القصيمي" (1907 - 1996) قد أدرك حقيقة "الصوت" العربي - أو الصمت العربي فلا فرق - فأطلق كتابًا من باريس عام 1977 بعنوان "العرب ظاهرة صوتية"، وأثار جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والدينية العربية. وأختلس عبارات من الكتاب قال فيها "القصيمي": "إن من أصل وأرسخ وأشهر مواهبهم (العرب) أن يعتقدوا أنهم قد فعلوا الشيءَ لأنهم قد تحدّثوا عنه". وفي الفرق بين الكلام والصوت، قال: "حقًا.. إن العرب ظاهرة كلامية أو لغوية. قد يكون الصدق أنهم ظاهرة صوتية أو تصويتيّة، أي أنهم لم يبلغوا طور أن يكونوا ظاهرة كلامية أو لغوية... إن الفرق كبير بين الكلام واللغة، وبين الصوت والتصويت.. الكلامُ تخطيطٌ أو تعبير عن تخطيط أو عن خطّة أو فكرة أو تفكير.. إن فيه معنى الهدف والتحديد والتسديد إلى شيء مُعيّن مرادٍ معروفٍ أو مظنون.. أما الصوت أو التصويت فإنه لا يصعد إلى هذا الطور، إنه ليس إلا تعبيرًا عن الذات أو عن الحالة، تعبيرًا ليس فيه معنى التحديد أو التسديد أو الهدف المراد المعروف المظنون. ليس فيه أيّ معنى من معاني الضبط أو القصد. إنه ليس إلا إفرازا أو إطلاقًا مثل البكاء والأنين والتوتر وارتجاف العضلات.. مثل كل الانفعالات الذاتية التي تُطلق أو تنطلق دون أيّة حسابات أو انضباط أو تحديد أو بحث عن شيء معين معروف أو مظنون".
و"التّصويت" في بعض الثقافات العشبية العربية هو إقامة مندبةٍ على ميّتٍ، فكل الصوت والتّصويت العربي في حرب الإبادة المُعلنة على غزة - مثلا - يندرج ضمن مَندبةٍ على الأمّة العربية ذاتها. وأرجو منك عزيزي القارئ ألاّ تذهب إلى ربط التّصويت بشؤون أخرى.. حتى لا أُتّهم مثل "القصيمي" بالمُروق والزندقة والإلحاد! كما أرجو أن تفهم المندبة بمعناها اللغوي وليس كما يتخيّلها ذهنك، فهي "صوت المرأة تُعدِّد محاسن الميت". وقبل أن أنحرف في الكلام إلى بُطينٍ آخر في قلب الصّمت، أدعوك إلى قراءة هذا المقطع الشعري للشاعر "نزار قباني" من قصيدته "متى يعلنون وفاة العرب؟"، قال "نزار":
أنا منذ خمسين عاما
أراقبُ حال العربْ
وهم يرعدون، ولا يُمطرونْ...
وهم يدخلون الحروب، ولا يخرجونْ...
وهم يعلِكونَ جلود البلاغةِ عَلْكا
ولا يهضمونْ...
أنا منذ خمسينَ عاما
أحاولُ رسمَ بلادٍ
تُسمّى - مجازا - بلادَ العربْ
رسمتُ بلون الشرايينِ حينا
وحينا رسمت بلون الغضبْ
وحين انتهى الرسمُ، ساءلتُ نفسي:
إذا أعلنوا ذاتَ يومٍ وفاةَ العربْ...
ففي أيِ مقبرةٍ يُدْفَنونْ؟
ومَن سوف يبكي عليهم؟
وليس لديهم بناتٌ...
وليس لديهم بَنونْ...
وليس هنالك حُزْنٌ
وليس هنالك مَن يحْزُنونْ!
عزيزي القارئ، إن شئت أن تسبح في عوالم قصيدة "نزار قباني" فتذكّر بأنها منشورة في ديوانه "خمسون عامًا في مديح النساء"، فلعلّ كلمة "النساء" تعدّل بوصلة التأويل لديك إلى المعاني الجميلة المُعطّرة.. ودعني أنحرف بك الآن إلى سؤال قد يبدو بسيطا وساذجًا: ما مصير كلامنا الذي ننطق به؟
للعلم أجوبته التي تحتاج إلى عقل يفقه الفيزياء والأمواج والتردّدات وغيرها من الشؤون المتعلّقة بالصوت، ونتركها إلى مَن يريدا جوابًا علميًّا، وحسبنا الأجوبة البسيطة التي تقول مثلا بأن ما ننطق به يذهب مع الرياح ويتداخل مع الضوضاء ثم يتلاشى.. ولكن ماذا لو أن هناك مكانا ما في هذا الكون تتجمّع فيه أصوات البشرية منذ عهد سيّدنا آدم إلى أن تقوم القيامة، وعندها - ساعة القيامة - يستعيد كل إنسان ما تفوّه ونطق به طيلة حياته.
قد يكون الأمر ضربًا من الجنون أو غلوًّا في المستحيل، ولكنني أزعم بأنه ممكن جدًّا إذا عرفنا بأن لكل إنسان بصمته الصوتية الفريدة - مثل بصمة اليد وقرنيّة العين - التي تميّزه عن غيره من الناس، وهي لا تتغيّر مع مرور الوقت، ولا تتأثّر بالتغييرات التي تطرأ على الإنسان نفسه، وتُستعمل لتحديد هويّته في مجالات حيوية كثيرة مثل النبوك أو حتى في متابعته والتجسّس عليه كما هو الشأن في الكيان الصهيوني. وقد عُرفت أوّل مرّة خلال ستينيات القرن الماضي من خلال دراسة بعنوان "تحديد بصمة الصوت" للمهندس الأمريكي "لورانس ج. كريستا".
تخيّل عزيزي القارئ أن كل ما نطقتَ به طيلة حياتك سيرتدّ إليك، حسب بصمتك الصوتية، ثم ينتظم أمامك مُرتّبًا بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسَّنة، فلا يسعك أن تُنكر حرفًا أو تتنكّر لكلمة أو جُملة! لا تدع الخيال يذهب بك أبعد من هذه السطور، ولندع القيامة إلى يوم القيامة، وتخيّل لو أن الإنسان توصّل إلى علمٍ يستعيد به كلام الأنبياء والعلماء والشهداء.. من خلال بصماتهم الصوتيّة، ربّما حينها، أوّل مَن يتبرّأ من نفسه هو التاريخ، وتاريخ العرب على الخصوص لكثرة ما يزدحم فيه من مآثر وحكايات عن النجدة والبطولة والشهامة ومزايا أخرى تتنافى وتتصادم مع الشخصية "القومية" لعرب اليوم! وهنا أفسح لك المجال واسعًا - عزيزي القارئ - لتتخيّل وتفكّر بالأشخاص الذين ستستحضرهم وتسمع أصواتهم سواءٌ كانوا من الأهل والأقارب أو من الشخصيات الإنسانية العظيمة.
في مدار الكلام والصمت، توجّهت جريدة "الأيام نيوز" إلى نخبة من الكتّاب الأفاضل بهذه الرسالة: يُقال: "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"، "كم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء"، "الكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملكها".. وأمثلة أخرى كثيرة تمجّد الصمت وتربطه بالحكمة والتعقّل، بينما ترى في الكلام طريقًا إلى إثارة الفتن والعداوات والكراهية.. والأمر ينسحب على مختلف الشعوب والثقافات ولا يختص بالثقافة العربية، فهل يندرج الأمر في إطار أدب التعامل والتربية التواصلية بين الأفراد - إن جاز التعبير - أم أن الكلام له خطورته فعليًّا في هدم حياة الأفراد والمجتمعات؟ وهل الصمت من الفضائل في كل المواقف أم أنه يُعتبر جريمة في بعضها؟
ثم أليس الموت هو الدخول في "صمت الأبدية"، والكلام هو دليل الحياة وإحدى النِّعم التي يتميّز بها الإنسان عن غيره من الكائنات، فلماذا نستعجل الموتَ بالصّمت، ومصيرنا سينتهي إلى "صمت الأبدية"!؟ ما هي رؤيتكم للصمت، وهل توافقون على الأمثلة الشائعة حوله، أم تعتبرونه نوعا من السلبية والانهزامية التي قد تصل إلى حدّ الخيانة؟ وما قيمة الصمت في الأدب وتاريخه؟.
عزيزي القارئ، لعلك تُردّد في سرّك المثلَ الجزائري الذي يقول: "المندبة كبيرة والميّت فأر"، وأتّفق معك بأنّ "الأمة العربية" تضاءلت في قوّتها وفعاليتها وتأثيرها إلى أقلّ من الفأر، لا سيما في هذه الظروف التي يُباد فيها الشعب الفلسطيني في غزّة بالتقتيل والتجويع وتخريب التّخريب.. ولكنها "أمّة" لها تاريخها العظيم، لا سيما تاريخها مع مشتقّات "المندبة" مثل: الانتداب والمندوب.. لنقتبس من الطبيعة معنى الصمت والكلام، ولنعتبر الصمتَ لغة الشتاء والسّبات، بينما الكلام هو لغة الربيع والحياة، ونردّد ما قاله الشاعر الجزائري الدكتور "كمال عجالي":
يا كاهن الحيِّ إن الحيّ مفترقٌ - هل من حديثٍ عسانا فيه نتّفق؟
فلنتحدّث فيما نتّفق فيه، ما دام الافتراق هو النهاية الأكيدة لكل لقاء، ولنتذكّر بأن الكلمة مثل الرصاصة إذا خرجت فإنها لن تعود، وهي لن تعتذر إذا ما قتلت أو أحدثت مأساة، أو كما قال "نزار قباني" في قصيدته "أحبك... أحبك والبقية تأتي": إنَّ الرصاصةَ في اللحم لا تتساءلُ من أين جاءت/ وليست تُقدِّم أيَّ اعتذار..

وحيد حمّود (كاتب من لبنان)
الصمت الثوري.. من "محمّد أبو طبيخ" إلى "يحيى السّنوار"
في الاجتماعات التي يُقال إنّها مهمّة، في التّكريمات المزيّفة، في اللّقاءات التي قد يتقاسم فيها البكّاؤون ما بقيَ من جسد الميت، يقف الجميع دقيقة صمت.
دقيقة صمتٍ، يمثّل فيها المتواجدون الحزن، يمسحون وجوههم بمساحيق الشّحوب، قطرةٌ في العين اليمنى وأُخرى في العين اليُسرى وقفا نبكِ يا عَين ويا لَيل من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ.
نحن، وأقصد العرب، ولا أريد أن أبحث في مَن وضع "بروتوكول دقيقة الصّمت"، قد برعنا بها وسُحِرنا بمفعولها، فهذه الدّقيقة هي الدّقيقة المشرِّعة لكلّ ما سنقوم به بعدها، ننسى قضايانا بدقيقة صمت على أرواح مليون شهيد مثلًا، دقيقة صمتٍ على قضايانا المحقّة مثلًا، دقيقة صمتٍ على راحلٍ ذو شأن مثلًا، ما أكثر دقائق الصّمت في حياتنا! وما أقلّ دقائق الكلام، وأنا الآن أفكّر، ماذا لو كانت دقيقة الصّمت تلك، التي ألبسناها بزّةً رسميّةً وقلنا لها: لا تقومي بشيء، وإلّا اتّسخت البدلة، وارتبك البريستيج، ماذا لو خلعت عنها هذا الزيّ الرّسميّ وعادت إلى الشّوارع، تتمردغ في التّراب، تحمل الحجارة، ترمي الصّوت من دون أن تخشى سلطة البريستيج العفِن؟ ماذا لو استبدلناها بدقيقة صَوت مثلًا؟ واسمعوا.
في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والثلاثين من ظهر 24 نوفمبر 1929، ترصّد الفدائيّ ابن بلدة قباطية في جنين "محمّد أبو طبيخ" لـ "نورمان بنتويش" رئيس النيابات العامة البريطاني، الصهيوني، ردًّا على قوانين تعسّفية أصدرها بحق الفلسطينيين خلال "ثورة البراق"، ترصّده وهو خارجٌ من مكتبه في القدس، وأطلق عليه ثلاث رصاصات وأصابه في فخذه، مُنفّذاً أوّل محاولة اغتيال سياسيّة موثّقة في فلسطين، منشئًا بذلك أوّل دقيقة صَوت.
ماذا نعرف عن قصّة الفدائيّ الأوّل "محمّد أبو طبيخ"؟ وماذا كتب الشاعر الفلسطينيّ الكبير "إبراهيم طوقان" في هذا البطل؟
صامتٌ لو تكلّمَا -- نطق النّار والدّما
قُل لمن عاب صمته -- خلق الحزم أبكما
وأخو الحزم لم تزل -- يدهُ تسبقُ الفما
الفتى البالغ من العمر خمسة عشر عامًا، "محمّد أبو طبيخ"، لم يجد في حكومة العدوّ ومن عاونها آذانًا صاغيةً لمطالب شعبٍ مكلوم، تتمزّق أرضه، تُباع وتُشترى على أعين الجميع وما من سامعٍ للصّوت، فارتأى أن يغيّر اللهجة، على مبدأ من لم يسمع يرَ، ملّ من مفردات التنديد ومن دقائق الصّمت، فخلق لنفسه وللثورة الحقّ دقيقة صوت.
قامت "ثورة البراق" تنديدًا بما أقدم عليه "نورمان بنتويش" من سلبٍ لحقوق الشعب الفلسطينيّ، ولم يكن للصوت المقاوِم قيمة حينها إذ هُمّشت النّداءات وأصوات الشجب والتنديد، فقرّر الفدائيّ الأوّل أن يُسمع العدوّ صوتًا آخر، يَعرفه حقّ المعرفة، فأطلق ثلاث رصاصات من مسدّسه على "بنتويش" وكاد يرديه قتيلًا، فأجبر بصوت رصاصاته ذاك الملعون القذر على الاستقالة من منصبه.
في فلسطين، كما في كلّ أرضٍ تُغتصب، معركةٌ كبرى تدور بين الصّمت والصّوت، صمت المتخاذلين المتآمرين، وصوت بنادق المقاومين الأحرار. لقد كفر أهل غزّة بما يُسمّى بالصمت الاستراتيجيّ، وقاوموا المخرز الصهيونيّ بعيونهم الجاحظة المحدّقة والصّامدة، تلك العيون الواثقة بنصر الله مهما اشتدّ الكرب والظلم، والمعركة لا تزال مستعرةً حتى اليوم، وهي باقية إلى أن تُستردّ الأرض المسلوبة، فما كان لبني صهيون أرضٌ يزرعونها وما كان لهم شأنٌ في يومٍ ما.
بين الصّمت والصّوت، معركةٌ لا تنطفئ نارُها، الطفل في فلسطين يصرخ بكم: عودوا إلى شتاتكم، أيّها المبلَسون (كل مبلَس هو مطرود من رحمة ربه كإبليس) المجرمون. إنّ صرخات الأطفال ستقضّ مضاجعكم أبد الدّهر، لن تذوقوا الهدوء يومًا، قالها المقاومون منذ أوّل قدمٍ صهيونيّة داست الأرض المقدّسة، قالها "السّنوار" يوم جاءكم بطوفانٍ من الصوت الفلسطينيّ المجاهد، قالها حين رمى عصاه في وجوهكم فشقّ بها بحر أحلامكم وأمانيكم وأغرقكم يا أقذر فراعنة العصر.
هو بالباب واقفُ
والردى منه خائفُ
فاهدئي يا عواصفُ
خجلاً من جراءته
ما أشبه اليوم بالأمس! ما أشبه أبو طبيخ بالسنوار! رجلان لم يعرفا النّوم، لم يطب لهما الهدوء قبل أن يفجّروها ثورةً في وجوه الجلّادين، هما بالباب واقفان، والرّدى منهما خائفُ، قاما بهزّ عرش العنكبوت المَقيت وأحرقا جبروته بصوتهم الواحد الذي ما عرف الخوف يومًا، تبدّلت الوجوه وبقي الصّوت نفسه: صوت المقاومة.
ألف "محمّد أبو طبيخ" وألف "يحيى السّنوار" يولدون كلّ يوم، من رحم الأمّهات الثكالى يخرجون، حبرهم الرّصاص وأصواتهم الجحيم، يبصقون في وجوه الصمت الدوليّ والتخاذل الكونيّ، يشدّون أياديهم بعضها ببعض، يربطون الحجارة على بطونهم الخاوية وينطلقون، في كلّ زاويةٍ بكم يتربّصون، من تحت الأنقاض يخرجون. في فلسطين يتعلّم الطّفل قتل المغتصب قبل أن يلفظ "ماما" و"بابا"، في فلسطين يعلّمكم صوت الرّصاص دروس التشبّث بالأرض والعرض.
من الفدائيّ الأوّل إلى كلّ الفدائيين، صوتٌ واحدٌ لا يعرف الهوان، إنّ أهل الأرض كلّهم لو اجتمعوا على أن يعلّموا أهل الحقّ الصّمت، سيُخذل الجمع ويولّون الدّبر، وسيبقى صوت الحقّ صادحًا، فدولة الباطل ساعة ودولة الحقّ باقيةٌ إلى قيام السّاعة.

سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
بتسكت أو بسكّتك بمعرفتي؟
كلّ شيء في الحياة يعتمد على العلوم الرّياضيّة، حتى الإنسان، بتكويناته الجسديّة والنّفسيّة يمكن برمجته ضمن معادلات خاورزميّة، وإن وضعنا ما نعرف في مقابلة مع ما نجهل، لكانت المتراجحة كما يلي: ما نجهله > ما نعرفه.
وأظن أنّنا جميعًا نتّفق على أنّ معرفتنا بالأشياء مرهونة بالمعلومات التي أمامنا وتحليلنا لها، ومهما كثرت التّحليلات وتعدّدت، تبقى المعرفة محدودة ضمن نقاط المعلومة الواحدة، وما غاب عنّا منه ما يمكن أن نكشف غراره يومًا، وربّما ألّا يكون مقدّرًا لنا كشف الغطاء عنه. فبعض الأمور قدرها أن تبقى سرًّا، وبعض الأسرار كشفها مصيره الدّمار.
وشتّان بين غياب المعرفة والصّمت عنها، وليس الجهل كتمثيله، وليس كلّ كلام مسموح له أن يُقال. فماذا حين يصرّ اللّسان على رمي نرد الكلام؟ وماذا لو كان الكلام سيفا موّجها صوب صوته؟ ففي علم المعادلات، أكثر معادلة مخيفة لمدّعي الحرّيات:
قوّة الكلام = قوّة الصّمت.
يتوقّف الزّمان لحظات، بين القول وغيابه، وتبدأ التّهديدات: "بتسكت أو بسكتك بمعرفتي؟"، فالبعض عنده حساسيّة من بعض الأصوات، تمامًا كوضع الصّحافيين النّاقلين للحقيقة، فليس هناك من عملية اغتيال "بريئة"، والحقيقة أن إسكات الحقّ هو أكثر ما يبرع به العدوّ. فالصّوت الذي ينقل الصّورة الحيّة، بصدق، بإنسانيّة، بواقعيّة، يهزّ مهد المغيّبين، يفطمهم عن جهلهم، وينقلهم من عالم التّلقين المنقّح ليفتح أمامهم أبوابًا لم يكن ليُسمح لهم بفتحها.
يصدح صوت الحقيقة على مسامع العالم، حتى يغتالهم الصّمت، وليس الصّمت عقابًا لهم، ولكنّه قوّة تضاهي قوّة صوتهم، فلولا إسكاتهم لما فهم العالم الحقيقة المدفونة تحت الافتراءات والتّلفيقات المفبركة، ونسمع حينها عبارة: "لولاهم ما كنّا عرفنا".
ولكن المفارقة هنا، هي عند المنافقين الذين يبدؤون بالمزايدة، "لو صمتوا وطأطأوا رأسهم لكانوا الآن أحياء"، وكأنّهم ضمنوا أنّ العمر لعبة نختار أن نربحها بمواقفنا الانهزاميّة. وكأنّ كلّ شيء قابل للتّفاوض، العمل، الأرض، الرّوح، الحياة، قد يُساوي صمتنا ثمنًا نعجز عن دفعه، ورغم قناعتنا أنّ "السّاكت عن الحقّ شيطان أخرس"، نمثّل الصّمت والرّوح تضجّ بالكلام.
أحيانًا بعض التّفاصيل الصّغيرة تمرّ في حياتنا من دون أن نعيرها أهميّة، أو بالأصح لا نكتشف أهميّتها إلّا حين يُرمى أمامنا نردٌ من الكلمات البسيطة، قرعة تجلي عيوننا لنُعيد النّظر في الأمور كما لم نرَها من قبل. فتخيّلوا لولا هذه الحقائق، لو باع الجميع صوتهم؟ كيف كانت حالنا؟
نعم، أحيانًا نصمت بإرادتنا، فبعض المواقف، في حياتنا الاجتماعيّة، لا تحتاج الكلامَ بقدر ما تحتاج منصتًا للصّمت، وكأيّ أحداث فيلم، تأتِ لحظة حاسمة، تتحرّك الكاميرا بصمت، وننتظر لنكتشف المفاجأة المدوّية التي ستجرفنا إلى حالة مختلفة. فهل فكّرنا بفيلمنا الخاص؟ لحظتنا الحاسمة؟ فقرة الصّمت الخاصّة بنا، ماذا بعدها؟
منهم من يقول: "الصّمت علامة الرّضى"، ومنهم من يقول: "الصّمت أبلغ الكلام"، وآخرون يقولون: "الصّمت عقاب"، "الصّمت دليل ضعف"، "هو دليل قرف"... إلى ما هنالك من أقوال حاولت أن تُقولب هذه الكلمة في قالب خاص، والحقيقة أنّ الصّمت كلّ ذلك، هو ببساطة موقف تعادل قوّته قوّة الكلمة، ولكن الفرق بينهما معتمد على لاعب الدّور، وشطارة الممثّل بإتقانه المشهد، فإمّا أن ينتقل إلى الصّف الأوّل ويأخذ البطولة، وإمّا أن يبقى كومبارس فشل في تجسيد حقيقة المشهد الصّامت.
"سكتت لأنّو مستحية مبيّن موافقة على العريس"، وتبدأ رحلة عذابها لأنّها عجزت عن إيصال رسالة الرّفض كم يجب، "سكت لأنّو ضعيف" ولكنّه ببساطة ملّ من المواجهة، والصّمت في الحقيقة مصحوب بلغات شتّى يحكيها الجسد وقلائل من يُتقن الإصغاء.
ولكن، لكلّ مقام مقال، فكما الكلام يفقد قيمته في بعض المواقف، كذلك الصّمت، والحقيقة أنّنا نكذب على أنفسنا إن ظنّنا أنّنا مررنا بلحظات صمت حقيقيّة، ولكنّه ابتلاع للكلام، يؤرق أرواحنا، ضمائرنا، هدوءنا، ونمثّل أنّنا سننتصر يومًا برصاصة كاتمة للصّوت، تقتل صمتنا، لتحرّر صوتنا من قيود الحلق القاتم.

د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، كلية الآداب ـ جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات العربية، بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر)
موقف الأنام بين الصمت والكلام!
وحديث في الحب إن لم نقله -- أوشك الصمت حولنا أن يقوله
(الشاعر اللبناني جورج جرداق)
بعض الكلام إذا يُقال نحسه -- لكن هذا الصمتَ حتمًا قال لك
(الشاعرة المصرية د. دعاء رخا)
يُقال: "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"، "كم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء"، "الكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملكها".. وأمثلة أخرى كثيرة تمجّد الصمتَ وتربطه بالحكمة والتعقّل، بينما ترى في الكلام طريقا إلى إثارة الفتن والعداوات والكراهية.. والأمر ينسحب على مختلف الشعوب والثقافات ولا يختص بالثقافة العربية، فالأمر يندرج في إطار أدب التعامل والتربية التواصلية بين الأفراد - إن جاز التعبير - كما أنَّ الكلام له خطورته فعليًّا في هدم حياة الأفراد والمجتمعات.
وإذا كان الصمتُ فضيلة في بعض المواقف فإنه يكون جريمة كبرى وخطيئة عظمى في مواقف أخرى، ولهذا قيل إنَّ الساكت عن الحق شيطان أخرس، فكم من حقوق ضاعت بسبب الصمت وكم من مصالح أهدرت بسبب الصمت!
ثم إنَّ الموتَ هو الدخول في "صمتِ الأبدية"، والكلام هو إحدى النِّعم التي يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات، ولهذا فإنَّ على الإنسان أن يستثمر هذه النعمة فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".
أما عن رؤيتي للصمتِ، فإنني لا أوافق على الأمثلة الشائعة حوله بل أعدّه نوعًا من السلبية والانهزامية التي قد تصل إلى حَدِّ الخيانة، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بالوطن ومصالحه، وبالناس ومصالحهم، فالله عز وجل سيسأل كل راع عمّا استرعاه، حفظ أم ضيّع! ومن الحفظ قول الحق وعدم الصمت على الباطل.
ولعلنا نضرب المثل من عالم الطيور، فهذا هدهد سليمان الذي طاف باليمن ووجد بلقيس وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أنكر صنيعهم وأبلغ نبي الله سليمان بقصتهم، قال حين سأل عنه سليمان لما تفقّد الطير وافتقده وتوعّده بالعذاب أو الذبح إن لم يأته بسلطان مبين، قال وقد مكث غير بعيد هيبة لسيدنا سليمان: "فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ..." (النمل، الآية: 22 – 23 – 24)، ثم أنكر عليهم قائلا: "أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ" (النمل، الآية: 25).
والصمت لغة السكوت، صمتَ المتكلم يصمُتُ صمتا وصُماتا صُموتا: سكت، وقيل: أطال السكوت، والصامت الساكت ومن لا نُطق له، والصمت السكوت والصموت كثير الصمت.
وسكت الرجل يسكت سَكتا وسُكوتا وسُكاتا: صمت، وانقطع كلامه، والساكوت والسِّكيت والسَّكُوت: الكثير السكوت.
والصمت والسكوت في القرآن الكريم يشيران إلى ترك الكلام، لكن الصمتَ أبلغ وأعمّ، وقد يكون صمتًا اختياريًا نابعًا من الحكمة والأدب، بينما السكوت قد يكون لسبب قهري أو لعدم القدرة على الكلام، أو حتى بسبب الخوف.
الصمتُ: هو ترك الكلام مع القدرة عليه، وقد يكون نتيجة اختيار وحكمة، أو يكون ميزة لمَن يتّسمون بالأدب والحكمة. والصمت: يدل على قوة الشخصية والحكمة، وقد يكون اختيارًا مقصودًا.
السكوتُ: قد يكون نتيجة لعجز عن الكلام بسبب مرض أو مانع، أو قد يكون نتيجة للخوف والتردد، وهو ترك الكلام مع القدرة عليه. والسكوت: قد يدل على الخوف أو التردد، أو قد يكون نتيجة لظرف قهري.
والكلام: المعنى القائم بالنفس يدل عليه بالعبارات، وينبّه عليه بالإشارات، يقال: في نفسي كلام، والكلام في أصل اللغة الأصوات المفيدة.
وقد ورد الصمت في القرآن الكريم في آية واحدة بصيغة اسم الفاعل في قوله تعالى من سورة الأعراف: "سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ" (الأعراف، الآية: 193).
كما ورد السكوت مرة واحدة في السورة نفسها بصيغة الفعل الماضي منسوبا إلى الغضب في قوله تعالى: "وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ" (الآية: 154).
أما الكلام ومشتقاته فقد ورد في القرآن الكريم ستا وخمسين مرة. ولعل في ذلك إشارة إلى أهمية الكلام وتفضيله عن الصمت.
والصمتُ عن الكلام نوع من الصوم أمرت به السيدة مريم العذراء في قوله تعالى: "فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا" (مريم، الآية: 26).
وقد جعله الله تعالى آية لسيدنا زكريا عليه السلام: "قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا" (مريم، الآية: 10 - 11).
العذراء مريم وفضيلة الصمت
صمتُ العذراء مريم كان الصمتَ المُشبع بالخشوع والاتّضاع والتأمل في محبة الله وعنايته وحكمته، فقد كان الصمت الممزوج بشكر الله، والتسليم لإرادته، فكان قلبها يهتف قائلاً "صَمَتُّ لا أفتح فمي لأنك أنتَ فعلتَ" (مز 39: 9).
وكانت في مريم العذراء، فضيلة الصمت والسكون والتأمل الباطني.. رأت أمورًا عجيبة وغريبة، رأت الملاك يبشرها، ورأت اليصابات تعظمها.. بل رأت يوم ميلاد المسيح عجائب مدهشة: فالملائكة تهتف وتسبح، والرعاة يأتون ويخبرون بما رأوا، والمجوس يُقدمون من المشرق يتبعهم النجم ليسجدوا ويقدموا هداياهم، ثم رأت سمعان الشيخ وجميع الذين ينتظرون الفداء فرحين متهللين بميلاد المخلص.
الصمتُ هو فضيلة مذكورة في الكتاب المقدس، وتُعدّ من الأمور المهمة في الحياة الروحية. يرى الكتاب المقدس أنَّ الصمتَ ليس مجرد غياب للكلام، بل هو حالة من الهدوء الداخلي والتأمل، ووسيلة للاتصال بالله والاستماع لصوته، وفي كل هذه الاحوال كانت العذراء صامتة متأملة! فلا يوجد كلام كثير للعذراء مريم في الكتاب المقدس، ولذلك نسب إليها الكتاب عبارة رددها أكثر من مرة "أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام، متفكرة به في قلبها" (لو 2: 19).
وكان منهجها أحسن أنواع التعليم، ليس بالكلام الكثير إنما بالقدوة والسيرة والمثال، يقول "ابن سيراخ": "المرأة المحبة للصمت عطية من الرب، والنفس المتأدبة لا يستبدل بها" (سيراخ 26: 18). وليتنا نتعلم هذا الدرس الثمين من السيدة مريم العذراء.
والصمت في الشعر العربي هو ظاهرة ذات دلالات متعددة، فهو ليس مجرد غياب للكلام، بل يحمل أبعادًا فلسفية واجتماعية ونفسية، وكان الشعراء يتناولون الصمت في أشعارهم للتعبير عن معانٍ مختلفة، تتراوح بين الحكمة والترفع عن السفيه، وبين الألم والوحدة، وبين قوة التأمل والإحجام عن الكلام في مواقف معينة.
أبعاد الصمت في الشعر العربي
الحكمة والترفّع: كان الصمت يُعتبر من صفات الحكماء، ويُرى وسيلة للتعبير عن الرزانة والبعد عن السفاهة. قال الشاعر العربي في هذا السياق:
إذا نطق السفيه فلا تُجِبه -- فخيرٌ من إجابته السكوت
وقديما قال عنترة بن شداد:
سكتُّ فَغَرَّ أعدَائي السُّكوتُ -- وَظنُّوني لأَهلي قَد نسِيتُ
وكيفَ أنامُ عن ساداتِ قومٍ -- أنا في فَضلِ نِعمتِهم رُبيت
وإن دارت بِهِم خَيلُ الأَعادي -- ونَادوني أجَبتُ متى دُعِيتُ
بسيفٍ حدهُ يزجي المنايا -- وَرُمحٍ صَدرُهُ الحَتفُ المُميتُ
خلقتُ من الحديدِ أشدَّ قلباً -- وقد بليَ الحديدُ وما بليتُ
وفي الحَربِ العَوانِ وُلِدتُ طِفلا -- ومِن لبَنِ المَعامِعِ قَد سُقِيتُ
وَإني قَد شَربتُ دَمَ الأَعادي -- بأقحافِ الرُّؤوس وَما رَويتُ
فما للرمحِ في جسمي نصيبٌ -- ولا للسيفِ في أعضاي َقوتُ
ولي بيتٌ علا فلكَ الثريَّا -- تَخِرُّ لِعُظمِ هَيبَتِهِ البُيوتُ
الألم والمعاناة: كان الصمت أيضًا تعبيرًا عن الألم الداخلي والمعاناة التي قد يعجز اللسان عن وصفها، قال أحد الشعراء:
ولقد هممتُ بأن أقول ولم أقُل -- ما أوجعَ الكلمات ساعةَ تُحبسُ
التأمل والوحدة: كان الصمت يُستخدم كفرصة للتأمل في الذات والابتعاد عن ضجيج الحياة اليومية، والاعتماد على فطنة السامع يقول أحد الشعراء:
وفي النفسِ حاجاتٌ وفيكَ فطانةٌ -- سكوتي بيانٌ عندها وخطابُ
ويقول الشاعر:
ولأنّ بعضَ الحالِ يصعبُ شرحهُ -- آثرتُ صمتًا والسكوتُ مريرُ
فالصمت في الشعر العربي ليس مجرد غياب للكلام، بل هو لغة بحد ذاتها تحمل معاني عميقة ومتنوعة، تعكس جوانب متعددة من شخصية الشاعر وعلاقته بالعالم من حوله.
ومما علق بذهني قول صديقي الشاعر المرحوم الدكتور "عباس عجلان" في ديوانه: "بلاغة الصمت"، من قصيدة بالعنوان نفسه: وأحب فيك بلاغة الصمت.
وهناك أبيات شعرية تُنسب للإمام الشافعي تتحدث عن الصمت، يقول فيها:
قالوا سكتُّ وقد خُوصِمتُ قلتُ لهم -- إنَّ الجوابَ لباب الشر مفتاحُ
والصمتُ عن جاهلٍ أو أحمقٍ شرفٌ -- وفيه أيضاً لصون العرض إصلاحُ
أما ترى الأسد تُخشى وهي صامتة -- والكلب يُخسى لعمري وهو نباحُ؟!
ويقول "نزار قباني" في فلسفة الكلام والصمت بين المرأة والرجل:
قُل لي - ولو كذباً – كلاماً -- ناعماً قد كاد يقتُلُني بك التمثالُ
ما زلتِ في فن المحبة.. طفلةً -- بيني وبينك أبحر وجبالُ
لم تستطيعي، بَعدُ، أن تَتَفهَّمي -- أنَّ الرجال جميعهم أطفالُ
إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجاً -- قزماً.. على كلماته يحتالُ
فإذا وقفتُ أمام حسنك صامتاً -- فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ
كَلِماتُنا في الحُبِّ.. تقتلُ حُبَّنَا -- إنَّ الحروف تموت حين تقال
قصص الهوى قد أفسدتك.. فكلها -- غيبوبةُ.. وخُرافةٌ.. وخَيَالُ
الحب ليس روايةً شرقيةً -- بختامها يتزوَّجُ الأبطالُ
لكنه الإبحار دون سفينةٍ -- وشعورنا أنَّ الوصول محال
هُوَ أن تَظَلَّ على الأصابع رِعشَةٌ -- وعلى الشفاه المطبقات سُؤالُ
هو جدول الأحزان في أعماقنا -- تنمو كروم حوله.. وغلالُ
هُوَ هذه الأزماتُ تسحقُنا معاً -- فنموت نحن.. وتزهر الآمال
هُوَ أن نَثُورَ لأيِّ شيءٍ تافهٍ -- هو يأسنا.. هو شكنا القتالُ
هو هذه الكفُّ التي تغتالنا -- ونُقَبِّلُ الكَفَّ التي تَغتالُ
لا تجرحي التمثال في إحساسهِ -- فلكم بكى في صمته.. تمثالُ
قد يُطلِعُ الحَجَرُ الصغيرُ براعماً -- وتسيل منه جداولٌ وظلالُ
إني أُحِبُّكِ من خلال كآبتي -- وجهاً كوجه الله ليس يطالُ
حسبي وحسبك.. أن تظلي دائما -- سِراً يُمزِّقني.. وليسَ يُقالُ
ويقول الحكماء عن الصمت: الصمت وقت الفوز، ثقة الصمت وقت الغضب، قوة الصمت وقت العمل، إبداع الصمت وقت الإساءة، حكمة الصمت وقت السخرية، ترفّع الصمت وقت الاستفزاز، انتصار الصمت وقت النصيحة، أدب الصمت وقت الحزن، شكواك لله وحده، لا تنطق بالكلام إلا إذا كان كلامك خيرا من صمتك.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبُه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جارُه بوائقه".
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تزال سالمًا ما سكتَّ، فإذا تكلَّمت كُتِبَ لك أو عليك".
"إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب" جملة عظيمة قالها لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه، ولا شك أنها وصية عظيمة جليلة لو عمل بها الناس لاستراحوا وأراحوا، ألا ترى أنَّ اللسان على صغره عظيم الخطر، فلا ينجو من شرِّ اللسان إلا من قيّده بلجام الشرع، فيكفه عن كل ما يخشى عاقبته في الدنيا والآخرة. أما مَن أطلق عذبة اللسان، وأهمله مرخيَ العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هارٍ، يضطره إلى دار البوار، ولا يكبّ الناسَ في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
فعن معاذ رضي الله عنه قال: "كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم في سفر فأصبحتُ يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلتُ يا رسول اللّه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على مَن يسّره اللّه عليه: تعبد اللّه ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، قال: ثم تلا: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المَضَاجِعِ يَدعُونَ رَبَّهُم) [السجدة:16] حتى بلغ (يعملون) ثم قال: ألا أخبركم برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه: قلت: بلى يا رسول اللّه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلتُ بلى يا رسول اللّه، قال: فأخذ بلسانه، قال: كُفَّ عليك هذا. فقلتُ: يا نبي اللّه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم".
ويقول الشاعر:
احـفظ لســانك أيهـا الإنســـــان -- لا يلــــدغـنـــك إنـــه ثعــبـــان
كـم فـي المقابر مـن قتيل لسـانه -- كـانت تخــاف لقـاءه الشــجعان
أَطايبُ الكلام تُورث سُكنى أعالي الجنان
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ في الجنة غُرفًا يُرى ظاهرها من باطنها وباطُنها من ظاهرها، أعدَّها الله تعالى لمَن أطعم الطعام، وألانَ الكلام، وتابع الصيام، وصلَّى بالليل والناسُ نيام".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطِب الكلام، وأفشِ السلام، وصِل الأرحام، وصلِّ بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام".
ومما يدل على عِظم خطورة اللسان قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، ما كان يظنُّ أن تبلغ ما بلغت، يكتُبُ الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظنُّ أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه".
وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله! حدِّثني بأمرٍ أعتصم به؛ قال: "قل: ربي الله، ثم استقم". قلتُ: يا رسول الله! ما أخوفُ ما تخاف عليَّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: "هذا".
ومن حفظ اللسان طول الصمت إلا عن خير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليك بُحسن الخلُق، وطول الصمت، فو الذي نفسي بيده، ما تجمَّل الخلائق بمثلهما". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسول الله! أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة على ميقاتها" قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: "أن يسلم المسلمون من لسانك". وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابيُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! علِّمني عملاً يدخلني الجنة. قال: "إن كنتَ أقصرتَ الخُطبة لقد أعرضتَ المسألة، اعتقِ النسمة، وفُكَّ الرقبة، فإن لم تُطِق ذلك، فأطعم الجائع، واسقِ الظمآن، وأمُر بالمعروف، وانهَ عن المنكر، فإن لم تُطق ذلك، فكُفَّ لسانك إلا عن خير". وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك". وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبُه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يَأمن جارُه بوائقه". وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تزال سالمًا ما سكتَّ، فإذا تكلَّمت كُتِبَ لك أو عليك". وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أوصني. قال: "اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئتَ أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله". قال: "هذا". وأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلها تُكفِّر اللسان؛ فتقول: اتَّقِ الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمتَ استقمنا، وإن اعوججتَ اعوججنا". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن يضمنُ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة". وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرَب اللسان على حدَّته". وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "والذي لا إله غيره؛ ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجنٍ من لسان". وعن أسلم أنَّ عمر رضي الله عنه دخل يومًا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مَه، غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إنَّ هذا أوردني شرَّ الموارد.
ومن عرف دقائق آفات اللسان، علم قطعًا أنَّ ما ذكره صلى الله عليه وسلم هو فصلُ الخطاب، حيث قال: "مَن صمت نجا". فلقد أوتي والله جواهر الحكم، وجوامع الكلم، ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته من بحار المعاني إلا خواصُّ العلماء.
تعلّموا الصمت كما تعلمه الأسلاف
قال "مورّق العجلي" رحمه الله: تعلمتُ الصمتَ في عشر سنين، وما قلتُ شيئًا قط - إذا غضبتُ - أندمُ عليه إذا زال غضبي. وقال "أبو إسحاق الفزاري": كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يطيل السكوت، فإذا تكلم ربَّما انبسط. قال: فأطال ذات يومٍ السكوت، فقلتُ: لو تكلَّمتَ؟ فقال: الكلام على أربعة وُجوه: فمن الكلام كلامٌ ترجو منفعته وتخشى عاقبته، والفضل في هذا: السلامة منه. ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته، فأقلُّ ما لك في تركه خِفَّة المؤنة على بدنك ولسانك. ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته وتأمن عاقبته، فهذا قد كُفي العاقل مؤنته. ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته، فهذا الذي يجب عليك نشره. قال "خلف بن تميم": فقلتُ لأبي إسحاق: أراهُ قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام؟ قال: نعم.
وعن "أم حبيب" زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا أمرٌ بالمعروف، أو نهي عن منكر، أو ذِكر الله".
وفي مدح الصمت والسكوت وذم الكلام يقول الشاعر:
الصمــت زيـن والسـكوت سـلامة -- فإذا نطقت فلا تكــن مكثـارًا
فـإذا نــدمت على ســكوتك مـرة -- فلتندمـن علـى الكلام مـرارًا
وقال "محمد بن النضر الحارثي": كان يقال: كثرة الكلام تُذهب بالوقار. وقال "محارب": صحبنا القاسم بن عبد الرحمن، فغلبنا بطول الصمت، وسخاء النفس، وكثرة الصلاة. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتًا أفضلهم في أنفسهم. وقال "الفضيل بن عياض" رحمه الله: ما حجٌّ ولا رباطٌ ولا اجتهاد أشدّ من حبس اللسان، ولو أصبحت يُهمُّك لسانُك أصبحتَ في غمٍّ شديد. وعن "عمر بن عبد العزيز" قال: إذا رأيتم الرجل يُطيل الصمت ويهرب من الناس، فاقتربوا منه؛ فإنه يُلَقَّن الحكمة. وقال رجل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: ربما أردتُ أن أتكلَّمَ بكلام حسن، أو أُحدِّث بحديث فأسكتُ، أريد أن أُعوِّد نفسي السكوت. قال: تُؤجَرُ في ذلك وتشرُف به. وقال عبد الله بن أبي زكريا: عالجتُ الصمتَ عشرين سنة، فلم أقدر منه على ما أريد. وعن مسلم بن زياد قال: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد أن يتكلَّم حتى يُسأل، وكان من أبشِّ الناس وأكثرهم تبسُّمًا. وقال خارجة بن مصعب: صحبتُ ابنَ عون اثنتي عشرة سنة، فما رأيته تكلّم بكلمة كتبها عليه الكرامُ الكاتبون. وقال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشدُّ على الناس من حفظ الدينار والدرهم.
ترك الكلام فيما لا يعني
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركُهُ ما لا يعنيه". وقال الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد: فإنَّ مَن أكثر ذِكر الموت، رضي من الدنيا باليسير، ومن عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامُه إلا فيما يعنيه. وقال عطاء بن أبي رباح لمحمد بن سُوقة وجماعة: يا بني أخي، إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ) [الإنفطار:10، 11]، (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق:17، 18]. أمَا يستحي أحدكم أنه لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره، كان أكثر ما فيها، ليس من أمر دينه، ولا دُنياه.
وعن الحسن قال: يا ابن آدم، بُسطت لك صحيفة، ووُكِّل بك ملكان كريمان يكتبان عمَلك، فأكثر ما شئتَ أو أقِلَّ. وكان رحمه الله يقول: مَن كثر ماله كثرت ذُنُوبه، ومَن كثر كلامه كثر كَذِبُه، ومَن ساء خلُقه عذَّب نفسه.
وكان "طاووس" يعتذر من طول السكوت، ويقول: إني جرَّبتُ لساني فوجدته لئيمًا راضعًا. (واللئيم الراضع هو الخسيس الذي إذا نزل به الضيف رضع بفيه شاته لئلا يسمعه الضيف فيطلب اللبن). وقال إبراهيم التيمي: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، وإلا أمسك عنه. فاحفظ لسانك أيها الحبيب تنج، وعـوّد لســانك قول الخير تنج به مـن زلة اللفظ أو من زلة القـدم.
وفي مقال لـ "البابا شنودة الثالث" عن الصمت والكلام، وكان شاعرا ومتكلّما بليغًا، يقول: بين الصمت والكلام كثيرًا ما يتحيّر الإنسان: أيهما أفضل: أن يصمت أم أن يتكلم؟ وهكذا عليه أن يحدد موقفه بين الصمت والكلام.
فضيلة الصمت: نلاحظ أنَّ غالبية القديسين قد فضلوا الصمتَ، واضعين أمامهم قول الحكيم: "كثرة الكلام لا تخلو من معصية". وفي ذلك قال القديس أرسانيوس - معلم أولاد الملوك - عبارته المشهورة: "كثيرًا ما تكلمتُ فندمتُ.. وأما عن سكوتي، فما ندمتُ قط".
ومن أجل هذا صلى داود النبي قائلًا: "ضع يا رب حافظًا لفمي، بابًا حصينًا لشفتي".. وقال الوحي الإلهي: "الاستماع أفضل من التكلم" وما أكثر ما تحدثت الكتب الروحية عن: "فضيلة الصمت" ودعت إليها، لكيما يتخلص بها الإنسان من أخطاء الإنسان وهي عديدة.. منها الكذب والمبالغة، وكلام الرياء والتملق والنفاق. ومنها التهكم، والكلام الجارح، والسبُّ واللعن والإساءة إلى الآخرين، والتحدث بالباطل في سيرة الناس. ومنها الافتخار بالنفس والتباهي ومدح الذات. ومنها الكلام البذيء، والقصص والفكاهات الخليعة، وكلام المجون.
ومن أخطاء اللسان أيضًا: التجديف، وكلام الكفر، والتذمر على الله. ومنها التعليم الخاطئ، والضلالة والبدع. ومن أخطاء اللسان أيضًا الثرثرة. لأنَّ الله لم يخلق اللسان فينا لكي يتكلم عبثًا بلا فائدة. لكل هذا فضّل القديسون الصمتَ.. ليس فقط، لكي يبعدوا عن أخطاء اللسان، إنما أيضًا لكي يتيح لهم الصمتُ فترة للصلاة والتأمل. لأنَّ الإنسان لا يستطيع أن يتكلم مع الله والناس في الوقت نفسه. لهذا قال الشيخ الروحاني: (سكِّتْ لسانك، لكي يتكلم قلبك). وقال مار إسحق: (كثير الكلام يدل على أنه فارغ من الداخل)، أي أنَّ قلبه فارغ من مناجاة الله، فارغ من العمل الروحي في التأمل والصلاة.
كلام المنفعة: يبقى بعد كل هذا سؤال هام وهو: هل كل صمتٍ فضيلة؟ وهل كل كلام خطيئة؟ كلا، طبعًا، فقد قال داود النبي في المزمور: "فاض قلبي بكلام صالح".
إذًا هناك كلام نافع ومفيد، وذلك حينما نتكلم بالصالحات. إنَّ الصمت حالة سلبية، بينما الكلام حالة إيجابية. وإنما يدرب الناس أنفسهم على الصمت، حتى يتدربوا على الكلام النافع. الصمت إذًا هو وضع وقائي يحمينا إن كنا نتكلم بدافع بشري. أما إن كان الله هو الذي يفتح شفاهنا، وهو الذي يضع كلامًا في أفواهنا، فحينئذ يكون كلامنا - لا صمتنا - هو العمل الفاضل. كان السيد المسيح يتكلم، والناس "يتعجبون من كلمات النّعمة الخارجة من فمه". والشهيد إسطفانوس تكلم فأفحم المجامع الخاطئة "ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به". وقد قال سليمان الحكيم: "فم الصديق ينبوع حياة".
وقد كان حكماء العالم يجوبون البر والبحر، لكي يسمعوا كلمة منفعة من المتوحدين والنساك في براري مصر وقفارها.. كلام المنفعة هذا، هو كلامٌ من الله يضعه في أفوه أحبّائه، ليبلغوه للآخرين، هادئًا كان أم شديدًا. ومن كلام المنفعة: كلمة النصح لمَن يحتاج إليها، وكلمة العزاء لقلب حزين، وكلمة التشجيع لناشئ أو ليائس، وكلمة التعليم لبناء النفوس، وكلمة الله للهداية والإرشاد، وكلمة البركة، وكلمة الحق وكلمة الحكمة.. إلخ.
نسأل سؤالًا بعد هذا، وهو: إن كان الكلام هكذا نافعًا في بعض الأوقات، فهل يمكن أحيانًا أن يُعتبر الصمتُ خطيئة، تمامًا كما يحسب الكلام الشرير خطيئة؟ وهل يمكن أن نُدان على صمتنا، كما ندان على كلامنا! نعم، أحيانًا ندان على صمتنا.. إنَّ لكل شيء تحت السماء وقتًا. وقد قال سليمان الحكيم: "للسكوت وقتٌ، وللتكلم وقتٌ". فإن كان للتكلّم وقتٌ، فلا شك أننا ندان إذا صمتنا فيه. فالبار لا يتكلم حين يحسن الصمت، ويصمت حين يحسن الكلام. إنما يعرف متى يتكلم، وكيف يتكلم. ويضع لكلامه هدفًا نافعًا روحيًا. وقد قال الحكيم: "تفاحة من ذهب، في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في موضعها". وكثيرًا ما أمر الله الناس بالكلام، فكان يرسلهم أحيانًا للإنذار، وأحيانًا للتبشير، وأحيانًا لإعلان حقه بين الناس. إنَّ الله لا يكلم الناس مباشرة، وإنما يكلمهم عن طريق أحبّائه من البشر. هو يريدنا أن نعلن وصاياه للناس، وقد طلب إلينا أن نكون شهودًا له على الأرض.
فإن صمتنا عن الشهادة للحق، نُدان على صمتنا، وإن صمتنا، وبصمتنا أعطينا مجالًا للباطل أن ينتشر وأن ينتصر فإننا ندان على صمتنا، وإن قصّرنا في إنذار البعض، فأضرّ بنفسه أو بغيره، ندان أيضًا على صمتنا. فإن رأيت إنسانًا يسقط في حفرة وهو لا يدري، هل تقول إنَّ الصمت فضيلة أم تحذّره؟! وإذا لم تحذّره، ألا تدان على صمتك، ويطالبك الله بدم ذلك الإنسان؟ بهذا يكون هناك واجب على الرعاة أن يتكلموا، وواجب مثله على الآباء والأمهات، وعلى القادة الروحيين، وعلى المعلمين، وعلى كل مَن هو في مسئولية.. كل هؤلاء كلّفهم الله أن يقولوا كلمة الحق، وأن يشهدوا لوصاياه في العالم.. ومثل هؤلاء يكون كلامهم أفضل من الصمت. فليعطنا الرب أن نعرف كيف ومتى نتكلم. وليعطنا الكلمة التي تتّفق ومشيئته الصالحة، والتي يعمل فيها روحه القدّوس فلا ترجع فارغة، بل تثمر ثمرًا في قلوب الناس. ويرى الرب ثمار هذه الكلمة فيفرح وتفرح ملائكته، ويكون هو الذي تكلم وليس نحن.. وليتمجد الرب في صمتنا وفي كلامنا، له المجد إلى الأبد أمين.
وقولوا للناس حُسنًا
البِــرّ شيء هيِّن: وجه طليق وكلام ليِّن، فلنرطِّب ألسنتنا بالكلمة الطيبة التي تزيل الجفاء، وتذهب البغضاء والشحناء، وتُدخل إلى النفوس السرور والهناء والمحبة والمودّة والوئام. الكلمة الطيبة، هداية الله وفضله لعباده "وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ" (الحج، الآية: 24)، وهي رسالة المرسلين، وسمة المؤمنين، دعا إليها رب العالمين في كتابه الكريم فقال: "وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا" (الإسراء، الآية: 53). إنّ القرآن الكريم بيّن لنا أهمية الكلمة الطيبة وعظيم أثرها واستمرار خيرها، وبين خطورة الكلمة الخبيثة وجسيم ضررها وضرورة اجتثاثها، يقول جل جلاله: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ" (إبراهيم، الآية: 24 - 26). يقول ابن القيم رحمه الله: "شَبّه الله سبحانه الكلمة الطيبة - كلمة التوحيد - بالشجرة الطيبة لأنَّ الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع".
الكلمة الطيبة هي حياة القلب، وهي روح العمل الصالح، فإذا رسخت في قلب المؤمن وانصبغ بها "صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ" (البقرة، الآية: 138)، وواطأ قلبُه لسانَه، وانقادت جميعُ أركانه وجوارحه، فلا ريب أنَّ هذه الكلمة تؤتي العمل المتقبَّل "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" (فاطر، الآية: 10).
والكلمة الطيبة هي كلمة الحق ثابتة الجذور، سامقة الفروع لا تُزعزعها أعاصير الباطل، ولا تحطِّمها معاول الهدم والطغيان، تقارع الكلمةُ الطيبةُ كلمةَ الباطل فتجتثّها فلا قرار لها ولا بقاء، لا بل "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ" (الأنبياء، الآية: 18).
الكلمة الطيبة حيَّةٌ نابضة، لا تموت ولا تذوي، لأنَّ بذورها تنبت في النفوس المؤمنة الثابتة على الإيمان، المتجددة بتجدد الأجيال، التي تعرف حقيقة وجودها ومعالم طريقها، والتي بها "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ" (إبراهيم، الآية: 27).
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى لأمّته لم يكن فظًّا غليظًا، بل كان سهلًا سمحًا، لينًا، دائم البشر، يواجه الناس بابتسامة حلوة، ويبادرهم بالسلام والتحية والمصافحة وحسن المحادثة، علَّمنا أدب التخاطب وعفّة اللسان، فقال صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء".
إنَّ "الكلمة الطيبة صدقة" كما قال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وأنها تحجب المؤمن من النار؛ ففي حديث عمر بن حاتم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "اتّقوا النار ولو بشقّ تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة" وإنَّ الكلمة الطيبة شعبة من شعب الإيمان؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» (متفق عليه). وبالكلمة الطيبة تتحقق المغفرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام"، بل إنَّ الكلمة الطيبة سبب في دخول الجنة؛ فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمَن ألان الكلام أطعم الطعام بات لله قائمًا والناس نيام" (رواه أحمد في مسنده).
والكلمة معيار سعادة الإنسان أو شقائه، فبكلمة ينال العبد رضوان الله فيرفعه بها إلى أعلى الدرجات، وبكلمة يسخط الله عليه فيهوي بها إلى أسفل الدركات، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلّم قال: "إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالًا يرفعه الله بها درجات وإنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم". فكم من كلمة طيبة كتب الله بها الرضوان: تدفع عن مسلم أذى، أو تنصر مظلومًا، أو تفرِّج كُربة، أو تعلّم جاهلًا، أو تذكّر غافلًا، أو تهدي ضالًا، أو ترأب صدعًا أو تطفئ فتنة؟! وكم من مشاكل حُلّت، وكم من صِلاتٍ قَوِيَت، وكم من خصومات زالت بكلمة طيبة؟! وكم من كلمة خبيثة مزّقت بين القلوب، وفرّقت بين الصفوف، وزرعت الأحقاد والضغائن في النفوس وخربت كثيرًا من البيوت؟ فمَن ألجم لسانه بلجام الإيمان وعطّره بطيب الأقوال قاده الرحمان إلى الرضوان وأعالي الجنان، ومَن لطَّخَ لسانه بقبح الكلام من زور وفُحش وكَذِب وبهتان هوى به الشيطان إلى دركات النار "وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟!".
والسلف الصالح والمؤمنون الصادقون الصالحون كانوا يتعهّدون ألسنتهم ويحرصون على انتقاء كلماتهم وألفاظهم فعاشوا أتقياء أنقياء أصفياء وسعداء. فهذا "الأحنف بن قيس" يخاصمه رجل فيقول له: "لئن قلتَ واحدة لتسمعن عشرًا"، فيقول له الأحنف: "لكنك والله لو قلت عشرًا ما سمعتَ واحدة". يقول "وهب بن منبه": "ثلاث من كُنّ فيه أصاب البر: سخاوة النفس، والصبر على الأذى، وطيب الكلام"؛ إنَّ الكلام الليّن يغسل الضغائن المستكنّة في النفوس، ويحوّل العدو اللدود إلى حميم ودود. مرّ يهودي يجرّ وراءه كلبًا بإبراهيم بن أدهم فأراد أن يستفزّه فقال له: يا إبراهيم أَلِحيتك أطهر من ذَنَب هذا الكلب أم ذنبه أطهر منها؟ فردّ عليه إبراهيم بهدوء المؤمن وأدبه وقوة حجّته: إن كانت لِحيتي في الجنة فهي أطهر من ذَنَب كلبك، وإن كانت في النار لذنب كلبك أطهر منها.. فما كان من اليهودي إلا أن قال: دينٌ يأمر بهذه الأخلاق حريّ بي أن أتّبعه، ونطق الشهادتين!
وقد جاء في "حلية الأولياء": قال الإمام سفيان الثَّوري رحمه الله: عليك بقلّة الكلام يلين قلبك.. وعليك بطول الصّمت تملك الورع.
ويقول الشاعر "سعيد يعقوب" في أهمية الكلام بين المُحبّين:
أَعِد مَا قُلتَ لَم تَسمَعهُ أُذنِي -- أَعِدهُ عَلَيَّ كَرِّرهُ طَوِيـــــــلا
فرددتٌ عليه قائلا:
أعيد كما أردتَ حبيب قلبـــــي -- أكرره لتسمعـــــه طويــــلا
أحبك يا حبيب القلب حبــــــــا -- أقمتُ عليه يا روحي الدليلا
فما لي يا حبيب أروم وصـلا -- وتأبى أن تمهد لي السبيــلا
فأمسي حائرا والقلب مضنى -- وأصبح هائما أبغي الوصولا
يلوم الناس من يهوى لجهل -- ومن يجهل ترى فقد الأصولا
فدع عنك الملام اليوم واطرح -- كلام الناس، أو قالا وقيلا
وقــل يا قوم زيدوني ملامــــا -- فإن اللوم يمنحني مقيـــلا
فشوقي للحبيب يفوق طوقي -- وأخشى أن يصيرني قتيلا
وقد قلتُ في بلاغة الصمت بين المُحبّين:
لا تكسري قلبي فديتك إنني -- أخشى عليك، فأنت في أعماقه
ولذاك أحفظه وأفدي ساكنا -- متربعا متمكنا بقراره
ملك الفؤاد فصار طوع يمينه -- يكفي الفؤادَ إشارة ببنانه
قالت: كثيرٌ، قلتُ: هذا بعض ما -- جَنّ الفؤاد وحِرتُ في تبيانه
قالت: عجزتُ عن الكلام، فقلتُ: لا -- تتكلمي، فالصمتُ خيرُ بيانه
ما لا يُقال بلاغةٌ نحيا بها -- قد ألهمت شعرا نلوذ ببابه
فاحمر خدَّاها لفرط حيائها -- وتنهدت، يا للفؤاد وما به!
ولعلي أسهبتُ في القول وأسرفتُ في الكلام، ولهذا يجب أن ألوذ بالصمت معتذرا للقارئ الكريم، ويمكنه أن يأخذ من كلامي ما يروقه ويدع ما لا يسيغه، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
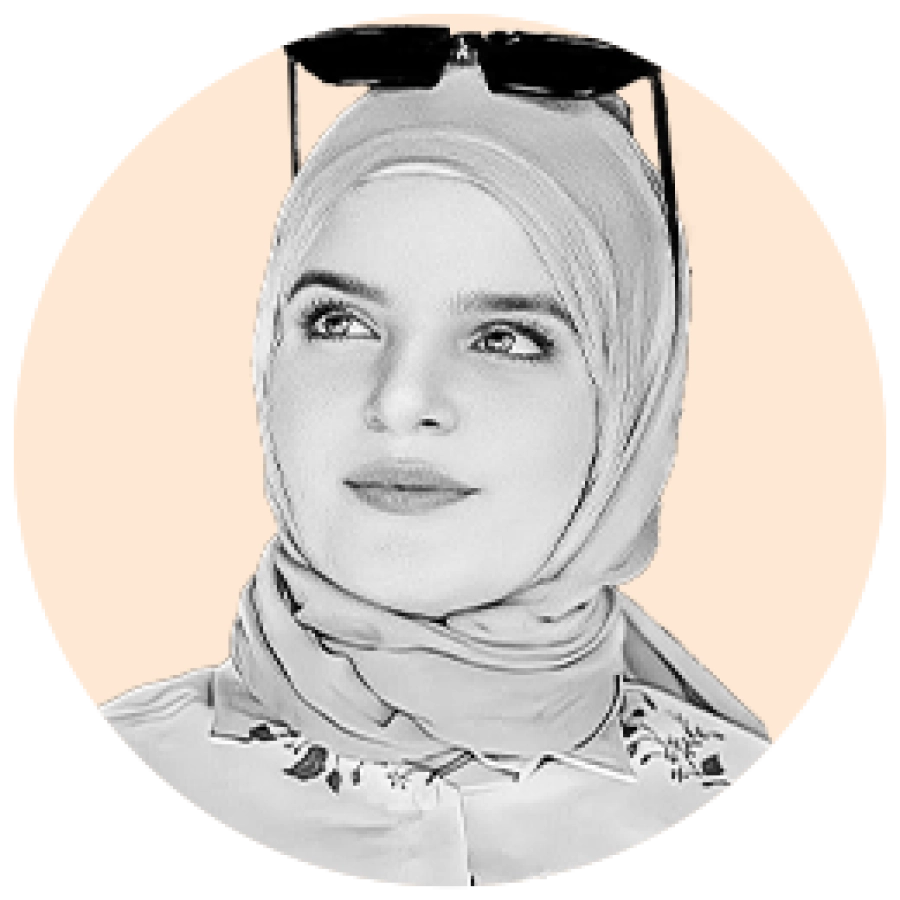
عدوية موفق الدبس (باحثة وكاتبة سورية - لبنان)
في لحظة الحقيقة.. الكلام شجاعة والصمت خيانة
منذ اللحظة الأولى التي ننطق فيها كلمة، تبدأ الحياة في رسم ملامح وعينا. أحيانًا تكون الكلمة الأولى التي نتعلّمها: بابَا، إذا كانت الأم راضية عن زوجها، وابتسامتها تسند حروفه على شفتَي الطفل. وأحيانًا تكون الكلمة الأولى: ماما أو مامي إذا كانت في قلبها غصّة، فتُوجّه الطفل ليبدأ بها. هكذا، منذ البداية، تندسّ العواطف في التعليم، وتختبئ النوايا خلف الكلمات.
نكبر قليلًا، فنكتشف أننا نحمل أسرار البيت معنا كما نحمل ألعابنا. نسمع حكايةً هنا أو نرى مشهدًا هناك، فنسرع بنقله دون وعي: "حتى بابَا يفعل هذا، وأمس صرخ بشدة على أخي"، نحكي التفاصيل الصغيرة كما لو كانت جزءًا من لعبة الحكي. لا ندرك أن للكلام أحيانًا ثمنًا، وللصمت أحيانًا وزنًا أكبر.
ثم نكبر أكثر، ونتعامل مع المشاعر ببراءة لا تعرف الأقنعة. يسألنا أحدهم: هل تحبّني؟ فنجيب فورًا: نعم أو لا، بلا مواربة ولا حسابات. لكن شيئًا فشيئًا، تبدأ ذاكرتنا بحفظ مشاهد لا تزول.
أتذكّر بوضوح يوم صاح شقيقي من شرفة المنزل للجارة قائلًا: "ماما هنا، لكنها متعبة ولا تريد أن تفتح لكِ الباب". وأتذكّر حين كسرت عمّتي طبقًا ثمينًا لجدّتي، وأوصتني ألّا أخبر أحدًا، بينما أمام عيني كان ابن عمي يُعاقب لأنه مشاغب، فقط لأنه مُتّهم جاهز لكل خطأ.
لا أنسى أول مرة تذوّقت فيها طعم الغشّ. كنت في الصف الرابع، حين كتبت المعلمة نص الإملاء على اللوح، وأوصتنا: لا تنقلوا، الله يراقبنا. لكن صديقتي همست لي: يمكننا النقل ولن يحدث شيء. وبعد جدال خافت بين خوف القلب وفضول العقل، استسلمت... وكتبت، ولم يعرف أحد، إلا الله وصديقتي وأنتم الآن.
وحين قالت لي أمي: لا تخفي شيئًا، قولي الصدق مهما كان الأمر، كنت أظن أن الصدق طريق واحد لا يتفرّع. لكن في اليوم التالي قالت: إذا سألك أحد عن أسرار البيت، قولي: لا أعرف. كيف يتعلّم الطفل الصدق والكذب في الوقت نفسه، والكلام والصمت معًا؟!
كبرنا، ورأينا كيف أن ما يظنه الناس أرقى الكلام، وما يعدّونه أجمل الصمت، ليسا دائمًا كما يُقال. اكتشفنا أن الصمت عن أسرار البيت ليس كذبًا ولا ضعفًا، لكن الصمت عن الحب قد يسرق العمر من بين أيدينا، ويفرّق بين قلبين كان يمكن أن يجتمعَا، فقط لأن أحدهما اختبأ خلف حكمةٍ كانت غطاءً للخوف. ليس عيبًا أن نقول: لا نريد استقبالهم في منازلنا، أو لا نرغب بالحديث الآن. لماذا نختار الصمت على حساب راحتنا، وهي أغلى من الذهب؟
أما الصمت عن الظلم، فهو خيانة صريحة، قبض العرب ثمنها بأغلى ما في خزائنهم، ورفعوا شعارًا لامعًا يخفي وراءه العجز والخذلان. لكن من بدّل الحق بالزيف، باع نفسه مع الحقيقة، وأرسل روحه إلى الغياب.
كبرنا وعرفنا أن الكبار قد يقفون أمام لجان التحقيق، يضعون أيديهم على كتاب الله، ويقسمون أن يقولوا الحق، ثم يستديرون ليغرقوا في صمت مصقول بعناية.
الصمت ليس جريمة، ولا الكلام خطيئة، لكننا نحن الذين قلبنا الموازين: صمتنا حيث كان يجب أن نتكلّم، وتكلمنا حيث كان الصمت أنبل. وقفنا متفرّجين أمام أرواح رحلت جوعًا، ثم ملأنا ليالينا بالولائم والرقص.
متى سنفهم أن الحكمة ليست في الانحياز المطلق للصمت أو للكلام، بل في إدراك اللحظة التي يصبح فيها الكلام شجاعة، والصمت خيانة، والصوت حياة، والسّكوت موتًا؟

سحر قلاوون (كاتبة من لبنان)
فنّ الصمت والكلام
لعلنا وجدنا أنفسنا، في مواقف كثيرة، لا ندري أنسكت أم نتكلم، فأصبحنا كالتماثيل غير قادرين على فعل شيء، وجُلّ ما نتمناه هو أن نختفي من الوجود.
منذ الصغر نتعلم نُطق الحروف ومن ثم الكلمات فالجُمل، فنغدو قادرين على إلقاء الخطابات الرنانة. نصرخ، نعاتب، نكذب، نشتم، ندعو على فلان وعلّان... وغيرها الكثير من الطرق التي نستخدم من خلالها الكلمات التي تعلمناها، فندمّر حياتنا، وليس حياة أيّ أحد آخر، فأنا أؤمن وبشدة أن ما نقوله ونفعله يعود إلينا، فإن خرجت من قلبنا دعوة بالخير لشخص ما فإنها ستعود إلينا عن قريب، وإن تمنّينا له شرًّا فنحن أول من سنرى هذا الشر، لذلك علينا الانتباه جيدا إلى ما نقوله لأنه سيلّف ويدور ويعود إلينا.
لكن هذا الكلام لا يعني أنه علينا أن نلتزم الصمت، بل علينا أن نحترم الأحرف والكلمات فنضعها في جملة مفيدة، كما تعلمنا عندما كنا تلاميذ في المدرسة.
فإن كانت ستخرج من فمنا كلمة بذيئة، أو دعوة بالشر، أو كذبة لعينة، أو عبارة ستجرح قلب شخص ما، فلنصمت. فلنصمت ولنحترم أنفسنا ومَن حولنا بدلا من أن نستخدم تلك النعمة التي أعطانا إيّاها الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة الكلام، في شيء يغضبه. أما الكلام، فهو جوهرة نادرة وعملة قوية وسلاح فتّاك، فعلينا التعامل معه بحذر وذكاء ووعي.
فإن رأينا شخصا يتعرض للظلم، فلنصرخ، فلنصرخ بأعلى صوتنا ليُرفع الظلم عن المظلوم. وإن شاهدنا من يتنمّر على أحد ما، فلنقل كلمة توقفه عند حدّه ولنجبر قلب من تعرض للتنمر بكلمة جميلة. وإن علمنا أن أحدهم يشتاق لسماع كلمة تشجعه وتدفعه للسير إلى الأمام، فلنسمعه إياها، وإنه والله لن ينساها وستبقى محفورة في قلبه إلى الممات، فمثلما لا ينسى الشخص كلمة جارحة سمعها، لن ينسى كلمة حلوة وصلته في وقت كان فيه في أشدّ الحاجة إليها. بإمكان كلمتنا أن تكون بلسمًا للجراح، وبإمكانها أيضا أن تكون سُمًّا قاتلا، ولنختر نحن ما نريد.
وبين الصمت والكلام، ليس هنالك مقارنة، فنحن لسنا مدعوين لاختيار أيّهما أفضل، بل حريٌّ بنا أن ندرك أهمية وقيمة كل منهما، فرأس الحكمة هو معرفة فضيلة الصمت وعظمة الكلام.
إنني أرى أنه مثلما هنالك فنّ الرسم والتصوير والكتابة والطبخ وإلى ما لا نهاية من أنواع الفنون، هنالك فن جميل جدا ونحن بحاجة لتعلمه ومن ثم لممارسته فإتقانه، وهو "فن الصمت والكلام"، من خلاله نستطيع معرفة متى يجب علينا أن نلتزم الصمت ومتى وماذا نتكلم، فهنيئا لمن بدأ بتعلّم وممارسة هذا الفن وهنيئا لمجتمعه به.

ردوان كريم (كاتب من الجزائر)
الصمت لغة الحكماء.. بين قوة الكلمة وبلاغة السكوت
كل يوم نلتقي، ونرى ونسمع مُتحدّثين كُثرًا من كل زاوية ووجهة من ربوع الوطن والعالم عبر وسائل التواصل والاتصال؛ ضجيج وضوضاء لا تنتهي. رسائل كثيرة، بعضُها يرفضها الدماغ، وبعضُها يُجبَر على تقبّلها، في حين أن المقبول منها قليل. فإذا كان العقل البشري يهرب من الصوت والكلام بكل أشكاله إلى الصمت والسكوت بحثًا عن الهدوء والراحة، فهل الصمت يقول ما لا يُقال قولًا؟
المعاني العميقة والقرارات الجريئة تتولّد وتُتّخذ في الصمت الذي يفصل بين الجمل والكلمات، ويصوغ أفكارًا دون كلمات. يصمت الحكيم والمتأمّل، فذاك هو رداؤه وسلاحه؛ فهو يدرك أن التوقيت أهم من القول نفسه. أرواح العظماء تخلد للسكون قبل شرارات التغيير.
وهو ملجأ العباد للصلاة، ودواء المتعبين. الصمت ليس غيابًا عن الواقع كما يظن البعض، بل حضورٌ من نوع آخر، أكثر تركيزًا، وأشد تأثيرًا، وأصدق وقعًا. إنه ابتعاد عن زحمة الأخبار وثرثرة الشاشات، للتقرب من الواقع الحقيقي.
الصمت في الموسيقى يُحدث إيقاعًا وتوازنًا، ولا يُختار موضعه عبثًا، فقيمته لا تقل شأنًا عن الصوت.
الحوار فن لا يدركه إلا القليل. فالحوار كالمعزوفة الموسيقية، كل كلمة فيه كالنوتة التي لها وزن وموضع، وأيّ خطأ في اختيارها أو مكانها يُفسد النّغمة.
في الحوار، يختار المتحدث العاقل كلماته بعناية، فكل كلمة لها وزن وقيمة، يَعي معناها والغرض من استخدامها وما يترتب عليها. بعض الكلمات تكون دافئة، تشعّ محبّةً وإخاءً وحكمةً. وبعضها الآخر يكون باردًا، جامدًا، يحمل امتعاضًا ونفورًا وكرهًا. فمثلما تكون بعض الكلمات على قلوب الناس كرشّ الماء على الورد لتنمو وتتفتح زهورًا، هناك كلمات كالسمّ واللكمة والطعنة، تحمل من الوجع والأذى ما يحمله الفعل.
في الحوار، نتحدث لإيصال فكرة إلى المستمع، وسكوته ونحن نتحدث من أخلاقه وفهمه لطبيعة الحوار، وإنصاتنا واستماعنا لأقواله ليس إحجامًا عن الكلام فقط، بل إعمالٌ للعقل للتمعّن في الأقوال التي تصلنا، ومنح فرصة لأنفسنا لمعرفة ما يريده المحاور.
أدب الحوار: كلامٌ نقوله وصمتٌ حين يُقال لنا كلام
الكثير من المتحدثين الفاشلين لا يُجيدون الاستماع، الذي هو الصمت بين الكلام، والذي لا يُقيمون له وزنًا. فالمثل الشعبي يقول: "الكلام مثل الرصاص، عندما تُطلقه لا يعود إلى فوهته"، لكن من لا يَزِن كلامه لا يزن الكلمات التي يتلقّاها، فلا يعي معناها. لذلك وُجد المثل الشعبي القبائلي القائل: "الكلمة الموزونة على صدر العدو العاقل رصاصة قاتلة، أما التي تُرجِعها لأحمق فهي ذخيرة ناقصة".
الكثير من الشخصيات السياسية والتاريخية والأدبية، والعديد ممن عاشوا مواقف مهمة وأحداثًا تاريخية ذات أهمية قصوى في مجالات عدة، اختاروا السكوت عمّا شاهدوه وعايشوه. لم يدلوا بدلوهم، ولم يُخبروا أحدًا عن موقفهم ورأيهم فيما حدث: كيف؟ ومن؟ ومتى؟ ولماذا؟ لم يسردوا قصتهم، ولم يقصّوا ذلك الجانب من ذاكرتهم لينيروا بها المجتمع ويكشفوا الغموض عن وقائع من الماضي لها تأثير على الحاضر والمستقبل.
نكتفي، في كل مرة يودّع أحدهم الحياة، بالقول: "لقد رحل في صمت، حاملًا معه حقائب أسراره. رحل وأخذ معه جزءًا من التاريخ غير المكشوف".
فهل سكوت الشخصيات الوطنية والعالمية المهمة عن سرد ذاكرتهم ومذكراتهم فيه فائدة ومنفعة، أم أنه خسارة للتاريخ الجماعي ولمحبّي معرفة الأحداث بظروفها وتفاصيلها؟
وهل الحديث عن الأحداث المهمة سيعيد تشكيل وفهم التاريخ (سواء في مجالات الثورات أو الرياضة أو الأدب أو الفن) بطريقة أحسن وأفضل، أم أنه سيعود سلبًا على المجتمع، كون الكشف عن خبايا وأسرار الأشياء يفقدها هيبتها وعظمتها وقدسيتها؟
في وقتٍ اختارت فيه بعض الشخصيات الأدبية والسياسية والرياضية وغيرهم كتابة مذكراتهم قبل وفاتهم، أثناء راحتهم، بعيدًا عن أحداث الماضي زمنيًّا وعاطفيًّا، كشفوا عن أحداث وأسرار لم يكن أحد يعلم بها من قبل. قدّموا دروس خبرتهم وتجربتهم، وجهة نظرهم، اعترفوا بأخطائهم، وافتخروا بنجاحاتهم، فشكّلوا قدوة لغيرهم، وأضافوا موضوعات جديدة للدراسة والبحث والخوض فيها من طرف الدارسين والباحثين والمعنيين والمهتمين.
هناك من هتف لهم ورفع لهم القبعة بعد ذلك، لكن هناك من قوبل بالسبّ والشتم، واتُّهِم بالتكبّر وتزوير التاريخ وغير ذلك. فكان اختياره للكلام نقمة لا نعمة.
في عالم السياسة، حيث يتغذّى الحوار السياسي على قرارات وأقوال السياسيين وردود خصومهم، واستغلال الجميع لأخطاء وزلّات بعضهم البعض، لا يتكلم السياسي لمجرد الكلام، بل تكون كل جملة محسوبة وموزونة. تجد رؤساء دول وأحزاب يتصدّرون عناوين الصحف لمجرد تصريح قوي المضمون أو لتفاهة ما قالوه. فمثلًا، أغلب الخرجات الصحفية للرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" الاستفزازية والكوميدية أثارت سخط بعض الأوساط لدى الشعب الأمريكي من جهة، ومن جهة أخرى لدى الدول التي تناولها في خطاباته.
الأمر لا يقتصر على دولة قوية كأمريكا فقط، بل يشمل حتى الدول الضعيفة، إذ إن تصريحات قادتهم غير المدروسة وقراراتهم التي تفتقر إلى رؤية بعيدة المدى قد تخلق لهم مشاكل، وقد تؤدي إلى حروب وخلق عداءات مع خصوم جدد، ما كان لها أن تكون لو أخذوا الوقت الكافي قبل إعلان مخطّطاتهم وآرائهم. وخير مثال على ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت أغلب قرارات وتصريحات الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" سببًا في تفاقم الأزمة.
الأحداث السياسية لا تحتمل السكوت أو الصمت، لأن في ظل هذا الفراغ تُبنى الكثير من التوقّعات وتُنسج العديد من السيناريوهات، ما يضع الصامت في موقف لا يُحسد عليه. فبدلًا من الصمت، يُفترض في السياسة اختيار ما يجب قوله في الوقت الراهن، وتأجيل ما يُفترض الإحجام عنه إلى وقت لاحق، من أجل تسيير الأحداث وتخفيف الضغوطات.
هناك قادة سياسيون أحسنوا اختيار وقت الكلام وما يجب قوله، فتركوا وراءهم خطابات تاريخية يُعاد قراءتها ودراستها جيلًا بعد جيل، ويستلهم منها الطلاب والمناضلون السياسيون، كخطاب "مارتن لوثر كينغ": "لديّ حلم".
بعض الشخصيات الرياضية من لاعبيـن ومُدرّبين، قبل التحديات الرياضية وبعدها، يجرون مؤتمرات صحفية يتحدثون فيها عن الحدث من وجهات نظرهم. في كثير من الأحيان، يتعرضون بعد ذلك إلى التنمّر والاستهزاء، خاصة إذا كانت النتائج سيئة وهزائم. بعض التصريحات غير المحسوبة مسبقًا تخلق غضبًا جماهيريًا يؤدي إلى إقالات وفسخ عقود. ويعود ذلك إلى غياب الخبرة في التعامل مع المشكلات، ولكن بالأخص إلى ضعف تقنيات الحوار الهادف، وعدم القدرة على ترويض الأسئلة لتناسب ما يود الرياضي التعبير عنه، وما ترغب الجماهير التواقة للفوز وتحقيق البطولات في سماعه.
في المقابل، هناك شخصيات رياضية تختار السكوت والصمت لتجنّب تفاقم المشاكل، معتقدين أنها فترة عابرة وسرعان ما ينسى الصحفيون والجماهير خيبة الأمل. وقد ينجح هذا الخيار مع البعض، لكن مع آخرين تتفاقم المشكلة بسبب السكوت والغموض الذي يكتنف الواقع الرياضي لصاحبها.
الكلام من ذهب، وليس من صدأ، إذا كان صادقًا، قصيرًا موجزًا، عميق المعنى، واضحًا ليس فيه غموض، مركزًا على الموضوع، يُقال بهدوء دون انفعال، فيه من الاحترام والأسلوب المُهذّب ما لا يجرح ولا يخدش، بل يحمل حكمة.
والصمت من ذهب، وليس مجرد فراغ صوتي، في زمانه ومكانه، ويكون اختيارًا واعيًا معوّضًا للكلام؛ احترامًا للآخر وتجنبًا للجدال، وتأملًا وتركيزًا وتصفية للفكر.. إنصات عميق يتيح الفهم، ويضفي الهيبة والوقار.
أولم يقل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا غضبت فاسكت"؟
وعليه، فالصمت تحكُّم في النفس وتجنّب للندم.

سامر المعاني (كاتب من الأردن)
السّكوت في زمن الكلام
في زمنٍ يتسارع فيه الكلام وتتعدّد فيه وسائل التواصل، يطرح السؤال عن قيمة الكلام والسكوت نفسه بطرق جديدة. قديمًا، قيل إن "الكلام من فضة والسكوت من ذهب"، مما يشير إلى أن للسكوت قيمة أكبر من الكلام في كثير من الأحيان. لكن، هل ما زال هذا المثل يصدق في عصرنا الحالي؟ وهل الصمت مطلوب في زمنٍ يبدو فيه الكلام ضروريًّا للوقوف ضد الظلم والجوع والحروب؟
يُعتبر الكلام أداة قوية يمكن استخدامها لبناء جسور الفهم والتفاهم بين الناس. من خلال الكلام، يمكننا التعبير عن مشاعرنا وأفكارنا، والتواصل مع الآخرين بطرق مختلفة. في مواجهة القضايا الاجتماعية والسياسية، يصبح الكلام ضروريًّا لرفع الوعي وتغيير الواقع. في حالات الفقر والبطالة والحصار والجوع والحروب، قد يكون الكلام هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للاحتجاج والتنديد والمناداة بالتغيير.
تكمن قيمة الصمت من ناحية أخرى ويمكن أن يكون ذهبًا في مواقف معينة. عندما نختار الصمت نعطي لأنفسنا الوقت للتفكير والتأمل. وربما نمنع أنفسنا من التورّط في كلام قد نندم عليه لاحقًا. في بعض المواقف يكون الصمت استراتيجية ذكية، خاصة عندما يكون الكلام قد يؤدي إلى مزيد من التوتر أو المشاكل.
في زمنٍ يتّسم بالصراعات والاضطرابات، يبدو أن الكلام يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، يظل السكوت مطلوبًا في بعض الأحيان، خاصة عندما يكون الكلام غير مجدٍ أو قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع. في مثل هذه الحالات، قد يكون الحياد في الكلام والصمت عن بعض الأمور هو الخيار الأمثل.
رفض الصمت والحياد والتنحي عن الكلام رفضا تاما ويكون أشبه بالجبن والتخاذل في حال الظلم والفقر والبطالة والحصار والجوع والحروب في بلداننا، من هنا يصبح من الصعب الحفاظ على الحياد. في مثل هذه الحالات، يصبح الكلام ضروريًّا للتعبير عن الرفض والاحتجاج. ومع ذلك، يجب أن يكون الكلام مدروسًا ومبنيًا على فهم عميق للقضايا المطروحة، حتى لا يؤدي إلى مزيد من التعقيدات.
يمكن القول إن الكلام والسكوت كلاهما له قيمته في السّياقات المختلفة. في بعض الأحيان، يكون الكلام ضروريًّا للتعبير عن الأفكار والمشاعر، بينما في أحيان أخرى، يكون الصمت هو الخيار الأفضل. في مواجهة التحديات الكبيرة مثل الفقر والبطالة والحصار والجوع والحروب، يصبح الكلام ضروريًّا للاحتجاج والتغيير، ولكن يجب أن يكون مدروسًا ومبنيًّا على فهم عميق للقضايا المطروحة. بهذه الطريقة، يمكننا أن نجد توازنًا بين الكلام والسكوت، ونسعى نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وسلاما.

زينب أمهز (كاتبة وباحثة من لبنان)
لغة الخذلان.. وجعٌ لا يُقال
"أحمدُ البلاغة الصمت، حين لا يحسن الكلام"، "إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب"، "لا تترك لسانك يسبق عقلك"، "الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل"، "الصمت هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك أبدًا"، وعن الإمام علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه): "لا حافظ أحفظ من الصمت"، "قلب الأحمق في فيه، ولسان العاقل في قلبه"، "يُستدل على عقل الرجل بحسن مقاله"، "الصمت آية الحلم"، "اللسان ترجمان العقل"، "نِعم قرين الحلم الصمت"..
والكثير الكثير من الأقوال والأمثال التي تتحدث عن الصمت ونعمة الصمت، لكن ما هو الصمت، ولِمَ نلجأ إليه؟ عِلمًا أنّ الأمثال لا تأتي من عبث، بل هي خلاصة تجارب أصحابها.
الصمت يا أعزّائي ليس عجزًا، بل فنٌّ راقٍ لا يتقنه إلا الحكماء. هو كدواءٍ إن أُحسن استخدامه شفى، وإن أُفرط فيه قتل. فلا تترك لسانك يسبق عقلك، فإن اللسان سيف، وجرحه لا يلتئم بسهولة. لذا نجد الكثير من الحِكم لا تُعدّ، تُجمع على قيمة الصمت لا بوصفه غيابًا للكلام، بل حضورًا للتأمُل، وضبطًا للنفس، وفطنة في اتّخاذ الموقف المناسب.
لكن هل الصمت يُعدّ علامة رضى؟
ليس كل سكوتٍ قبولًا، ولا كل صمت رضى. قد نصمت لأنّ الألم أكبر من أن يُقال، أو لأن الكلام لن يغيّر شيئًا، أو لأن الصمت أحيانًا أقوى صرخة. نعم، الصمت نِعمة حين يُنقذ من خطأ، وحكمة حين يُغني عن جدال، ووقار حين تُحفظ به الكرامة.
وقد دخلت حكايات تُمجّد فضيلة الصمت إلى أدب الأطفال منذ القِدم، على ألسنة الحيوانات، كقصة الغراب والثعلب، وقصة البطتين والسلحفاة. فلو أنّ الغراب صمت، لما خُدع بكلمات الثعلب وسُلب طعامه، ولو أن السلحفاة لم تتكلم، لما أفلتت من بين منقاري البطّتين وسقطت من السماء. نستخلص من هاتين القصتين أنّ الصمت في بعض الأحيان نجاة، وأنه قد يفوق الكلام حكمة وأثرًا.
وفي حياتنا اليومية، نلجأ إلى الصمت في مواقف كثيرة... لكن لماذا؟ هل لأننا لا نُحسن الرد؟ أم لأننا لا نملك ما نقول؟ الحقيقة أن للصمت دافعًا أعمق.
كنتُ يومًا من أولئك الذين لا يسكتون، لا سيّما حين أرى الظلم أو الباطل، فقد كانت كلماتي درعي، وصوتي سلاحي. وكم كانت والدتي، رحمها الله، تردّد على مسامعي: "إنتِ ما بتعرفي تعيشي، كلامك دَج!" نعم، لأنني كنت أظن أنّ قول الحق واجب في كل حين، حتى لو لم يلقَ قبولًا، وكل ما دون ذلك هو بالنسبة لي كذب في زمنٍ بات الغالبية فيه يمتهنون النفاق والتمثيل.
لكن، وكما تغيّر الزمان، تغيّرنا. علّمتني الحياة أنّ ليس كل من ينطق بالحق يُنصَف، وأن كثيرين لا يريدون حوارًا بل معركة. في الماضي، كنت أجادل وأدافع حتّى الرمق الأخير، أمّا اليوم، فأنا أشرح وجهة نظري مرّة واحدة، وإن لم أجِد آذانًا صاغية، آثرت الصمت، لا ضعفًا، بل حفاظًا على طاقتي.
الصمت أحيانًا لغة أبلغ من الكلام، لا سيّما حين يتحوّل النقاش إلى ساحة قتال، لا ساحة تفاهم. نعم، قد تضحكون من كلمة "حرب"، لكنها حقيقة… بعضهم يخوض النقاش وكأنه معركة عليه أن ينتصر فيها بأيّ ثمن. هنا فقط، يكون الصمت حكمة.
وأحيانًا، يكون الصمت لأن الألم بلغ ذروته، لأنّ كل مفردات اللّغة، وجميع الحروف، تعجز عن التعبير. انظر إلى اليتيم حين يرى صديقه يمشي برفقة أمّه، كيف يخفت صوته، وتنطق نظراته، وتتكلم عبراته، تخنقه العَبرة وتخرج تنهيدة من صدره تكاد تذيب أضلعه.
وتأمّل الأم الثكلى، المفجوعة بولدها، حين تلمح أترابه من حولها… أيّ كلامٍ يصف حسرَتها؟ أيّ معجم يستطيع ترجمة هذا الكمّ الهائل من الوجع؟ لا شيء. هناك أوجاع لا تُقال، وهموم تفقد هيبتها إن نُطقت، ومشاعر لا تُفهم، ولا تُحكى، بل تُسكن في الصدور.
من هنا نفهم عمق تلك الأقوال التي جعلت من الصمت بلاغة، لأنه أحيانًا أصدق من ألف كلمة. فبعض الكلام يُحرَّف بحسب أهواء من يسمعه، وبعضه يُبتَر ليتناسب مع مصلحة المتلقّي، وربما تتحدث مطوّلًا، فلا تُسمَع منك سوى آخر كلمة، أو نبرة صوتٍ، فيُساء فهمك.
وفي أحيانٍ كثيرة، نصمت لأن الكلام الموجّه لنا لا يليق بنا، ولا بمقامنا، لأنه كلامٌ ساقط، لا يستحق ردًّا، هو مجرّد كلام يُقال لاستفزازك لا أكثر، وهنا أستذكر بيت الشعر الخالد (كنت قد استشهدت به حين كنت في الصف الثامن اتّجاه موقفٍ تعرّضت له):
وذي سَفَهٍ يُخاطبني بجهلٍ -- فأكره أن أكون له مُجيبا
يزيدُ سفاهةً وأزيدُ حِلمًا -- كعودٍ زاده الإحراقُ طيبا
وهذا هو ديدن الحكماء. فالعاقل لا يردّ إلّا إذا كان الردّ يُفيد، ويختار متى، ولمن، وبأيّ مستوى يُلقي كلماته. وكما قال الإمام علي (كرّم الله وجهه): "ما جادلتُ عالِمًا إلا غلبته، وما جادلتُ جاهلًا إلا غلبني". فالصمت في حضرة الجهل، حكمة، وفي حضرة الألم لغة.
ثمّ ما بالك إن وضعت ثقتك في غير موضعها، وبُحت بأسرارك وخصوصياتك لمن ظننته صديقًا، فإذ به يتحوّل ذئبًا يتغذّى على نقاط ضعفك؟ ستحزن على نفسك، وتتحسّر على سذاجتك، وتتمنى لو أنك لذت بالصمت، واحتفظت بهمومك داخلك، تحمِلها بصمتٍ أهون من طعنة خيانةٍ لبست ثوب الصداقة.
ثمّ تأمّل أجمل لحظات حياتك، أو أقساها حزنًا… حين يسرح بصرك في الطبيعة الخضراء، تحيط بك الأزهار بألوانها الزاهية وكأنها ترتدي ثوبًا من بهاء، ويسكن سمعك خرير الماء العذب، ماذا تفعل؟ تصمت… لتتناغم مع الجمال وتستشعره، فالصمت في حضرة الجمال… جمالٌ آخر. وحين تتلاقى عيناك بعيني من تحب، تصمت، لأنّ هناك ما لا يُقال، وما لا تسعه الكلمات، فإن نطقت خذلتك العبارات، فيكون الصمت أصدق. وفي لحظة ينهمر فيها وجعك، ويتكثّف في صدرك، تصمت… لأنّ الألم إذا فاق التّعبير، لن تجد في الكلام عزاء. فالصّمت، يا صديقي القارئ، أبلغ من كلّ لغات العالم…
أمّا فيما يخص تلك المقولة المشهورة في بلادنا "السكوت علامة الرضى"، كانت شائعة جدًّا قديمًا وقد ارتبطت هذه المقولة بعاداتٍ وتقاليد أبرزها طلب يد الفتاة للزواج، فحين تُسأل عن رأيها تلتزم الصمت حياءً، فيُفسّر صمتها قبولًا. لكن، لا يا عزيزي، فلكلّ قاعدة شواذ، وما كان يُفسّر قديمًا على أنه حياء، قد يكون اليوم وجعًا لا يُحتمل.
ليس كلّ صمت رضًى، لا سيّما في زمننا هذا. السكوت اليوم بات مرآة للخذلان، لغة من لا تُصغي له الآذان. هو وجع يُكتم لأنّ البوح به لن يجدَ من يفهمه. السكوت اليوم ليس ضعفًا، بل صدىً لانطفاءٍ داخلي… حين تنطفئ من كثرة المحاولات، وخاب ظنّك بكلّ من حولك.
حين تكون في مكانٍ لا يشبهك، محاطًا بمن لا يشعر بك، لا يعود للكلام معنى. فما معنى مثلًا أن تتحدث زوجة عن معاملة زوجها السيئة لها، وهي في مجتمع يقدّس الرجل، ويبحث عن أتفه زلّة للمرأة كي يحاسبها، مجتمعٍ ذكوريٍّ بحت، وما نفع الحديث عن حقوقها؟.. وغيرها الكثير من الأمور التي تجبر نفسك على الصمت لأن الكلام سيستنزفك عبثًا. تصمت لأنك تعبت من أن تشرح وتبرر وتُوضّح… فلا مجيب. كأن في آذانهم وقرًا، وكأنك تنادي في صحراء خالية.
وهكذا، يبقى الصمت أكثر من مجرّد غيابٍ للكلام… هو لغةٌ تنبض بالمعاني، حين تعجز الحروف عن التعبير، وحين تغدو الكلمات قاصرة عن احتواء المشاعر.
ذاك الصمت… هو صوت الروح حين يخذلها العالم.

غِوى غوراني (كاتبة من لبنان)
ميزان الإنسان في معادلة الصمت والكلام
إنّ قدرة الإنسان على التكلّم نعمةٌ من النِّعم التي أغدَقَها الله عليه، ليميّزه عن سائر المخلوقات، فمن واجبه أن يصون هذه النعمة بالقول الطيّب ويوجّهها إلى ما فيه من الخير ولا يجعلها سببا لنشر الفتن والبُغض أو وسيلة للإساءة إلى الآخرين. إن عجَز المرء عن قول الخير فليصمت، فإنّ الصمت حينها يصبح موقفا نبيلاً وضرورة أخلاقية ملحّة، ليس انسحابًا منه بل حكمة ناضجٍ وامتناع واعٍ عن إلحاق الأذى بغيره. فمتى يُعتبر الكلام واجبًا لا يمكن التكتّم عنه من دون الوقوع في التخاذل والتقصير؟ ومتى يصبح الصمت نوعًا من أنواع التحيّز والتهرّب من المسؤولية والواجب؟
هناك قولٌ يُنسب للخليفة عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه): "المحايد شخصٌ لم ينصر الباطل، لكنّه من المؤكّد أنّه خذل الحقّ". يأخذنا هذا القول إلى التفكّر في عمليّة الحياد السلبي المؤدّي إلى خذلان الحقّ، إذ لا مكان للحياد حين يُصفع الحق، لا مجال للصمت حين تصرخ ألف امرأةٍ وا معتصماه!
إن الصمت للحظة في عالم يضج بالأصوات وتتنافس فيه الكلمات قد يكون ضرورة وليس ضعفًا، إذ ليس كل ما يقال يستحق أن يقال ولا كل لحظة تصلح للكلام. فالصمت أبلغ من ألف خطاب حين يكفّ لسانًا عن الأذية، فإن حكمته ليست عجزًا ولكنها وسيلة للحد من انتشار الفتن التي تبدأ بكلمة وخاصةً في حالات الغضب، أي حين يتحوّل الإنسان إلى فريسة لانفعالاته غير آبه لما يخرج من فمه من سُمٍّ يُميت قلوب أحبّته، فكم من علاقات انهارت وبيوت تهدّمت وصداقات تفككت بسبب كلمة قالها صاحبها بلا تفكير، كانت كالسهم أصابت قلبًا وفجّرت فتنة؟ فالكلمة إما أداة بناء وإما معول هدم، فلا عجب أن قالوا: "الكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك فإذا خرجت صرت أنت بيدها".
إذ إنّ في عصرنا هذا، عصر الفتن الطائفية والسياسية والإعلامية، قد تكون الكلمة أخطر من السلاح بسبب ما تفعله من تحريض وتشويه وإثارة نعرات، فلا بدّ من الصمت الإيجابيّ لمنع انهيار العلاقات والمجتمعات. فيعتبر هنا الصمت قوة وليس استسلاما، حكمة وليس خوفًا، وعيًا وليس خذلانًا يحمي الحق ولا يخفيه.
ولكن إذ كان للصمت وقته وثقله فللكلام أيضًا مقامه وضرورته التي لا غنى عنها، بل ويصبح واجبًا أخلاقيًا لا يمكن التغاضي عنه، فحين يُدفن الحق برمال الباطل بسبب الظلم الطاغي، حينها يكون الصمت وساماً للخيانة ويتحول الكلام إلى شهادة محقّة ونصرة للواجب ونورًا يُهتدى به وصوتًا يعبر لمن لا صوت لهم في مواجهة الظلم، فليس بالضرورة أن تكون الكلمة شرًّا يُخشى حينها، ولو زُهقت في سبيلها الأرواح. ألم نسمع بالحديث النبوي الذي حدّثنا عن أنّ "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله"، هل هناك رتبة أعلى من سيّد الشهداء؟ وقد نالها رجلٌ قال كلمة حق فقُتل إثرها.
في الحروب والإبادة، وبخاصة أمام ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في غزّة من ظلم، يصبح الصمت جريمةً كبرى، فإن أقلّ ما يمكن أن يقوم به الإنسان إن كان كاتبًا أو شاعرًا أو غيره هو أن ينقل الحقيقة للعالم بالنيابة عن الذين حرِموا من حق إيصال صوتهم للعالم. فهنا لا تُعتبر الكلمة مجرّد رأي يقال أو يقترح أو يُكتب، بل تمسي شكلًا من أشكال التضامن مع أهل غزّة والمقاومة الباسلة ضد العدوّ، وتكون وسيلة من وسائل الدفاع عن كرامة شعب يُذبح أمام أعين العالم المتخاذل المتصَهيِن. فالقضية الفلسطينية قضية إنسانية وأخلاقية ودينية، والصمت تجاهها يُعتبر خيانة للضمير الإنساني. ففي حديث نبوي: "من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه..."، فالكلمة قد تكون أضعف الإيمان ولكنها أبلغ من الصمت في مكانها الصحيح حين تنصر الحق ولا تخذله، إنها قد تنير قلبًا بائسًا أثقلته الحياة بمآسيها وشرّدته في زواياها القاسية، ففي زمن كثرت فيه الألسنة الجارحة أصبحت الكلمة الطيبة سلوكًا نادر الحدوث، مع أنها تُعبر عن إنسانيتنا وأخلاقنا، فكيف لنا أن نسكت أمام أرواحٍ كستها الحياة برداء الحزن والهموم والتجويع الممنهج؟
أختمها قولًا بأن الحياة ليست سوى امتحان دائم يقف أمامه الإنسان، بين لحظة يجب أن يصمت فيها ليحمي نفسه والآخرين وبين لحظة يجب أن يتكلم ليحمي الحق ويبيد الظلم.
فالصمت ليس دائما شجاعة ولكن السكوت عن الفتنة حكمة وعن الظلم جريمة، فما ميزان الإنسان إلّا في كلمته وصمته. فكيف نربّي أولادنا على التمييز بين صمت الجُبنِ وصمت الحكمة، وبين كلام الفتنة وكلام النصرة؟

لين شريدي (طالبة إعلام في جامعة بيروت العربية. فلسطينية/ لبنان)
ما بين الصمت والكلام.. حضور يتعثّر!
الصّمتُ، كاد أن يأكُل معي ويُشارِكني غُصّتي في كثيرٍ من أُمورٍ كان يُراكِمُها قلبي في باطِنِه. أظلُّ أُدّخِرُ فيه ما لا يُمكِنُ أن أتفوّه به مع مُحيطي، أُزاحِمُ في قلبي ما لا أجرؤُ على أن أواجه به هذا العالمِ الباهِتِ والمُتخلِّف. كنتُ مُؤمِنةً جِدًّا بأنّ الصّمت كان هو الجواب لِكُلِّ المتاهاتِ الّتي كُنتُ أُعاني مِنها وفيها. لا أُحِبُّ كثرة الكلامِ، وأُفضِّلُ الاحتِفاظ به لِنفسي، لأنّني أرقى مِن أن أشرحهُ لِلعالمِ مِن حولي. فأيُّ جِنسٍ مِنهم سيفهمُ أنّي أُعاني وأبتسِم؟ وأيُّ مِنهُم سيعرِفُ تشخيص حالتي لِيُعطيني الدّواء الأنسب لِدائي؟
لم أعتقِد أنّ كثرة الكلامِ والجِدالِ ستُوصِلني إلى برٍّ يروي عطشي، فأقرِّرُ اللُّجوء إليه بِنفسي، بِسكينتي وهُدوئي.
أحيانًا نعجزُ عن فهمِ أنفُسِنا، فكيف لِلعالمِ أن يفهم ما بِنا؟ لِم أحكي والحكايا عديمةُ الخلاص؟ ولِم أشكو والشّكوى مُتاهةُ المُراد؟ أحتفِظُ بِذهبِ ذِهني لي كي لا أُفسِّرهُ لِجاهِلٍ قد يُناقِشُني بِما تغذّيتُ به لِسِنين، وأنا التي كنتُ أدوسُ شوك العِلمِ حتّى أُدرِك ما قد أدركته اليوم. فكيف لِعابِرِ سبيلٍ قرّر مُجالستي، أن يُخالِط ما حصدتُهُ والذي أرهقني جمعُه؟
فإن تكلّمتُ معه في السِّياسة، لواجهني بِجُذورِ تعصُّبِه حتّى خنقني بِمُبرِّراتٍ قد توارثها مُنذ نشأتِه في عالمٍ لا يُدرِكُ فيه إلّا ما قد راود سمعه. وإن حدّثتُهُ عنِ الثّقافةِ، لجاء يُبارِزُني بِما تثقّف بهِ مِن مصادِر حتّى هو نفسُهُ لا تعرِفُها. وإن فتحتُ لهُ قلبي بِمكنوناتِه، لاتّهمني بالجنونِ والجهل، فهو لن يزور قلبي بِم فيه، ولن يُساكِن أوجاعي وأعماقها، يكفيهِ التّعامُلُ مع ما أرويه ككتابٍ لم تُعجِبهُ سُطورهُ الخلفيّةُ على ظهرِه.
يحكي لي عن أوجاعِه بأنّها أفظع، وأنا الغريقُ في زاوِيةٍ لا تُساوي بُحوره. أُحاوِلُ مُجاهدةً الفكّ مِن تشخيصاتِه الهمجِيّة، والنّدمُ يسري في قلبي ويخنُقُ لِساني، لم تتبق لي عندئذٍ طاقةٌ أن أُجادِل بِما أحمِلُهُ مِن دلائل في رأسي، فهلك ذِهني مِن العبثِ والبعثِ إلى حنجرتي الشاكية النّادِمة.
أأشعر بأني راديو متكلّم لا تدركه الوجدان، يشغّل في سيارة أُجرة بين زحمة السير الخانقة تحت حر الشمس، لا يهمّ السائق من المتحدّث ولا ماهية الخبر، فقط يسمع ما يلفت سمعه من ألحان، ويشغّله كي يأنس روحه من تعب النهار الشاق؟ هذا السائق لن يفهم كل ما تنطق به المذيعة ولن يعرف كل ضيوفها من خبراء في مجالات لا يدرك نصفها، فقط تتكلّم من أجل كسر صمت العالم، كي تحرّك أو لعلّها تغيّر شيء ممّا فيه، دون جدوى. لعل اسمها يُذكر ولعل ضيفها يُحمد، ولعلّ شكواها تنجو من غرق النسيان واللامبالاة. كحالة تلك المذيعة أنا، أنادي الأصم بما أرجو، فلا الرجاء يتحقق ولا الأصم آت.
فبقِيتُ وحدي، لم يتبقّ لي أحد، حتّى أدركتُ أن لا قِيمة لِحُضوري سِوى لِساني، فيظلُّ وُجودي صمتًا مُظلِمًا لا يُدرِكُهُ سِوى من يُشارِكني الخرسان. ظللتُ أتخبّطُ في أُفُقِ رأسي مع ذاتي، تارِكةً الأقوال لهم تتُوهُ بين الجُدرانِ والشّطآن، حتّى وقفتُ وقفة غضبٍ: فإن لم أتكلّم، فمن سيُنظِّفُ قلبي مِن الخُذلانِ؟
فقطعتُ حِبال الصّمتِ، وقصصتُها بِأقوالي حتّى بِتُّ مِن أبرزِ من تفوّه وخلّد السُّطور. فهل مِن الجديرِ أن تترك المسرح لِصاحِبِ الكلامِ المُتوارث، وأنت ساكِتٌ في زوايا وعيِك الشّامِخِ النّرجِسي؟ فرّغتُ ما فيّ مِن عِلمٍ وألم، حتّى أصبحتُ مِن أبرزِ من قال وكتب، فلن تُدرِكك البشرُ سِوى لو حضرت كلِماتُك مقاعِد التّجمُّعاتِ، ولن يُعرف اسمك إلا لو جعلت لِاسمِك مجدًا مُستعينًا بِحنجرةٍ مِن بُركان.
فصدق من قال: "تكلّم حتّى أراك"، فالعُيونُ عمياءُ إن لم يتواجد لحنٌ لِلآذان.

بدر شحادة (باحث في الشؤون التاريخيّة والاستراتيجية)
الصمت.. حين يصبح خيانة!
قيل: "الصمت من ذهب"، فأُلبِسَ ثوب الحكمة، وعُلّق على جدران الأخلاق، وسُوِّق له في مواطن لا تمتُّ للسكينة بصِلة. لكن، مَن الذي قال؟! وفي أيّ سياقٍ قيل؟ وهل يُطلق هذا الحُكم على كل صمتٍ في زمنٍ طغى فيه الظلم، أم أنّ في بعض الصمتِ خيانةً تُخفي وراءها وجعَ الشعوب وانهيار القيم؟!
ليس كلُّ صمتٍ راحة؛ بل كم من صامتٍ تُخاض في داخله عواصف لا تُرى؟ ويكابد جراحًا لم تُداوَ، ويكتم في صدره قهرًا لو نُطِقَ به لزلزلَ الأرض تحت أقدام الطغاة!
وليس كلُّ من سكت حكيمًا، فقد يصمت الجبان خشية المواجهة، ويصمت المنافقُ اتّقاءً للانكشاف، ويصمت المتواطئ طمعًا في مكسب، ويصمت العاجزُ بعدما استُنفدت من يده كلّ أدوات التأثير.
فالصمت - وإن كان يُحسب أحيانًا ضمن أدوات العقل - إلا أنّه إذا ما تجاوزَ حدَّ الحياء إلى التخاذل، وانقلب من ضابطٍ للحكمة إلى حاجبٍ للحق، صار داءً فتّاكًا لا يُرجى منه شفاء، ومقدّمةً لانهيارات لا تُبنى بعدها الأمم ولا تُستعادُ بها الأوطان.
إنّ من يختبئ خلف الصمت حين تموت الحقيقة، لا يستحق إلا وصمة الخذلان. ومن يلوذ بالصمت حين تصرخ الضمائر، فلا مكان له في صفوف الصادقين.
صمت اللسان وصمت الموقف
ثمّة فرقٌ بين صمت اللسان، الذي قد يكون سجيّة أو ظرفًا طارئًا، وبين صمت الموقف، ذاك الذي يُخلخل توازن الحقّ والعدل في المجتمعات. فاللسان قد يصمت عن لغوٍ أو فتنة، أمّا الموقف فلا يحق له أن يصمت إذا ما انتُهكت القيم، وسُفِكَ الدم، واغتُصبت الأرض، وذُلّ الإنسان.
وقد تماهت في عصرنا كثيرٌ من النخب مع هذا الصمت الهشّ، فسمَّته "دبلوماسية"، وألبسته "استراتيجية ناعمة"، وروّجت له بوصفه "حيادًا إيجابيًا"! لكن أيّ حيادٍ هذا؟! وهل يُصلح الصمتُ شأن أمّةٍ تُغتال هُويّتها وتُمزّق وحدتها؟!
إنّ التاريخَ لم يشهد بناء حضارةٍ واحدة بالصمت، ولا نهضةً انطلقت من منصّة السكوت، بل كلُّ عظيمٍ في التاريخ كان صوته فعلًا، وموقفه جهرًا، ودمه ثمنًا! كما أنّ الصمت الدولي الذي نراه اليوم إزاء قضايا الحق والإنسانية، ليس إلا تواطؤًا مغلّفًا بمفردات السياسة المعاصرة.
"تحييد الأدوار"، "مسافة واحدة من الجميع"، "علاقات متوازنة"! عبارات مخدّرة تُشبه المراهم التي تُوضَع على جرحٍ عميقٍ نازفٍ لا تُجدي معه المسكّنات، ولا تُفلحُ معه المجاملات.
حين تُذبح الأوطان، يُصبح الصمتُ قتلًا من نوع آخر. وحين يُسحق الإنسانُ باسم "الحسابات الكبرى"، يتحوّل صمت العقلاء إلى جريمةٍ موثّقة في أرشيف التاريخ.
فلست أؤمنُ بتلك الحِكم التي تُروّجُ لأن يرحل الإنسان بصمت، حتى الموت، يجب أن يكون فعلًا من أفعال الأمل، موقفًا، خطبةً، شهقةَ كرامة، لا أن يكون انزلاقًا ناعمًا إلى العدم.
فالصامتون في زمن الاحتياج إلى الكلمة، ليسوا محايدين، بل شركاء في الجريمة. الصامتون حين تصرخ المآذن ويُخرَسُ الأحرار، ليسوا عقلاء، بل هم المنافقون.. هم الذين حين يُحاصَرُ الوطن وتُجهَض الكرامة، لا يُعوَّل عليهم.. لأنهم على بيّنة من كلّ ذلك، ثمّ يصمتون. يعلمون الحقيقة، ويختارون الحياد الكاذب. يرَون الدم، ويجفّفون أقلامهم. يسمعون النداء، ويغلقون النوافذ. أولئك هم أخطر من العدو؛ لأنهم يقتلون الأمل من الداخل.
فالصمتُ الحقّ هو ذاك الذي يلتقط أنفاس العقل قبل أن ينطق الصدق. أما الصمتُ المريض، فهو القبرُ الذي يُدفن فيه صوت الإنسان، قبل أن يموت الجسد. فلنرفع الصوت حيث يجب، ونكسر جدار الصمت حين يصير خيانة. فالكلمة موقف.. والموقف حياة.
وإنني أختار الحياة، وإن كانت مؤلمة، على موتٍ صامتٍ لا يُبقي أثرًا ولا يُوثِّقُ بصمة.

منيرة جهاد الحجّار (كاتبة وباحثة من لبنان)
ضجيجٌ صامِت
صمتٌ يضجّ في رحاب الحياة، يتنقّل بين أزقّة النّسيان، حتّى بتنا نشتاق إليه على الرّغم من حضوره في كلّ مكان، كيف نُغلق أفواهًا تخترق آذاننا من دون استئذان؟
صمت يحبِسنا في زجاجة موت مؤقّت، نتنقّل فيه فوق رفات أرواحنا، لا صراخ، لا كلام! صمت يعلّق على صدره قلادة حرّيّة مزيّفة، يتنقّل من شاشة إلى أخرى ينهش العقول بصمت وسط ضجيج احتكر قلب كلّ إنسان، احتلّ عقله، وكبّله بإشعاعات ضوئيّة، فصار يضحك بلا ألوان، ويرسم حياته فوق شاشة صامتة بلا إحساس.
صمت يترقّب اصطياد التّفاهات! مَن حدّد اليوم معايير "الترندات"، من حدّد إطار الحرّيّة، وعلامات الجمال؟ كلّها انحرفت عن المعنى الحقيقي والتحقت بالمادّة وسط صمت عميق! هل من منادٍ ينفخ صور الحقّ؟ ترانا في سبات عميق، إن حاولتَ الفرار من هذه القيود، أو اعترضتَ خيوطَها، سيقولون إنّك مجنون، أو متخلّف... كيف لا، وقد أكل الصمت ألسنتنا، فهل هنا نقول إنّ السّكوت من ذهب؟ لا، إنّما هو شيطان أخرس يفتك بمجتمعاتنا، صمت يلاحق واقعًا فاسدًا بعيون اختنقت بصيرتها، والمؤسف أنّ الكلّ يدّعي المثاليّة، ويلوم الجيل الجديد، برأيكم مَن بنى هذا الجيل؟ مَن المسؤول؟ ألَسنا نحن؟ أيُّ عجز هذا الذي يُرمى ليلقي اللّوم على عنوان البراءة، أيّ ضعف هذا؟ وأيّ استسلام؟؟
السّكوت من ذهب؛ نعم، في حالاتِ الغضب الشّديد، في حالاتٍ قد تستنزف مشاعر الآخرين، إنّما في بناء مجتمع، فلا مساومة، كفانا صمتًا فإنّنا ذيَّلْنا أيّامَنا بالذّلّ والتّحقير.
صَمتُ اليوم ليس بريئًا، إنّما يمهّدُ لمرحلة انتقاليّة كبيرة بدأَتْ تتكاثر معه آفاتٌ تفتك بالجيل الجديد، حتّى ظهرَت هشاشتُه، وَكُلّنا راعٍ، وكلّنا مسؤول عن رعيّته.
نأسف أنّنا نعيش في زمن أعظم طموحاته الحصول على "اللايكات" والمتابعين، وأكبر مشروع فيه، مشروع تافه يجول في العالم الافتراضيّ، ويدخل كلّ بيت بلا استئذان لينتزع من أبنائنا أصواتهم ويلحقهم بقافلة الصّامتين، المنبهرين بضحيج الضّوء، خلف شاشات باردة سحبت كلّ شعور حقيقيّ يجمعهم بالواقع.
هو صمتٌ يرسلُ أصابعه النّاعمة ليعبث بفطرة الإنسان، ويلحقه بقافلة "الروبوتات"، صمت ينتزعُ الحقّ، ويستسلم لضحيج ينتهك كلّ الصّلاحيّات رويدًا، رويدًا، فإنّنا لن نجد بعد ذلك سوى بقايا رفات مُنهَك لمن كان يومًا يُسمّى: إنسان.
نعم لِخَوضِ رحلة افتراضية، لكن بوعي، ورقابة، وضمير، فالعالم الافتراضي عالم واسع إن لم تحدُّه المبادئ والقيم سيكون بحرًا يبتلع الجميع، ولن ينجو منه إلّا القليل، فرأفةً بقلوب غضّة لا تزال تنحتُ أيّامها وتشقُّ الطّريق...
أمام هذا الصّمت الذي يصطحب ضحيج العالم التّكنولوجي، لا بدّ لنا من الكلام عن صمت ترك بصمة عار بحقّ الإنسانيّة، بحقّ كلّ من افترش السّماء والتحف الأرض، وكلّ من نادى متألّمًا خوفًا، أو جوعًا، أو إبادة...

عمران جمعة (كاتب وناقد من لبنان)
التّوازن المفقود.. متى نحسن الصّمت ومتى نتقن الكلام؟
الكلامُ نعمةٌ ربَّانيَّةٌ وهبَها اللّٰه للإنسانِ ليعبِّر ويتواصل ويُنشِئ علاقات مع مجتمعه أكثر. والصَّمتُ ليسَ مجرد غياب للكلام، بل هو في ذاتِه لغة. هذه اللّغةُ الصَّامتةُ كثيرًا ما تُعبِّرُ عن أشياء يعجزُ الكلامُ عن توضيحِها.
فالصَّمت ليس دومًا هروبًا أو ضعفًا، بل أحيانًا يكونُ قوّة، مقاومة، بلاغة، وأحيانًا أخرى... خيانة. وبين الصَّمت والكلام، تتأرجحُ النَّفسُ البشريَّةُ باحثةً عن التَّوازن: متى نصمت؟ ومتى نتكلَّم؟ ومتى يكونُ صمتُك عارًا؟ ومتى تكونُ كلمتُك خنجرًا؟
نلجأُ أحيانًا إلى الصَّمتِ لأنَّنا نعلمُ أنَّ ما في داخلِنا أكبرُ من أن يُقال، أو أنَّ ما نودُّ قوله لا يستحقُّ أن يُقال. في لحظةِ الألمِ، قد نصمتُ لأنَّنا نخجلُ من انكسارِنا، أو نخافُ أن نعرِّيَ أرواحَنا. في لحظةِ الحبِّ، نصمتُ لأنَّنا لا نعرفُ كيفَ نُعبِّرُ دونَ أن نفقدَ التَّوازن.
الصَّمتُ ليس عدمًا، بل هو مشاعر مكتظَّة لم تجد لها صيغة كلاميَّة. هو عقلٌ يتروّى وقلبٌ ينتظر.
والكلامُ أحيانًا أداةٌ قاسيةٌ. ليس كلُّ من يتحدَّث يُعبِّر، ولا كلُّ من يصمت عاجز. هناك كلمات تُقال بدافعِ الغضبِ، لكنَّها تبقى كطعنةٍ في القلبِ إلى الأبد، كما قالَ الشَّاعرُ "يعقوب الحمدوني":
جراحاتُ السِّنانِ لها التئام -- ولا يلتامُ ما جرحَ اللِّسانُ
في لحظاتٍ كهذه، يصبحُ الصَّمتُ حمايةً، واحترامًا للموقف، وللنَّفس، وللآخر. الصَّمتُ قد يكون البلسم حين تكون الكلماتُ قنابلَ، وقد يكون حضنًا غيرَ ملموسٍ في وجهِ الجرحِ.
ورغمَ كلّ ما قيلَ في مدحِ الصَّمتِ، لا بدَّ من الاعترافِ بأنَّه ليس دائمًا موقفًا نبيلًا.
الصَّمتُ أمامَ الظُّلمِ جريمة.
الصَّمتُ عن نصرةِ الحقِّ تخلٍّ.
الصَّمتُ حين ينتظرُ أحدُهم كلمةَ حبّ، اعتذار، أو دعم... خذلان.
أن تسكتَ وأنت قادرٌ على تغييرِ شيءٍ هو مشاركةٌ في الخطأ. أن تسكتَ حفاظًا على راحتِك النَّفسيَّة بينما أحدُهم يتألَّمُ بانتظارِك هو خيانةٌ للإنسانيَّة.
الصَّمتُ ليس دائمًا حيادًا، في بعضِ اللَّحظات، هو إعلان خيانة.
من جهةٍ أخرى، كلُّ ما نقولُه له أثر، قد لا نراه لكنَّ الآخرَ يعيشه. فالكلمةُ ليست مجرّد صوت، بل موقف، وكلّ موقفٍ يُبنى عليه ما بعده.
نندفعُ للكلامِ في لحظةِ الغضبِ، وغالبًا ما يكونُ كلامُنا ردَّ فعلٍ لا أكثر، لكنَّ الصَّمتَ هنا يصبحُ فعلًا واعيًا. أن تصمتَ في قمَّةِ غضبِك ليس كبتًا، بل هو تدريبٌ على السَّعادةِ الدَّاخليَّةِ. الحكيمُ هو من يعرفُ أنَّ بعضَ الكلماتِ لا يُمكنُ استعادتها، وأنَّ لحظةً واحدةً من الصَّمتِ قد تحفظُ علاقاتٍ لسنين.
لكن لا يجبُ أن يصبحَ هذا الصَّمتُ سلوكًا دائمًا، فالإفراطُ فيه يحوِّلُ الإنسانَ إلى جدار، فالصّمتُ لا يعالجُ كلَّ شيءٍ، بل يجبُ أن يكونَ خيارًا لا ملجأً دائمًا من المواجهة.
أمَّا في الحبِّ، الصَّمتُ سلاحٌ ذو حدَّين. قد يكون دلالةَ عمقٍ أو دلالةَ خوفٍ. كثيرًا نصمتُ مخافةَ ألَّا يفهمَنا من نحبّ، أو خشيةَ أن نحبّ أكثر ممّا يجب. لكنَّ الحبَّ الحقيقيّ لا ينمو في الصَّمتِ وحده، بل يحتاجُ الكلمةَ. فالكلمةُ الطَّيِّبةُ هي ماءُ العلاقةِ، والصَّمتُ جفافُها.
حين نحبّ، علينا أن نتعلَّمَ متى نصمتُ احترامًا، ومتى نتكلَّمُ اعترافًا، ومتى نُصغي لنبضِنا دون أن نخاف.
وأمَّا في الأدب، فالأدبُ ليس فقط ما يُكتب، بل ما يُقصَد ألّا يُكتب أيضًا. في الرِّواية والشِّعر والمسرح، لا يقتصرُ المعنى على الجملِ المنطوقةِ، بل يكمنُ كثيرٌ منه في الصَّمتِ، في البياضِ بين السُّطور، في لحظاتِ التَّوقُّفِ التي تُثيرُ شعورًا، أو تتركُ فجوةً يقفُ فيها القارئُ وجهًا لوجهٍ مع ذاته.
ومثال الصَّمتِ العدائي في الأدب ما وجدناه في نهايةِ رواية "رجال في الشَّمس" للأديب الفلسطيني "غسان كنفاني"، حين يموتُ الرِّجال الثَّلاثة في خزَّان المياه، ويصرخُ السَّائقُ: "لماذا لم يدقُّوا جدرانَ الخزَّان؟!"، لم ينطقوا ولم يصرخوا ولم يقاتلوا، صمتُهم لم يكن مجرّد سكوت، بل رمزًا للهزيمةِ والاستسلامِ، وهنا جاءَ الصّمتُ ليُدينهم، ويُدين جيلًا بأكملِه، فالصَّمتُ هنا يُستخدمُ كرمزٍ للخضوعِ والخيانةِ تجاه الذَّات والقضيَّة.
ومن الأمثلة على الكلام العدائي في الأدب، ما ورد في مسرحيَّة "عطيل" للكاتب "شكسبير" حيث كان "ياغو" يُقنعُ "عطيل" بأنَّ زوجتَه خائنة عبر كلمات بسيطة وموحية جدًّا، لم يقل "ياغو" صراحةً أن ديدمونة خائنة، لكنَّه أوحى بذلك. فالكلامُ في الأدبِ قد يكونُ سلاحًا فتَّاكًا، لا بالتًصريح، بل بالإيحاء.
أمّا من النَّاحيةِ الإيجابيَّة، فقد وردَ في الأدبِ الكثيرُ من الأمثلةِ عن الصَّمتِ الواعي، منها ما وردَ في إحدى حكايات "كليلة ودمنة" عن صمت الحكيم، حيث يصوِّرُ الحكيمَ وهو يختارُ الصَّمتَ أمامَ الملكِ الظَّالمِ فيُقال: "الصَّمتُ زين للعاقل، وستر للجاهل"، فهذا الصَّمتُ ليس خوفًا، بل حكمة، لأنَّه يدركُ أنَّ الكلامَ في لحظةِ الغضبِ لا يُثمر.
وكذلك الأمرُ بالنّسبةِ للكلامِ الواعي، فقد وردَ في الأدبِ العديدُ من الأمثلةِ ما يشيرُ إليه، منها ما جاءَ في رواية "البؤساء" للأديب "فيكتور هوغو" حيث كان الأب "مادلين" (الذي هو جان فالجان) يُنقذُ طفلةً تُدعى "كوزيت" من الإهمال، ويُعاملُها بكلماتِ حنانٍ وتشجيعٍ بعدَ أن عاشت في قسوةٍ مهينةٍ. فكلماتُ الأب مادلين لكوزيت كانت بسيطة، لكنَّها غيَّرَت عالَمَها بالكامل، قال لها: "أنتِ آمنة الآن. لن يؤذيك أحدٌ بعدَ اليوم"، تلك الجملة الّتي جاءت بعدَ سنوات من الإهانات لم تكن مجرّد وعد، بل كانت إعادة بناء نفس. فالكلمة هنا فعل، والكلام الواعي هو ليس مجرّد تعزية، بل هو احتواء يُعيدُ للإنسانِ كرامتَه، ويصنعُ أملًا كان ميتا.
لذلك، لا الصَّمت فضيلة مطلقة، ولا الكلام خطيئة، التَّوازنُ بينهما هو مفتاحُ النَّجاة. علينا أن نعيدَ للكلمةِ وزنَها، وللصَّمتِ معناه، أن ندركَ أن لا شيءَ يضيعُ في الحياةِ، لا الكلام ولا الصَّمت، أن نعرفَ متى نعلنُ موقفًا ومتى ننسحب، متى نقولُ الحقيقةَ ومتى نُؤجّلها، متى نصمت لنُحافِظ ومتى نتكلّم لنُصلح.
وهذا التَّوازنُ لا يأتي من كتبٍ أو نصائح، بل من التَّجربة، من المراقبة، من الألم، من النَّدم، من حالات صمتٍ تمنّينا لو تكلّمنا، أو كلماتٍ تمنّينا لو لم نقلها.
والسُّؤال الأهم الآن ليس: متى نتكلّم؟ ومتى نصمت؟ بل: لماذا؟
بناءً على ذلك، الصَّمتُ قوّةٌ حين يكون عن وعي، وضعفٌ حين يكون هروبًا. والكلامُ شجاعةٌ حين يكون في مكانِه، وخطيئةٌ حين يُلقي الزَّيتَ على النَّارِ. نحتاجُ اليومَ أن نُعيدَ فهمَ أدواتِنا البشريَّة الأولى: الصَّوت، والسّكوت. أن نُدرِّبَ أنفسَنا لا على الكلامِ فقط، بل على متى نتكلَّم، ولماذا نصمت.
الكلمةُ الطَّيِّبةُ تُصلح، والصَّمتُ الحكيمُ يُنقذ، والمواقفُ تُبنى من الاثنين معًا.

التّعبير بين الصّمت والكلام
هند سليمان أبو عزّ الدين (باحثة وكاتبة من لبنان)
تغرق في التّعبير الصّامت آلاف العيون، حين يُصبح الكلام ثقيلًا على الألسنة، ويُمسي الحديث حوارًا خفيًّا مع الذّات، فتضيع الحروف في غابات السّكوت التي تصير في كثير من الأحيان وسيلة التّعبير الوحيدة، وبلسمًا يُضمّد الجراح، ويُواسي أنين الآلام والتّعب، وقديمًا قيل: "إذا كان الكلام من فضّة فالسّكوت من ذهب"، فقد يصنع الصّمت صخبًا أقوى من الكلام وأكثر تأثيرًا منه، لأنّه يشكّل فرصة تدعونا للعودة إلى أنفسنا، لنفهم مشاعرنا وأحاسيسنا، ونجد طريقة للتّعامل معها بهدوء وعقلانيّة، فندرس سلوكنا وتصرّفاتنا بعناية، ونحاول تفادي الوقوع في الأخطاء، ثمّ نراجع أقوالنا كي لا نتفوّه بكلام قد نندم عليه في المستقبل.
والصّمت يمنح الإنسان راحة وهدوءًا، ويقلّل الإحساس بالقلق والتّوتّر، فحين يكفّ اللّسان عن الثّرثرة، يفسح المجال للتّفكير العميق، فتُبحر سفُن الطّمأنينة في بحار التروّي، ويرسم العقل النّاضج نصائحه على صفحات قراراتنا، فنسير في دروب الحياة بخطى ثابتة من دون أن نضيع في أزقّة الأحاديث العشوائيّة التي قد تحمل معها مشاعر الإحباط واليأس، أو قد تتضمّن كذبًا أو غيبة أو نميمة، أو غيرها ممّا نهى عنه اللّه عزّ وجلّ، فالكلام الذي لا فائدة منه ضياع للوقت والجهد، وقد يجرّ المرء إلى الغرق في الآثام والآفات والمعاصي، لذا يجب الابتعاد عنه وتركه، وهنا يكون الصّمت "من ذهب"، ويكون السّكوت واجبًا علينا الالتزام به والحرص عليه.
ولكن، هناك مواقف كثيرة لا بدّ فيها من إطلاق العنان للّسان وتشجيعه على البوح والتّعبير، فصاحب العلم النّافع إذا صمت يضيع علمه من دون أن يستفيد منه أحد، لذا عليه أن يتكلّم ليزيد عدد المتعلّمين في بيئته، ويصبح كلامه سراجًا يضيء دروب قومه، ويحثّهم على اكتساب العلم والمعرفة، ويمسك بيدهم ليزرع فيها وردة البحث عن المعلومات المفيدة التي تغني العقول، وتغرس فيها بذور الوعي، فينفع النّاس، ويستفيد الجميع من علمه الذي قد يشكّل منارة تُسهم في تطوّر المجتمع وتقدّمه ونهضته وازدهاره.
والكلام الطيّب يُمسي واجبًا اجتماعيًّا في كثير من الأحيان، فقد يزيد الألفة بين البشر، ويُسهم في فضّ النّزاعات، وقد يكون دواء لأجساد تعاني من الوجع والمرض، فينطلق ليُصبح منديلًا يمسح دمعة حزين، ويواسي قلبًا متعبًا، ويلملم من صدور كثير من النّاس أنين الخوف والوحشة، وكم يحتاج المرء في مراحل كثيرة من حياته إلى كلام طيّب يُعيد له الاطمئنان والسّكون!
وتتدفّق من الكلام الطيّب ينابيع المحبّة والودّ والإخلاص، فحين يهمس اللّسان في أذن المريض قولًا مزيّنًا بعطر الأمل، يُخفّف عنه الألم والوحدة، ويمنحه قوّة تُعينه على تحمّل معاناته بصبر وثبات، وما أجمل الكلام حين ينطق بتعابير ترسم الضّحكة على وجوه الأطفال، فتنشر المودّة بينهم، وتمنحهم الإحساس بالطّمأنينة! فالكلمة الطيّبة لها تأثير إيجابيّ في الآخرين، وقد قال النّبيّ محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم: "الكلمة الطيّبة صدقة".
والكلام الذي يحمل تشجيعًا على البرّ والتّقوى، أو نشرًا للخير والفضيلة بين النّاس، أو إظهارًا للحقّ ودفاعًا عن المظلوم واجب علينا التّمسّك به لنحافظ على مكارم الأخلاق.
لذا علينا تحكيم العقل قبل التكلّم، فالسّكوت فضيلة إن لم يكن الكلام نافعًا أو ضروريًّا، وفي مواضع كثيرة يجب أن يتمسّك الإنسان بالصّمت لأنّ إطلاق اللّسان بالكلام قد يجلب الضّرر على الفرد والمجتمع، فالقدرة على التّعبير مسؤوليّة كبيرة يجب أن نحسن استخدامها، لتكون لنا معينًا يفيد النّاس، ويُساعدنا على الصّدق والخير والعطاء، ويحثّنا على التمسّك بالفضائل والأخلاق الحميدة، وقد قال النّبيّ محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم: "من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".
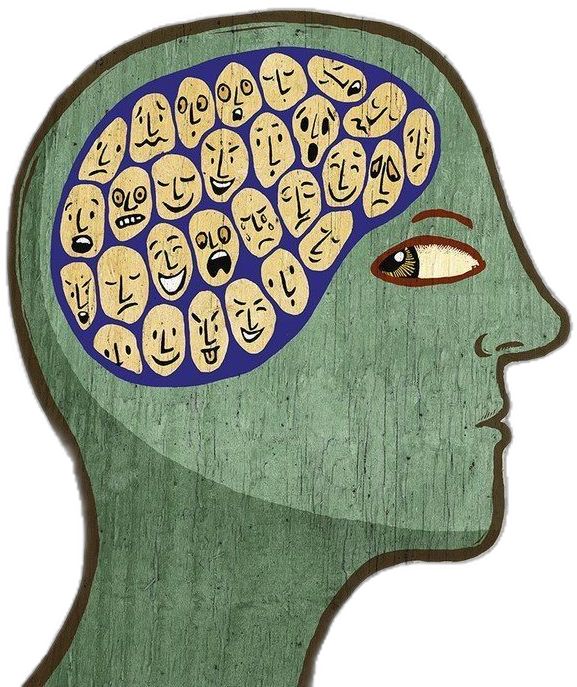
الصمت... الدّرع الحكيم
سمر توفيق الخطيب (كاتبة وباحثة فلسطينية - لبنان)
يقال: "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"، ويقال أيضًا: "لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك"، فكم من كلمة انطلقت كالسهم وتسببت بنزف القلوب وجرح المشاعر، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد؟
من هذا المنطلق علينا أن نلتزم الصّمت، حيث لا لزوم للكلام، حفاظًا على الود ومشاعر الآخر، ففي لحظة الغضب قد نتفوّه بما يجرح. ومن هنا تكمن أهمية التّحكم بالكلمات التي تُطلق من اللّسان، والتّمتع بقدر كبير من الوعي والحكمة لكي نتجنّب الكثير من المشاكل والمواقف الصّعبة التي نكون في غنى عنها وقد تؤدي بنا إلى حالة من النّدم الشديد، حيث لا ينفع الندم.
ولهذا كان جليًّا موقف الدين الإسلامي في التّنبيه والتّشديد على أن نكون قدوة، فنحسب ألف حساب لما يصدر عنا من أقوال، وهذا ما نستشفه من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النّبوية التي تحثّ على أهمية الكلام الحسن والصمت في المواقف المناسبة. فنجد الإسلام، يُشجع على الكلام الطيب والحقّ، ويُحذّر من الكلام السيئ والباطل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" (الأحزاب: 70)؛ فهذه الآية تربط بين الإيمان والكلمة، وتعلّمنا أن التّقوى لا تكتمل دون انضباط اللّسان، لأن الكلمة قد ترفع الإنسان أو تهوي به. فالمؤمن مطالَب بأن يجعل كلامه ميزان عدل، لا سببًا للأذى أو الفرق؛ يقول تعالى في كتابه الكريم: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" (الحجرات: 13)، ويقول تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" (الأحزاب: 70).
كما يقول تعالى: "وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا" (الإسراء: 53) إذ تحثّنا هذه الآية على حسن التّعامل مع الآخرين لاسيما ضبط اللّسان وأن لا نستسلم لوساوس الشيطان؛ ويقول أيضًا: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" (الإسراء: 36)، وهذه الآية تُحذّرنا من الكلام بدون علم أو دليل، وأن لا نروّج لأيّ خبر لم نتحقق من صحّته، وأن لا نحكم في أمر نجهله، لأن الإنسان سيحاسَب على كل ما يراه ويسمعه ويعتقده أو حتى يفكر فيه، وعليه أن يتحكم بضبط هذه الوسائل وأن لا يستخدمها بتهور وكيفما يشاء؛ يقول تعالى: "مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" (ق: 18). وفي هذه الآية إشارة إلى الرقابة الإلهية حيث الثّواب والعقاب، فكل ما يصدر عنا لا بد وأن نحاسَب عليه وإن رحمنا الله، عز وجل، حاسبنا في الدنيا، وإلا وهنا تكمن الكارثة انتظار العقاب في الآخرة، حيث يستنفذ الإنسان رصيد الحسنات ويقع في متاهات شرّ أعماله.
يقول تعالى: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ" (النساء: 140)، تتضمن هذه الآية تحذيرًا شديدًا من مغبّة المشاركة في المجالس التي يُستهزأ فيها بكلام الله، عز وجل، أو يُكفر بالدين، وتحض هذه الآية صراحة على احترام الآيات القرآنية والابتعاد عن كل مجلس تُهان فيه قدسيتها، وفي حال كنا مكرهين على التّواجد في مثل هذا المجلس، فعلينا بالصمت وأضعف الإيمان أن ننكر بقلبنا ومن ثم نتنحّى ونغادر المكان، لأن السكوت عن الباطل موافقة ضمنية وذلك ما تشير إليه الآية "إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ" (النساء: 140). وهذا ما أكد عليه الحديث الشّريف، إذ يقول سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم): "من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم (حديث رقم: 49).
وقد حثنا نبي الرّحمة محمد (صلى الله عليه وسلم) أن نتّبع الصمت ولا ننطق وفق أهوائنا وغرائزنا، ونبّهنا أن ذلك من تعاليم الدّين كي لا نضل ونشقى: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" (رواه البخاري ومسلم).
من هنا تكمن أهمية التّفكير قبل التّفوه بالكلام، واختيار الكلام العطر والمنمّق، والتزام الصمت إذا لم يكن هناك داع للكلام أو أن فيه أذى للآخرين أو فتنة تثير العداوة والبغض بين النّاس.
ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار أقوال الحكماء العرب في مدحهم للصمت متوافقًا مع القيم الإسلامية الّتي تُحث على التؤدة في الحديث؛ فكم من مصيبة خلّفها الكلام الحاد وبلحظة غضب، وهذا كما جاء في قوله تعالى: "لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ" (الغاشية: 7)، وللأسف، صدر بلحظة غضب أعمى، فصعق الآخر وأصابه في صميم القلب، وقد يؤدي ذلك إلى قطيعة الأرحام، فيؤدي إلى غضب الله، سبحانه وتعالى.
فـ "كل ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التوّابون"، وهذا الحديث يحثنا على الإكثار من التّوبة والاستغفار؛ ويحثّ على عدم اليأس من رحمة الله، سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم. ومن هنا نجد أن في الصمت فضيلة، إنه أعلى مراتب النُّبل والرفق. فلنُدرّب أنفسنا على أن نزن الكلمة قبل إطلاقها، فربّ سكوتٍ أنقذ قلبًا من كسرٍ، وربّ كلمة فتحت باب قطيعة وأغلقت باب المحبة، فالصمت إذًا كنز في لحظة الغضب، إنه عبادةٌ وخُلق.

الصمت فضيلة أو خيانة؟
تمام قلعجي (باحثة في الأدب العربي - لبنان)
"الصمت من ذهب"... مقولة نُردّدها كثيرًا، لكننا لا نخدع بها إلّا أنفسنا حين نضعها في خزانة المسلّمات ولا نشكّك بقدسيّتها.
هيا نحصي معًا فاتورة هذا الكبت الذي ندفعه من صحتنا: قلقٌ مزمن، صداعٌ دائم، تأتأةٌ في النطق، فقدانٌ للقدرة على التعبير، أمراضُ قلب، ورجفةٌ في الأطراف... القائمة تطول، ويمكن لأيٍّ منا التأكّد من صحة هذا الكلام وبكبسة زر، فمن علّمونا لغة السّكوت تركوا لنا الأبواب مفتوحةً لنبحث، وجلسوا يتحدّثون، يتهامسون علينا ويضحكون.
حين كنت صغيرةً أخذتني أقدار التعلّم إلى غرفةٍ ضيّقة كالقبر، كان عددُنا يفوق العشرين طالبًا من أعمار مختلفة وكنا نُحشر فيها ككبيس أمّي المالح المخنوق في زجاجة، وفي أكثر الأحيان كنّا نضطر للجلوس على درج المبنى كلّما ضاقت بنا هذه الغرفة وقررت بصقَنا خارجها. كنّا نفرح لأننا سنطوي الدرس، ونتشارك الأحاديث والمواقف، نثرثر، نتشاجر، ونتغامز على بعضنا البعض... وفي كثير من الأيام، وفي زحمة الضجيج تُطوى صفحات الدروس فلا نعود إلى مذاكرتها، وللنتائج قَولان؛ فإذا كانت العلامات متدنّية قيل: "هذه هي قدرات ابنكم"، وإن ارتفعت قيل: "هذه ثمار خبرتي وجهدي". كان النّفاق يسري في عروق أكثر الذين يجاهدون لكي يعلّموننا الأخلاق. هكذا وببساطة يقتنع الأهالي وبالأخص أصحاب الدخل المنخفض الساعين لتعليم أبنائهم بسبلٍ يسيرة تناسبهم.
كنّا أشقياء نضحك على المعلّمة من خلف ظهرها، ويبلغ ضحكنا الصامت ذروته كلما انفجرت غضبًا، ومنا من تخونه قهقهاته فتخرج لتدل عليه لينال عقابه، ما هو العقاب؟ أقصى عقاب هو الطرد إلى المنزل من دون أن يُتمّ الطالب واجباته.
في أول يوم لي هناك، رأيتُ ولدًا في العاشرة يرتجف وهو يقرأ، يتلعثم بحروفه كأن شريطًا كهربائيًا يمسّه كلّما تفوّه ببنت شفة، سألته: "هل أنت مصاب بالبرد؟"، فعبس وجهه وتوتّرت ملامحه، وقبل أن يجيبني تدخّلت المعلمة بنظرات مرتبكة وقالت: "اجلسي عند الباب وأنجزي واجباتك". نفّذتُ ما طلبت مني، لكن الحزن سكنني. لم أكن أقصد أن أجرحه، ربما خانتني ابتسامة صغيرة، لكنّ شيئًا ما في نظراته ظلّ يخنقني. تمنّيتُ لو أنني لم أتكلم، لو أنني خرستُ، لو...
غادرت المكان قبل نهاية الشهر الأول، كان ذلك أملي منذ البداية. لم ألتقِ بعدها بأيٍّ من تلك الوجوه.
ثم جاء اليوم الأول من عطلة الربيع، وذهبت وأمي إلى السوق. قابلته صدفةً، كان هو الطفل ذاته. ابتسمت له ولوّحت له بيدي لأحيِّيه، لكنّه قابلني بالعبوس القديم نفسه ومضى. تتبعته بنظراتي حتى وقف إلى جانب رجل غاضب. بصوتٍ مرتفع سأله: "أين كنت كل هذا الوقت؟!"، ثم أشبعه ضربًا مبرحًا. بقي المسكين صامتًا، وعيناه في الأرض لا يقوى على رفعهما، وجسده كله ينطق رقصًا عدا شفتيه. تابع الرجل: "ولدٌ فاشل، راسب، لا فائدة منك لا في علم ولا في عمل". كان هذا الرجل والده.
الجميع مرّ من جانبه بصمت، بعضهم أسرع الخُطى، والبعض الآخر وقف يتفرّج وكأنّه يشاهد مسرحية مجانية. لا تزال كلماتهم تطنّ في أذني: "يُربيه على كيفه". أمسكتُ بثوب أمي، رجوتها أن تتدخّل، فأجابت: "أنا امرأة... وهذا الرجل مريض". سألتها بدهشة: "وما معنى مريض؟ أليس المريض من ينام ولا يقوى على النهوض؟ كيف يكون مريضًا وهو يصرخ ويضرب؟!".
ومنذ ذلك اليوم، سؤال لا يفارقني: هل كان الصمت حينها فضيلة... أم خيانة؟
أنا لا أقوم بدعوة أحد إلى الصراخ في كل موقف، ولا إلى الكلام الطائش، ولكن لا يصحّ أن نواجه الظلم بالصمت دائمًا، فالكلمات التي نكتمها تتحول مع الوقت إلى عُقد، تكبر بداخلنا وتنهشنا، تُفقدنا حقوقنا واحترام ذاتنا.
لقد كنتُ طفلة، لكن الذنب الذي ارتكبته لم يظل صغيرًا، بل كبر في داخلي. واليوم حين أسمع من يردد "الصمت من ذهب"، لا أرى في العبارة حكمة، بل خيانة مضاعفة: خيانة للذات، وخيانة للآخر.
تُطاردني على أثرها صورة ذلك الطفل حتى الآن: جسدٌ مهتز، صوتٌ مرتجف، رأسٌ لا يجرؤ على الارتفاع... وأمي تقول: "أنا امرأة"، ومعلمةٌ تستقوي على الفقراء باسم "الرسالة".
الصمت حين يأتي من خوف، يسلبنا مع الوقت كل شيء... ذاتنا... كرامتنا... هويتنا... أرضنا، فماذا لو لم نصمت اليوم عن الإبادة الجماعية التي يحدثها العدو في غزة؟ هل كان المحتل سيتمادى؟
انظروا كيف فعل بنا الصمت: جعلنا نجلس خلف شاشات، نشاهد أطفالًا - بل هياكل عظمية - تموت جوعًا، بينما تتواطأ حكومات العالم، أو تُجبر على السكوت بقوة فرض العقوبات.
فهل الصمت فضيلة؟ أنا أراه رذيلة، خيانة، تواطؤًا، إثمًا... فهل السكوت يسلب الإنسان شعوره وضميره وإنسانيته؟!






