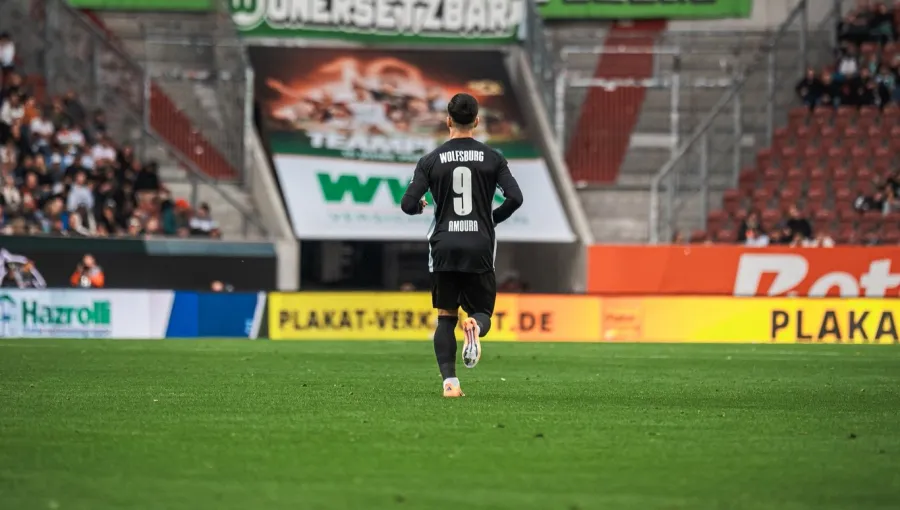تتصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي لتصبح واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في منطقة حوض النيل، إذ تتقاطع فيها الاعتبارات القانونية والسياسية والبيئية، مع تأثير مباشر على حياة ملايين البشر في مصر والسودان. منذ الإعلان عن المشروع عام 2011، أعربت دولتا المصب، مصر والسودان، عن قلقهما العميق إزاء تأثيرات السد المحتملة على تدفقات المياه، وهو ما دفعهما للتحرك على مستويات متعددة لحماية حقوقهما المائية وضمان أمنهما الاستراتيجي.
وتتمثل العقدة الأساسية في تنفيذ إثيوبيا لمشروع السد بشكل أحادي، دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان، في مخالفة واضحة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المتعلقة بالاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود. فالاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، أكدت على ضرورة التنسيق المسبق في مشاريع المياه الكبرى، وهو التنسيق الذي غاب عن مشروع سد النهضة، ما يثير مخاوف كبيرة حول قدرة دول المصب على حماية حقوقها المائية.
وعلى المستوى القانوني، تُعد آليات القضاء الدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، أداة محتملة لمساءلة إثيوبيا وضمان مصالح مصر والسودان. يمكن للجانبين اللجوء إلى هذه المحاكم للطعن في الإجراءات الأحادية للسد، خصوصًا إذا كانت تؤدي إلى ضرر ملموس لحقوقهما المائية.
ومع ذلك، تبقى فعالية هذه الآليات مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، وهو عنصر صعب التحقق منه في ظل التوترات المستمرة.
ولا تقتصر المخاطر على الجانب القانوني، بل تمتد إلى استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها. فالسياسات الأحادية لإثيوبيا تزيد من احتمال تصاعد النزاعات بين دول الحوض، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي ويعوق جهود التنمية المستدامة، ويفاقم من مشكلات الفقر والجوع التي تعاني منها بعض المنطقة.
وفي السودان، يواجه السكان تحديات كبيرة بسبب تصريف المياه من السد، إذ يمكن أن يؤدي التدفق الكبير أثناء فترات الفيضانات إلى أضرار جسيمة في المناطق المنخفضة على المستويين البشري والمادي. ورغم تصريحات إثيوبية تشير إلى أن السد يخفف من حدة الفيضانات، يحذر الخبراء من أن التصريف غير المنظم قد يزيد المخاطر البيئية ويهدد سلامة البنية التحتية، في ظل تقارير عن تسريبات في بعض السدود الفرعية.
على الصعيد الدولي، قدّمت مصر رسائل قوية أمام الأمم المتحدة تؤكد موقفها الثابت، معتبرة أي إجراءات أحادية الجانب من إثيوبيا تهديدًا لأمنها المائي. ورغم قوة هذه الرسائل، يبقى التساؤل حول مدى قدرتها على ردع التجاوزات المستقبلية، خاصة مع غياب آليات تنفيذية واضحة. ومن هنا تبرز أهمية الوساطات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. إلا أن نجاح هذه الوساطات يعتمد على توفر إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف والالتزام بالحلول السلمية.
وتشكّل إدارة الفيضانات تحديًا مباشرًا أمام السودان، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الحكومة السودانية ودول المصب، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي. وتشمل الإجراءات الطارئة تعزيز البنية التحتية لمواجهة الفيضانات، وتوفير الدعم الإنساني للمناطق المتضررة، وتطوير أنظمة إنذار مبكر لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.
على المدى الطويل، تكمن الحلول في تأسيس نظام متفق عليه لإدارة مياه النيل يضمن مصالح جميع دول الحوض، عبر اتفاقيات ملزمة تحدد قواعد واضحة لاستخدام المياه وتشجع على التعاون الفني والمالي بين الدول. ومن خلال هذا النهج، يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تصعيد النزاعات المائية، وضمان استقرار المنطقة وحماية الموارد المائية الحيوية.
تؤكد أزمة سد النهضة مجددًا أن التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل أمر حيوي لضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه، وذلك يتطلب التزامًا بالقانون الدولي واستعدادًا للحوار البناء، والبحث عن حلول توافقية تحمي مصالح جميع الأطراف، مع مراعاة المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لأي قرارات أحادية في هذا الملف الشائك.
كيف يمكن للسياسات الأحادية لإثيوبيا أن تؤثر على استقرار منطقة القرن الإفريقي، وما المخاطر المحتملة لتصعيد النزاعات بين دول الحوض؟
بحسب د. عبدالناصر سلم حامد، مدير برنامج السودان وشرق أفريقيا في مركز فوكس للأبحاث بالسويد، وفي تصريح خاص للأيام نيوز، فإن "النيل الأزرق يمد السودان سنويًا بما يقارب 49–52 مليار متر مكعب، لكن سعة سد النهضة البالغة 74 مليار متر مكعب تجعله قادرًا على حجز تدفق كامل لعام كامل تقريبًا". وأضاف حامد أنه "منذ بدء الملء الأول للسد عام 2020 وحتى 2024، احتجزت إثيوبيا نحو 50 مليار متر مكعب، ما أدى إلى نقص مباشر في مياه السودان بلغ بين 5–8 مليارات متر مكعب في بعض المواسم، وهو ما أثر بشكل كبير على الري، خصوصًا في مناطق الجزيرة والرهد". ولفت إلى أن "غياب التنسيق يجعل السودان في مواجهة مفاجآت مائية؛ فعام من الوفرة قد يتحوّل فجأة إلى عام شحّ يربك دورة الزراعة بالكامل".

د. عبدالناصر سلم حامد، مدير برنامج السودان وشرق أفريقيا في مركز فوكس للأبحاث بالسويد
وعن تأثير السد على الزراعة والأمن الغذائي، أوضح حامد في حديثه للأيام نيوز، أن "المشروعات الزراعية المروية في السودان، وعلى رأسها مشروع الجزيرة، تعتمد على مياه النيل الأزرق لري أكثر من 2.5 مليون فدان". وأكد أن "أي نقص بمقدار مليار متر مكعب من المياه يُعرّض نحو 200 ألف فدان للجفاف، وإذا انخفض التدفق بمقدار 5 مليارات متر مكعب كما حدث في بعض سنوات الملء، فإن ما يقارب مليون فدان قد يتضرر، أي نحو 40% من المساحات المزروعة في الجزيرة وحدها". وأضاف أن "هذه الخسائر لا تعني تراجع الإنتاج الزراعي فحسب، بل تهدد الأمن الغذائي لملايين السودانيين وتزيد الاعتماد على استيراد الحبوب في وقت يعاني فيه الاقتصاد من حرب وعقوبات، ما يضاعف الأعباء على السكان".
وبالنسبة لقطاع الكهرباء، أشار حامد للأيام نيوز، إلى أن "سدود الروصيرص وسنار تنتج مجتمعة نحو 1,000 ميغاواط من الكهرباء، لكن التغيرات غير المنتظمة في التصريف قد تخفض الإنتاج بنسبة 30–40%، أي بخسارة تصل إلى 300–400 ميغاواط". وأضاف أن "في بلد يعاني أصلًا من نقص الإمدادات، تعني هذه الخسارة انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والمصانع، وتعطيل شبكات الري والمستشفيات، ما يضاعف الأثر الإنساني والاقتصادي ويزيد من هشاشة الخدمات الأساسية".
وفيما يخص التأثير البيئي، أكد حامد في حديثه للأيام نيوز، أن "النيل الأزرق يحمل سنويًا نحو 140 مليون طن من الطمي، لكن سد النهضة سيحتجز نحو 90% منه، ما سيؤدي على المدى الطويل إلى تراجع معدل خصوبة الأراضي السودانية بنسبة 15–25% خلال عقد واحد، ويزيد اعتماد المزارعين على الأسمدة الصناعية". وأضاف أن "تقديرات أولية تشير إلى أن تكلفة الإنتاج الزراعي قد ترتفع بنسبة 10–15%، مما يجعل السودان يفقد ميزة طبيعية تاريخية جعلت تربة الجزيرة من أخصب الأراضي في إفريقيا، والخسارة ليست وقتية بل تراكمية تهدد مستقبل الزراعة".
أما فيما يخص المخاطر الإنسانية، فقد حذّر حامد من أن "أي إطلاق مفاجئ للمياه من السد قد يرفع منسوب النيل الأزرق عند الروصيرص بما بين 1.5–2 متر خلال 24 ساعة، ما يعرض آلاف القرى المنخفضة على ضفاف النيل لخطر مباشر". وأوضح أن "التقديرات تشير إلى أن نحو 500 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للغمر المفاجئ، والخطر مزدوج؛ تدمير الممتلكات والبنية الزراعية، وتكرار النزوح الداخلي في بلد يعاني أصلًا من أزمة إنسانية خانقة".
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب حامد في حديثه للأيام نيوز، حقيقة أن السودان يواجه تحديات متعددة نتيجة السياسات الأحادية لإثيوبيا في تشغيل سد النهضة، من تداعيات مائية وزراعية وكهربائية وبيئية، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا مع الدول المعنية وضرورة وضع خطط استباقية لمواجهة أي طارئ. وأكد الخبراء على أهمية تأسيس آليات مشتركة لإدارة مياه النيل تضمن مصالح جميع دول الحوض، وتحد من المخاطر المتفاقمة على الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمنطقة.
وفي ذات السياق أكد الباحث في الشؤون العربية والإفريقية علي فوزي، للأيام نيوز، أن إثيوبيا "خالفت بشكل واضح قواعد القانون الدولي بملئها وتشغيلها سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم مع مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن هذا التصرف الأحادي "يهدد الحقوق التاريخية والمكتسبة لدول المصب في مياه النيل، ويعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للمجاري المائية الدولية".

الباحث في الشؤون العربية والإفريقية علي فوزي
وأوضح فوزي أن "مصر والسودان تمتلكان كامل الحق في اللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي للدفاع عن مصالحهما المائية"، مؤكدًا أن "المحكمة الدولية وميثاق الأمم المتحدة يضمنان حماية تلك الحقوق ضد أي إجراءات أحادية الجانب".
وأضاف أن "السياسات الإثيوبية الأحادية لا تقتصر آثارها على ملف السد فحسب، بل تمتد لتهديد استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها، نتيجة تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، إلى جانب المخاطر البيئية الكبيرة التي يتعرض لها السودان بسبب الفيضانات المدمرة، والتي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة وتدمير المنازل والأراضي الزراعية".
وأشار فوزي إلى أن "الرسائل المصرية أمام الأمم المتحدة كانت قوية وواضحة في تحذيرها من استمرار الانتهاكات الإثيوبية"، لافتًا إلى أن "القاهرة تستعد للقيام بتحركات إضافية على المستويين الإقليمي والدولي لردع أديس أبابا"، وهو ما ظهر – بحسبه – في تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي الأخيرة.
وفي حديثه لـ"الأيام نيوز" صرّح الدكتور عماد بحرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة منيسوتا والباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في الخرطوم عام 2015 أكدت في بندها الخامس على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث – مصر والسودان وإثيوبيا – في مرحلتي ملء وتشغيل السد، بما لا يُلحق ضررًا بدولة المنبع والمجرى السودان ودولة المصب مصر.
كما صرّح الأستاذ أن ما حدث على أرض الواقع جاء مختلفًا، إذ عمدت السلطات الإثيوبية، وقبل افتتاح السد رسميًا، إلى تخزين كميات كبيرة من المياه خلف البحيرة وهو ما تسبب في فيضانات مفاجئة داخل الأراضي السودانية، لا سيما على طول مجرى النيل الأزرق. وأشار إلى أن التساؤلات تظل مطروحة بشأن ما إذا كانت إثيوبيا قد أخطرت الجانب السوداني بشكل رسمي في الوقت المناسب قبل فتح بوابات السد، خاصة وأن اتفاقية 2015 تُلزمها بالإخطار والتنسيق المسبقين.

الدكتور عماد بحرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة منيسوتا والباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية
وصرّح الأستاذ كذلك أنه ورغم احتمالية قيام الجانب الإثيوبي بإبلاغ السودان، إلا أن المؤشرات الفنية والوقائع على الأرض تدل على أن عملية التفريغ تزامنت مع موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية، مما أدى إلى وفرة مائية غير مسبوقة في مجرى النيل الأزرق، وفاقم من حجم الفيضان. وأضاف أن هذا التزامن بين تفريغ مياه الخزان والأمطار الموسمية الكثيفة أدى إلى أضرار بيئية ومادية جسيمة في الأراضي السودانية، منها فقدان السيطرة على تشغيل سد الروصيرص القريب جدًا من سد النهضة، إلى جانب تعرية الأراضي الزراعية وغمر عدد من القرى.
وفي السياق ذاته صرّح الأستاذ أنه من غير المعقول أن تكون إثيوبيا قد تصرفت بشكل أحادي تام في إدارة وتصريف مياه سد النهضة، بالنظر إلى ما تفرضه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية من التزامات قانونية، وفي مقدمتها مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار بمصر والسودان. كما أوضح أن إعلان مبادئ سد النهضة لعام 2015 يؤكد صراحة ضرورة التنسيق والتفاهم المشترك قبل تنفيذ أي إجراء يؤثر على تدفق المياه. وأردف قائلاً إنه إذا كانت إثيوبيا قد قامت بفتح بوابات السد وتفريغ كميات كبيرة من المياه، فمن المرجح أنها قد أخطرت الجانب السوداني بشكل ما، ولو على مستوى فني أو غير معلن، رغم أن نتائج الفيضانات اللاحقة تثير الشكوك حول مدى فعالية هذا الإخطار وتوقيته.
كذلك أكد الأستاذ أن من الضروري تصحيح المفهوم المغلوط الذي يُروَّج له أحيانًا بأن السودان دولة مصب، موضحًا أن الواقع الهيدرولوجي يثبت أن السودان دولة منبع ومجرى رئيسي، خاصة بالنسبة للنيل الأزرق الذي يشكل أكثر من 59% من إجمالي مياه نهر النيل. وأوضح أن السودان تمر عبر أراضيه العديد من الروافد الموسمية والدائمة مثل نهر الرهد والدندر وعطبرة، فضلًا عن شبكة من الوديان التي تغذي النهر خلال فصل الخريف. وأضاف أن السودان لا يتلقى المياه من دول أعالي النيل فقط، بل يسهم في تكوين وتوجيه تدفقات النهر بشكل فعّال، في حين أن مصر هي الدولة المصب النهائية لنهر النيل.
كما أشار الأستاذ أن إدارة التدفقات المائية الطارئة تفرض على السودان تعزيز قدراته الوطنية في مجال الرصد الهيدرولوجي والإنذار المبكر، إلى جانب تحديث البنية التحتية للسدود والمنشآت المائية، ولا سيما سد الروصيرص وسد سنار. وأكد على ضرورة وضع خطط إجلاء سريعة للسكان في المناطق المنخفضة، وإنشاء مصدات طبيعية وممرات لتصريف مياه الفيضانات، بما يخفف من الأضرار المحتملة في حال تكرار السيناريو الحالي.
وفي الإطار الإقليمي صرّح الأستاذ أن الوساطات التي تقوم بها أطراف مثل الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة قد تساهم في تقريب وجهات النظر، إلا أن نجاحها يظل مشروطًا بأن تكون مدعومة بإرادة سياسية ملزمة من الأطراف الثلاثة، وألا تقتصر على مسارات تفاوضية غير ملزمة أو مفتوحة الزمن. وشدّد على أن الوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يبقى هو الحل الوحيد لضمان استقرار إقليمي دائم، وتوزيع عادل للمياه، وتشغيل منسق للمشروعات الكبرى كالسدود.
وأخيرًا صرّح الأستاذ أن تأمين مستقبل حوض النيل يتطلب تأسيس آلية إقليمية مشتركة لإدارة المورد المائي، تقوم على مبادئ الشفافية وتبادل البيانات والتخطيط المشترك وتقاسم المنافع بدلاً من الدخول في صراعات حول الحصص. وأوضح أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تفعيل مبادرة حوض النيل أو تطويرها ضمن إطار قانوني أكثر فاعلية، يعترف بمصالح كل الأطراف ويسعى إلى تنمية مستدامة لا تأتي على حساب أحد. واختتم بالقول إن التحدي الحقيقي لا يكمن في بناء السدود، بل في بناء الثقة والحوكمة الرشيدة للمياه المشتركة، وهو ما يُحتم على جميع دول حوض النيل أن تتعامل مع المورد المائي كمجال للتعاون لا للصراع، بما يخدم شعوب المنطقة بأكملها.