إن ما حقّقته الإنسانية من مُكتسبات مادية كبرى في عصرنا الراهن، قد خسرت في مقابله أمورا روحية أكبر، من أهمّها الأمن النفسي والاستقرار العاطفي والتصالح مع الذات. ولا يبدو المستقبل مُبشّرا بعودة الإنسانية إلى رشدها، وتحقيقها للتعادلية التي توازن بين الجسد والروح، بين المادة والقِيم، إلا إذا اعتنقنا التفاؤل وزعمنا بأن الحروب والكوارث والأزمات البيئية والصحية ووباء "القنوط العالمي".. أسبابٌ ستدفع بالإنسانية، لا سيما المجتمعات الغربية، إلى البحث عن الأمن النفسي في الأديان الصحيحة، بمعنى أن العصر القادم، الذي سيفتح أبوابه خلال سنين أو عقود قليلة آتية، سيكون "عصر الروح". ونترك للقارئ مهمّة استشراف الدين الصحيح القادر على انتشال الإنسانية وإنقاذها من "أمراض المادية"!
يُفترض أن تكون الإنسانية المعاصرة أكثر سعادة من عصورها الغابرة، فقد ارتقت بحياة الإنسان في جميع مناحيها: العلمية والتعليمية والغذائية والصحية.. غير أن مجرد الحنين إلى "الزمن الجميل" يحيل إلى تساؤلات حول افتقاد الإنسانية إلى كثيرٍ من قيمها الروحيّة "الفطرية"، كما يُحيل إلى التساؤل حول كينونة الإنسان ذاته: هل تحوّل إلى كائن قابل للبرمجة فكريًّا ووجدانيًّا؟
لن نطارد الأجوبة في مدارات الأفكار، ولكننا نستوقف الزمن الحاضر ونتساءل حول محاولات إيقاظ الضمير العالمي من خلال المظاهرات "العالمية" المُطالبة بوقف حرب الإبادة المُعلنة على غزّة. هذه المظاهرات هي في حقيقتها صرخاتُ الإنسانيةِ لطلب النجدة من الغول الذي صار يُهدّد أمنها النفسي، ويحجر على عواطفها وعلاقتها بالمحبة والخير والجمال، ويدفع بها إلى الانتحار في أتون الزّيف والأكاذيب والحروب والدّمار.
يُمكن القول بأن تلك المظاهرات لا تهدف إلى إنقاذ غزّة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى خلاص الإنسانية من غيلان هذا العصر، والتحرّر من لعنات المادية وما يرتبط بها من مشتقّات مثل: الجشع، العبث، الظلم، الطغيان.. بمعنى أن آخر، إذا كانت الطوائف الدينية - على اختلاف أديانها - تنتظر مُخلِّصها، فإن غزّة قد تحمّلت مسؤولية تخليص الإنسانية جمعاء من "غيلان العصر"، فهي المعادل الموضوعي للمخلّص في جميع الأديان السماوية والوضعية..
وحتى لا نغالي في فكرة أن تكون غزّة هي المخلًّص، سنعتبرها المُجدّدة للفطرة الإنسانية التي ترفض الظلم والطغيان، وتؤمن بالمحبة والخير والجمال.. وفي الدين الإسلامي حديثٌ نبويٌّ صحيح يقول: "إنَّ اللَّهَ يبعث لهذه الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها"، وباعتبار أن أنموذج العالِم الموسوعي الواحد – أو حتى مجموعة العلماء – الذي تثق به الأمّة وتُجمع عليه، قد انتهى، فإن غزّة يُمكنها أن تُحقّق الاجماع الذي يُجدّد معنى الامّة ويدفع شعوبها إلى العودة إلى الإسلام "الصحيح"، ويُمكنها أيضًا أن تكون المُجدّد للفطرة الإنسانية التي تكاد أن تلتهمها "غيلان العصر".
عزيزي القارئ، إن الحديث عن الأمن النفسي للإنسان العربي - أو الإنسان بشكل عام - من أخطر الأحاديث في عصرنا الراهن، ليس لأنه يرتبط بالصحة النفسية فحسب، بل لأنه أيضًا يرتبط بمستقبل الأجيال وكيف سيكون عليه واقعهم خلال العقود القادمة. ومن المُجدي التفكير جديًّا في التربية النفسية للأجيال الصاعدة وتحصينها روحيًّا، وضمان كل العناصر التي تؤمّن تنشئتها ونموّها في بيئة صحيّة مثالية.
ومن المُجدي استشعار الأخطار التي تهدّد النفسية الفردية والمجتمعية من خلال المظاهر التي يُمكن أن نرصدها في شيوع "الاغتراب الروحي"، والسلوك العدواني، والانقلاب في القيم.. وغيرها من المظاهر التي ترسم لنا شخصية الإنسان خلال مراحل قادمة. ومن الضروري استباق الأخطار والاحتياط منها، فما يدخل اليوم ضمن الخيارات الممكنة سيكون غدًا ممّا يفرضه العصر وضغوطات الحياة ولا مناص من التسليم والاستسلام..
في مدار هذه الأفكار، توجّهت جريدة "الأيام نيوز" إلى نخبة من الكُتّاب الأفاضل بهذه الرسالة: الإنسان هو معادلة بين الروح والجسد، وفي عصرنا الراهن تكاد نزوات الجسد أن تطغى على كل شؤون الروح، والله يعلم ما الذي ستكون عليه أحوال أجيالنا خلال العقود القادمة.. وإذا تأمّلنا في واقعنا الراهن، نرى مظاهر عدم الاتزان الشخصي وعدم التحكم في الانفعالات في المعاملات بين الناس أو حتى في الجوانب العاطفية والوجدانية، وافتقاد مجتمعاتنا إلى تقاليد الصراحة والوضوح وانتشار مظاهر سلوكية غريبة.. من هذا المنظور، هل تعتقدون بأن التربية النفسية صارت أمرًا ضروريًّا في تنشئة الأجيال؟ ولكن ما هي مصادر هذه التربية، وهل لها جذور وتاريخ في ثقافتنا العربية والشعبية؟
وباعتبار الأدب يلامس ويتقاطع مع علوم إنسانية واجتماعية عديدة، فهل تعتقدون بأنه من الواجب استثماره (الأدب) في التربية النفسية للأجيال؟ وهل على الكاتب والشاعر والمُبدع أن يكون على معرفة بأصول التربية النفسية؟
هل تستشعرون الأخطارَ المحدقة بالأجيال الصاعدة ذات التأثير على بيئتهم النفسية؟ وكيف ترون طُرق استباق "الكوارث" التي قد تلحق بمجتمعاتنا وأجيالنا؟
وماذا عنك عزيزي القارئ، هل تعتقد بأن الخوض في موضوع التربية النفسية والأمن النفسي مجرّد ترف فكري لا طائل منه، أم أنه ضرورة تستدعيها توجّهات العصر الذي يسوق الإنسانية إلى الهاوية؟ اجمع أبناءك أمامك، ثم انظر في عيونك، واستحضر الأفكار التي تقرأها في هذا الملف، وتساءل: أيّ مصير ينتظر أبنائي في عصر تتوجّه فيه الإنسانية من سيّء إلى أسوأ، والإنسان من خسران إلى خسران أكبر؟ وحتى لا أثقل عليك عزيزي القارئ، أدلّك على موقف بسيط استلّه العرب من سياقه ثم اعتنقوه لمواجهة الحياة، موقف يقول: "دعوها فإنها مأمورة".

وحيد حمّود (كاتب من لبنان)
التربية النفسية.. هذه العبادة المنسية!
في البيت، في الشّارع، بين الأصحاب، في أروقة العمل، عند إشارات المرور، مع الفوز والخسارة، عند الخذلان والتعب، في كلّ مسارٍ من مسارات الحياة، لا جدوى من جسدٍ لا تهذّبه نفسٌ متّزنة أو تسعى للاتّزان بكلّ ما أوتيَت من عزم.
فلنفكّر مليًّا في أمر التّربية النّفسيّة، ما هي؟ وهل هي كما يُقال عبادةٌ منسيّة ومهمَلة؟ وما الشيء المترتّب عن إضاعة عبادةٍ كهذه بدءًا من الحلقة الصّغرى "حلقة العائلة" وانتهاءً بالحلقة الكبرى "حلقة المجتمع"؟
بدايةً، ووفقًا للمصدر "ويكيبيديا" لوحظ ظهور مفهوم التربية النفسية لأوّل مرّة في الكتابات الطبية في مقال كتبه "جون إي دونلي" بعنوان "العلاج النفسي وإعادة التأهيل" في دورية "علم النفس المرضي" التي نُشرت عام 1911. ولم يظهر الاستخدام الأول لكلمة "التربية النفسية" في الكتابات الطبية إلا بعد مرور 30 عامًا في عنوان كتاب "عيادة التربية النفسية" من تأليف "براين إي توملينسون" وقد نُشر هذا الكتاب في عام 1941. أما في اللغة الفرنسية، فإن أول ظهور لمصطلح (psychoéducation) - أو التربية النفسية - فكان في الرسالة الجامعية (La stabilité du comportement) التي نُشرت في عام 1962.
ويُعزى انتشار مصطلح التربية النفسية وتطوّره إلى شكله الحالي في المقام الأول إلى الباحثة الأمريكية "سي إم أندرسون" في عام 1980 في سياق علاج الفصام. فقد ركّز بحثها على تثقيف الأقارب بشأن عملية الفصام وأعراضها. كما ركّز بحثها على ترسيخ السلطة الاجتماعية وتحسين تعامل أفراد العائلة مع بعضهم البعض. وأخيرًا، تضمّن بحث "سي إم أندرسون" أساليب أكثر فعالية للتحكم في الضغوط. وللتربية النفسية في العلاج السلوكي أصولها في إعادة التعرف على المهارات العاطفية والاجتماعية. وفي السنوات القليلة الأخيرة ازداد تطوير برامج المجموعات النظامية، وذلك لجعل المعلومات مفهومة بصورة أكبر للمرضى وذويهم.
في محاولةٍ للتعقيب على هذه المعلومات، نرى أنّ هذا المصطلح حديث النّشأة، ولكنّه قديم المنشأ، إذ إنّ النفس البشريّة هي نفسها منذ أمر الله سيّدنا آدم وأمّنا حوّاء أن يسكُنا الأرض. ولا جرم أنّ التطوّر في علم المصطلحات هو دليلٌ على الوعي المجتمعي بما يختلج في هذه النّفس، من أجل ضبط التصرّفات أكثر وفَهم التغيّرات وفقًا للأحداث الكونيّة والتبدّلات الجغرافيّة والكوارث الطبيعيّة.
إضافةً إلى ما تقدّم، إنّ الإنسان محكومٌ بالتمَوضع والتعايش مع ما يحيطه، وهو إذّاك يقوم بأيّ شيء من أجل البقاء، إذ إنّ الحياة بكلّ ما فيها من متاعب مغرية، ولأنّ الإنسان، ملحدًا كان أم مؤمنًا، تظلّ لديه فكرة الحياة الثانية مبهَمة ومخيفة في آن، بحيث أنّ فاصلًا مؤكّدًا سيدخله الجميع وهو الموت أو كما يسمّى في عند العرب "هادم اللذّات"، ينغّص عليه سعادته، فيحاول درء هذا الفاصل وإبعاد شبح هذا الخطر عنه قدر المستطاع. وإنّنا إذا ما ألقينا نظرةً على الحضارات وجدنا أنّ الحروب منذ البدء وحتّى يومنا هذا تُقام من أجل البقاء، ويتمثّل هذا البقاء في التهافت والتنافس بل والتصادم من أجل الحصول على الموارد الأساسيّة من طعام وماء، وأُضيفت إليهما في عصرنا هذا، التكنولوجيا الذكيّة، بصفتها نوعًا من الموارد التي يستطيع المالك الأقوى لها التحكّم بحيوات البشر، وإفقارهم أو إغنائهم، والسيطرة على مواردهم الأخرى، وهنا تبرز أهميّة التربية النفسية جليّةً، إذ هل على الإنسان قضم موارد غيره من أجل أن يبقى؟ وهل عليه أن يقتل لكي ينجو؟ وهل تحتّم عليه أن يسيطر على ما ليس له من أجل أن يديم سعادته؟ أم أنّ التفكير بالآخر كشريكٍ على هذه الحياة يجب أن يوضع في الحسبان كي لا نصبح - وللأسف أصبحنا - في قانون الغاب؟
عَودٌ على بَدء، الطّفل يقلّد، فلا داعي لأن نعلّمه التعامل، إذ إنّه حتمًا سيتدرّب على ما يراه بأمّ عينيه، وما يسمعه بأذنيه، يكفي أن يصرخ الأب دائمًا في وجه كلّ شيء لكي يتعلّم الطّفل ألّا يقيم وزنًا لأحد، وربّما أن يكون متهوّرًا لا يعرف لغة العدّ حتى العشرة قبل أن يغضب، وهذا مثال بسيط يفقهه الطفل ويتجذّر في شخصيّته فيتحوّل إلى اضطراب نفسيّ حين يكبر. وإذا ما فتّشنا في فحوى العلاقات الأسرية بين الطفل والأهل لوجدنا العجب، لا سيما في عصرٍ تتشارك فيه الأجهزة الإلكترونيّة والمؤثّرون الجدد في تثقيف الطفل وتربيته نفسيّا في ظلّ غياب الأهل وانشغالاتهم، وهنا تتبدّى جليًّا هذه العبادة المنسيّة على النطاق الضيّق "نطاق العائلة" والتي ستتحكّم برحلة هذا الفرد في النطاق الواسع "نطاق المجتمع" مع الوقت.
إذًا، لا بُدّ من دقّ ناقوس الخطر، فالمجتمعات العربيّة تحديدًا تحيا في غفلة، وتقصّدت ذكر المجتمعات العربيّة لأنّها مجتمعات لم تزل تعطي أهميّةً للدين في الحياة، وإن بأشكال متفاوتة، فالرّسالات السّماويّة الثلاث تولي اهتمامًا شديدًا للتعامل مع الغير، وهذا الأمر إن دلّ على شيءٍ فإنّما يدلّ على انطلاق مصطلح التربية النفسيّة بنشأته من خالق هذا الكون، ولله المثل الأعلى، فهو الذي أمر بالعطف على الكبار ومجاراة الصّغار والحسنى للأهل وصلة الرحم للأقارب والمسامحة وغيرها من التعاليم التي وصلت مع كلّ رسالة سماوية.
ختامًا، ومن منظور الأدب، فإنّ للكلمات وَقعًا في نفس المتلقّي، إذ إنّ الأدباء والشعراء وأهل الفن عمومًا هم أكثر الذين يملكون القدرة على التأثير في الآخر عبر رسالتهم الفنية والأدبية، بحيث إنّ دور الأديب يمكن أن يتجلّى أيضًا في محاولة تقديم صورة أفضل للواقع وللعلاقات الإنسانيّة، فيكون بذلك قد قدّم ولو جزءًا بسيطًا من إبداعه في سبيل إنعاش هذه العبادة المنسيّة، لربّما نعود كعربٍ على الأقلّ أفضل أمّةٍ أُخرِجت للناس.

(باحثة وكاتبة سورية - لبنان)
جيل منتصف التسعينيات... الحظ واللعنة معا!
جيل منتصف التسعينيات، بل آخر دفعةٍ منه تحديدًا، جيلٌ محظوظ كما يصفه البعض، إذ لحق ببقايا زمنٍ أكثر هدوءًا وأقلّ تعقيدًا. جيلٌ عاش لمحة من البساطة قبل أن تغزونا التكنولوجيا بكل ما فيها من فوضى السرعة والسطحية.
كنتُ واحدةً من أولئك الذين امتدت لهم يد الحظ، لأكون في آخر صفوف هذا الجيل، الجيل الذي أصابته "لعنة الخوف من الزواج" كما يحلو للآخرين تسميتها. جيلٌ وُصِف بأنه معقّد تجاه الارتباط، يخشى المجهول، يهاب المسؤولية، أو يُتَّهَم بأنه غير مقتدرٍ ماديًّا، أو أنه يعيش ظلال خيبة حبٍّ فاشلة جعلته متردّدًا أمام أيّ خطوة تالية.
في الحقيقة، أيها القارئ العزيز - ويا سعيدًا إن كنتَ واحدًا منا - فربما كان من يطلق هذه الأحكام محقًّا إلى حدٍّ ما، لكنهم نسوا حلقةً خفيّة، ضائعة، لم يسلّط الضوء عليها أحد، لا نحن ولا هم.
خوفُنا الحقيقي ليس من الزواج بحدّ ذاته، بل من الخطأ الذي لا يمكن إصلاحه، من التراجع المستحيل بعد القرار، من أن نختار شريكًا يحمل في داخله عُقدًا نفسيةً لا تنكشف إلا بعد فوات الأوان.
فإن حالفنا الحظ وأحببنا، جاء خوفٌ آخر أشد وطأة: أن يكون الحبّ ابتلاءً آخر في صورة جميلة، أن نُصاب باضطراباتٍ نفسيةٍ لا شفاء منها، أو بأمراض القلب والقلق والوساوس التي تفتك بالروح قبل الجسد.
وإن تجاوزنا كل ذلك، طرَق بابَنا خوفٌ جديد... الخوف من أن نُعيد الخطأ ذاته في تربية كائنٍ صغيرٍ أتى إلى هذا العالم البارد. أن نخشى أن يكون طفلنا ضحية جديدة في دائرةٍ مكرّرة من الخلل التربوي، أو أن نعجز عن تحقيق التوازن بين الحزم والحنان. أن نكون ميسورين ماديًّا فنمنحه كل شيء، حتى يغدو شابًّا لا يعرف قيمة ما بين يديه، يطلب المزيد دون شكر، وحين يدور دولاب الحياة وتتعثر الخطى، نُدرك أننا ربّينا في داخله بذرة الترف المفرط التي لا تعرف الصبر ولا القناعة.
نخاف أيضًا أن نغرس فيه وهمَ التفوّقِ الدائم، فنريده الأول في كل شيء: في اللعب، في الدراسة، في الحياة. فنخلق في داخلِه مريضًا جديدًا على هذا الكوكب... إنسانًا لا يحتمل الخسارة، لا يفهم أن الحياة لا تُقدّم كل ما نريد، فينهار أمام أول انكسار، لأنه لم يتعلّم أن السقوط جزءٌ من النمو.
ولعلّ أكثر ما يُدهشني، ذلك الأب الذي يصرخ في وجه ابنه ليمتنع عن التدخين، بينما هو ينفث الدخان أمامه كأستاذٍ في الرذيلة، أو تلك الأم التي تطلب من ابنها أن يتحدث بهدوء وهي توبّخه بصوتٍ مرتفعٍ يزلزل الجدران! وعن تلك العائلة التي تلقّن طفلها الكذب لتجنّبِ الإحراج، ثم تعاقبه لاحقًا حين يصبح كاذبًا بارعا...
هذا هو الخوف الحقيقي، أن نُسيءَ تربية أطفالنا نفسيًّا ونحن نظنّ أننا نحسن صنعًا. أن نحاصرهم بالحماية المفرطة أو نغرقهم بالحرمان، فننتج شخصياتٍ مهزوزة، تائهة بين التمرد والاعتمادية.
إن علّمنا أبناءنا قيمة الصدق، استرحنا من عبء الشك، وإن تحدّثنا معهم بهدوءٍ، أسهمنا في تهدئة خلاياهم العصبية، ليصبحوا أكثر اتزانًا وقدرةً على استقبال الحياة بعقلٍ مطمئن.
عزيزي القارئ، لا تغترّ بالنجاحات الأكاديمية، فالطبيب أو الكاتب أو المهندس قد يحمل داخله عُقدًا تكفي لإشباع "يأجوج ومأجوج" من الاضطرابات! فالنجاح لا يعني بالضرورة سلامة النفس.
ولهذا، حين يحاول الطبيب النفسي فهم انهيار مريضه، يعود إلى هناك، إلى الطفولة، إلى البذرة الأولى التي لم تُروَ بالحبّ الصحيح ولا بالوعي الكافي.
أتذكر صديقةً لي تكبرني بسنوات، فقدت زوجها ودخلت في دوّامةٍ من رفض الواقع. وبعد فترةٍ طويلةٍ من التقبّل والعلاج، قررت أن تُعلّم ابنها ثقافة "الفقد" بوعيٍ عجيب. علّمته أن الأشياء قد تختفي فجأة، أن لعبته المفضلة قد تُكسر، وأن مدرسته قد تتبدّل، وأن الإنسان الذي يحبّه قد يغيب. كان الأمر قاسيًا، لكنه حقيقي. لقد أرادت أن تزرع في قلبه المناعة العاطفية قبل أن تفرضها عليه الحياة بقسوتها.
كم كنّا سنختصر من الألم لو أدركنا مبكرًا أهمية التوازن في التربية النفسية، لو فهمنا أن بناء الإنسان لا يبدأ من عقله بل من روحه، وأننا إن لم نحسن تربيتهم نفسيًّا، فسننجب أجسادًا تنمو وعقولًا تتكسّر.
جيل منتصف التسعينيات... جيل الحظّ واللعنة معًا. رأى كل شيء، وخاف من كل شيء، لكنه على الأقل وعى الخطر، وأدرك أن النجاة في هذا الزمن تبدأ من الداخل، لا من الخارج.

زينب أمهز (كاتبة وباحثة من لبنان)
ما قيمة الحياة إن فقدت أرواحُنا قدرتَها على الحلم؟
الإنسانُ روحٌ تتجلّى في هيئةٍ من طين، لا جسدٌ عابرٌ تسكنه ومضةُ روحٍ تائهة. وحين يَخفت صوتُ الداخل، ويغيب الهمسُ الذي يربطنا بأنفاسنا الأولى، يضطربُ ميزانُ الكائن، ويتداعى ما كان يشدّه إلى المعنى والجوهر. نغدو حينها أشبهَ بظلالٍ تمشي على الأرض، تُحركها المادّة وتُطفئها الضوضاء.
إنه زمنٌ تُستنزَفُ فيه الأرواح كما تُستنزَف الطاقات، وتُقايض فيه الأحلامُ بالوظائف، والكرامةُ بالتصفيق، والمشاعرُ بنقراتٍ على الشاشات. نُحاصَر بالخيبات، ونتنفسُ العدم في كل لحظةٍ من الصباح إلى المساء. نمنح فلا يُرى عطاؤنا، ونُحاطُ بأشباهِ بشرٍ لا يشبهوننا، يبتسمون بوجوهٍ ناعمةٍ تخفي قسوةَ الحجر. فكيف لا تتآكل النفس في هذا الطوفان؟
نستيقظُ على ألمٍ لا نعرف مصدره، وننام على وجعٍ يرفض أن يهدأ. وما بين الصحو والمنام، يتكاثرُ الخراب: قتلٌ ودمارٌ، ظلمٌ وتجويع، خيانةٌ تُعلن عن نفسها كأنها بطولة، وبيعٌ للضمائر تحت لافتة المصلحة.
نعيش في دوّامةٍ تصهرنا من زفراتِ الخارج إلى أنينِ الجدران، حتّى يصبح البيتُ ضيّقًا، والسكوتُ صاخبًا، والهواءُ مثقلًا بما لا يُقال. فكيف يُرجى من روحٍ مرهقة أن تظلّ نقيّة؟ وكيف يُطلب من إنسانٍ محطّم أن يبتسم للعالم؟
لذا وفي مثل هذا العصر، لا تكون التربية النفسية ترفًا ولا زينةً في الخطاب، بل هي الملاذُ الأخير، ضرورةُ البقاء، وجرعةُ الوعي التي تحفظُ الإنسان من السقوطِ في العدم. إنها عودةٌ إلى الأصل، إلى النور الذي يسكننا منذ الأزل، إلى صوتٍ خافتٍ في أعماقنا يقول: "لا تنسَ أنك روحٌ، وأن جسدك ظلّها لا أكثر".
إذا ما تأمّلنا مشاهد الحياة اليومية، نرى الفرد منّا يجهل نفسه، يعجز عن احتواء مشاعره، لا يُحسن التعبير عنها، ولا يعرف كيف يواجه الأزمات. نرى الغضب يفيض لأبسط المواقف، والاكتئاب يتسرّب في صمتٍ كالماء في الجدران، والعلاقات تنهار تحت وطأة انفعالاتٍ لم تُفهم بعد. كلّ هذا ليس سوى دليل على غياب أدوات التوازن النفسي، وعلى فقرٍ في الوعي العاطفي والسلوكي، ما يجعل التربية النفسية ضرورةً لا تقلّ شأنًا عن التربية العلمية أو الدينية أو الأخلاقية.
إنها تربيةُ القلب قبل الفكر، وتهذيبُ الشعور قبل السلوك. تلك التي تُعلّم الإنسان كيف يُصغي إلى ذاته، كيف يتنفس حين يشتدّ الغضب، وكيف يرمّم شقوقه الداخلية دون أن يجرّح الآخرين. فما نفعُ علمٍ يشيّد المدن إن كان الإنسان في داخله خرابًا؟ وما جدوى الأخلاق إن لم تُلامس جرح النفس لتضمّده؟
التربية النفسية ليست دروسًا تُلقَى، بل رحلة وعيٍ صامتة، يبدأها المرء حين يجرؤ على النظر في مرآته الداخلية بلا خوف. هي أن تُصالح نفسك على ماضيك، وتغفر لضعفك، وتُدرّب قلبك على الصبر لا على التبلّد، وأن تتعلّم الإصغاء إلى الآخرين كما تُصغي إلى نَفَسك حين يتقطّع.
إنها فنّ العيش بسلامٍ في عالمٍ لا يعرف السكينة، هي البوصلة التي تُعيدنا إلى إنسانيتنا كلّما أوشكنا أن نضيع في الزحام. ومن دونها، سنظل نُكرّر أخطاءنا، ونُبدّل وجوهنا دون أن نُبدّل دواخلنا.
فيا ليتنا ندرك أن بناء الروح لا يقلّ شأنًا عن بناء الجسد، وأنّ الوعي بالنفس هو أوّل درجات النور، فمن عرف نفسه، عرف طريقه، ومن رعى قلبه، أزهر العالم من حوله.
في زمنٍ مثقلٍ بالحروب، حيث لا بيت يخلو من غائبٍ أو مفقود، ولا قلبٍ إلا واعتاد على الفقد كعادةٍ يومية، تغدو التربية النفسية طوقَ نجاةٍ وحيد في بحرٍ متلاطمٍ من الألم.
في وطنٍ مثل لبنان، كم من طفلٍ وُلد على أصوات الانفجارات، وفتح عينيه على ركام البيوت لا على ألوان الصباح؟ كم من أمٍّ فقدت أبناءها، وكم من شابٍّ تاه بين الحزن والنجاة؟ ومن لم يخسر عائلته خسر صديقًا، أو جارًا، أو أمنَه الداخلي.
نحيا وسط الخسارات المتراكمة، وفي ظلّ ضيقٍ اقتصاديٍّ يثقل الجيوب والأرواح معًا. صار الهمّ اليومي أكبر من طاقة النفس، وصارت الابتسامة مقاومةً صغيرةً في وجه الانهيار.
وفي خضمّ كل هذا، يقف الطفل اللبناني على عتبة الوعي المبكر، يحمل في عينيه صورًا لا تُناسب طفولته: دخان، صراخ، وجوه قلقة، ونقاشاتٍ في المنازل تُشبِه المعارك الصغيرة. كيف تنمو نفسٌ صغيرةٌ بين الركام ولا تلتوي؟ كيف يتعلّم الطفل الحبّ، إن لم يجد من يعلمه كيف يُحبّ ذاته أولًا؟
من هنا تبدأ الحاجة الملحّة إلى تربيةٍ نفسيةٍ رحيمة، تحتضن جراح الصغار قبل أن تتكلّس، وتزرع فيهم معنى الأمان لا الخوف، والتعاطف لا القسوة، والرجاء لا اللامبالاة. وهنا، وكما في كلّ مجال، يبرز دور الأدب والأديب، فالأديب هو من يُمسك بجمر الحقيقة بيدٍ، ويُمسّد على قلب القارئ بالأخرى. الأدب ليس ترفًا لغويًّا في زمن الخراب، بل هو علاجٌ للروح بالكلمة، هو مساحةٌ آمنةٌ يتنفّس فيها الإنسان، فيرى نفسه في الحروف فيشعر أنّه ليس وحده.
في القصيدة، يجد الموجوع مرآته. وفي الرواية، يتلمّس القارئ طريق الخلاص. فالكلمة الصادقة تفتح نافذةً للنور في أضيق الجدران، والأديب الذي يكتب عن الوجع لا يُثير الشجن فحسب، بل يُعلّم الناس كيف يتعاملون مع وجعهم بوعيٍ لا بانكسار.
والأدب الحقيقيُّ هو امتدادٌ للتربية النفسية، فكلاهما يُعالج الإنسان من الداخل، ويُعيد له صلته بما هو جميل، بما هو إنساني. إنه فنّ التطهير بالمعنى، حيث تتحوّل الكتابة إلى شفاءٍ بطيءٍ، كأنّ كل جملةٍ تضع ضمادًا على جرحٍ غير مرئي.
ولم يكن الأدب يومًا فنًّا قائمًا بذاته، يعيش في عزلة عن سائر ميادين الفكر والمعرفة، بل ظلّ على الدوام مرآةً تعكسُ تفاعل الإنسان مع الحياة في أبعادها المتعدّدة. فقد ارتبط الأدب بعلم الاجتماع حين صوّر البنى والعلاقات داخل المجتمع، وكشف علله وآماله وصراعاته. وامتدّ ليصافح علم النفس، فغاص في أعماق الذات الإنسانية، كاشفًا دوافعها، وهواجسها، وما يختلج في سرائرها من ألمٍ وأمل.
كما تداخل الأدب مع الفلسفة، إذ حمل همَّ الوجود الإنساني وسعى إلى الإجابة عن أسئلة المعنى والغاية، ومع التاريخ حين سجّل الحوادث بروحٍ إنسانية نابضة، لا كما تسجّلها الوثائق الجامدة. بل إنّ الأدب اقترب حتى من العلوم الطبيعية والسياسية والاقتصادية، فكان في كلّ ميدانٍ لسانَ الإنسان وضميرَ العصر.
وهكذا فإنّ الأدب، في جوهره، مساحةَ التقاءٍ بين العاطفة والعقل، بين الفنّ والعلم، وبين الواقع والحلم، لأنه الفنّ القادر على ترجمة الإنسان في كلّ حالاته، فردًا كان أو مجتمعًا.
وإذا أردنا إيجاد بعض الحلول، فلعلّ المدرسة اليوم هي المكان الأقدر على حمل هذه الرسالة (فيما يخص الأطفال على وجه التحديد). فليست وظيفتها أن تُخرّج متفوّقين في الحساب واللّغة فحسب، بل أن تُربّي أرواحًا تعرف كيف تُحبّ، وكيف تُسامح، وكيف تصمد. ينبغي أن تُدرَّس في المدارس مهارات الحياة النفسية كما تُدرّس العلوم، أن يتعلّم الأطفال كيف يُعبّرون عن مشاعرهم، كيف يتعاملون مع الخوف والغضب، كيف يُصغون، وكيف يُشاركون الألم دون عنفٍ أو صمتٍ مُدمّر.
يمكن أن تُنشأ في المدارس جلسات تفريغٍ نفسي، حصص رسم وموسيقى، ومساحاتُ حوارٍ آمنةٍ يشرف عليها مختصّون أو تربويون مؤهّلون، يتعلّم فيها الأطفال كيف يعبّرون عن أنفسهم وعن مخاوفهم، كما يتعلمون أنّ البكاء ليس ضعفًا، وأنّ الحديث عن الخسارة بدايةُ التعافي منها.
إنّ زرع الوعي النفسي في الطفولة هو استثمارٌ في مستقبلٍ أقلّ قسوة، فكلّ جيلٍ متوازنٍ نفسيًّا هو وطنٌ قادرٌ على النهوض من تحت الركام. فيا ليتنا نُدرك أنّ بناء الإنسان أعمق من بناء الحجر، وأنّ التربية النفسية ليست ترفًا في زمن الوجع، بل هي اللبنة الأولى في إعادة إعمار الروح (خاصة في بلدنا). فما قيمة الأوطان إن لم يسكنها بشرٌ أصحّاء من الداخل؟ وما قيمة الحياة إن فقدت أرواحنا قدرتها على الحلم؟

سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
فقر في الفيتامينات النفسية!
لا شكّ أنّنا اليوم نعيش لحظة حاسمة في حرب غزّة، شاخصة أبصارنا على أسطول النّجاة المتوّجه نحو المياه الإقليميّة الغزّاويّة. ولا أظن أنّ أحدًا منّا ما يزال غافلًا عن هول المجاعة التي حاصرت الشّعب المقاوم على يد أعداء الحياة، هؤلاء الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: 74). أولسنا نلمس من الإجرام إنقراض الرّحمة والإنسانيّة؟
نعم قد أخبرنا الله عنهم حتى شهدنا قسوة قلوبهم بأمّ العين، وعلى كلمة: (شو طالع بإيدنا؟)، جالسين نحن، واضعين الهمّ نصب أعيننا، خاضعين لضعفنا وهواننا، كعرب أوّلًا، وكمسلمين ثانيًا. أفليس من الواجب علينا أن نلبّي دعوة المظلومين ومشاركتهم مائدة المقاومة والدّفاع عن كينونة الإنسانيّة؟
إنّ أعراض الهوان الذي نعيشه، واللامبالاة في مسيرة الحقّ، والدّوخة التي نمثّلها كلّما مرّت أمامنا مشهديّات لهياكل عظميّة حيّة، يجعلني أتساءل: هل ترانا نعاني من فقر في فيتامينات النّخوة؟ لست أدري إذ لم يخطر ببال أحد يومًا أن يقصد مختبر المتفلسفين ليخضع إلى فحص الإنسانيّة، رغم أنّ الأعراض واضحة، والإنسان طبيب نفسه.
وحين بدأت البحث عن علاج وقائي، وجدت أنّنا ربّما تربّينا في طفولتنا تربية نفسيّة تختلف عن انتماءاتنا، ووجوديّتنا، حتى صادفني كتاب "فيتامينات نفسيّة" لمؤلّفته "نانسي صميدة"، وجدني ليقدّم لي عرضًا لثلاثين كبسولة تعمل على معالجة النّفس وتطوير الذّات، من ضمن هذه الكبسولات الدّوائيّة كان هناك وصفة خاصّة عن الحرّية، وربّما حان الوقت لنتجرّع بعض هذه الفيتامينات، للوقاية، (على صحّة السّلامة).
فجلست أفكّر قليلًا بيني وبين نفسي، إلى أيّ مدى تجرّعنا أصول تربيتنا النّفسيّة؟ أم أنّنا استهلكناها في اتّجاهات ومآرب حياتيّة أخرى؟ هل نحن أحرار أصلًا؟ هل انكسارنا حرّية؟ هل المحاصرون ضمن سلاسل من القتل والتّجويع أحرار؟ هل المستضعون أحرار؟ هل المهدّدون بكلمة الحقّ أحرار؟ هل الصّارخون المحاربون لحقوق الإنسان صوتهم يعكس صورة الحرّية؟ ماذا نمتلك من هذه الحريّة داخل عروق إنسانيّتنا؟
نعم، نحن تربّينا أنّ أمهّاتنا ولدننا أحرارًا، وأّنّ رأسنا المرفوع ليس اختيارًا، ولكن متى كنّا حلفاء هذه الحرّية؟ متى طأطأنا رؤوسنا ويبست جذور التّربية النّفسيّة فينا حتى حرقتها شعلة الاستسلام والاكتئاب؟ متى تجرّعنا هذا الفيتامين ونحن في الأصل نطرق الأبواب ونعزف على أوتار الصّارخين ليكون صوتنا مسموعًا عبرهم. لست أدري إن كان انتظار اختفاء الأعراض وحدها سذاجة منّا، ونحن نعلم أنّ لا علّة إلّا ولها الدّواء المناسب، ولكنّنا ربّما نخاف الطّعم.
وحيث أنّنا أصبحنا واعين لحالتنا الصّحيّة، فربّما "أسطول الصّمود" يحمل معه بعض العلاج لعجزنا، أتراه يصل إلى ميناء النّجاة؟ فنتبادل معهم الدّواء، نعطيهم الفيتامين دال، ويتبرّعون لنا بفيتامين نون (نخوة) علّه يكون صدقة تساعدهم في فرج كربتهم، لنعيد إحياء النّفوس المريضة.

يوسف الشمالي (كاتب من لبنان)
مطلوب وزارة للاتزان النفسي والعواطف المعتدلة!
في زمنٍ صار فيه الجسد هو البطل الأوحد على مسرح الوجود، تُرفع له الرايات وتُقدَّم له القرابين، بينما الروح واقفة عند الباب تنتظر إذن الدخول… يبدو أننا بحاجة ماسّة إلى "تربية نفسية" لا تقلّ أهمية عن تربية العضلات أو تعليم مهارات استخدام الهاتف المحمول بمهارة تفوق مهارة "سقراط" في الجدل. الإنسان، كما نحبّ أن نردّد في دروس الفلسفة، هو معادلة بين روح وجسد، غير أن ميزان المعادلة اليوم اختلّ إلى درجة باتت فيها الروح مجرّد "ملف مؤجل" على سطح المكتب.
حين ننظر حولنا، نجد أنفسنا وسط جيلٍ يجيد التعبير عن انفعالاته بالرموز التعبيرية أكثر من الكلمات، ويقيس صدقه بعدد "اللايكات"، ويعتقد أن الصراحة جريمة أخلاقية تستحق الإعدام الافتراضي. في المقاهي والجامعات وحتى البيوت، نرى وجوهًا تتكلّم كثيرًا ولا تقول شيئًا، وانفعالات تُشبه النيران العشوائية، وقلوبًا تحتاج إلى إعادة برمجة. فهل نلوم المدارس التي تُعلّمنا كيف نرسم خريطة العالم ولا تُعلّمنا كيف نرسم خريطة أنفسنا؟ أم نلوم الأسر التي تخاف من "الحديث النفسي" كأنّه طقس غامض من طقوس اليوغا الشيطانية؟
التربية النفسية إذًا ليست رفاهية، بل ضرورة وجودية لو أردنا أن نحافظ على ما تبقّى من إنسانيتنا قبل أن تتحوّل حياتنا إلى حلبة صراع بين الغرائز والتطبيقات. غير أنّ السؤال الأخطر هو: من أين نأتي بها؟ من معالج نفسي لا يجد وقتًا إلا بعد شهر من الحجز الإلكتروني؟ من مؤثّرٍ على "تيك توك" يُقدّم دروسًا في السلام الداخلي بخلفية موسيقية وصوت رخيم؟ أم من كتب علم النفس القديمة التي تتحدّث عن "اللاشعور الجمعي" بينما اللاشعور الفردي لدينا ينهار أمام إعلان عطر جديد؟
ولعلّ المفارقة الجميلة أن جذور التربية النفسية كانت دائمًا في ثقافتنا دون أن نمنحها اسمًا. ألم تكن وصايا الأمّهات والأجداد نوعًا من تربية الروح؟ ألم يكن الشعراء القُدامى يعلّموننا الصبر والعشق والكرامة من دون أن يفتحوا كتابًا في التحليل النفسي؟ في الأمثال الشعبية وحدها تجد علم نفسٍ عميقًا: "كل إناء بما فيه ينضح"، و"اللهم لا تجعلنا من الذين يرون القذى في عيون الناس وينسون الخشبة في عيونهم". لكننا، في زمن السرعة، صرنا نحفظ الأمثال كما نحفظ كلمات الأغاني: بلا روح ولا عبرة.
وهنا يدخل الأدب، ذاك الطبيب النفسي الذي لا يطلب أجرًا. فالرواية الجيدة جلسة علاج جماعية، والقصيدة نافذة تهوية للعقل، والمسرحية مرآة تشخّص العطب. الأدب ليس ترفًا لغويًّا، بل ممارسة علاجية لمن يجرؤ على مواجهة نفسه. ولعلّ الكاتب الحقّ هو من يمارس تربيةً نفسيّة على نفسه أولًا، قبل أن يكتب عن الآخرين. فكيف يمكن لشاعرٍ يكتب عن الجمال أن يزرع الجمال في النفوس وهو نفسه غارق في فوضاه؟ وكيف لمبدعٍ أن يكون "مربيًّا نفسيًّا" للأجيال إن لم يعرف أصول التوازن بين الحلم والواقع؟
المشكلة أننا نتعامل مع الأدب كما نتعامل مع الأدوية: نقرأه بعد فوات الأوان. نلجأ إليه عندما تصيبنا خيبات الحب أو الغربة أو القلق، بينما الأدب كان يجب أن يكون جزءًا من مناعتنا النفسية منذ البداية. فبدل أن نعلّم أولادنا جدول الضرب فقط، ماذا لو علّمناهم كيف لا "يضربهم" الواقع بهذه القسوة؟
أما عن الأخطار المحدّقة بالأجيال، فهي لا تحتاج إلى عالم اجتماع ليكتشفها؛ يكفي أن تفتح هاتفك خمس دقائق لتدرك حجم العطب. أجيالٌ تعرف كل شيء عن التكنولوجيا، ولا تعرف شيئًا عن ذاتها. أجيالٌ تظنّ أن الحرية في أن تفعل ما تشاء، لا أن تفهم لماذا تفعل ما تشاء. أجيالٌ تحتاج إلى "مناعة نفسية" أكثر من أيّ لقاح. وإن لم نبادر نحن إلى تربيتها نفسيًّا، فستتكفّل الشاشات بالمهمة، لكن بطريقتها الخاصة: تحويل الإنسان إلى صورة جميلة من الخارج، متكسّرة من الداخل.
باختصار، التربية النفسية ليست شعارًا ولا مادة دراسية، بل هي فن العيش بوعي. وإن لم نستيقظ قريبًا، فسنحتاج يومًا إلى "وزارة للاتزان النفسي" و"هيئة عامة للعواطف المعتدلة" وشرطة خاصة تضبط حالات الغضب المفرط في التعليقات الإلكترونية. وحتى ذلك الحين، فلنحاول على الأقل أن نربّي أنفسنا قليلًا قبل أن نُطالب بتربية الأجيال.

د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، كلية الآداب ـ جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر)
في عصر العولمة الثقافية والفكرية.. التربية النفسية ضرورة لضمان الحصانة الروحية؟
الإنسان ليس جسدا فحسب، كما إنه ليس روحا فقط، وإنما هو معادلة بين الروح والجسد، في توازن يكفل استقامة الحياة وسعادة الإنسان، وفي عصرنا الراهن تكاد نزوات الجسد أن تطغى على كل شؤون الروح، والله يعلم ما الذي ستكون عليه أحوال أجيالنا خلال العقود القادمة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه من طغيان الحياة المادية وإهمال الجوانب الروحية.
وإذا تأمّلنا في واقعنا الراهن، نرى مظاهر عدم الاتزان الشخصي وعدم التحكم في الانفعالات في المعاملات بين الناس أو حتى في الجوانب العاطفية والوجدانية، وافتقاد مجتمعاتنا إلى تقاليد الصراحة والوضوح وانتشار مظاهر سلوكية غريبة..
ومن هذا المنظور، فإننا نعتقد بأنَّ التربية النفسية صارت أمرًا ضروريًّا في تنشئة الأجيال، حفاظا على توازنها واستقامتها وضمانا لحياة سويّة مستقرة تُوازن بين المادة والروح، بين حاجات الجسم وضرورات النفس.
ومما لا شك فيه أن هذه التربية المتوازنة لها جذور وتاريخ في ثقافتنا العربية والشعبية، ولأنَّ الأدب يلامس ويتقاطع مع علوم إنسانية واجتماعية عديدة، فإننا نعتقد أنه من الواجب استثمار الأدب في التربية النفسية للأجيال، مثله مثل سائر العلوم والفنون القديمة والمستحدثة على السواء كالرسم والنحت والتصوير والموسيقى والغناء وغيرها.
وعلى الكاتب والشاعر والمُبدع أن يكون على معرفة بأصول التربية النفسية، حتى يكون لأدبه الأثر المرجو في هذه التربية المتوازنة لمَن يتعاطون هذا الأدب شعرًا كان أم نثرًا، لأننا نستشعر أخطارًا محدقة بالأجيال الصاعدة ولها تأثير كبير على بيئتهم النفسية والاجتماعية.
كما نرى ضرورة استعداد المجتمعات العربية وقادة الرأي فيها، من مؤسّسات وأفراد لإيجاد طُرق لاستباق "الكوارث" التي قد تلحق بمجتمعاتنا وأجيالنا، في عصر العولمة الثقافية والفكرية، ومحاولة فرض الأنموذج الغربي على مجتمعاتنا في التنشئة الاجتماعية، كما نرى ضرورة الاهتمام بالتربية النفسية للنشء، ومعرفة سبل اكتسابها، وعلاقتها بالأدب.
فالتربية النفسية ليست ترفًا فكريًّا ولا مسألة هامشية، بل هي عملية عميقة تهدف إلى بناء الإنسان من الداخل، وتحقيق التوازن بين روحه وجسده، وضبط انفعالاته، وتطوير شخصيته، ليعيش حياة متوازنة قوامها الأخلاق والوعي الذاتي.
وفي عصرنا الراهن، أصبحت التربية النفسية ضرورة ملحّة في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يواجهها الفرد والمجتمع.
مفهوم التربية النفسية وأهميتها
التربية النفسية هي عملية شاملة تهدف إلى تزكية النفس، وتنمية القدرات العقلية والعاطفية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الجسد واحتياجات الروح. وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية تزكية النفس في قوله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا" (الشمس، الآية: 9 – 10). وهذا يؤكد أنَّ نجاح الإنسان وفلاحه مرتبط بقدرته على تزكية نفسه وضبط شهواته وانفعالاته. وفي السنة النبوية، نجد حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"، وهذا الحديث يؤكد على أهمية التحكم في الانفعالات، وهو أحد أهداف التربية النفسية.
وهناك آيات قرآنية كثيرة تتناول مسألة التوازن بين متطلبات الجسد وتزكية النفس وتطهيرها، ولعل في حديث النفر الذين سألوا عن عبادة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما أخبروا بها، كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما علم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس مني.
وهذه التوجيهات النبوية وغيرها كثير تؤكد على أهمية التوازن بين مطالب الجسم والروح وعدم تغليب أحدهما على الآخر، فلا رهبانية في الإسلام، وقديما قيل: وراء كل راهبة قصة.
أهمية التربية النفسية
تتبدّى أهمية التربية النفسية في الجوانب الآتية:
1. الحد من الاضطرابات النفسية والاجتماعية.
2. بناء شخصيات متوازنة قادرة على مواجهة التحديات.
3. تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية في المجتمع.
سُبل اكتساب التربية النفسية
اكتساب التربية النفسية عملية متدرّجة تحتاج إلى وعي وجهد وممارسة مستمرة، ومن أهم سبلها:
1. المصادر الدينية:
- القرآن الكريم والسنة النبوية هما الأساس في تزكية النفس، وقد قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" (آل عمران: 134).
- الممارسات التعبديّة كالصلاة والصوم والزكاة والحج تُعلّم الإنسان الصبر والانضباط وضبط النفس، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم جُنّة من اللغو والرفث، والزكاة تطهير للمال وتزكية للنفس من الشح والبخل، والحج غسل للنفس من أدرانها فمَن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
2. التربية الأسرية:
- تبدأ التربية النفسية من الأسرة عبر غرس القيم منذ الصغر، فالتعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وفي الحديث النبوي الشريف: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه. والفطرة هنا تعني الإسلام.
كما يقول الشاعر:
وينشأ ناشئ الفتيان منا -- على ما كان عوده أبوه
- تشجيع الحوار والتواصل الإيجابي بين أفراد العائلة، لأنَّ التسلّط وفرض الرأي والقهر وعدم الحوار ينتج شخصيات مريضة نفسيًّا وغير قادرة على المشاركة في بناء المجتمع والإسهام في تطوره وتقدمه سياسيا واجتماعيا ونفسيا.
3. التربية الذاتية:
- محاسبة النفس بشكل دوري، وقد ورد في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسَبوا، وزِنوا أعمالكم قبل أن توزَن عليكم. فمحاسبة النفس مدعاة لتصحيح الأخطاء أولا بأول، وإحداث التوازن بين الجسم والروح من جهة وبين الإنسان ومجتمعه من جهة أخرى.
- التأمل ومراجعة المشاعر والانفعالات، مما يؤثر في النفس، ويدعو إلى تصحيح الأخطاء بضبط المشاعر والانفعالات في تعاملات الإنسان مع نفسه وأقاربه وأصدقائه وزملائه وأبناء مجتمعه بل وأبناء المجتمعات الأخرى الذين قد يتعامل معهم، فيكون صورة مشرفة ومرآة صادقة لنفسه ولدينه ولمجتمعه، فكل إناء بالذي فيه ينضح.
4. المدرسة والمجتمع:
- المدارس بيئة مهمّة لتعليم مهارات الحياة والذكاء العاطفي، فهي الحاضنة التربوية الثانية بعد الأسرة ومنها يتعلم النشء كيفية السلوك السوي في المجتمع ومع الأقران والأساتذة، كما يتعلم مبادئ الحياة ومهاراتها كالتعاون والإيثار وحب الوطن والتضحية في سبيله وعدم الأنانية والرياضة وحب الأدب والفنون والعلوم وكيفية التعامل مع الآخرين وغير ذلك مما يسهم في إحداث التوازن في حياة الصغار بين مطالب الروح والبدن.
- توفير برامج إرشاد نفسي للطلاب، لمعالجة أوجه القصور التي تنتج عن جهل الآباء أو انشغالهم عن أبنائهم أو التفكك الأسري نتيجة انفصال الوالدين وغير ذلك مما يؤثر على نفسية الأبناء وعلى سلوكهم في المجتمع، ومن هنا كان هناك أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي في كل مدرسة بل وفي كل كلية ومعهد تعليمي لتقويم سلوك الطلاب وتوجيههم ليكونوا لبنات صالحة في بناء المجتمع.
5. الأدب والفن:
- الأدب يعكس النفس البشرية ويساعد في فهمها، فالأدب هو مرآة المجتمع التي تعكس أمراضه وعيوبه وتحاول أن تعالجها وتضع لها الحلول الناجعة.
- قراءة الروايات والقصص والشعر ينمِّي التعاطف والقدرة على التأمل، ويرهف الحس ويهذّب الذوق بحيث يكون الإنسان مثقفا يتعاطف مع النماذج البشرية المهضومة الحق، ويقف في وجه الظلم في المجتمع ويصحح المفاهيم المغلوطة ويعالج الآفات التي خلفتها عصور الجهل والتخلف وسيطرت عليها الأعراف الفاسدة والتقاليد البائدة، بدلا من القيم الدينية السمحة والمبادئ القويمة، وكأننا عدنا إلى جاهلية القرون الأولى، ومن أمثلة ذلك موضوع الأخذ بالثأر وهو من العادات المتأصلة في صعيد مصر حتى اليوم وإن خفت حدّتها بعض الشيء مع انتشار التعليم وسيطرة الدولة وتطور العادات. وكذلك قضية ظلم المرأة وهضم حقها في الميراث، فهي من العادات الذميمة التي تخالف الشرع الحنيف.
علاقة الأدب بالتربية النفسية
الأدب هو مرآة النفس الإنسانية، وهو أحد الوسائل الفعّالة في التربية النفسية، حيث يتيح للإنسان فهم مشاعره ومشاعر الآخرين.
الأدب كأداة للتعبير عن النفس
يُعدُّ الشعر مرآة النفس الإنسانية، وصوت الضمير الجمعي للأمّة، وأداة من أقدم أدوات التهذيب والتوجيه، فمنذ أن نطق العربي بالشعر في الجاهلية، كان شعره تعبيرًا عن القيم التي تشكّل وعيه ووجدانه، وكان وسيلةً لتربية النفس على مكارم الأخلاق، وتغذية الروح بالمعاني السامية، وظل الشعر في كل عصر ينهض بهذا الدور التربوي والنفسي، حتى أصبح أحد أعمدة الأدب الأخلاقي في التراث العربي.
الشعر في العصر الجاهلي: مدرسة الفضائل والقيم
لم يكن الشعر الجاهلي مجرّد وصفٍ للخيل أو المديح أو الفخر، بل كان منبرًا للفضيلة والقيم، فقد دعا إلى الكرم، والشجاعة، والوفاء، والعفة، وصيانة العرض، واحترام العهود. وكان الشاعر يمثل ضمير القبيلة ومربيها، يمدح المحسن ويهجو المسيء، وبذلك يهذب السلوك العام.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك قول حاتم الطائي في الكرم، وعنترة بن شداد في الشجاعة والعفة، وزهير بن أبي سلمى في الحكم والعقل حيث يقول:
ومَنْ لا يَذُدْ عن حوضِه بسلاحِه -- يُهدَّمْ، ومَنْ لا يَظلمِ الناسَ يُظلَمِ
فقد دعا زهير إلى التوازن بين العدل والقوة، موجهًا النفوس إلى الحكمة في السلوك، وهو نوع من التهذيب النفسي والاجتماعي.
صدر الإسلام.. الشعر في خدمة الإيمان والأخلاق
فمع بزوغ الإسلام، انتقل الشعر من ميدان القبيلة إلى ميدان العقيدة والإنسانية، فقد أصبح وسيلة للدفاع عن القيم الإسلامية، ومساندة الدعوة إلى الخير والإصلاح.
قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ من الشعر حكمة" (رواه البخاري). فقد كان الشعر عند المسلمين وسيلة لتربية النفس على الصبر والتقوى، وحبّ العمل الصالح. ومن شعراء تلك المرحلة "حسان بن ثابت" الذي جعل شعره سلاحًا للدفاع عن الرسول والدين، فغرس في النفوس معاني الإيمان والكرامة والعزة، وكذلك كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم.
العصر الأموي والعباسي: الشعر بين الحكمة والتهذيب
وفي العصرين الأموي والعباسي، اتّسعت آفاق الشعر لتشمل موضوعات الزهد، والحكمة، والموعظة، والفكر، فظهر شعراء جعلوا من الشعر منبرًا للتأمل في النفس والوجود، أمثال أبي العتاهية والحسن البصري وأبي تمام والمتنبي.
قال أبو العتاهية في الزهد:
لا تأمن الموتَ في طرفٍ ولا نفسٍ -- وإنْ تمنَّعت بالحُجّابِ والحــــــرسِ
فهنا يربّي الشاعر النفس على التواضع، ويذكرها بفناء الدنيا.
أما المتنبي فقد غرس في النفوس الاعتداد بالذات والسعي إلى المجد، فقال:
وإذا كانتِ النفـــوسُ كبارًا -- تعبتْ في مُـرادِها الأجسامُ
وقال أيضا:
ولم أر في عيوب الناس عيبا -- كنقص القادرين على التمـــام
فكان شعره مدرسة في الإرادة والطموح وعلوِّ الهمة.
في العصور المتأخرة والنهضة الحديثة: الشعر التربوي والوطني
وفي العصور المملوكية والعثمانية، ظل الشعر وسيلةً للحفاظ على الأخلاق والقيم رغم ضعف اللغة والسياسة، ثم جاء عصر النهضة، فنهض الشعر برسالة جديدة، تمزج بين تهذيب النفس وبعث الأمة.
فالشعراء أمثال محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وإيليا أبو ماضي وحافظ إبراهيم أعادوا للشعر دوره التربوي والإنساني.
قال شوقي في تربية النفس:
وإنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيتْ -- فإن همُ ذهبتْ أخلاقُهم ذهبوا
وهنا يربط الشاعر بين الفضيلة وبقاء الأمة، مؤكدًا أنَّ تهذيب النفوس هو أساس النهضة والخلود.
الشعر في العصر الحديث والمعاصر: تهذيب بالوعي والوجدان
وفي القرن العشرين وما بعده، أصبح الشعر وسيلةً للتهذيب الوجداني والفكري معًا، فدخلت إليه قيم إنسانية كالسلام، والحرية، والعدالة، والتسامح.
نجد في شعر إبراهيم ناجي ومحمود غنيم ومحمود درويش وغيرهم دعوات إلى تأمّل الذات، وتزكية الروح، والارتقاء بالإنسان نحو الوعي. فقد غدا الشعر في هذا العصر تربية فكرية ونفسية معًا، تزرع في النفس حبّ الجمال، وإدراك عمق الوجود، ومقاومة القبح والظلم.
أثر الشعر في تهذيب النفوس وغرس الفضائل
1. غرس القيم الأخلاقية: كالصدق، والكرم، والوفاء، والشجاعة، والتواضع.
2. تربية الوجدان: بإيقاظ الحسِّ الجمالي، وتنمية المشاعر النبيلة.
3. التزكية النفسية: بتطهير القلب من الأحقاد والأنانية.
4. الإصلاح الاجتماعي: بتصوير المظالم والحثِّ على العدل.
5. تحفيز الإرادة: ببثِّ روح الإصرار والأمل والمقاومة.
6. التذكير بالمآل: من خلال الزهد والتأمل في الموت والحياة والجزاء.
فلقد كان الشعر العربي منذ الجاهلية وحتى اليوم ضمير الأمّة ومربّيها. لم يكن ترفًا لغويًّا، بل أداة إصلاح وتهذيب وبناء للإنسان. وإذا كانت النفوس تُصاغ بالكلمة، فإنَّ الشعر هو أرقى تلك الكلمات، لأنه يخاطب الوجدان والعقل معًا، ويغرس في النفس معاني الخير والحق والجمال.
القصة والرواية
لا شك أنَّ القصة تساعد القارئ على استكشاف شخصيات متنوعة وصراعات نفسية مختلفة، مما يعزز قدرته على فهم ذاته والآخرين.
دور القصة والرواية في غرس القيم النبيلة وتهذيب النفوس
تُعدّ القصة والرواية من أعرق فنون الأدب الإنساني وأقواها تأثيرًا في وجدان المتلقي، إذ تخاطبان العاطفة والعقل معًا، وتقدمان القيم والمبادئ في ثوب فني شيق يجعل من التوجيه الأخلاقي تجربة وجدانية ممتعة، فالأدب القصصي ليس مجرد تسلية، بل هو وسيلة من وسائل التربية الفكرية والنفسية والاجتماعية، يسهم في تهذيب النفوس وغرس الفضائل، على نحو ما فعل القصص القرآني والنبوي، وما واصلته الرواية العربية المعاصرة بأساليبها الحديثة.
القصة في القرآن الكريم والتربية الأخلاقية
جاء القصص في القرآن الكريم لتربية الإنسان على الإيمان والفضيلة، لا لمجرد السرد أو التسلية. فقد عرض الله تعالى قصص الأنبياء والأمم السابقة للعبرة والعظة، قال تعالى: "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ" (يوسف: 111).
ومن أبرز الأمثلة قصة يوسف (عليه السلام) التي تمثل مدرسة في الطُّهر والعفّة والصبر والعفو. فقد عرضت القصةُ فتنَ الشهوة والظلم والسجن، ثم أظهرت انتصار القيم على الأهواء، حين قال يوسف (عليه السلام): "مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ" (يوسف، الآية: 23)، فكانت أنموذجًا رفيعًا للعفة ومقاومة الإغراء.
وكذلك قصة موسى (عليه السلام) التي تُعلّم الشجاعة والثقة بالله في مواجهة الطغيان، وقصة لقمان الحكيم التي تجسد الحكمة والأدب مع الله والوالدين والناس. وبهذا، أسّس القصص القرآني قاعدة تربوية متينة تجعل من السرد وسيلة للتهذيب النفسي وتزكية الروح.
القصة النبوية وغرس القيم العملية
اقتدى النبي (صلى الله عليه وسلم) بالمنهج القرآني في التربية بالقصة، فكان يروي لأصحابه قصصًا موجزة ذات دلالات عميقة. من ذلك قصة الرجل الذي سقى كلبًا فغفر الله له، وهي درس في الرحمة والعطاء الإنساني. وكذلك قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فكانت مثالاً للصدق في العمل والإخلاص في الدعاء والبر بالوالدين. وبهذه القصص الموجزة رسَّخ الرسول (صلى الله عليه وسلم) في نفوس أصحابه معاني الإخلاص والتوبة والرحمة والوفاء، فأصبحت القصة وسيلة تربوية عملية تُخاطب القلب والعقل معًا.
القصة والرواية في الأدب العربي الحديث
مع تطور الأدب العربي في العصر الحديث، أصبحت الرواية مرآة المجتمع ووسيلة فاعلة لغرس القيم والنهوض بالوعي، فقد استخدم كبار الروائيين القصة لتصوير الصراع بين الفضيلة والرذيلة، والعدل والظلم، والعلم والجهل. فنجد "طه حسين: في روايته "الأيام" يقدم أنموذجًا لمعاناة الإنسان في سبيل العلم والنور، داعيًا إلى الصبر والمثابرة. ويبرز "نجيب محفوظ" في رواياته مثل "اللص والكلاب" و"بين القصرين" صورة الإنسان الذي يتأرجح بين القيم والغرائز، ليخلص القارئ إلى ضرورة التمسك بالمبادئ رغم التحولات الاجتماعية. أما "عبد الحميد جودة السحار" في روايته "أم العروسة"، فقد صوَّر دفء الأسرة المصرية وتماسكها، مُبرزًا قيم التعاون والتضحية.
وفي روايات "غسان كنفاني" مثل "رجال في الشمس"، نرى تجسيدًا لقيمة الكرامة ورفض الاستسلام، بينما تبرز روايات الطاهر وطار وعبد الرحمن منيف قيم الحرية والعدالة والصدق الفني في مواجهة الظلم.
الوظيفة النفسية والجمالية للقصة
تتجاوز القصة وظيفتها التعليمية إلى وظيفة نفسية عميقة، إذ تُسهم في تطهير النفس (التطهير الأرسطي)، وتحرير العواطف المكبوتة، وتقديم القدوة الحسنة، فحين يتماهى القارئ مع بطل الرواية الصالح أو المصلح، تتولد لديه رغبة في الاقتداء به، وحين يرى عاقبة الشر والفساد، يتجنبها طوعًا. وبهذا، تصبح القصة علاجًا للنفس ووسيلةً لبناء الضمير الجمعي للمجتمع، تجمع بين اللذة الفنية والفائدة الأخلاقية.
إنَّ القصة والرواية، منذ القصص القرآني والنبوي حتى الأدب المعاصر، كانت ولا تزال من أنبل وسائل التربية الإنسانية، فهي تُهذّب النفس، وتزرع في الإنسان قيم الصدق والعدل والصبر والرحمة، وإذا أحسن الكاتب استخدام هذا الفن بما يوافق قيم الحق والخير والجمال، تحولتْ الكلمة إلى طاقة روحية ترفع الإنسان إلى مدارج الكمال، وتجعل من الأدب رسالة للإصلاح والبناء.
الأدب الصوفي
- يركّز على تزكية النفس والسمو الروحي، مثل أشعار ابن الفارض وجلال الدين الرومي.
يُعَدُّ الأدب الصوفي من أرقى ألوان التعبير الإنساني التي سعت إلى تهذيب النفس، ورفعها من عالم الحسِّ إلى عالم الروح، تحقيقًا للتوازن الذي دعا إليه الإسلام بين الجسد والروح، فالإسلام لا ينكر الجسد ولا يُهمل الروح، بل يجعل لكلٍّ حقَّه، كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ لِرَبِّكَ عليك حقًّا، ولِنَفْسِكَ عليك حقًّا، ولأَهْلِكَ عليك حقًّا، فأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه"، فكان الأدب الصوفي صوتًا حيًّا لهذه الفلسفة الوسطية التي تجمع بين الزهد والعمارة، بين العبادة والعمل.
مفهوم الأدب الصوفي: الأدب الصوفي هو نتاج التجربة الروحية التي يعيشها الصوفي في سعيه نحو معرفة الله، فيتحوّل الوجدان إلى كلمات، والمعرفة إلى شعرٍ أو نثرٍ مشبعٍ بالرموز والدلالات الروحية. وقد عبّر المتصوّفة عن مشاعرهم بلغة المحبة والعشق الإلهي، كما نجد عند الحلاج وابن الفارض وابن عربي وجلال الدين الرومي وغيرهم.
دوره في الارتقاء بالنفس الإنسانية: يهدف الأدب الصوفي إلى تطهير النفس من أدران الشهوة والأنانية، ودعوتها إلى السموّ بالحبّ الإلهي، فالإنسان في التصوُّف لا يُخلَق للغرائز فحسب، بل خُلق ليكون خليفة الله في الأرض. ومن هنا جاءت رمزية العشق الإلهي في الشعر الصوفي لتعبّر عن الاتحاد بالمطلق لا بالمعنى المادي، بل بالمعنى الروحي الذي يُذيب الأنا في محبة الله.
يقول ابن الفارض في تائيّته الكبرى:
زدني بفــــــرطِ الحبِّ فيكَ تحيُّرًا -- وارحمْ حشىً بلظى هواكَ تسعَّرا
فهو يطلب من الله مزيدًا من الحبّ الذي يطهّر النفس من التعلّق بالدنيا، ويقرّبها من النور الإلهي.
تحقيق التوازن بين الروح والجسد: الأدب الصوفي لا يدعو إلى إهمال الجسد أو احتقاره، بل إلى تزكيته ليكون وسيلة لا غاية، فالمتصوف يروِّض الجسد بالصوم والذكر، ويغذّي الروح بالتأمل والعبادة، وهنا يتحقّق التوازن الذي أكّد عليه الإسلام، إذ إنَّ الروح بدون جسد لا تعمّر الأرض، والجسد بلا روح آلة خاوية. يقول جلال الدين الرومي في ديوانه:
لستُ من الطينِ، بل من روحِكَ يا ربِّ -- فكيفَ أُقيمُ في سجـــــنِ الجسدِ طويلاً؟
فهو لا يُنكر الجسد، لكنه يرى أنه ممرّ نحو النور، لا موطن إقامة.
أثر الأدب الصوفي في المجتمع الإسلامي: كان الأدب الصوفي مدرسة في الأخلاق والرحمة والتسامح، فقد علَّم الناس محبة الله والخلق جميعًا، ووجّههم إلى الزهد بلا انطواء، والعبادة بلا عزلة، وانتشرتْ أشعاره ونثره في الزوايا والطرق، تذكِّر الناس بالحق، وتواسي المهموم، وتدعو إلى الصفاء الداخلي.
وقد تأثر بالأدب الصوفي كثير من الأدباء والمفكرين، مثل الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين"، وابن عربي في "الفتوحات المكية" و"ترجمان الأشواق"، حيث امتزج الفكر بالعاطفة، والعلم بالذوق.
إن الأدب الصوفي لم يكن مجرّد كلماتٍ عن الحبّ الإلهي، بل كان منهج حياة يسعى إلى بناء الإنسان المتوازن روحًا وجسدًا، مؤمنًا بأنَّ السَّعادة الحقيقية تكمن في صفاء القلب لا في متاع الدنيا، وهكذا أسهم التَّصوُّف الأدبي في الارتقاء بالنفس الإنسانية، وفي تحقيق الانسجام بين عالم المادة وعالم الروح كما أراد الإسلام.
فالأدب، بجميع أشكاله، يسهم في غرس القيم، ويقدّم نماذج للتعامل مع الانفعالات والصراعات النفسية.
الأخطار المحدقة بالأجيال المعاصرة
تواجه الأجيال الصاعدة تحديات نفسية كبيرة، منها:
1. التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل التنمّر الإلكتروني وضغوط المقارنة.
2. الصراع بين القيم التقليدية والحديثة، مما يؤدي إلى فقدان الهوية.
3. ضعف الروابط الأسريّة وقلّة الحوار داخل الأسرة.
4. قلة الوعي بالصحة النفسية وعدم توفر الدعم الكافي.
هذه الأخطار تستدعي برامج تربوية متخصصة لحماية الشباب وتنمية وعيهم النفسي.
استباق الكوارث النفسية
لمواجهة التحديات النفسية، نحتاج إلى استراتيجيات استباقية، منها:
1. إدخال التربية النفسية في المناهج الدراسية.
2. تدريب المعلمين والأسر على مهارات الدعم النفسي.
3. تعزيز القراءة الأدبية التي تبني الوعي النفسي.
4. إنشاء مراكز استشارية نفسية متاحة للجميع.
5. نشر ثقافة الصحة النفسية عبر الإعلام والمؤسسات الثقافية.
هذه الإجراءات تسهم في بناء جيل متوازن قادر على مواجهة الحياة بثقة وإيجابية، فالتربية النفسية هي الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع.
ومن خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، والأدب بأشكاله المختلفة، نستطيع غرس القيم النفسية السليمة في الأجيال.
إنَّ الاستثمار في التربية النفسية ليس ترفًا، بل هو ضرورة لحماية الفرد والمجتمع من التفكك والاضطرابات.
وبهذا تتضح العلاقة الوطيدة بين الأدب والتربية النفسية، فكلاهما يسعى إلى بناء إنسان متوازن، يمتلك الوعي بذاته وبالآخرين، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
ويطيب لي أنْ أختم هذا المقال المهم بقصيدة توجهتُ بها إلى ابني أحمد منذ سبعة عشر عاما في (10 - 11 - 1429 هـ - 8 - 11 - 2008 م)، بعنوان "رسالة إلى ولدي"، تجسّد دور الشعر في التربية والتوجيه إلى الفضائل والقيم والنبيلة والمُثل العليا، والتحذير من ضدها، والحضّ على طلب العلم والتمسك بالأخلاق لتحقيق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.
ولدي أحبك هل تعــــــي -- إني وهبتك أجمعــــــــي
لم يا بني تثيــــــــــــرني -- وتسيل أنهر أدمعــــــــي
وتثير أمك يا فتــــــــــى -- قد أجهشت بمدامــــــــــع
دمع الأبوة يا حبيـــــــــ -- ـب، دليل حرقة أضلـــــع
إياك أن تعصي الإلــــــ -- ـه بقول "أف" هل تعي؟
حرفان لو نطقا لكــــــــا -- نا صكة لمسامــــــــــــع
فاربأ بنفسك عنهمــــــــا -- كي لا تثير مواجعــــــي
وتحطم الآمال فيــــــــــ -- ــك، وتنتهي لفجائــــــع
إنا نريدك طيب الـــــــــ -- أخلاق، رب منافـــــــــع
ونريد منك تواضعـــــــا -- فلتتصف بتواضــــــــــع
لكن نريدك شامخـــــــــا -- ذا هيبة وترفـــــــــــــــع
بالدين كن مستمســـــــكا -- في همــــة وتدافـــــــــع
والعلم أتقنه تفــــــــــــــز -- فالعلم أكبر شافـــــــــــع
فمداد عالمنا يفـــــــــــــو -- ق دم الشهيد فســــــارع
للفوز بالعليــــــــــا وكن -- في العلم دون منــــــازع
قم يا بني بهمــــــــــــــة -- عليا كسيف قاطـــــــــــع
لنعيـــــــــد مجــد بلادنا -- ونكف بأس الطامــــــــع
لن تستقيم أمــــــــــورنا -- إلا بعلـــــــــم نـــــــــافع
وبحسن أخلاق وديــــــ -- ـن للشباب الخاشــــــــــع
وتذكرن يا نجلنـــــــــــا -- إني وهبتك أجمعــــــــي
(والدك المحب لك).

سحر قلاوون (كاتبة من لبنان)
التربية النفسية فريضة في عصر "الدخول إلى الخارج"!
إن الأيام التي تمرّ علينا في العصر الراهن فيها من التعقيد الكثير، ومن المشاكل ما لا يُعدّ ولا يُحصى، وعلى الرغم من ذلك قد تجد بعض الأهالي حين يتم الحديث أمامهم عن التربية النفسية يتململون ويتأفّفون، حتى أن قسما لا بأس به منهم قد يسخر من الفكرة قائلا: وما الداعي للتربية النفسية؟! لقد كبرنا ولم يتم التركيز كثيرا على مثل هكذا أمور حين كنّا صغارا، فلماذا نركّز نحن اليوم عليها؟!
لذلك لا بد لنا من أن نوضّح خطورة الأيام التي نعيشها، ولا ينبغي تجاهل أن هذه الأيام لا تشبه سابقاتها، فالمشاكل قد تفاقمت والأزمات قد ازدادت حدّة وخطورة، وبات الأبناء والبنات عِرضة لها.
فلا يمكن للأهل في يومنا هذا أن يتجاهلوا أمر التربية النفسية، مدّعين أن الأيام كفيلة بتعليم أبنائهم وتقويتهم، لأنهم إن فعلوا ذلك حقا، ستمرّ الأيام ليصدموا في نهاية المطاف بأنّ أولادهم قد باتوا أناسًا مدمّرين، خائفين على الدوام، قلقين ومتوتّرين بشكل مريب، غير قادرين على اتّخاذ قراراتهم بأنفسهم ومحبَطين من الدنيا وما فيها.
ففي السابق، كان إغلاق باب المنزل على الطفل، يعني أنه قد أصبح حاضرا بكامل تركيزه مع أبويه، يصغي إليهما ويتفاعل معهما، أما اليوم فالأمور قد اختلفت كثيرا، فباب المنزل وإن أغلق على الطفل، يبقى باب العالم مفتوحًا أمامه من خلال الهاتف والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
فكم من الأهالي حين يسألون عن أطفالهم، يجيبون بأنهم في غرفتهم، ظنا منهم بأن وجود الطفل في غرفته يعني أنه لوحده، لكن الحقيقة المُرّة هي أن الطفل ليس وحيدا في الغرفة، بل يكون ممسكًا بهاتفه بيده، مطَّلعا على أخبار من سمّوا أنفسهم "مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي"، يستمع إليهم، يراقب نمط معيشتهم بعينين يملؤهما الذهول، ويتمنى لو كان مكانهم، ويصبح ناقمًا على وضعه المادي والاجتماعي وحاقدا على والديه لأنهما لا يساعدانه لكي يصبح مشهورا وغنيًّا ومؤثرا في عالم كثر فيه المؤثّرون بنسبة مخيفة.
كل هذا يجري مع الطفل، في حين أن أمّه وأباه يشعران بالاطمئنان لأنه لم يخرج من المنزل، إنهما يعتقدان أنه في أمان وأنه يتسلّى قليلا على هاتفه، لكنهما لا يعلمان أن الهاتف هو من يتسلى به، مع الأسف.
سيكبر هذا الطفل بروتين الحياة نفسها، ومع مرور السنوات سيصبح مراهقا غاضبا ووحيدا، وسيغضب أهله منه ويقولون إنهم لم يحسنوا تربيته، فيقررون معاقبته وإعادة تربيته من جديد لعلّهم يحصلون على نسخة أفضل من ولدهم.. لكن التربية التي يحتاجها ليست تلك التي تنتهي باللوم والعتاب والصراخ وإلقاء الاتهامات على هذا وذاك، بل إن الموضوع أعمق من هكذا بكثير.
إن المشكلة ليست في الأهل وحدهم، كما أنها ليست في الطفل وحده، بل إنها مشكلة عصرٍ بأكمله، لكن وكما نعرف أن لكل مشكلة حل ولكل داء دواء، علينا معالجة هذه المشكلة، والعلاج هنا يكون من خلال التربية النفسية.
أولا: يقع على عاتق الأبوين أن يثقّفا نفسيهما لكي يستطيعا تقديم المساعدة لأطفالهما.
ثانيا: عليهما التوقف عن لوم نفسيهما وعن لوم الأطفال، وأن يدركا أن المشكلة تبدأ بالانحسار متى ما توقفت حفلة اللوم وبدأ بالمقابل العمل الجاد من أجل تحسين الأمور.
ثالثا: ليس هنالك وقت متأخر، فحتى لو لم يتم البدء بالتربية النفسية السليمة منذ الصغر، سيتمكنان من السيطرة على الأمور بمجرد اتخاذ القرار الجدي النافع.
أخيرا وليس آخرا، على الأبناء أن يتذكروا أن أهلهم يحبونهم بلا أدنى شك، وهم لن يجدوا أحدا يحبهم مثلهم، وأن العالم الخارجي مليء بالصور البرّاقة والخادعة، فلا يجب أن يسمحوا لهذه الصور بأن تستمر في خداعهم، فكل مظاهر الثراء الفاحش التي يرونها تخفي وراءها حقائق مؤلمة، الله وحده يعلم بها، لذلك عليهم ألا يحسدوا أحدا على حياته التي لا يرون من حقيقتها الشيء الذي يذكر.
والآن، لا ينبغي علينا نسيان أن استشارة الأخصائيين النفسيين ليست بعيب أو حرام، بل هي ضرورة لكل أم وأب يجدون أنفسهم عاجزين عن مساعدة أولادهم، فربما يحتاجون شخصا آخر ليمدّ لهم يد العون ويساعدهم على الخروج من الدوامة التي وجدوا أنفسهم يعيشون فيها.
المهم في جميع الحالات مهما صعبت ألّا يتم تجاهل التربية النفسية لأنها ضرورية لكل طفل.
فالتربية النفسية واجب على كل أهل اتجاه أطفالهم، وإن لم يؤدوا هذا الواجب بكل أمانة وإخلاص سيجدون أنفسهم مضطرين لتحمل النتائج القاسية والمريرة.
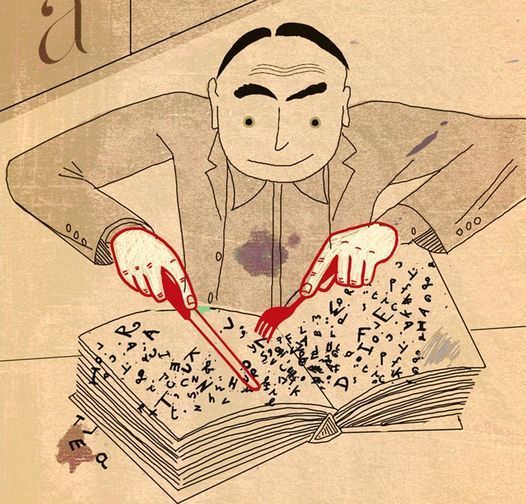
غنى نجيب الشفشق (كاتبة من لبنان)
في عصر الجسد وافتقاد الروح.. ثرثرة القلم.. شفاء النفوس!
لا تشرق الرُّوح إلّا من دُجى ألمٍ -- هل تزهرُ الأرض إلّا إنْ بكى المطرُ
(جلال الدين الرُّومي).
تتعقّد الحياة يومًا بعد يوم، وتزداد شجون النَّاس واضطراباتهم في زمنٍ جوهرُه المادَّة. لم تعد التربيَّة النَّفسية ترفًا روحيًّا بل أصبحت أمرًا ضروريًّا كلَّما توالت الأيَّام وازدادت تشابكا.
عصر المادَّة، عصر الجسد، عصر التَّرفِ والشَّكليات، عصر السُّلوكيات... سمِّهِ ما شئتَ؛ كلَّها دلالات على أنَّنا افتقدنا الحسَّ الرُّوحي وتهذيب النَّفس.
والتَّربية النّفسيّة ليست منتجًا غربيًّا تمَّ تسويقهُ إلينا، بل على العكس فقد نشأت في قلب المجتمع العربيّ وتطوّرت. فلو استرقنا نظرة إلى الأدب الصُّوفي نجدهُ يتغنّى بالتَّزكية بالنَّفس وكبحِ الشَّهوات، وكذلك الأمر بالنِّسبةِ للشِّعر العربي والأدب الشَّعبيّ المتخم بالحكم والاتزان بين العقل والقلب.
فالأدب جسر عبور إلى محطّةِ الرُّوح وغسل النَّفس من براثنِ المادَّة وأوساخها.
الكاتب بين المادة والرّوح
يمكن للكاتب أنْ يطهّرَ الرُّوح وينقِّيها لو استطاع أن يضعَ قلمَه في خضمِّ هذه المشكلة، لا أن يزيدها تعقيدًا بتمجيدِ الفرديّةِ وفوضى العبثيَّة وإرهاق الرُّوح بتساؤلاتٍ تزيدنا اضطرابًا. ومن إيمانِنا بالكلمةِ، فإنَّ النَّفس المتألِّمة تجد شفاءها بين أغلفة الكتبِ، وبين انزياحاتِ القلمِ وهو يعبِّرُ بثرثرةٍ أشبهُ بالهمسِ عن أوجاعها وقضاياها عندما يفتح لنا بوَّابة التَّفكير النَّقدي وتأمَّل تجارب الآخرين.
"الإنسان معادلةُ روحٍ وجسد" وعليها أن تبقى متوازنة من أيِّ خللٍ، فلا يجوزُ الفصلُ بينهما. الرُّوح زائلة والجسدُ فانٍ، وكلاهما يحدِّدان طبيعة الإنسان.
دور الأدب يتجلّى في تكريس الوعي ونشر الثّقافة وتهذيب النُّفوسِ، والقراءة والكتابة طقسان من طقوسِ التَّربية النَّفسية فمن خلالهما يمكن للمرء أن يغوص في أغوارِ ذاتِه ويكشف مكنونات أعماقهِ فيذهبُ بروحِهِ نحو التأمّل والتَّفكر بعيدًا عن ضجيجِ المادِّياتِ وصخب السُّلوكياتِ الغريبة.
"جلال الدّين الرومي" رمز السَّكينة الرُّوحيّة وعلمها، ولا يراها مشرقة إلا من دجى التَّعب، فلولا المشقَّة لما أشرقت شمسنا ولا أمطر الغيم فوق حقولِ يبابِ النَّفس، حتَّى أنَّنا قد نفنى في البحثِ عنها خلف مخلّفاتِ الدّهر. وينادي قائلاً:" أعطيتُ الرُّوح أُذنًا خاصّة بها لتسمعَ أمورًا لا يفهمها العقل". وانطلاقًا من هنا نرى إيمانه الرَّاسخ بقيمةِ الرُّوح وأهميَّتها، فهي عينُ وأذن العقل نقطع بهما سبلاً وعرةً لا يجيدُ القلب السَّير فيها، فإن أصغينا لزقزقتها بصمتٍ وعينين مغمضتين قادتنا نحو الخلاص، وإن تمسكّنا بما يتخبَّطه عقلُ الفرد لكنَّا نُصرَعُ في المهالكِ.
ورغم ذلك يؤكّد ضرورة ارتباط الفرد بمجتمعه، فالاضطراب والأمراض النَّفسية خُلقت من رَحمِ الوحدة، لذا على المرء أن يتمسَّكَ بيدِ صاحبِهِ في زمنٍ قلَّ فيه ترابط الأخوّة والمحبَّة.
"ذلك أنَّ الرُّوح عندما لا تكون متّصلة بالمحبة تصبحُ إلى الأبدِ مع ذاتِها عمياء وحزينة".
لندع الأدب يحملنا معه من فوضى العالم إلى سكينة الرُّوح، فهو تأشيرة الخلاص؛ يوقظنا من غفلتنا ويحثّنا بأنَّ جوهر الإنسان ليس مادياته إنَّما ذلك النُّور المنسوج في ظلمةِ داخله.

أ. د. صبري فوزي أبو حسين (وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات بجامعة الأزهر - مصر)
التربية بالأدب في ظلال الإسلام
لا ريب في أن الإنسان هو معادلة بين الروح والجسد، وفي عصرنا الراهن تكاد نزوات الجسد أن تطغى على كل شؤون الروح، والله يعلم ما الذي ستكون عليه أحوال أجيالنا خلال العقود القادمة.. وإذا تأمّلنا في واقعنا الراهن، نرى مظاهر عدم الاتزان الشخصي وعدم التحكم في الانفعالات في المعاملات بين الناس أو حتى في الجوانب العاطفية والوجدانية، وافتقاد مجتمعاتنا إلى تقاليد الصراحة والوضوح وانتشار مظاهر سلوكية غريبة.. من هذا المنظور، فالتربية النفسية صارت أمرًا ضروريًّا في تنشئة الأجيال. وباعتبار الأدب يلامس ويتقاطع مع علوم إنسانية واجتماعية عديدة، ومن الواجب استثماره (الأدب) في التربية النفسية للأجيال القادمة وعلى الكاتب والشاعر والمُبدع أن يكون على معرفة بأصول التربية النفسية. وذلك لأننا نستشعر الأخطار المحدقة بالأجيال الصاعدة ذات التأثير على بيئتهم النفسية!
والأدب مرتبط بالتربية ارتباطًا شديدًا حتى في دلالاته اللغوية؛ فقد جاء في "لسان العرب" و"تاج العروس": "الأَدَبُ، مُحَرَّكَةً: الذي يَتَأَدَّبُ به الأَديبُ من الناس، سُمّيَ به لأَنه يَأْدِبُ الناسَ إلى المَحَامدِ وَيَنْهَاهُم عن المَقَابِحِ، والأَدَبُ مَلَكَةٌ تَعْصِمُ مَنْ قامت به عمَّا يَشِينُه، وفي المصباح: هو تَعَلُّم رِيَاضَةِ النَّفْسِ ومَحَاسِن الأَخْلاَقِ. وقال أَبو زيد الأَنصاريّ: الأَدبُ يَقَع على كل رِيَاضَةِ مَحْمُودَةٍ يَتَخَرَّجُ بها الإِنسانُ في فَضِيلَةِ من الفَضَائِلِ.. أو هو استعمالُ ما يُحْمَدُ قَوْلاً وفِعْلاً، أَو الأَخْذُ أَو الوُقُوفُ مع المُسْتَحْسَنَات أَو تَعْظِيمُ مَنْ فوقَك والرِّفْق بمَنْ دُونَكَ، أو هو حُسْنُ الأَخلاق وفِعْلُ المَكَارِم... أَدَبْتُه أَدْباً، مِنْ بابِ ضَرَب: عَلَّمْتُه رِيَاضَةَ النَّفْسِ ومَحَاسِن الأَخلاق، وأَدَّبْتُه تَأْدِيباً مُبَالَغَةٌ وتَكْثِيرٌ، ومنه قيل: أَدَّبْتُه تَأْدِيباً، إذا عَاقَبْتَه على إِسَاءَته؛ لأَنه سبَبٌ يدعو إلى حَقِيقَةِ الأَدَبِ، و... أَدَبَه، كضَرَبَ وأَدَّبَه: راضَ أَخْلاَقَه وعَاقَبَه على إِساءَته لِدُعَائِه إِيَّاهُ إلى حَقِيقَةِ الأَدَب".
وبتدبّر ألفاظ: (اللسان والقول والكلام والشعر والقصص والبيان) في القرآن الكريم يتضح لنا وجود نظرية متكاملة حول ضوابط البيان الإسلامي من حيث متطلباته ومحاذيره، من خلال ثنائية: الكلم الطيب والكلم الخبيث، ومدح الكلم الإيجابي بالعروبة، والإبانة، والطيب، والحسن، والسداد، ونفي رذائل الخبث والكذب والخيانة واللغو والإفساد والهمز واللمز عنه. ومن خلال التنظير لأهم جنسين أدبيين: الشعر والقصة؛ فالإسلام: "لا يحارب الشعر والفن لذاته كما قد يفهم من ظاهر اللفظ. إنما يحارب المنهج الذي سار عليه الشعر والفن بمنهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها، ومنهج الأحلام الموهومة التي تشغل أصحابها عن تحقيقها، فأما حين تستقر الروح على منهج الإسلام، وتنضج بتأثراتها الإسلامية شعرا وفنا، وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق هذه المشاعر النبيلة في دنيا الواقع، ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فيها، وتدع واقع الحياة - كما هو - مشوهًا متخلفا قبيحا، أما حين يكون للروح منهج ثابت يهدف إلى غاية إسلامية، وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية لإسلام، في ضوء الإسلام، ثم تعبر عن ذلك كله شعرا وفنا، فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن كما يفهم من ظاهر الألفاظ". فلم يحرم القرآن الكريم قول الشعر، ولم يقف دونه أو ينتقصه من حيث قيمه المعرفة إذا التزم بالحق، وأغراض الشعر جميعها معرضة للشاعر، إذا قصد فيها تغليب جانب الخير على جانب الشر، فالمضامين الشعرية وحدها هي التي خضعت لمبدأ الصالح وغير الصالح من الشعر، أما الأطر الشكلية فلم ينتقصها القرآن "ولم يحدد شكلا معينا يلتزم به الشعراء ولا يخرجون عنه، لأن الصياغة في ذاتها لا توصف بالفضيلة أو بضدها". كما يقرر الدكتور "محمد بن مريسي الحارثيط.
إن الدين يلتقي في حقيقة النفس بالفن؛ فكلاهما انطلاق من عالم الضرورة، وكلاهما شوق مجنِّح لعالم الكمال؛ وكلاهما ثورة على آلية الحياة... والفن الإسلامي ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن الإسلام! وهو على وجه اليقين ليس الوعظ المباشر والحث على اتباع الفضائل (فقط)، وليس هو كذلك حقائق العقيدة مجردة، مبلورة في صورة فلسفية. إنما هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود... هو الفن الذي يهيّئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق؛ فالجمال حقيقة في هذا الكون، والحق هو ذروة الجمال، كما يقرر صاحب كتاب "منهج الفن الإسلامي".
وكان موقف الرسول (صلى الله عليه وسلم) من الشعر والشعراء يدور حول إبراز المفهوم الجديد الذي حدّده القرآن الكريم للشعر والدور المطلوب من الشعراء؛ فقد تشكل موقف الرسول (صلى الله عليه وسلم) من الشعر في الاتجاهين نفسهما الوارد ذكرهما في خواتيم سورة الشعراء، وهما:
الأول أعطى فيه الشعر أهميةً باعتباره فنًّا معرفيًّا قادرًا على تشكيل العقول من خلال قيمه المعرفية الخيرية والفنية الموحية. وهذا هو الاتجاه الذي استأثر باهتمام الرسول الكريم. ومن أمثلة ذلك:
- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما" وفي رواية: "إن من الشعر لحكمة"؛ فليس كل شعر غواية بل منه ما يتضمن إقامة الحق والحث على الخير، وإطلاق اسم الحكمة يدعو إلى رزانة العقل والرأي وشرافة الخلُق.
- أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: "لما نزلت وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ" أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت: يا رسول الله، ماذا ترى في الشعر؟ فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفس محمد بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل".
- قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا ابن عوف عن ابن سيرين "أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لكعب بن مالك: هيه: فأنشده. فقال: لهو أشد عليهم من وقع النبل"، وفي رواية لمسلم عن عائشة (رضي الله عنها): "اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل"، وفي رواية للترمذي: "خل عنهم يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل"، وفي لفظ للنسائي: قال لحسان: "اهج المشركين، فإن روح القدس معك".
- أخرج الحاكم وابن مردويه من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال يوم الأحزاب: "من يحمى أعراض المسلمين؟ فقال حسان: أنا. قال: فقم اهجهم، فإن روح القدس سيعينك".
- وروي عن عمر بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني النبي (صلى الله عليه وسلم) شعر أمية ابن أبي الصلت وأنشدته، فأخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: "هيه هيه". حتى أنشدته مائة قافية. فقال: "إن كاد ليسلم".
أما الاتجاه الثاني فقد تناول فيه الشعر من زاوية ما يحدثه من ضرر أو أذى فذلك مذموم منهي عنه، وكانت مواقفه قليلة في هذا الاتجاه إذا ما قورنت بمواقفه التوجيهية للشعر والشعراء في الاتجاه الأول؛ فالرسول (صلى الله عليه وسلم) بشر يتأثر بالكلمة والموقف، وعربي في قمة الفصاحة، يقدّر التعبير الفني، ويعرف خطره وعمق تأثيره في النفوس ويطرب له حين يعبّر عن مبادئ خلقية وجمالية مقبولة من وجهة الدين الجديد، ويرفضه ويقبحه حين يكون دعوة للشر أو الشقاق أو الرذيلة أو تحريضًا على طرح الجدِّيَّة في الحياة والاستسلام لمباذلها. ومن أمثلة ذلك ما رُوي من أن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا". والتَّحْقِيقَ أَنَّ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ الْمُصَرِّحَ بِأَنَّ امْتِلَاءَ الْجَوْفِ مِنَ الْقَيْحِ الْمُفْسِدِ لَهُ خَيْرٌ مِنِ امْتِلَائِهِ مِنَ الشِّعْرِ، مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَقْبَلَ عَلَى الشِّعْرِ، وَاشْتَغَلَ بِهِ عَنِ الذِّكْرِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى الشِّعْرِ الْقَبِيحِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْكَذِبِ، وَالْبَاطِلِ كَذِكْرِ الْخَمْرِ وَمَحَاسِنِ النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
أما عن شبهة أن نفي الشعر عن الذات النبوية دال على رفض الشعر وذمِّه قاطبة؛ فقد اتفق المفسرون والباحثون قاطبةً على أن الله تعالى لم يجعل في طبع النبي (صلى الله عليه وسلم) القدرة على نظم الشعر، وقد فطره على النُّفرة بين ملَكته الكلامية والملَكة الشعرية، أي لم يجعل له ملَكة أصحاب قرض الشعر؛ لأنه أراد أن يقطع من نفوس المكذبين دابر أن يكون النبي (صلى الله عليه وسلم) شاعرًا، وأن يكون قرآنه شعرًا؛ ليتضح بهتانهم عند من له أدنى مُسكة من تمييز الكلام. وليس المراد نفي إنشاء الشعر عنه؛ لأن إنشاء الشعر غير تعلُّمه، فكم من راوية للأشعار ومن نقَّاد للشعر لا يستطيع قول الشعر. وكذلك كان النبي (صلى الله عليه وسلم) قد انتقد الشعر ونبَّه على بعض مزايا فيه، وفضّل بعض الشعراء على بعض، وهو مع ذلك لا يقرض الشعر، كما يقرر المفسرون قديمًا وحديثا.
لقد حسم القرآن الكريم صلة النبي الخاتم (صلى الله عليه وسلم) بالشعر إنشاءً وإنشادً وتذوقًا وتوجيهًا، فنفى الإنشاء للشعر والإبداع له عن الرسول الكريم نفيًا قاطعًا؛ تنزيهًا لشخصه العظيم، وتنزيهًا للقرآن الكريم، وحفظًا له من الظنون المشوِّهة والشكوك المشوِّشة. وينبغي ألا يُفهَم هذا النفي فهمًا خاطئًا، ويؤدي إلى نتائج منافية للفهم الصحيح، أو مُجافية للحقيقة الجلية، كما يقول الدكتور "شوقي رياض"، في كتابه "الشعر في السيرة النبوية". قال الحافظ ابن حجر: "وأما الشعر فكان نظمه محرّمًا على الرسول (عليه الصلاة والسلام) باتفاق. قال الله عز وجل: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ}"...
إن نفي إبداع الشعر عن الذات النبوية لا يعني موقفًا سلبيًّا من الشعر والشعراء؛ فالرسول الكريم كان من أفصح العرب، وقد جمعت له أسباب البلاغة وأُوتي من البيان منزلة رفيعة فكلامه يأتي بالمنزلة التالية لكلام الله عز وجل. وبذلك تضافرت لديه مقومات الذوق الرفيع، الذي يميز به جيد الكلام من رديئه، ويستشعر به جميل القول من قبيحه، والشعر من فنون القول التي استوعبت الكثير من آيات الإبداع الشعري، بل هو عند العرب الفن الرئيس الذي صبوا فيه كل طاقات فصاحتهم وبلاغتهم وإبداعهم، فليس غريبًا – إذًا - أن يكون له في نفس النبي الكريم موقع إعجاب وتأثير. ويقرر هذه الحقيقة الجليلة الخليل بن أحمد (ت 170 هـ) بقوله: "كان الشعر أحب إلى رسول الله من كثير من الكلام، ولكنه لا يتأتَّى له"... وتتوارد كثير من الروايات والأخبار والآثار التي تُبيِّن تلك العلاقة الوطيدة بين الرسول الكريم والشعر حبًّا للحسن منه، وتقديرًا له، وإقبالاً على سماعه، وتبصّرًا بالجيِّد منه وإعلانًا عمَّا فيه من قيم سامية، ورفضًا للقبيح منه، الذي فيه نزعات جاهلية مرفوضة، وتعبيرات شيطانية محاربة وغير مقبولة في المجتمع المسلم الجديد الواعد، وكذلك كان شأنه (صلى الله عليه وسلم) مع بعض النصوص النثرية.
ومن توجيه النبي (صلى الله عليه وسلم) لغرض الفخر إسلاميًّا ذلك الموقف النبوي الشريف مع النابغة الْجعْدِيِّ، حيث روي عن النابغة قال: "أتيت النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) فأنشدته قولي:
بلغنا السماء: مجدُنا وجدودنا -- وَإِنَّـا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَا
قال النبي (صلى الله عليه وسلم): أين المظهرُ يا أبا ليلى؟ قلت: الجَنَّةُ، قال: أَجَلْ إن شاء الله". فجلي أن البيت يحتمل النزعة الجاهلية في الفخر، فجاء السؤال النبوي وعظًا للشاعر ولفتًا لانتباهه حتى لا يعود إلى ماضيه في التعبير أو التفكير من كبر زائف أو فخر خيالي غير واقعي، ومن ثم جاءت إجابة الشاعر - لما أحس الغضب في السؤال النبوي - قاطعة، دالة على أنه فخر إسلامي معتدل متوجّه وجهة أخروية طيبة فيها إيمان بالغيب. ثم كان تعليق الرسول الكريم على إجابة الشاعر - بعد أن اطمأن إلى أنه حين عبّر بمجد جدوده المتطاول قد انتهى إلى التطلع في ظل الإسلام إلى ما هو أعظم - مقررًا قيمة الاعتدال، وحاثًّا على الحرص على كل ما هو أخروي. قال: "ثم قال: أَنْشِدْنِي، فأنشدتُهُ قولي:
ولاَ خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ -- بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا
وَلاَ خَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ -- حَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرَا
قال النبي (صلى الله عليه وسلم): أَحْسَنْتَ، لاَ يَفْضُضِ الله ُفَاكَ".
فعبارته (صلى الله عليه وسلم): "أَحْسَنْتَ"، جامعة للإحسان في جمال اللفظ وحُسْنِ سَبْكِهِ وإيقاعِهِ، وفي معناهُ البارِعِ أيضا، وهذا ما لا يخفى في هذه الأبيات التي تنضح بالبَهَاءِ الشعري على نحو لا يُدْفَع. والعبارة النبوية تدل على ارتياح إلى ما يُسمع من وحي الروح الدينية، ومن التوجيه الخلُقي الرشيد...
وهكذا نجد الرسول الكريم يقف موقفًا رائعًا من الشعر فيه إيجابية ووسطية مقبولة محمودة؛ فهو تارة لا تعجبه لفظة فيها روح الجاهلية، وتارة أخرى يشير إلى عمق فهمه لمراد الصحابي الشاعر، وتارة ثالثة يعجب بشعر الصحابي لما فيه من تحديد لخيرية الحلم ونفعيته تحديدًا ينطلق من ثوابت الإسلام، ومنطوق نصوصه. ومن ثم جاء النقد الأدبي في عصر صدر الإسلام في تربة صالحة توجه رسالة الشعر في إطار الإسلام "فالجو الإسلامي في ذراه متمثلاً في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتفتح في أحضانه المواهب الشعرية وتتفتح بتفتحها ملكات النقد، ويقف الإسلام من وراء ذلك عاملاً أساسيًّا يستلهمه الشعراء وينهلون من نبعه الشعر الفياض، ولا يدخر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسعًا في تقويم الشعر الذي بقي فيه أثَرةٌ من عصبية أو ظلت فيه بعض الرواسب التي تضرب بجذورها للإسلام.
ثم أصبحت مواقف النبي الكريم وتوجيهاته للأدب والأدباء فيما بعد أساسًا بنى عليه كثير من الخلفاء والعلماء والمهتمين بالشعر والنقاد العرب نظرية عربية إسلامية أصيلة في ميدان النقد الأدبي، منطلقين من أن الأدب كلام، ومن الكلام حسن جميل مقبول، ومنه سيء خبيث مرذول، والتمييز بين النوعين لا يخفى على عاقل. وتزداد نظرة الإسلام إلى الشعر وضوحًا في موقف الخلفاء الراشدين من الشعر والشعراء، وهي نظرة مستمدة من الاتجاه الديني الذي وضع أسسه القرآن الكريم وطبقه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في توجيه الأدب وتهذيبه وتقويمه.
وهكذا ينطلق الرسول (صلى الله عليه وسلم) وخلفاؤه الكرام منطلقًا إسلاميًّا واضح المعالم، بيِّن القسمات، مستمدًّا من نور القرآن وما يدعو إليه من مكارم الخلاق وجميل الخلال، فلا يعري الشريفة أو يرمي العفيفة، ويقر على نفسه بالفضيحة، ويبتعد عن الهجاء فإنه يحنق به كريمًا ويستثير به لئيمًا. والمدح كسب الوِقاح وطُعْمة السؤَّال، وافخر بمفاخر قومه، وليقل من الأمثال ما يزين به نفسه وشعره ويؤدب به غيره".
فللأدب إذًا رسالة إنسانية نبيلة تعلو به وتجعله في مصاف الكلام الطيب الذي يرفعه الله، والذي هو كالشجرة الطيبة وصدق الرسول الكريم الذي قال: "إنما الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق فيه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه". وفي رواية: "الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه". فلا ريب في أن الشعر طاقة فنية فعّالة، كان ديوان العرب في جاهليتهم، وسجلّ مفاخرهم ومُنتهى علمهم، به يأخذون إليه يصيرون. إنه كما قال الشاعر الجاهلي:
والشعر لب المرء يعرضه -- والقول مثل مواقع النبل
فللشعر - بفكره العميق وصياغته البديعية - فعل السحر في النفوس. وقد كان كذلك في عصر صدر الإسلام، إذ خاض - إلى جوار النثر - معركة التحدي التاريخي بين نصراء الإسلام وخُصَمائه، عندما استحرَّ الخلاف العقَدي بين الفريقين... وأخذ صوت التوحيد يتعالى على ألسنة الشعراء، وتدفق الحس القرآني، فلون نبض الإبداع الشعري بعبَق التعالي وطهارة الإلهام، وانتشر الشعر المسلم في كل بيت، حتى قال جابر بن سمرة (رضي الله عنه): "جالست النبي (صلى الله عليه وسلم) أكثر من مئة مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر، ويتذاكرون من أمر الجاهلية، وهو ساكت، فربما يبتسم معهم"، وقال عبد الله بن الزبير (رضي الله عنهما): "ما أعلم رجلان من المهاجرين إلا قد سمعته يترنم"، وقال أنس (رضي الله عنه): "كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وما بالمدينة بيت إلا يقول الشعر"، وقالت عائشة (رضي الله عنها) لعروة: "الشعر منه حسن، ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارًا، منها القصيدة، منها أربعون بيتًا، ودون ذلك".
وروى الإمام البخاري قال: "حدثنا إسحق قال: حدثنا محمد بن الفُضَيْل عن الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنْحَرِفِينَ ولا مُتَمَاوِتِينَ، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، ويذكرون أَمْرَ جاهليتهم، فإذا أُرِيدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الله دَارَتْ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ".
وروى الإمام الترمذي قال: "حدثنا علي بن حُجْرٍ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة (رضي الله عنه) قال: جالست رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أكثر من مائة مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعرَ ويتذاكرون أشياء مِنْ أَمْرِ الجاهلية، وهو ساكِتٌ، وربما تَبَسَّمَ مَعَهُم"، فهذه المجالس تضم أكمل الخلق، محمدًا (صلى الله عليه وسلم)، و أَفْضَلَ ما في هذه الأمّة، صحابته رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بكلام العرب، وبالضوابط الشرعية التي عَلَّمَهُمْ إياها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وبالتالي فَلُغَةُ المجلس أَنْظَفُ لغة وأصفاها وأضبطُها، و مع ذلك، فهم يتكلمون في أمر الجاهلية ويتناشدون أشعارها ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتابع بحرص المعلم الأمين ما يَتَفَوَّهُ به أصحابه، لأن أقوالهم وأفعالهم في حضرته (صلى الله عليه وسلم) تشريعٌ لِمَنْ بَعْدَهُمْ في هذه الأمة، وربما يعجبه (صلى الله عليه وسلم) هذا البيت، أو تلك الحادثة، فيتبسم (صلى الله عليه وسلم)؛ إنه حقاًّ لفرقٌ كبير بين هذا المجلس الزَّكِيِّ الطاهر، وبين مجالس اللهو والقَصْفِ والخلاعة التي تُتَنَاشَدُ فيها الأشعارُ الجاهلية وأحاديثُها بما فيها من فِسْقٍ ومجون، وبالتالي شَتَّانَ بين شعر جاهلي يُنْشَدُ في ذلك المجلس الطاهر، وبين هذا الذي يُنشد في هذا المجلس الفاجر.
يقول سيدنا عمر (رضي الله عنه): "خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم، ويستعطف بها اللئيم"، ويقول سيدنا عمر (رضي الله عنه) لأبي موسى الأشعري: "مُرْ مَن قبلك بتعلم الشعر؛ فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب".
وهذا يجسد بوضوح ذلك البعد الإنساني العميق في النظرة النبوية الشريفة إلى الشعر، فهي تأخذ من الإبداع الجاهلي ما يعبّر عن الإنسان البريء، الناطق بالحكمة المعبّرة عن مشاعر الإنسان وخَلَجَاتِهِ بما هو إنسان، و ليس بالكلام البذيء الذي يحط من هذه الإنسانية ذاتها إلى مدارك الحيوان الْمُمَجِّدِ للشُّذُوذِ واللَّذَّةِ والْخَطِيئَةِ، أو التي تقدس الحجر فَتَعْبُدُه من دون الله عز وجل؛ و كأني بمجلس رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وهو يقوم بعملية التصفية للإرث الشعري العربي، فيأخذ منه ما يتلاءم مع الشعور الإنساني النبيل وذوقه الفطري السليم، وينبذ ما يتعارض مع دينه وإنسانيته، وهذا ما يحيل عليه قول جابر بن سمرة (رضي الله عنه): "فإذا أُرِيدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الله دَارَتْ حَمَالِيقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ"، فكل ما يتعارض مع دين المسلم أو يطعن فيه من إبداع مهما كانت طبيعته، يظل إبداعًا مرفوضًا، حتى و إن صدر عمّن يدّعي بأنه مسلم فضلا عن سواه، لأن ما يعارض الدين الإسلامي، يعارض بالضرورة الفطرة الإنسانية.
فالإبداع العربي قبل الإسلام هو إنتاج إنساني، فيه الغَثُّ والسمين والطَّيِّبُ والرديء، فليس من العدل أن يقاس كله بمقياس واحد، وأن يُهْمَلَ كلُّه بحجة أن قائله ليس بمسلم، لا، لأن عظمة الإسلام تكمن في تهذيب الإنسان وإصلاحه وتكريمه، وليس في هدمه وتحطيمه، وأولى هذه الجوانب استدعاءً لهذا الإصلاح وذاك التهذيب، بعد تصحيح عقيدته وتنقيتها، هو فكره و ثقافته، فما كان من إبداعه فطريا وإنسانيا لا يصادم الحق ولا يضاد العقيدة الإسلامية، وَجَبَ احتضانه وتزكيته مهما كان قائله، لأنه أَوَّلاً وقبل كل شيء هو إنسان له أحاسيسه وعواطفه التي أودعها الله عز وجل فيه، ليعبّر بها عن فطرته وإنسانيته في إبداع يُؤْخَذُ منه ويُتْرَكُ، ويُقْبَلُ منه و يُرَدُّ، وهذا هو هَدْيُ محمد (صلى الله عليه وسلم)، وهَدْيُ صحابته رضي الله عنهم، وهَدْيُ من تبعهم بإحسان.
فما أجمل أن نوظّف الأدب شعرًا ونثرًا في تربية الأجيال القادمة تربية هادية بانية نافعة واقية، بدل هذا الغثاء الشيطاني الذي يُقدّم لهم وإن شئت قل: يُفرض عليهم فرضًا، ويُدسّ لهم من خلاله كل سمّ وكل زيف وكل ضلال وكل إضلال! وما تاهت أجيال العرب خلال هذا العصر الحديث البائس إلا من خلال النصوص الأدبية المنحطة الهابطة الداعرة في فنون القصة القصيرة والرواية والمسرحية، والأغنية الشعبية والشوارعية! وعبر توظيفها في الدراما مسرحيًّا وسينمائيًّا وتلفازيًّا وإذاعيا!

الدكتور عبد الوهاب برانية (الأستاذ بجامعة الأزهر - مصر)
علم النفس للأدب كالملح للطعام
قد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل هناك علاقة بين علم النفس والأدب؟
ربما يقول قائل: وما حاجة الأدب إلى علم النفس؟ وما ارتباطه به؟ وهذا القول إن صدر عن واحد من الناس، فقائله عرضة للاتهام في ثقافته وتفكيره؛ فالأدب وعلم النفس إنما ينبعثان من مشكاة واحدة، فالباحث النفسي يعتمد الخيال والعاطفة والغرائز الإنسانية كظواهر أساسية في تشكيل العقل البشري وضبط توازنه، وتمييز الناس فيما بينهم وفق معطيات تلك الظواهر، والأديب شاعرًا كان أو كاتبًا، إنما يتغنّى بعواطفه ومشاعره وأحاسيسه، التي تملك عليه وجدانه، وينقل تلك المشاعر إلى الآخرين، حاملة رؤيته للحياة والأحياء، عبرَ فنّه الأدبي الأثير لديه، شعرًا كان أو قصة أو مسرحية أو أيّ لون إبداعي، راح يجد نفسه من عشاقه وموهوبيه.
ويأتي دور علم النفس تجاه الأدب، في أنه قد يساعدنا كما يقول الدكتور "محمد مندور": "في فهم نفسية الكُتَّاب وتحليل الشخصيات الروائية التي يخلقها أولئك الكتاب، ولكنه قد يضللنا أيضًا في ذلك الفهم وهذا التحليل... فاستخدام علم النفس في نقد الأدب يجب أن يتمّ في حذر، لأنك بذلك قد تذهب بالأصالة الموجودة في العمل الأدبي، فتفهم الشخصية الروائية مثلا، أو تحليل نفسية الشاعر على ضوء قوانين نفسية عامة لا يصدق إلا في التخطيطات العامة، وذلك لأن النفس البشرية يستحيل أن تتطابق تطابقًا تامًّا". (في الأدب والنقد ص 39 – 40).
فعلم النفس يقوم بدور كشفي مهم، حين يفسر الظواهر الأدبية من خلال واقع ملموس، بلا إفراط ولا تفريط، دونما نضوبٍ أو إغراقٍ، فالحكم على الظواهر الأدبية والأدباء من خلال قواعد نفسية عامة، واستخلاص الأحكام والمسلّمات من خلال الاستنتاج، الذي قد يكون مجرد حدس أو تطبيق لنظرية نفسية، قد لا تنطبق إلا على حالات خاصة من البشر، ولا تصلح لتعميمها على كل ما يشبهها من الحالات؛ فالبشر متفاوتون في السلوك والدوافع إليه، وتعميم الأحكام عليهم فيه كثير من التجوز وعدم الدقة؛ مما ينبئ بعدم سلامة الطرح من الخطأ، والوقوع في براثن الوهم، غير المبرر.
وأمام القارئ المثقف أنموذج من "أبي نواس"، الشاعر العباسي، فقد دارت حول شعره وشخصيته دراسات عديدة، منها دراسة الأستاذ "العقاد" (أبو نواس الحسن بن هانئ) حيث طبق نظريات علم النفس على الشاعر وشعره، وأفرط في التوغّل في التفاصيل النفسية التي ربما ينطبق بعضها على الشاعر، ومن المؤكد أن بعضها يرتبط بظروف المجتمع وطبيعة الحياة في ذلك العصر، من ذلك أن "العقاد" وضع مجمل شعر "أبي نواس" في الغزل ووصف الخمر والتغني بعشقها وتصوير حياته الماجنة بلا تحفظ، وضع "العقاد" ذلك كله في (لازمة العرض) التي تشمل الإظهار بكافة درجاته، بدعوى أنّ الشاعر قد عمد إلى التمتّع بالمحرّمات والجهر بها، والدعوة إلى اقترافها، والتشجيع عليها وذلك في مثل قوله:
وإن قالوا حرام قل حرامٌ -- ولكنّ اللذاذةَ في الحرامِ
وقوله:
ألا فاسقني خمرًا وقل لي هي الخمرُ -- ولا تسقني سرًّا إذا أمكن الجهرُ
فما العيش إلا سكرةٌ بعد سكرةٍ -- فإن طال هذا عنده قَصُرَ الدَّهرُ
فـ "العقاد" يرى أنّ ما يقوم به "أبو نواس" من الجهر بالمحرّمات ما هو إلا محاولة الظهور وعرض شخصيته، ليسدّ بذلك حاجة نفسيّة في داخله، كما يقول المثل: "خالِف تُعرَف".
ولكن إفراط الأستاذ "العقاد" في تطبيق اللوازم النفسية، والبحث عن أصولها عند "أبي نواس"، والربط بين مظاهره الخِلْقِية وشذوذه، كعلم وظائف الأعضاء وارتباطه بهرمونات الأنوثة والذكورة، كل ذلك جعل الأستاذ "العقاد" يغفل طبيعة المجتمع، الذي عاش فيه "أبو نواس"، ولم يوله الاهتمام المستحق؛ لأن جلّ اهتمامه كان منصبًّا على ما ذكرنا، مع أن تلك الحقبة كانت تضجّ بألوان البذخ وصنوف الترف والمجون، وليس من الضروري أن يكون الدافع وراء تلك المجاهرة بمثل هذه المحرمات راجعًا إلى شذوذ جنسي، أو اختلال في الغدد لدى صاحبها، بل ربما كان ذلك بسبب نقصٍ مَّا لدى الشخصية، أو انعدامٍ للتربية، أو مخالطة وسطٍ يشجع على مثل تلك السلوكيات، التي لا تراعي للدين حرمة ولا للمجتمع أصولا وأعرافًا.
وبينما وجدنا الأستاذ "العقاد" يفسر ظاهرة الشذوذ لدى "أبي نواس"، وفق ما تمليه نظريات علم النفس، والفكرة النرجسية التي انتابته، وأثّرت في سلوكياته وأشعاره، وجدنا أيضًا دارسًا آخر هو الدكتور "محمد النويهي" في كتابه عن "نفسية أبي نواس" ينطلق من وجهة أخرى في تفسير حياة الشاعر وشعره، معتمدًا على "عقدة أوديب"، التي تنهض على فكرة تعلّق الطفل بأمّه، ومحاولته الاستئثار بها، إذ يرى الدكتور "النويهي"، والكلام للدكتور "طه حسين"، أن النواسي الطفل: "أحب أمّه وكلف بها كلفا بلغ الهيام، وحيل بينه وبين غايات هذا الحب فأدركه ما أدركه من هذه العلة التي أفسدت عليه أمره كله، وحولته عن الجادة إلى الطريق الملتوية في الحب".
فانظر يا قارئي العزيز كيف أخذت النظرية النفسية قامتين مثل العقاد والنويهي إلى افتراض أن الشخصية المدروسة شخصية معقدة، وكيف أنهما راحا منذ البداية إلى النهاية يدوران في فلك تلك الفكرة ويحاولان إثباتها والانتصار لها، مغفلَينِ - في الغالب - طبيعة البيئة والمجتمع والحياة في عصر الشاعر؛ مما حدا بالدكتور "طه حسين" إلى انتقاد منهج الناقدين معا في مقالة أدرجها ضمن كتابه "خصام ونقد" وحملت عنوان "بؤس أبي نواس" حيث رأى ما فحواه أن المنهج النفسي له دارسوه ومتخصّصوه، وأن مجاله الحقيقي في المعامل والتجارب على الأحياء، وحين يقوم بهذا الدور نقاد الأدب فإنما ينقلون إلينا نظريات وأفكارًا، قد لا تصلح لتطبيقها على الأموات ومن ليس تحت أيدينا تقارير طبية ونفسية، بناء على فحوص أجريت لهم واستخلصت النتائج من خلالها، حينئذ يكون التحليل النفسي قائمًا على أسس وثوابت، لا على فرَضيات ونظريات غير قابلة للتطبيق إلا على أفراد، مِن قبيل مَن خضعوا للفحص والتجربة، لا عموم الناس.
ولما كانت دراسة الأدباء - أحياء وأمواتًا - وإخضاعهم للدراسات النفسية، لا تأتي في الغالب بنتائج حقيقية، يمكن اعتمادها في الحكم على الأدباء ونتاجهم، لما كان الأمر كذلك، وجدنا أن اعتماد تلك المناهج في الدراسات الأدبية لا يحظى باهتمام كثير من الأوساط الثقافية؛ لعدم التخصص من ناحية، ولأن غالبية تلك المناهج تنطلق في تفسيراتها للظواهر من تفسير جنسي لدى الأدباء، مما يعدّه البعض إقحامًا لسلوكيات سلبية، لا تسلم من محاولة تقليدها والتأسّي بها، وبالتالي، فإن أصحاب هذه الرؤية، يرون أن التحليل الفني للنص الأدبي يكفي لفهمه وبيان الدوافع، التي صبغت أدبه بلون معين، وأخذته إلى وجهة مَّا دون غيرها من الوجهات الأخرى.
ولكن.. هل معنى ذلك: أن على دارسي الأدب ونقّاده إهمال الجوانب النفسية في دراسة الأدب والأدباء؟ والجواب عن ذلك بالنفي قطعًا، فالنقد الأدبي لا يعيش بمعزل عن المناهج المختلفة، ولكن يفيد منها بمقدار ما يضيف إليها، ويسلط الضوء على ظواهرها ويبرز دوافعها وأسبابها، بشكل متوافق مع منطق الأحداث وتراتبها، بلا إغراق في المبالغة والتفسيرات العميقة التي تجافي الواقع وتباين الحقيقة، فمثلا عند تناول ظاهرة وصف الليل لدى بعض الشعراء كامرئ القيس والنابغة والعباس بن الأحنف مثلا، نجد أن جميعهم يشتركون في وصف الليل بالطول والتمدد والجثوم الطويل والإثقال على النفس، فامرؤ القيس يصفه قائلا:
وليلٍ كموج البحر أرخى سُدُولَهُ --عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تَمَطَّى بصُلبِهِ -- وأردف أعجازا وناءَ بكلكل
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي -- بصبح وما الإصباح منك بأمثلِ
فيا لك من ليل كأن نجومه -- بكل مُغَارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بِيَذْبُلِ
كأن الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ في مَصامِهَا -- بأمراسِ كِتَّانٍ إلى ُصِّم جَنْدَلِ
والنابغة يقول:
كليني لِهَمٍّ يا أميمة ناصبِ -- وليلٍ أقاسيه بطيءِ الكواكبِ
وصدرٍ أراح الليلُ عازبَ همِّهِ -- تضاعف فيه الحزن من كل جانبِ
تقاعسَ حتى قلت ليس بمنقضٍ -- وليس الذي يرعى النجومَ بآيبِ
والعباس بن الأحنف يقول:
أيها الراقدون حولي أعينو -- ني على الليل حسبةً وائتجارا
حدثوني عن النهار حديثًا -- أو صفوه فقد نسيتُ النهارا
فالشعراء الثلاثة جميعهم يعبّرون عن استثقال الليل وجثومه وامتداده.
فعلى الباحث الأدبي ألّا يقف عند حدود التفسير اللغوي للنص، والتحليل الفني لمعطياته الأسلوبية والموضوعية، وإنما عليه أن يبحث في الدوافع التي تكمن وراء تلك النظرة إلى الليل، فامرؤ القيس كانت تلاحقه فكرة الثأر لمقتل أبيه، وتنغّص عليه حياته وتؤرّق منامه، والنابغة كان غضب النعمان بن المنذر عليه، وهو مليكه المُحبّب، من وراء تلك الصور التي رسمها الشاعر لليل، والعباس بن الأحنف كان عشقه وغرامه وصدّ محبوبته عنه شغله الشاغل، الذي أطال بقاء ليله، وأيأسه من نهار، يكون فيه خلاصه من الهموم الجاثمة الطاغية.
حين يبحث الناقد عن مثل تلك الدوافع الاجتماعية، وما تسبّبه لأصحابها من ضغوط نفسية، مستخدما منهج التحليل النفسي يكون قد جعل الأدب يضيء من مشكاة المنهج النفسي، بما يكشف له عن الدروب المظلمة والسبل المعتمة، بمقدار ما يعبر تلك الطرق آمنًا مطمئنًا.
ولو أنه أوغل في مصطلحات المنهج النفسي وأوغل في تطبيق نظرياته، ربما لم يسلم من الخطأ؛ إذ إن تعميم تلك المعطيات النفسية على كل من تتشابه ظواهرهم خطأ فادح، وإلا قل لي رأيك في تجربتي الخاصة مع الليل، بما يخالف فحول الشعراء الذين شكوه للقاصي والداني، بينما أنا أراه على خلاف ذلك وفيه أقول:
آه يا ريف يا جمال الدُّنَى -- فيك ليل لو يشترى أشتريهِ
فيك سحرٌ هاروته مبدعٌ -- سحرُهُ صادقٌ ولا إثمَ فيهِ
أيها الليل أنت لي مُسْعِدٌ -- وصديقٌ مَحَبَّبٌ أصطفيهِ
كم من الهَمِّ قد أزحتَ إذا -- أثقل الهمُّ بالمصاب الكريهِ
وقديما حُمِّلْتَ ثُقْل الجَوَى -- ذاك ظلمٌ يا ليلُ ما أرتضيهِ
بلسمٌ أنت لم تزل آسيًا -- جُرحَنا مطفئًا لظًى نكتويهِ
ما شكوناك يا صديقُ فلَمْ -- نلقَ من ليلنا أذًى نشتكيهِ

بدر شحادة (باحث في الشؤون التاريخيّة والاستراتيجية من لبنان)
دراسة في شخصية القائد "أتيلا الهوني".. العامل النفسي في صعود وسقوط الأمم
لا شكَّ أنّ العامل النفسي يُشكّل أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع وتوجّهه، إذ ينعكس مباشرةً على سلوك الأفراد، وتكوين الأجيال، واستقرار العلاقات الاجتماعية. فالمجتمع لا يُبنى بالقوانين فحسب، بل بالنفسيات التي تُسهم في صياغة أنماطه الفكرية والتربوية، وفي تشكيل ضميره الجمعي. ومن هنا تأتي أهمية دراسة أثر العوامل النفسية في تطوّر المجتمعات، واستحضار النماذج التاريخية التي تجسّد هذا التأثير، ومن أبرزها شخصية "أتيلا الهوني"، أحد أكثر القادة إثارةً للجدل في التاريخ القديم.
أولاً: أثر العامل النفسي في تكوين المجتمعات
يدخل العامل النفسي إلى حدٍّ كبير في تسيير المجتمع، سواء على صعيد التربية أو العلاقات الاجتماعية، ويُعدّ أحد المحدّدات الخفيّة لمسار التطوّر الاجتماعي والحضاري. فالنشأة ضمن ظروفٍ نفسيّةٍ قاهرة - كالحرمان، أو الحروب، أو الاضطرابات البيئية - تترك بصمتها العميقة في الأجيال اللاحقة، فتكوّن لديهم أنماطًا من الصبر والصلابة، أو على العكس، الرفض والتفلّت من القيم والأطر المجتمعية.
وتُجمع الدراسات النفسية على أنّ الإنسان في مراحل تشكّل شخصيته يعتمد على المحاكاة، متأثرًا بمن هم في مستوى ثقافي مماثل، أو من ذوي التأثير الاجتماعي والعلمي الرفيع. فالنماذج البشرية التي تُحيط بالفرد - سواء كانت رموزًا تربوية أو سلطات فكرية أو سياسية - تُسهم في بناء صورة "الأنا" وتوجّه السلوك الجمعي لاحقًا.
وعلى امتداد التاريخ، يظهر أن العوامل النفسية - أكثر من المادية أحيانًا - كانت قادرة على هدم الأمم حين يسودها جنون العظمة، كما كانت قادرة على بناء الحضارات حين يسودها الإيمان والصبر والتكامل الداخلي.
ثانيًا: "أتيلا الهوني" أنموذجًا تاريخيا
1. نبذة تاريخية
يُعدّ "أتيلا الهوني" (Attila the Hun) أحد أشهر القادة العسكريين في التاريخ الأوروبي القديم، وقد حكم قبائل "الهون" ما بين عامي 434 و453 م. بسط سلطانه على أجزاء واسعة من أوروبا الوسطى والشرقية، وامتدّ نفوذه إلى الإمبراطوريتين الرومانية الشرقية والغربية.
قاد حروبًا طاحنة ضد الرومان، أشهرها معركة "كاتالونيان" سنة 451 م، وغزا إيطاليا عام 452 م، ودخل مدنًا كميلانو وأكوينيا قبل أن يتراجع بعد مفاوضات دبلوماسية مع البابا ليو الأول.
توفي "أتيلا" عام 453 م في ظروف غامضة ليلة زفافه، لتنقسم بعد موته قبائل "الهون" وتنهار إمبراطوريته سريعًا، ما يدلّ على أن نفوذها كان قائمًا على قوّة شخصيته الفردية لا على مؤسسات راسخة.
2. قراءة نفسية في شخصية "أتيلا"
إن دراسة شخصية أتيلا من منظور علم النفس التاريخي والاجتماعي تتيح فهمًا أعمق لتأثير الفرد في حركة التاريخ، إذ تتداخل السّمات الفردية مع الظرف السياسي والثقافي العام.
- الطموح والهيمنة: تشير سيرته إلى شخصية ذات نزوع قوي للهيمنة والتوسّع، لا تكتفي بالسيطرة العسكرية بل تسعى إلى فرض تصورها الذاتي للعظمة. هذا السلوك يمكن ربطه بما يُعرف في التحليل النفسي الحديث بـ "النزعة السلطوية" أو عقدة السيطرة، التي تدفع صاحبها إلى توسيع دائرة نفوذه بلا حدود واضحة.
- الازدواج بين العنف والسياسة: رغم اشتهاره بالقسوة، أظهر "أتيلا" براعة دبلوماسية عالية في عقد المعاهدات والمفاوضات، ما يكشف عن ذكاء تكتيكي وقدرة على ضبط الانفعالات حين تقتضي المصلحة ذلك.
إن الجمع بين الشدة والمرونة يدل على شخصية تدرك قوانين القوة النفسية، وتوظفها في إخضاع الآخرين عبر الرهبة قبل السلاح.
- الشعور بالعظمة والقدرية: لُقّب "أتيلا" بـ "سوط الله" (Scourge of God)، وهو لقب أطلقه عليه خصومه الرومان، لكنّه تبنّاه ضمنيًّا في خطابه وسلوكه، ما يُظهر إحساسًا بالاصطفاء التاريخي، وشعورًا بأنه أداة إلهية للعقاب أو التغيير. وهذا يعكس نمطًا قريبًا من اضطراب العظمة (Megalomania)، حيث يُبالغ الفرد في تقدير ذاته ودوره في التاريخ.
- الكاريزما والتأثير الجمعي: نجاحه في توحيد القبائل المتناحرة تحت رايته يُظهر كاريزما قيادية قوية، وقدرة على استثمار الرموز والخوف لتثبيت السلطة. هذا النمط من القيادة يعتمد على التحفيز النفسي السلبي (الخوف، التهديد، الغموض)، وهو ما جعل حكمه سريع الصعود وسريع الانهيار في آنٍ واحد.
ثالثًا: العلاقة بين النفس والقيادة الاجتماعية
إن شخصية "أتيلا" تمثل مثالًا واضحًا على كيف يمكن للبنية النفسية للفرد القائد أن تؤثّر في مسار التاريخ.
فالزعيم الذي تحركه دوافع العظمة أو مشاعر القهر، يعكس على المجتمع كله حالة نفسية جماعية قد تدفعه إمّا إلى نهضة قصيرة الأمد أو إلى دمار شامل.
ومن هنا تبرز ضرورة دراسة الدوافع النفسية في القيادة والسياسة، لأن الأمم لا تُقاد بالقرارات وحدها، بل بالعواطف، والمخاوف، والإيحاءات التي يبثها القائد في وعي الناس ولا وعيهم.
الخاتمة
يتضح أن العوامل النفسية تُعدّ عنصرًا حاسمًا في تشكيل الأفراد والمجتمعات على حدٍّ سواء. فكما قد تبني شخصية متّزنة حضارةً راسخة، قد تهدم أخرى أممًا بكاملها.
ويُعدّ "أتيلا الهوني" أنموذجًا صارخًا لتجلّيات النفس على مستوى القيادة؛ حين تنفلت من ضوابط القيم والاتزان، فتغدو قوةً مدمّرة بقدر ما هي ملهمة.
إنّ دراسة مثل هذه الشخصيات لا تهدف إلى الإدانة أو التمجيد، بل إلى فهم الآليات النفسية التي تؤثّر إلى حدٍّ كبير في المَسَارِ التاريخيّ للأمم.

سامر المعاني (كاتب من الأردن)
التربية النفسية.. أي ضرورة في حياة الفرد؟
التربية النفسية هي عملية تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات الفرد النفسية والعاطفية، وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات والضغوط اليومية. في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية، أصبحت التربية النفسية ضرورة حتمية لضمان صحة نفسية جيدة وتحقيق التوازن بين الجوانب النفسية والجسدية.
الحاجة إلى التربية النفسية
ضرورة التربية النفسية مردّه إلى عدة أمور منها:
- تساهم التربية النفسية في تعزيز الصحة النفسية للأفراد، وتقليل خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.
- تساعد التربية النفسية الأفرادَ على تطوير مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين، مما يعزز العلاقات الاجتماعية الإيجابية.
- تمكن التربية النفسية الأفرادَ من التعامل مع التحديات والضغوط اليومية بفعالية، وتحسين قدرتهم على التكيف مع التغيرات.
- تساهم التربية النفسية في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في العمل، من خلال تحسين مهارات إدارة الوقت.
اكتساب التربية النفسية
يمكن اكتساب التربية النفسية في حياتنا من خلال:
- التعليم والتدريب والبحث والتفاعل مع الأخرين.
- من خلال الدراسة الأكاديمية في مجالات علم النفس والتربية الخاصة.
- يمكن الحصول على التدريب المهني في مجالات التربية النفسية من خلال البرامج التدريبية والورش العمل.
- يمكن للأفراد تعزيز معرفتهم ومهاراتهم النفسية من خلال القراءة والبحث الذاتي في مجالات علم النفس والتربية النفسية.
- يمكن للأفراد تعلّم مهارات التربية النفسية من خلال التفاعل مع الآخرين، والتعلم من تجاربهم وخبراتهم.
علاقة التربية النفسية بالأدب
التربية النفسية لها علاقة وثيقة بالأدب، حيث يمكن للأدب أن:
- يمكن للأدب أن يعزز الوعي النفسي للأفراد، ويساعدهم على فهم تجارب الآخرين وخبراتهم النفسية.
- يمكن للأدب أن يوفر نماذج إيجابية للتعامل مع التحديات والضغوط النفسية، ويساعد الأفراد على تعلم مهارات التكيف والمرونة.
- يمكن للأدب أن يعزز التعبير العاطفي للأفراد، ويساعدهم على فهم مشاعرهم وعواطفهم بشكل أفضل.
بين الأدبي العربي والأدب الغربي
حالة الروح وحالة الجسد في التعاطي مع المتاعب والأزمات في الأدب العربي مقارنة مع الأدب الغربي:
- في الأدب العربي، غالبًا ما يتمّ التركيز على حالة الروح والجوانب الروحية في التعاطي مع المتاعب والأزمات. ويمكن رؤية ذلك في أعمال الأدباء العرب الكلاسيكيين مثل "ابن سينا" و"الغزالي"، حيث يتم التأكيد على أهمية الروح والجوانب الروحية في تحقيق التوازن النفسي والجسدي.
- في المقابل، غالبًا ما يتم التركيز على حالة الجسد والجوانب المادية في التعاطي مع المتاعب والأزمات في الأدب الغربي. ويمكن رؤية ذلك في أعمال الأدباء الغربيين مثل "فريدريك نيتشه" و"سيجموند فرويد"، حيث يتم التأكيد على أهمية الجسد والجوانب المادية في فهم السلوك الإنساني والتعامل مع التحديات النفسية.
خلاصة الكلام
إن التربية النفسية ضرورة حتمية في حياة الفرد، ويمكن اكتسابها من خلال التعليم الرسمي والتدريب المهني والقراءة والبحث الذاتي والتفاعل مع الآخرين. وعلاقة التربية النفسية بالأدب وثيقة، حيث يمكن للأدب أن يعزز الوعي النفسي ويوفر نماذج إيجابية ويعزز التعبير العاطفي. حالة الروح وحالة الجسد في التعاطي مع المتاعب والأزمات تختلف بين الأدب العربي والأدب الغربي، حيث يتم التركيز على الروح في الأدب العربي والجسد في الأدب الغربي.






