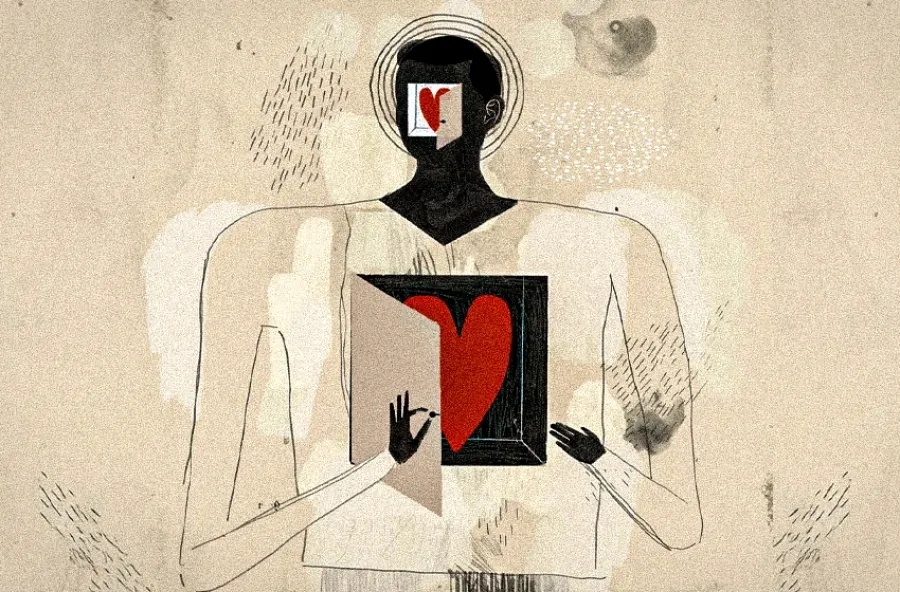منذ قرون يُرجعها بعض الدارسين إلى العصر الأموي، كانت الفضيحة بـ "جلاجل" (أجراس صغيرة) يتردّد صداها في الأسواق الشعبية والساحات والحواري وكل ركن في المدينة. وجلاجل الفضيحة مرتبطةٌ بعقوبةٍ تُسمّى: "التَّجريس"، كانت تُنفَّذ على السارق أو المختلس أو خائن الأمانة، فيُدهَن وجهه بالأصباغ الملوّنة، ويُجبَر على ارتداء لباس، مثل لباس المهرّجين، يدعو إلى السخرية والهزأ والضحك، ثم يُحمل على حمار يحيط برقبته أجراسٌ صغيرة (جلاجل)، حيث يكون ظهر المُجرَّس إلى جهة رأس الحمار، ووجهه إلى جهة الذّيل، ثم يُطاف به في الأسواق والحواري، ومن خلفه منادٍ يُشهِّر بجريمته.. كان التّجريس عقوبةٌ يُصدرها قاضٍ، وله شروط وقواعد وتقاليد، وهدفه التشهير بالجاني بين الناس، و"إعدامه" معنويًّا واجتماعيًّا حتى يكون عبرة لغيره.
أما اليوم فلا حاجة للفضيحة إلى جلاجل، فهي "مُجلجلة" رقميًّا بالكلمة والصوت والصورة، وصداها يتجاوز أسوارَ المدينة القديمة إلى كل أرجاء العالم.. تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي في زمن قياسي، وقد يجعل منها الإعلام مادةً يستثمرها في استقطاب المتلقّين وإغوائهم لمتابعة موادّه الأخرى، وأيضًا، قد يستثمرها السياسيون والاقتصاديون في الحروب المعلنَة وغير المعلنة.. فلم تعد الفضيحة مقتصرةً بجلاجلها على اللصوص والمختلسين وخائني الأمانة وكل هؤلاء الصغار الذين لا يمثّلون بعوضةً على رأس فيل، بل امتدّت إلى صُنّاع الأحداث، و"المؤثّرين" في أفكار الناس وثقافتهم الحياتيّة، من المشاهير في عوالم الآداب والفنون والرياضة والسياسة وغيرها من العوالم التي لها نجوم وزعماء!
ويُمكن القول إن الفضيحة تطوّرت وصارت "ثقافة فضائحيّة" تُميّز مجتمعات القرية الصغيرة التي أوجدتها تكنولوجيا الاتصال والتواصل. وهي تتشابك، في بعض أبعادها وخفاياها، مع مفاهيم مثل: الديمقراطية وحريّة التعبير.. ولعله من الأهداف "السريّة" للأنترنت ومجتمع المعلومات، ترسيخ "الثقافة الفضائحية" في نفسيّة المجتمعات ومدارات أفكارها وقِيَمها.. لتصنيع "الإنساني العالمي" اللامنتمي - دينيًّا ووطنيًّا وتاريخيًّا - والمُفرَغ من عناصر أصالته ومنظومته القيميّة! ولن نذهب في التّهويم أكثر والادّعاء بأن "الثقافة الفضائحية" هي إحدى وسائل "الاستعمار الجديد" لبرمجة الإنسان والسيطرة على فكره ووجدانه!
ولعل مجال الحب والعشق والعلاقات غير المشروعة هو أكثر المجالات التي برزت فيها الفضيحة، لا سيما خلال القرن الثامن عشر، فقد أصدرت الكاتبة والإعلامية الإنجليزية "نينا إيبتون" (1923 - 2010) مجموعة من الكُتب - ذات البُعد الأدبي والاجتماعي والتاريخي - عن العلاقات العاطفية، منها: "الحب والفرنسيون" (1959)، "الحب والإنجليز" (1960)، "الحب والإسبان" (1961). وقد تحدّثت "نينا" عن "نوادي الفضائح" في فرنسا باعتبارها ظاهرة غريبة سبقت الثورة الفرنسية بحوالي نصف قرن. كما تحدّثت حول نادٍ (صالون) كان يجمع محرّري الصحف "الصفراء" كل مساء، ليقوموا بفرز ومناقشة ما جمعوه من أخبار الفضائح، ثم تدوين الصحيح منها في كتاب، والمشكوك حولها في كتاب آخر. وقد توالدت النوادي والجمعيات "الفضائحية" في فرنسا، خلال القرن الثامن عشر، بشكل جعل منها ظاهرة اجتماعية مُلفتة. ومن تلك الجمعيات، جمعية "البهجة" التي ابتدعت تقويمًا جديدًا يحذف أسماء "القدّيسين" ويعوّضها بأشهر حسناوات "باريس" اللّواتي اشتهرت بمغامراتهنّ العاطفيّة.
لسنا في معرض تتبّع تاريخ "الفضيحة بجلاجل"، فيُمكن القول بأنها صارت صناعة منذ عصر النهضة الأوروبية، ولعل ازدهارها ارتبط باختراع المطبعة وحركة الطباعة والصحافة. كما يُمكن القول بأن أكبر اختلاف يُميّز الفضيحة بين ذلك العصر وعصرنا الراهن، أنها كانت بالأبيض والأسود وتعتمد على الكلمة المكتوبة والصورة الشّاحبة، أما اليوم فهي فضيحة مُلوّنة بأدوات وتقنيات (سمعية - بصرية) مُذهلة.
نعم، إن جماهير الناس تنجذب إلى الفضيحة والأخبار الفضائحيّة تمامًا كما تنجذب الذبابة الزرقاء إلى اللَحم النّتن، وهذه طبيعة بشرية مرتبطة بالفضول وعومل نفسية واجتماعية عديدة يمتلك إجابتَها "علم اجتماع الفضائح"، ونحيل القارئ الكريم، إن شاء الاستزادة، إلى كتابٍ بهذا العنوان للدكتور "معن خليل العمر".. هذا الانجذاب الجماهيري دفع إلى انتعاش "تصنيع الفضائح" من أجل تحقيق غايات عديدة أدناها تدمير الإنسان وأقصاها تدمير الأوطان. وعندما نقول "تصنيع الفضائح" فإننا نعني منظومةً متكاملةً تتضمّن التوزيع والترويج والتشهير.. سواء كانت الفضيحة تستند إلى حقيقة أو إلى إشاعة!
كانت الفضيحة تزحف على بطنها في زمن "المجتمع الورقي"، فكان في الإمكان محاصرتها ومنع انتشارها، أما في زمن "المجتمع المعلوماتي" - الرقمي - فهي كائنٌ أثيريٌّ يقتحم عزلة الإنسان، مهما كان نائيًّا عن أحداث العالم وحوادثه، فيستفزّه ويثير فضوله ليعرف تفاصيل الفضيحة! ولعل هذا الإنسان صارًا محاصرًا بالفضائح أكثر من أيّ شيء آخر، فضائح في كل مجالات الحياة: السياسة، الاقتصاد، الدين، الرياضة، الآداب والفنون، الحروب، هيئة الأمم المتحدة، المنظمات العالمية على اختلاف تخصّصاتها، المجتمعات العلمية والأكاديمية.. بالمختصر، صار الإنسان يتغذّى بالفضائح يوميًّا، ولا يستطيع الصومَ عنها مهما اجتهد في عزلته!
ويُمكن اعتبار "وثائق ويكيليكس" أضخم وجبة "فضائح" تناولتها البشرية عبر تاريخها، فهي تُحصى بالأطنان، وتتضمّن أمورًا بالغة السريّة بين الدول والهيئات العالمية، وحول خفايا الحروب والبنود غير المُعلنة للاتفاقيات الدولية، وغيرها من الشؤون التي لا تكاد تُقارن بالفضيحة التي دفعت الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" إلى الاستقالة عام 1974 فيما سُمّي "فضيحة ووترغيت". والحق أن تاريخ الرؤساء الأمريكيين حافلٌ بالفضائح السياسية والاقتصادية والغراميّة، بل إن وجود الولايات المتحدة الأمريكية نفسها يُعتبر أكبر فضيحة هضمها الضمير العالمي وتقبّل إبادة عشرات الملايين من السكّان الأصليين الذين يُطلق عليهم "الهنود الحُمر"، وكذلك الشأن بالنسبة للدول الاستعمارية التي تغوّلت في "عصر البخار" وما يُسمّى النهضة الأوروبية.. ولا تزال فلسطين تمثّل عار الإنسانية منذ احتلالها عام 1948، كما لا يزال الكيان الصهيوني هو أفظع فضيحة للدول الغربية التي تبشّر بشعارات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان!
في مدار هذه الأفكار، توجهت جريدة "الأيام نيوز" إلى نخبة من الكتّاب الأفاضل بهذه الرسالة: يُقال بأن هذا العصر هو عصر القلق، وهو عصر الفضائح أيضًا، فلا يكاد الإنسان ينام على فضيحة في مكان ما من هذا العالم حتى يستيقظ على فضيحة أخرى في مكان آخر، كأنما الفضائح صارت صناعةً عالمية لها مختبراتها وصُنّاعها.
والفضائح صارت تغزو كل مجالات الحياة: الإعلام والآدب والفنون والسياسة والرياضة وحتى مؤسسات التربية والتعليم والدين.. وفي الحياة اليومية للإنسان عموما. وقد أسهمت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في انتعاش الفضائح وسرعة انتشارها دون التثبّت من صدقيّتها. ومما يؤسَف له أن "الجهر بالسّوء" صار سمة من أبرز سمات هذا العصر، فإلى وقت قريب كانت المجتمعات، العربية على الخصوص، تحتاط للفضيحة وتحتويها وتُخمدها في مهدها حتى لا يكون لها ضحايا لا ذنب لهم، لا سيما الفضائح في مجال العواطف والعلاقات بين الجنسين، وأما اليوم فكأنما هناك تسابق غير مُعلن لنشر الفضائح وتداولها..
هل صارت الفضائح جزءًا من ثقافة هذا العصر، ويُمكن أن نُطلق عليها "الثقافة الفضائحية"؟ وهل هي داءٌ يجب استئصاله، أم لها منافع وإيجابيات تخدم الإنسان والمُجتمع؟ وما هي الفضائح التي رسخت في ذهنكم سواءٌ كانت من واقع الحياة التي تعيشها أو من الأحداث العالمية في مختلف المجالات؟ وما هو موقفكم من الفكر الفضائحي، وهل يُمكنه أن يُنتج أدبًا مثلا؟ ولماذا يعشق الناس الفضائح ويتابعونها أكثر ما يتابعون الشؤون التي ترتقي بهم وتطهّر أعماقهم.
عزيزي القارئ، حدّثتك عن "الفضيحة" ولم أضع لك تعريفًا يضبطها، لأن ما يعيشه العالم تجاوز المعنى التقليدي للفضيحة، ونحن في حاجة إلى اختراع لغة أخرى لتوصيف ما نُسمّيه "فضيحة". وإن شئت أن أقدّم لك تعريفي الشخصي لها، سأختار التعريف على طريقة السرياليين، وأقول: الفضيحة هي - في الغالب - حقيقة متوهّجة بـ "كامل مشمشها" (كما قال محمود درويش)، تعرّت من كل ثيابها، ثم راحت تأخذ حمّامًا شمسيًّا في سوق شعبي. وأترك لك عزيزي القارئ أن تختار السوق الشعبي الذي تراه يليق بمثل هذا التعريف!
لعل ذهنك عزيزي القارئ لا يزال يناور في عقوبة "التّجريس"، ولعلك تتساءل: هل تكفي أعداد الحمير، الداجنة والمتوحّشة، لتجريس سارقي أحلام الشعوب ولصوص السلام ومغتصبي الأوطان؟ كل ما يسعني تسجيله إن قواميس اللغة تقول: تَجريسُ الإنسان: التَّنديد به والتَّصريح بِعُيوبه. وتقول أيضًا: جَرَّسَ الدَّهرُ فلانًا: حَنَّكه. ولك أن تختار المعنى الذي يروقك!

هيّا بنا نركض وراء الفضائح!
سحر قلاوون (كاتبة من لبنان)
حين أتصفّح مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن خبر قد يهمّني، أجدني أغرق فجأة بين كومة من الأخبار التي تكشف فضائح متنوّعة. وأتساءل حينها: لماذا أنا مضطرة لرؤية هذه الأخبار التي لا تعني لي شيئا؟ ولماذا تهطل عليّ هذه الأخبار كالمطر الغزير، مع فارق بسيط، لكن جوهري، وهو أنّ هذه الأخبار لا تروي الأرض ولا تساعد النباتات على النمو؟ فهي على العكس من ذلك، فكل فضيحة - مهما قوي عيارها أو خفّ - تدمّر الكثير من حولها، فهي تهدم البيوت وتقتلع النباتات من جذورها وتجعل الأرض عبارة عن صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا خَضار ولا حتى نقطة ماء.
الحياة بوجود الفضائح صعبة، هذا بالنسبة للأشخاص الذين يتمتّعون بقدر معيّن من الوعي والثقافة والنضج، أما بالنسبة لمن لا يملكون هذه الأشياء، فهي بالنسبة لهم تسلية تساعدهم على الشعور بأن الوقت يمرّ، فهؤلاء بطبيعة الحال لا يدركون قيمة الوقت ولا يعرفون أهميّته، لذلك تجدهم يبحثون عن الفضائح كمن ينقّب عن الغاز أو البترول أو كنز مخبّأ لم تطله يديا بشري منذ عقود.
أما صنّاع الفضائح، والمروّجون لها، فلهم بالطبع استفادة ما من انتشارها، ولولا ذلك لما ساهموا في وصولها إلى أكبر قدر ممكن من الناس، فالإنسان بطبيعته يميل إلى فعل ما يأتي لصالحه، وهذا ليس عيبا، لكنّ العيب هو أن يؤذي الآخرين ويشوّه سمعتهم وحياتهم ومستقبلهم وحتى ماضيهم من أجل مصلحة يرجوها.
لقد أصبحنا نعيش في زمن يبدو وكأنه يقول لنا: هيا بنا نركض وراء الفضائح، لكن لا ينبغي لنا أن ننجرّ وراء هذه اللعبة. فالتعامل مع الفضائح يجب أن يميل إلى التستّر لا إلى المزيد من "القيل والقال"، فعلى المسلم أن يستر أخاه المسلم، فينصحه حين يرى منه تصرّفا خاطئا، لكن لا يحكي عنه للجميع.
وإن سألتموني: هل علينا دومًا أن نتستّر على الأخبار؟ أجيب بأن لكل قاعدة استثناءات، وهنا علينا فضح الأمور حين تكون هنالك مصلحة سامية من ورائها، على سبيل المثال لا الحصر: علِمنا أن أحدهم يعتدي بالضرب على شخص ما بشكل متكرّر، وقد نصحه بعض العقلاء بالتوقّف عن فعلته تلك، ولكنه راح يتمادى أكثر فأكثر، فهنا علينا أن نفضح أمره لكي يتوقّف عن فعلته السيئة.
أخيرا وليس آخرا، أدعو الجميع من مكاني المتواضع أن يفكّروا مرّة واثنتين وثلاثة قبل أن يكونوا مشاركين في الفضيحة، لأن الله فوق الجميع، يرى الجميع وسيحاسب كل منا على أعماله.

الأدب يولد من رحم الفضيلة
أ. د. عبد الوهاب برانية (جامعة الأزهر - مصر)
يُولد الأدب من رحم الأخلاق. ولكن كيف ذلك؟ بقليل من التدبّر ندرك تلك الحقيقة، فكل قيمة خلقية تستدعي حمدها والثناء عليها، فالإنسان الكريم يلهج الناس بمدحه، والشجاع يثمّنون شجاعته وإقدامه ومواجهته للمخاطر وتصدّيه لها، وهكذا كل مكرمة تستدعي ذِكر الناس لها ولهجهم بالثناء على صاحبها.
وقد تعلّمنا في المراحل الأولى لدراسة الأدب، أن كلمة "أدب" مرّت بمراحل عديدة منذ العصر الجاهلي مرورًا بعصر "صدر الإسلام" وما يليه من عصور حتى وقتنا الحاضر، فكان من معانيها في الجاهلية الدعوة إلى الطعام، فيقال: صنع فلان مأدبة وجمع الناس لها، إذا كان هذا الصانع كريمًا، يُطعم الناس، ويجمعهم على طعامه وسقائه، ومن هنا قال "طَرَفَة بن العبد"، الشاعر الجاهلي، مفتخرًا ومعتزًا بقومه وكرمهم، وما يقدّمونه للناس في النوازل والأزمات من طعام، لا يفرقون بين غني وفقير، ولا بين سيّد ومَسود:
نحن في المشتاة ندعو الجَفَلَى -- لا ترى الآدب فينا ينتقرْ
أي: نحن في وقت الشتاء، حين يحلّ بالناس القَرُّ أو البرد الشديد، ويكونون أشدّ ما يكونون حاجةً إلى الطعام، نصنع لهم الموائد وندعوهم إليها دعوة عامة، لا نفرق بينهم لمكانة أو ثراء.
أرأيت إلى الأدب وكيف يُعلي من شأن أهل الكرم والسخاء، ويدعو بشكل مَّا إلى عدم التفرقة بين الناس على أي نحو من الأنحاء. هنا يكون الأدب فاعلا في المجتمع وإيجابيًّا في النهوض به وتعزيز قيم الحق والعدل والخير.
فقد كان العرب يتغنّون بمثل تلك المكارم الحميدة والخلال الطيبة، ويعتزون بها، ويطوعون أدبهم لخدمتها والتعويل عليها، لأن تداول تلك المعاني يُعدي على تمثّلها والعمل بها، وبذا تنتشر الفضيلة وتعمّ القيم النبيلة، وتسود العدالة والمساواة بين الناس.
وإني أراني وقد فرغت لكتابة هذا المقال، تأسرني بعض مواقف الشعراء، وأراني لا أتجاهلها لما فيها من جميل الخلال، ولارتباط بعضها بقصصٍ تُحكَى ورواياتٍ يذكرها التاريخ الأدبي ويسلط عليها الأضواء، لما تحمل من قيمة، وما تبين عنه من مكرمة، كقصيدة الأعشى "أبو بصير" (أَرِقْتُ وما هذا السُهَادُ المُؤَرِّقُ) التي تنطوي على قصة مفادها: أن المحلَّق الكلابي، واسمه الحقيقي عبد العزى بن جشم، كان رجلا فقيرًا، وكان له ستّ بنات، فاتهن قطار الزواج بسبب فقر والدهن، وذات يومٍ مَرَّ الأعشى الشاعر بحي بني كلاب، فأشارت زوجة المحلق عليه أن يستقبل الأعشى وينزله ببيته ويكرمه، ثم قالت: "إنه ما مدح أحدًا إلا وارتفع صيته بين القبائل"، ولم تزل بزوجها حتى أقنعته، ولم يكن له من المال سوى ناقة واحدة، فقرّر أن يستقبله وينحر له ناقته، وبات يطعمه ويكرمه، ثم إن الأعشى تركهم، ومضى إلى سوق عكاظ حيث مجتمع الناس والشعراء، وأنشد قصيدته الشهيرة التي ذكرنا مطلعها منذ قليل، وخلص فيها إلى مدح المحلق الكلابي، وافتنّ في وصفه، وإقرانه بالكرم، حتى جعلهما كأخوين توأمين، رضعا من ثدي أمٍّ واحدة، وأقسما عندها أن لا يتفرقا أبدًا، وكان مما جاء فيها:
لعَمرِي، لَقد لاحَتْ عُيُونٌ كَثيرَة ٌ -- إلى ضَوءِ نَارٍ في يَفَاعٍ تُحَرَّقُ
تُشَبّ لمَقْرُورَيْنِ يَصْطَلِيَانِهَا -- وَبَاتَ عَلى النّارِ النّدَى وَالمُحَلَّقُ
رضيعَيْ لبانٍ ثديَ أُمٍّ تحالفا -- بِأسْحَمَ داجٍ عَوْضُ لا نَتَفَرّقُ
فلما سمعه الناس كبر في نفوسهم المحلق، ولم يمض وقت يسير حتى تسابق أشراف العرب إلى حيِّ المحلق يطلبون الزواج من بناته، فتزوجن كلهن. فانظر كيف لاذ المحلق وزوجته بالشاعر الأعشى، ليجدَا في أدبه الخلاص من همومهما، وليشاركهما معاناتهما التي تنغص حياتهما، وهما يريان ستًّا من البنات الجميلات وقد قعد بهن فقر الوالد عن الزواج.
والقصيدة إحدى روائع شعر "أعشى قيس"، وتدل الحكاية التي تُروى حول هذه القصيدة على ما كان للشعر من أثر بالغ في رفع شأن الإنسان أو الحطّ من قدره في المجتمع الجاهلي، وهكذا ينبغي للشعر أن يكون في كل مجتمع وفي كل عصر، بما يعزز من دور الأدب، في إبراز المكارم والدعوة إلى التكافل، وأيضا مشاركة المجتمع همومه، ومحاولة الإسهام بالكلمة في وضع حد لمعاناة الناس.
لقد عُرِفَ العرب بالعزة والإباء، وعُرفوا بالكرم والسخاء، ونفروا من سيّء الطباع ومسترذل الخصال، ومن هنا راح شعراؤهم يتغنّون بما يجلب لهم الذِّكرَ الحسن والأثر الجميل، فاشتهر "حاتم الطائي" بالكرم، حتى صار يُضرب به المثل فيه فيقال: "أكرم من حاتم"، واشتهر ابنه "عدي بن حاتم الطائي" بالكرم، حتى قال فيه "رؤبة بن العجاج" مادحًا:
بِأَبِهِ اقتدى عدِيٌّ في الكرمْ -- ومن يشابهْ أبَهُ فما ظلمْ
ولقد أحبّ العرب تلك الصفات، وأحَبّوا من تحلّى بها منهم، وقدّروا من يوصَف بها، وأنزلوه منزلة يستحقها، حتى قيل بأن النبي الكريم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) عرف لحاتم الطائي مكانته الاجتماعية، وذكره بالخير مع أن حاتم مات على نصرانيته قبل الهجرة بنحو أربعين سنة، وفي السنة التاسعة من الهجرة أرسل النبي (صلى الله عليه وسلم) عليًّا بن أبي طالب على رأس سريّة إلى قبيلة "طيء" ليهدم صنمًا يقال له (فلس) كانوا يعبدونه، وكان "عدي بن حاتم" سيّدا في قومه، فلما علم بقدوم السريّة فرّ بأهله إلى الشام، وبقيت أخته "سَفَّانَة بنت حاتم" بين قومها فأخذت مع السبايا، فلما مرّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالسّبي يتفقّدهم، قامت "سفانة" وكانت جزلة القول فقالت: "يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي، كان أبي يفك العاني، ويحمي الذمار، ويُقري الضيف، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، أنا بنت حاتم الطائي"، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "يا جارية، هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه. خلّوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق".
والإنسان بفطرته السليمة وذوقه الذي لم تَشُبه شائبة، يُقبِل على كل ما يدعو إلى الفضيلة، وينفر من كل ما يبعث على الرذيلة، فلا يقبل الفحش، ولا ينسجم مع العري المادي والأخلاقي، لأن العُري على خلاف ما فطره الله عليه، ولأن العري قرين المعصية، فآدم أبو البشر (عليه السلام) لما أغواه إبليس وزوجه حواء بالأكل من الشجرة التي منعا منها ونهيا عنها، ووقعا في حبائله أصابهما العري وراحا يبحثان عما يواريان به سوآتهما، وفي القرآن الكريم: "فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ" (طه، الآية: 121).
فعندما يأتي بعض الأدباء والفنانين ليصوروا الرذائل في أعمالهم الإبداعية، قصةً كانت أعمالهم أو قصيدة أو مسرحية أو عملا دراميا أو نحو ذلك، زاعمين أنهم يصوّرون الواقع، وأنهم يعبّرون عن شريحة في المجتمع، وأن هدفهم في نقل الواقع بغرض معالجته أو كشفه للآخرين، فحجّة هؤلاء داحضة، لأن الأولى بهؤلاء تسليط عدساتهم على ألوان الجمال في الحياة ومصادر الخير فيها، وإبراز الصفات النبيلة والأفكار الإيجابية، حتى يقلدها الناشئة ويذهبوا في اتجاهها، فيعمّ الخير، وأما الباطل والشر والقبح المادي والمعنوي فيشار إليه باستهجانه ومقته ونبذه، حتى يلفظه المجتمع، ويتبيّن للناس زيفه. ولنا في القرآن الكريم المثل الأعلى، وهو أرقى درجات الأدب، فحين يتناول الذِّكرُ الحكيم ظواهر مثل العلاقة الزوجية وقضاء الحاجة عند الإنسان يستخدم أسلوب الكناية للوصول إلى المعنى، ولا يصرّح بتفاصيل ذلك كما اعتاد الناس في استعمالاتهم اليومية، فيقول القرآن الكريم: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ" (البقرة، الآية: 187)، ويقول أيضا: "مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ" (المائدة، الآية: 75)، فانظر إلى الأدب القرآني كيف يربّي في الأمّة الذوقَ ويُعلي من قيمة الفضيلة لا الرذيلة، وهكذا ينبغي أن ينطلق الأدب البشري، من رحم الفضيلة، وينأى عن الابتذال والإسفاف.
واعجب معي أشدّ العجب، ممن لا تجد في إبداعاتهم - من بعض من يُسمّون أنفسهم أدباء - إلا مثل تلك السفاسف والسخائم، ثم يقولون هذه حرية لا تسلبوها منا ولا تحجروا علينا فيما نكتب، فنقول لهؤلاء: إنكم تعملون على انهيار الأخلاق بحجة حرية الإبداع، وتروّجون لكل إباحي قولًا وتصويرا وتمثيلا، وإذا كنتم تستقطبون بعض الأصوات المؤيدة لكم فإن هؤلاء قلّة، ولكن عموم المتلقّين وغالبية المطالعين لأدبكم يلفظونه، لأنه يناقض الفطرة السليمة، والذوق الإنساني الذي لا يقبل السخائم ولا يتعايش مع الرذائل.
ويبقى الأدب أدبا، كما توحي لفظته، نبلا ورقيًّا وقيمةً إنسانية، ويبقى الزيف زيفا، وإن انطلق من عباءة من ينتسبون لأروقته، ويرفلون في أثوابٍ خلعها عليهم مَن سلكهم هذا المسلك وأرادهم لهذا النهج. ولقد خاطبتُ بشعري مثل هؤلاء قائلا:
فن بلا قيم دمارٌ فاتكٌ -- أفخاخُ رجسٍ للبقية فينا
لا تفسدوا باسم التحرر طهرَنا -- فالطهرُ في أخلاقنا يُحيينا
وفي الختام يقول الله تعالى: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" (الرعد، الآية: 17).

فضيحة شركة "التائب وأبو سبحة لإكرام الموتى"
وحيد حمود (كاتب من لبنان)
ما أشبه اثنين باثنين، إنسان بائس يرى الناس دولارات تسير بقدمين وآخر يبيعهم ضحكةً مزيّفة فيزيد في رصيده، وآخَرَين يفقهان جيّدًا لغة الحياة ولغة الموت: بائع الخمر وتاجر الكفن.
في منطقتنا التي تجمع التناقضات، ليس في الشارع الواحد، بل في البيت الواحد أحيانًا، كان لدينا بائع خمر وتاجر كفن، ومن الجدير ذكره أنّهما كانا على علاقةٍ وطيدة، فلا ترى ضحكة الأوّل إلا متى رأيت وجه الثاني، فكأنهما ظلّان لشخصٍ واحد. كيف ذلك؟ وحده الله يعلم. الأوّل يجتهد لكي ينسيَهم الموت والثاني يحرص أن يذكّرهم به.
عرفتُ فيما بعد أنّ الأوّل كان يساهم في تجهيز الزبائن للثاني، وفق مبدأ جديد: ما قليله حرام كثيره حرام أيضًا، فاغتنموا الحرام واحيوا حياتكم. ربّما كان هذا سبب علاقتهما الوطيدة.
كان بائع الخمر يحرص كلّ الحرص على أن يذكّر الناس أنّ الحياة لا تستحقّ أن نحياها بنكد، وإذّاك كان يروّج لبضاعته بأنّها تجلب السّعادة للعقل، فتنسيه ما يكدّر خلاياه في الحياة، أضف إلى ذلك أنّه كان ماهرًا في التّعاطي مع زبائنه وفق عقولهم، إذ كان يحيّي الثّائر بأقوالٍ لـ "غيفارا" ويدغدغ مشاعر المثقّف بذكره كلمات "محمود درويش": "على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة"، ويشير ضاحكًا.. يغمز إلى الخمرة، فيضحك المثقّفون ويضربون الكأس تلو الآخر، ولا يبكون على منزلةٍ كانت تحلّ بها هندٌ وأسماءُ.
أمّا تاجر الكفن فتراه يركض كلّما سمع نواحًا في منزل وحال نفسه تقول: جاءت الرزقة. يدخل المنزل المفجوع أهله، يذرف معهم دموعًا حرّى، ولا تسألوني عن منسوب الدمع الذي يمتلكه ومصدره، فهذا سرّ المهنة على ما يبدو، يجالسهم ويتمتم بشكلٍ غير مسموع عبر حبّات سبحته القابعة بين إبهامه والسبّابة: (ثمن الكفن، أجرة غسل الميت، أجرة حفر القبر، طباعة النعوة، إلصاقها على الجدران، سكب الدموع، أدعية للميت، تلقين الميت لحظة الدفن، قاعة العزاء، القهوة والتمر والماء..) يحمد الله حمدًا كثيرًا، يواسي أهل الفقيد ثمّ يقول: إكرام الميت دفنه، سأهتم بكلّ شيء، لا تشغلوا بالكم. والمفجوع ليس كالواعي، إنّها لحظةٌ ينسى فيها المرء كلّ شيء. وكان تاجر الكفن يدرك هذا الأمر جيّدًا، ويجيد استغلاله.
كان موسم عام 2019 زاخرًا، وعبارة "مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ"، كانت في أوجّ عطاءاتها، إذ إنّ تاجر الكفن ذاك لم يعد يحسب حسابًا لبائع الخمر، فالزبائن كثر، إذ إنّ "كوفيد" المُفيد كما سمّاه، كان دجاجةً تبيض له الذّهب. في حين أنّ تاجر الخمر الذي أجبرته الدولة أن يحذو حذو جميع المحال، فيقفل حرصًا على منع اختلاط البشر بعضهم ببعض وانتقال عدوى "كوفيد"، كان يتقلّب على جمر الخسارات الفادحة والفاضحة.
تدهورت حال بائع الخمر الماديّة، وفهم أنّ الكون برمّته عاد فجأةً إلى الله، فلمعت في رأسه فكرة التوبة، إذ إنّ كلّ الدروب أُغلقت في وجهه ولم يبقَ سواها: لمَ لا أعود إلى الله أيضًا؟ ولكزه شيطانه بفكرةٍ أخرى: لمَ لا تتاجر بالأكفان؟ تاجرت بالحياة والآن أتاجر بالموت، انظر لصاحبك أبي سبحة، لقد ضحكت الدنيا في وجهه فجأةً، هذا "الكوفيد" مشروعٌ رابح. استساغ صاحبنا الفكرة، كافأ شيطانه بضحكة، وقرّر أن يلتزم منزله لمدّة شهرٍ من الإقفال، ثمّ خرج بعد تلك المدّة بلحيةٍ وعباءةٍ وسبحة، وصار يرتاد المساجد التي خالفت قرار الإقفال لكي يظهر للناس بحلّته الجديدة، أودع رقم هاتفه عند شيخ الجامع، وأخبره بتوبته النصوح، وأنّه عازمٌ على العمل بالأكفان وسيقدّم خمسين كفنًا من حسابه الخاص تكفيرًا عن سيئاته. باركه الشيخ، وربّت على كتفه ودعا له بالثبات على التقوى.
لكنّني جديدٌ في المهنة، وعليّ إذّاك أن أتعلّم أصول تجارة الموت جيّدًا، إذ لن يتقبّلني الناس فجأةً ولو تمسكّت بستار الكعبة. قال في سرّه بعد العودة من المسجد. وتحرّك شيطانه مجدّدًا وهمس في أذنه: ابدأ بشراكةٍ مع صديقك أبي سبحة، إنّ له خبرةً طويلةً في هذه الأمور، ثمّ عِوَض أن تتنافسا في هذه المهنة، قفا جنبًا إلى جنب وستفوزان معا.
كيف لم تخطر لي هذه الفكرة؟ صاح والفرحة تغمر صدره، ارتدى عباءته، ترك كأس الخمر من دون أن يبتلع منه رشفة وركض قاصدًا منزل صديقه.
اجتمع الاثنان وكان الشيطان ثالثهما، واتفقا على تأسيس شركة للتجارة وقد وقع الاختيار على اسم: التائب وأبي سبحة لإكرام الموتى.
بدأت الشركة بالعمل مباشرةً، إذ إنّ حالات الوفيات كانت تزداد يومًا بعد يوم، وفي تلك الفترة بدأت الدول المتقدّمة بتجارب على اللقاحات، الأمر الذي قضّ مضجع التاجرَين، فراحا ينشران الأفكار المضادّة عن الخطر القادم إلى الشرق عبر هذه اللقاحات، وأنّ هذه الأمّة مستهدفة والمستهدِفون يحاولون سرقة أدمغة البشر والتحكم بمصائرهم عبر شريحةٍ صغيرة تُبثّ في اللقاح.
- الأمور تتعقّد، إنّ اللقاحات بدأت بالانتشار. قال تاجر الخمر (التائب).
- إنّنا أمّة مستهدَفة، احفظ هذه الجملة جيّدًا، لعلّها تؤخّر في إفلاسنا. ردّ "أبو سبّحة".
- ولكن، ماذا لو سألني أحدٌ بما نحن مستهدَفون؟ يا رجل ماذا لدينا لكي يستهدفونه؟ قال (التائب).
- همممم! قل لهم أيّ شيء، يستهدفون أدمغتنا، لم يكتفوا بهجرة الأدمغة، يريدون استهداف ما بقي لدينا.
- بربّك! انظر إلى رأسك المربّع هذا، والله لو شققته لوجدت عنكبوتًا يغفو بداخله. يا رجل لم تستخدم دماغك منذ وُلدت! ماذا يسرقون منه؟ قهقه (التائب) وهو يردّد كلماته، فاستشاط "أبو سبحة" غيظًا، وقال:
- ما شاء الله على دماغك، "أينشتاين" الأبله!
وحين بدأ الناس بالميل إلى أخذ اللقاح، بدأت الشركة بالتراجع، وشبّ الخلاف بين مؤسّسَيها، وانتهى الخلاف إلى فضّ الشراكة، وانتقلت الشركة إلى شركتين متنافستين في مجتمعٍ تحكمه التناقضات بين مصدّقٍ للعلم ومسحورٍ بالدين فقط.
بدأت الحياة بالعودة تدريجيًّا، وكان الخلاف يزيد أكثر فأكثر إلى أن فاض الكأس بما حمل وتسرّبت منه مياه الفضيحة.
- هل تشترون الكفن من سكّير؟ إنّه يبيع ويشتري في دينكم ثمّ يصرف ماله على الخمر. قال "أبو سبحة" لجمعٍ من النّاس.
وفي زاويةٍ أخرى وقف (التائب) يقول:
- هذا اللعين "أبو سبحة" يبيعكم كلام الله، إنّه يسبّح بحمد الدولار لا الله، بئس التاجر هو، اسألوني أنا عنه.
ارتفعت الفضائح في المنطقة، بتنا ننام على فضيحة ونصحو على أُخرى، بل بتنا ننتظر صباح كل يوم ما سنسمعه عن اللذين كانا أقرب الناس.. اشتدّت نبرة الخلاف واختلطت الأحاديث بعضها ببعض حتى التقى الرجلان وجهًا لوجه في يوم أحد، تجمهر الناس حولهما وبدأت المعركة، لطمةٌ من هذا وأخرى من ذاك، ركلةٌ من هذا ورفسةٌ من ذاك حتى سالت الدماء، والناس متجمهرون يصفّقون، يضحكون على عهدٍ انقضى بين كاذبَين ثالثهما الفضيحة.

تأمّلات في "أدب الفضائح" و"الثقافة الفضائحية"
د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، كلية الآداب ـ جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر)
تعريف "أدب الفضائح"
يُقصد بـ "أدب الفضائح" ذلك الاتجاه الأدبي الذي يقوم على كشف المستور من حياة الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، فيتناول ما يُعتبر عادة من المنطقة المحرّمة أو المسكوت عنه، سواء كان ذلك في السياسة أو الدين أو الجنس أو العلاقات الاجتماعية، ويعرضه بأسلوب صادم أو مثير للجدل.
خصائصه:
1. يركّز على الاعتراف والبوح وكشف الأسرار الشخصية أو الاجتماعية.
2. يوظّف الفضيحة كأداة فنية أو نقدية لفضح الفساد أو النفاق الاجتماعي أو السياسي.
3. يثير الدهشة والصدمة لدى المتلقي ليحرك تفكيره أو يثير نقاشًا عامًا.
4. قد يتراوح بين "الصدق الفني" والبحث عن "الإثارة والربح التجاري".
نماذجه:
في الغرب، ارتبط هذا الأدب بسير المشاهير واعترافاتهم (مثل مذكّرات السياسيين أو الفنانين التي تكشف فضائحهم).
وفي الأدب العربي، نجد إشارات له في بعض الاعترافات الأدبية أو السير الذاتية الجريئة أو الروايات التي تكشف فساد السلطة أو المجتمع (مثل بعض أعمال صنع الله إبراهيم، أو "عمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني).
إذًا، هو أدب يعتمد الفضيحة وسيلةً لاكتشاف الحقيقة أو نقد الواقع، لكنه قد ينزلق أحيانًا إلى الابتذال أو الإثارة المجانية إنْ غابت عنه القيمة الفكرية أو الجمالية.
الثقافة الفضائحية
أما "الثقافة الفضائحية" فهي أوسع من الأدب، إذ تشير إلى ظاهرة اجتماعية وثقافية يعيشها المجتمع حين تصبح الفضيحة سلعة جماهيرية تُستهلك في الإعلام ووسائل التواصل والدراما.
سماتها:
1. تطبيع الفضيحة: أي جعلها أمرًا عاديًّا ومشوقًا، يتابعه الناس كما يتابعون الأخبار العادية.
2. تراجع الخصوصية، وانتشار الفضول العام في معرفة أسرار الآخرين.
3. هيمنة الإعلام الرقمي الذي يحوّل الخطأ أو الخطيئة إلى حدث جماعي.
4. تحويل القيم: يصبح الإنسان معروفًا بفضيحته أكثر من إنجازه، وتتحوّل الأخلاق إلى مادة للسخرية أو التندر.
ويُطلق على هذه الظاهرة أيضًا اسم: "ثقافة الفضيحة" أو "ثقافة العري" أو "ثقافة البوح الفجّ".
وهي من ملامح ما بعد الحداثة، حيث تتراجع القيم الكبرى أمام سحر الصورة والفضيحة والإثارة.
العلاقة بين المفهومين:
أدب الفضائح يمثّل الجانب الإبداعي والفني من الظاهرة. أما الثقافة الفضائحية فتمثّل الإطار الاجتماعي والإعلامي الذي يرحّب ويحتفي بالفضيحة. فالأول يُنتج الفضيحة من أجل النقد أو الفن، أما الثانية فتستهلكها من أجل المتعة أو السيطرة.
من ثقافة الحياء إلى زمن الفضيحة
يُقال إنَّ لكل عصرٍ عنوانه البارز، وإذا كان القرن العشرون قد وُصف بأنه "عصر القلق"، فإنَّ القرن الحادي والعشرين هو بلا شك "عصر الفضيحة"، إذ لم يعد الإنسان بحاجة إلى وقت طويل ليعرف ما جرى في أقاصي الأرض من أحداثٍ فاضحة، سياسية كانت أو فنية أو أخلاقية، فالعالَم اليوم يعيش على إيقاع الانكشاف الدائم.
لقد تحوَّلت "الفضيحة" إلى صناعة عالمية لها مروِّجوها ووسائلها ومتابعوها، وصار "الجهر بالسوء" مشهدًا يوميًّا في الإعلام والمسلسلات والأفلام ومواقع التواصل، حتى غدتْ الفضيحة سلعةً ثقافية رائجة تُروَّج وتُستهلك بلا ضوابط.
الفضيحة في التراث العربي: من الهجاء إلى نقد المجتمع
لم يكن التراث العربي خاليًّا من الفضيحة بوصفها أداة نقد أو تعبير عن الصراع الإنساني، ففي الجاهلية كان الشعر الهجائي وسيلةً لإلحاق العار بالقبيلة أو الفرد، وكان الهجّاء يُعَدّ أخطر من السيف؛ لأنَّ الكلمة قد تقتل المعنى والشرف معًا، وقد تجلّى ذلك في معارك الشعراء الكبار في العصر الأموي مثل: جرير والفرزدق والأخطل والراعي النميري.
وفي العصر العباسي، ظهرت نصوصٌ تتعامل مع الفضيحة بجرأةٍ أدبية، لا بوصفها شهوة في الكشف، بل كآليةٍ فكرية تسعى إلى تعرية الزيف الاجتماعي والسياسي، فنقرأ في كتب الأدب مثل: الأغاني والعقد الفريد والبيان والتبيين والبخلاء قصصًا وأخبارًا تتضمن فضائح الخلفاء والوزراء والفقهاء والشعراء، لكنها لم تكن تُروى دائمًا بدافع التشهير، بل أحيانًا لتوثيق السلوك الإنساني بكل ما فيه من ضعفٍ وهشاشة.
حتى في التصوّف الإسلامي، نجد أدبًا يتحدث عن "فضيحة النفس"، أي كشف سترها أمام الله، بوصف ذلك الفضح نوعًا من التطهير الروحي، فالفضيحة في هذا السياق ليست سقوطًا أخلاقيًّا، بل كشفًا نورانيًا للباطن المظلم. وهكذا، لم يكن التراث يخلو من "الفضيحة"، لكنه كان يتعامل معها بحسٍّ تربوي وجمالي وروحي، لا بشهوة إعلامية.
الثقافة الفضائحية في العصر الحديث: من النقد إلى التلذّذ
أما اليوم، فقد انتقلت الفضيحة من النص الأدبي إلى المجال العام، ومن أداة نقد إلى أداة استهلاك. لقد أعادت التكنولوجيا والإعلام تشكيل مفهوم "الفضيحة"، فصارت تُبثّ لحظةَ وقوعها بالصوت والصورة، وأصبح الجمهور شريكًا فاعلًا في إنتاجها وتداولها وتحليلها.
وهكذا نشأت ما يمكن تسميّته بـ "الثقافة الفضائحية"، أي منظومة فكرية وإعلامية تقوم على كشف المستور وتضخيم الزلات وتبرير التطفّل باسم حرية الرأي أو الحق في المعرفة.
ومن الملاحظ أنَّ الإنسان المعاصر، رغم شعارات التقدُّم، يعيش نوعًا من الفضول الفضائحي، فهو يتابع الأخبار التي تفضح أكثر ممّا يتابع ما ينهض به.
لقد أصبحت الفضيحة الاجتماعية تسليةً جماعية، والفضيحة السياسية مادة إعلامية يومية، والفضيحة الفنية موسمًا للشهرة، والفضيحة الأخلاقية وسيلة للانتقام أو التشهير.
وهكذا، تحوَّلت الفضيحةُ من كشفٍ للحقيقة إلى تسلية تُغذّي الغرائز وتُميت الضمير، ومن نقدٍ اجتماعي إلى ابتذالٍ ثقافي يهدم الخصوصية ويُكرِّسُ التفاهة.
الفضيحة بين الهدم والكشف
يمكن النظر إلى الفضيحة من زاويتين:
1. الفضيحة الهدَّامة: وهي التي تسعى إلى تحطيم صورة الآخرين وتشويههم، دون غاية معرفيّة أو أخلاقية، وغالبًا ما تنبع من الحقد أو حب الشهرة.
2. الفضيحة الكاشفة: وهي التي تفضح الفساد وتُسقط الأقنعة وتدعو إلى الإصلاح، كما نرى في بعض الأعمال الأدبية الحديثة التي استخدمت الفضحَ الفني لكشف تواطؤ السلطة والمجتمع، مثل روايات نجيب محفوظ، وصنع الله إبراهيم، وعلاء الأسواني، وغادة السمان، وغيرهم.
فـ "أدب الفضيحة" في هذه الحالات يصبح فنًّا إصلاحيًا، لا فضيحةً من أجل الفضيحة، لأنه يُعرّي الزيف ليُعيد للإنسان وعيه وكرامته.
لماذا يعشق الناس الفضائح؟
قد يعود هذا العشق إلى دوافع نفسية واجتماعية مركبة، منها:
- الرغبة في المقارنة والتفوق الزائف: حين يرى الفرد سقوط الآخرين يشعر بتبرئة ذاته.
- الفضول الإنساني القديم في معرفة الأسرار.
- الملل الروحي في زمن يفتقر إلى المعنى، فيتحوّل البحث عن الفضيحة إلى بحثٍ عن الإثارة.
- هيمنة الإعلام الذي يصنع من الحدث البسيط دراما ضخمة تُلهب المشاعر وتُغري بالمتابعة.
نحو ثقافة السّتر لا ثقافة الفضيحة
لقد عرف الإنسان الفضيحة منذ القدم، لكنَّ أخطر ما نعيشه اليوم هو تحوُّلها إلى ثقافة، أي إلى نمط تفكير وسلوكٍ جماعي.
ولعلّ الواجب الأخلاقي والثقافي في زمن الانكشاف هو إحياء ثقافة السَّتر، لا إخفاء الفساد، بل ستر الضعف الإنساني والتمييز بين النقد المسؤول والفضيحة العابثة.
فالمجتمع الذي يتلذّذ بفضائح الآخرين يُفقد نفسه المعنى والحياء، أما المجتمع الذي يواجه الفساد بعقلٍ راشدٍ وضميرٍ يقظٍ فهو الذي يصنع الفضيحة النبيلة: فضيحة الحق في وجه الباطل.
أدب الفضائح في الرواية العربية المعاصرة: قراءة في رواية "عمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني
يسعى هذا الجزء من المقال إلى تحليل ظاهرة أدب الفضائح في الرواية العربية المعاصرة من خلال أنموذج تطبيقي هو رواية "عمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني، بوصفها عملاً روائيًّا مثَّل نقلة نوعية في المشهد السردي العربي لما حمله من جرأة في الطرح، وكشف للمسكوت عنه سياسيًّا واجتماعيًّا وجنسيًّا، ويهدف البحث إلى بيان الحدود الفاصلة بين "الفضيحة" كأداة فنية نقدية و"الفضيحة" كمادة تجارية إعلامية، مع تحليل البنية السردية ودلالاتها الأخلاقية والاجتماعية.
تُعدُّ الفضيحة في السياق الثقافي المعاصر واحدة من أكثر الظواهر حضورًا وتأثيرًا في الإعلام والأدب على السواء، وإذا كانت الثقافة الفضائحية قد وُلدت في حضن الإعلام المرئي والمكتوب، فإنَّ "أدب الفضائح" ظهر كاستجابة فنيّة تسعى إلى إعادة صياغة الواقع المنفجر بالفساد والنفاق والازدواجية.
وقد مثّلت رواية "عمارة يعقوبيان" (2002) علامة فارقة في هذا السياق، إذ كشفت عورات المجتمع المصري في مرحلة ما بعد الانفتاح الاقتصادي، وقدّمت بانوراما من الفساد السياسي، والانحراف الأخلاقي، والتفاوت الطبقي، مستخدمةً أدوات أدب الفضيحة لتوليد الصدمة وإيقاظ الضمير الجمعي.
مفهوم "أدب الفضائح" وإشكالية التلقي
يُعرَّف "أدب الفضائح" بأنه الكتابة التي تعتمد الكشف والبوح وتفكيك المحظورات (السياسية، الجنسية، الدينية، أو الأخلاقية) بهدف مساءلة الواقع وكشف تناقضاته. ويتميّز عن الكتابة الإثارية بكونه يمتلك وظيفة نقدية لا تسويقية، إذ يفضح لا ليُهين، بل ليُنبّه ويوقظ.
غير أنَّ التلقي العربي لمثل هذه الأعمال غالبًا ما يتأرجح بين قراءتين متعارضتين:
1. قراءة أخلاقية محافظة ترى في الكشف عن العيوب خرقًا لقيم الحياء والتقاليد.
2. وقراءة نقدية تحديثية تعدُّ الفضيحة وسيلة لتحرير الخطاب من الرقابة والكبت الاجتماعي.
وبين هذين الحدّين تتحرك تجربة "الأسواني"، جامعًا بين الجرأة التعبيرية والنقد الاجتماعي اللاذع.
"عمارة يعقوبيان" أنموذجًا لأدب الفضيحة الاجتماعية والسياسية
تتّخذ الرواية من عمارة قديمة في وسط القاهرة مسرحًا سرديًّا يرمز إلى تاريخ مصر الحديث بكل طبقاته وتناقضاته؛ فالعمارة ليست مجرد مكان، بل استعارة كبرى للدولة والمجتمع.
من خلال شخصيات متعددة (زهرة، طه الشاذلي، زكي الدسوقي، بثينة، الحاج عزام، وغيرهم)، يقدّم الكاتب خريطة أخلاقية تتقاطع فيها الفضائح الخاصة بالفساد العام.
1. الفضيحة السياسية: تعرية فساد السلطة
من أبرز فضائح الرواية تورّط رجال الأعمال والسلطة في علاقات مشبوهة تجمع المال بالسياسة بالدين.
شخصية الحاج عزام تمثل أنموذجًا لرجل الأعمال الذي يستخدم الدين غطاءً للثراء الحرام، ويمارس النفاق الاجتماعي عبر زواج المتعة واستغلال النفوذ.
يكشف "الأسواني" عبر هذه الشخصية عن آلية الفساد في النظام المصري القديم، حيث تتحول السلطة إلى سوق مفتوحة للبيع والشراء.
وهكذا تتحوّل "الفضيحة" إلى وسيلة لتعرية خطاب السلطة الزائف، وليس إلى تشهير شخصي.
2. الفضيحة الاجتماعية: انهيار منظومة القيم
شخصية "بثينة" تُجسّد مأساة الطبقة الفقيرة المقهورة، حيث تضطر البطلة إلى تقديم تنازلات أخلاقية كي تعيش.
في علاقتها بـ "زكي بك الدسوقي"، تتداخل مشاعر الحاجة بالحب وبالانكسار الاجتماعي، وهنا تتبدّى الفضيحة بوصفها نقدًا بنيويًّا للفقر والتفاوت الطبقي، وليست إدانة أخلاقية للمرأة.
"الأسواني" يستخدم الواقعية الفاضحة ليعرِّي آليات القهر الاقتصادي والاجتماعي التي تدفع الإنسان إلى السقوط.
3. الفضيحة الجنسية: المسكوت عنه في الجسد
شخصية "حاتم رشيد"، الصحفي المثقف المثليّ، تفتح ملفًا محرَّمًا في الأدب العربي: المثلية الجنسية.
يقدم الكاتب الشخصية بإنسانية وتعقيد نفسي، لا بوصفها رمزًا للانحراف، بل كنتاج لتشوّهات اجتماعية وتربوية، وبهذا يقدّم "الأسواني" الفضيحة كأداة تفكيك للمحرَّم وكشفًا لمنطقة مظلمة في وعي المجتمع العربي الذي يُمارس الإدانة دون فهم.
واستخدامه لهذه الثيمة يعكس جرأة غير مسبوقة في الرواية المصرية، لكنها لا تخلو من جدل حول حدود الحرية الأدبية.
البنية السردية وتقنيات الكشف
تعتمد الرواية على تعدّد الأصوات (البوليفونية) بحيث تتحوّل كل شخصية إلى مرآة فاضحة لوجه من وجوه المجتمع:
- السارد العليم يتيح رؤية بانورامية تربط بين الحكايات الجزئية والكل الاجتماعي.
- الحوار الداخلي والاعتراف وسيلتان لخلق صدمة سردية تنقل الفضيحة من الخارج إلى الداخل (من فضيحة اجتماعية إلى أزمة وجودية).
- اللغة الواقعية المباشرة تكشف دون تجميل، لكنها لا تنزلق إلى الابتذال، مما يجعل النص يتوازن بين الجمال والجرأة.
الفضيحة بوصفها خطابًا نقديا
تُحوِّل الرواية الفضيحة إلى منهج في التفكير، لا مجرد حكاية فاضحة، فهي تُسائل القيم الزائفة التي تُخفي الفساد تحت ستار التدين أو الوطنية، وتفضح تحالف المال بالسلطة، وازدواجية الخطاب الاجتماعي الذي يدين الفقراء ويتسامح مع فساد الأغنياء. ومن ثم، فالرواية تمارس نوعًا من التطهير الأرسطي (Catharsis) عبر الصدمة، إذ تُجبر القارئ على مواجهة واقعه بلا تجميل.
من أدب الفضيحة إلى الثقافة الفضائحية
بعد نجاح الرواية الكبير وتحويلها إلى فيلم سينمائي، دخل النص إلى دائرة الثقافة الفضائحية الجماهيرية: تحوّل النقاش من نقد الفساد إلى جدل حول "المشاهد الجريئة". وأصبح الاهتمام الشعبي بالفضيحة الجنسية أكبر من الفضيحة السياسية أو الاقتصادية.
وهنا يتحوّل العمل الأدبي من نصّ نقدي إلى منتَج إعلامي يُستهلك فضائحيًّا. وهي ظاهرة خطيرة تكشف كيف يُفرغ الإعلام المعاصر العمل الأدبي من مضمونه النقدي لصالح الإثارة السطحية.
دلالات نقدية وفكرية
1. أدب الفضائح عند "الأسواني" ليس هدفه الهتك بل الفضح، والفرق بينهما كبير، فالفضح فعل نقدي؛ أما الهتك فهو فعل تشهيري.
2. الرواية تضعنا أمام سؤال الحداثة الأخلاقية: هل يحق للفن أن يقول كل شيء؟ وما الحدّ بين حرية التعبير وواجب الذوق العام؟
3. أثبتت الرواية أنَّ كشف المسكوت عنه شرط للتطور الاجتماعي، وأنَّ التستّر هو وجه آخر للفساد.
4. لكنها في الوقت ذاته نبّهت النقاد إلى خطر تحوُّل الأدب إلى سلعة إعلامية تبيع الفضيحة بدل أن تفضح الزيف.
إن رواية "عمارة يعقوبيان" تقدّم أنموذجًا متقدّمًا لأدب الفضيحة النقدي، الذي يوظف الكشف والاعتراف والبوح لتفكيك البنية العميقة للفساد الاجتماعي والسياسي، دون أن يغرق في الإثارة المجانية، وقد نجح "علاء الأسواني" في أن يجعل من الفضيحة وسيلة فنية للتعرية والتنوير، لا أداة للابتذال.
غير أنَّ تحويل الرواية إلى مادة استهلاكية إعلامية بعد نشرها يُبرز الحاجة إلى وعي نقدي جديد يميّز بين الأدب الذي يفضح من أجل الإصلاح والثقافة التي تستهلك الفضيحة من أجل الترفيه.
ويمكن للقارئ مراجعة بعض المصادر التي توسّع مداركه وتفتح له آفاق المعرفة حول هذا الموضوع المهم في حياتنا المعاصرة، ومنها:
1. علاء الأسواني، عمارة يعقوبيان، القاهرة: دار ميريت، 2002م.
2. ميخائيل باختين، مشكلات شعرية دوستويفسكي، ترجمة يوسف حلاق، دمشق: دار طلاس، 1992.
3. بيير بورديو، عن التلفزيون، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، الدار البيضاء: دار توبقال، 2001م.
4. رولان بارت، لذة النص، ترجمة رضوان الشهيد، بيروت: دار الطليعة، 1983 م.
5. عبد الله الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، بيروت: المركز الثقافي العربي، 2005 م.
6. صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992.
وبوصفنا مجتمعًا عربيًّا وإسلاميًّا ينبغي أن نوضّح موقف الإسلام من أدب الفضائح ومن الثقافة الفضائحية:
لقد شهدت الثقافة الإنسانية في العصور الحديثة بروز ما يُعرف بـ "الثقافة الفضائحية"؛ ثقافةٍ تُعلي من شأن الفضيحة وتُغري بتداولها، حتى غدت مادةً أساسية للإعلام، والرواية، والفن، ومواقع التواصل الاجتماعي، وامتد هذا التأثير إلى الأدب فيما يُسمى بـ "أدب الفضائح"، الذي يستدرج القارئ إلى عوالم الخطيئة والانكشاف والاعتراف العلني، باسم "الجرأة" و"الصدق الفني".
ولكن حين ننظر إلى هذه الظاهرة من زاوية الفكر الإسلامي، فإننا نجد تصوّرًا مغايرًا يقوم على قيم الستر والحياء والإصلاح، ويقيس الكلمة الأدبية بميزان المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية.
مفهوم أدب الفضائح والثقافة الفضائحية
يقوم "أدب الفضائح" على كشف العيوب الخاصة للأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات، سواء في السياسة أو المجتمع أو الجنس أو الدين، وغالبًا ما يتّخذ طابعًا استعراضيًّا مثيرًا للفضول، يهدف إلى الصدمة أو التشويق أو المكسب التجاري.
أما "الثقافة الفضائحية" فهي المناخ الفكري والإعلامي الذي يُشجع على تداول الأسرار والفضائح، ويجعل من التعرية والفضح نوعًا من التسلية الجماعية، فيتحول الانتهاك الأخلاقي إلى "ترفيه"، والسقوط الإنساني إلى "خبر عاجل".
الموقف الأخلاقي للإسلام من الفضيحة والستر
يقوم المنهج الإسلامي على حماية الكرامة الإنسانية، وصيانة الأعراض، واحترام الخصوصيّة، ولذلك جعل الإسلام السّتر على الناس عبادة، ونهى عن تتبّع العورات أو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" (النور: 19). وفي الحديث الشريف، قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة" (رواه مسلم).
فالإسلام لا يكتفي بالنّهي عن نشر الفضيحة، بل يُدين حتى حبّ إشاعتها، أي الرغبة في تداولها أو التلذّذ بسماعها، ومن هنا يتعارض منطق "الثقافة الفضائحيّة" تمامًا مع روح الإسلام التي تجعل الستر قيمة عليا، والإصلاح هدفًا لا التشهير.
حرية التعبير وحدودها في الأدب الإسلامي
الإسلام لا يُعادي الحرية الفنية أو الأدبية، بل يقرّها في إطار المسؤولية الأخلاقية، فالقرآن نفسه كشف فساد المجتمعات، وفضح الطغيان، لكنه لم ينزلق إلى التشهير بالأفراد أو الخوض في أعراضهم، بل اتّخذ من النقد الأخلاقي وسيلة للإصلاح، ومن الرمز والموعظة أسلوبًا للتأثير. يقول تعالى في وصف وظيفة الكلمة: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ" (إبراهيم: 24).
فالكلمة في التصوّر الإسلامي أمانة ومسؤولية، لا يجوز أن تُستخدم في هتك الستر أو إثارة الغرائز، لأنَّ ذلك يهدم البناء القيمي للمجتمع، ويحوّل الأدب من رسالة تهذيب إلى أداة انحلال.
بين فضح الفساد وكشف الحقيقة
قد يُبرّر بعض الكُتّاب ما يسمى بـ "أدب الفضائح" بأنه نوع من فضح الفساد وكشف الحقيقة، وهذا التبرير مقبول جزئيًّا إذا التزم الكاتب بضوابط النقد النّزيه، الذي يهدف إلى الإصلاح الاجتماعي لا إلى التشهير أو الإثارة.
وقد مارس الإسلام نفسه "الفضح الأخلاقي" للطّغاة والمُرابين والمنافقين، لكن دون تسفيهٍ أو امتهان أو خوضٍ في خصوصيات الناس، فالقرآن الكريم كشف النفاق كظاهرة اجتماعية، لكنه لم يُسمِّ المنافقين بأسمائهم، مراعاةً للسّتر وحفظًا للوحدة العامة.
"الثقافة الفضائحية" في ضوء القيم القرآنية
تنبع "الثقافة الفضائحية" من نزعة استهلاكية تجعل الإنسان سلعة تُباع أسراره في السوق الإعلامي، بينما يربّي الإسلام الإنسانَ على الحياء والوقار و"كفّ الأذى".
ففي حين يقدِّس الغرب "الفضيحة الصحفية" باعتبارها انتصارًا للشفافية، يرى الإسلام أن الفضيحة تُميت الضمير وتقتل الثقة، وتُشيع الريبة بين الناس، فينهار النسيج الاجتماعي الذي يقوم على الستر والاحترام.
ولهذا قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورتَه حتى يفضحه في بيته" (رواه الترمذي).
أدب الفضائح في ميزان النقد الإسلامي
حين نقرأ بعض الروايات أو المذكرات التي تُسمّى: "اعترافات" أو "كشف المستور"، نجد أنها تُغري القارئ بالفضيحة أكثر ممّا تثير وعيه بالخطأ أو التوبة، فتصبح الفضيحة غاية في ذاتها، لا وسيلة للإصلاح.
أما في الأدب الإسلامي الحق، فإنَّ الاعتراف الصادق هو الذي يؤدّي إلى التطهير لا التشهير، كما في تجارب الشعراء الصوفيين الذين كشفوا عيوب نفوسهم لا للتسلية، بل للتوبة والنقاء.
إنَّ موقف الإسلام من أدب الفضائح والثقافة الفضائحية يقوم على تحكيم الأخلاق في الفن، وعلى الموازنة بين حرية التعبير وحفظ الكرامة الإنسانية.
فالأدب في نظر الإسلام ليس منبرًا للفضيحة، بل منارة للهداية والتنوير، وسلاحًا ضد الفساد دون أن ينزلق إلى التشهير أو الانحلال.
إنّ السّتر قيمة حضارية، والفضيحة انحطاط قيمي، وبينهما يُقيم الإسلام ميزانه الدقيق، الذي يربط الكلمة بالضمير، والفن بالمسؤولية، والحرية بالإنسانية.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

خبر عاجل.. فضيحة!
سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
والآن فضيحة من العيار الثّقيل! تشخص أبصارنا، وتسبقنا آذاننا نحو صوت المذياع، الحماسة تتآكلنا وكأنّنا جمر بانتظار نفخة شعلة. لا يهم ما هي الفضيحة، ولسنا نمتلك مكيالًا يحدّد ثقلها، لسنا نهتمّ أصلًا بنوعيّة الفضيحة، المهم أنّ هناك حدثًا جديدًا يكسر روتيننا اليومي، خبر يهزّ إحساسنا بالملل ليفجّر طاقاتنا المكبوتة، ونحن شعب بطبعنا يحبّ (اللألأة)، وها هو خبر ساخن طازج يملأ جلسات النّميمة الشعبيّة، ويحرّك عجلة التّحليلات الاستراتيجيّة من على الشّرفات.
هل خانت "ميني ماوس" "ميكي"؟ هذا الثّنائي الذي يعكس الصّورة المثاليّة لمجتمع العلاقات السّعيدة الذي نحتذي به، ونتّخذه سبيلًا في تطلّعاتنا العاطفيّة، هل هو أيضًا تعرّض للخيانة؟ أليست ميني أظرف الكائنات الكرتونيّة وأكثرها رومنسيّة؟ كيف لها أن ترمي بنا في صدمات الخيانة؟ واو! حتى "ميني" ترتدي قناع النّعومة لتداري الوحش الكامن داخلها. ليست سهلة هذه الأنثى، هل تعرفون من تلك التي تشبهها؟ هي شبيهة بعض النّساء المكّللات بمزايا تبيح لهنّ اللّامبالاة، وهو يشبه أمثاله من الذّكور المغيّبين عن الحقيقة، وبالعكس. وليست الخيانات مقتصرة على فئة من دون أخرى، والأخبار، مفبركة أم لا، تشكّل دسامة على مائدة (اللّألأة).
في الحقيقة ليس مهمًّا إن تحقّق فعل الخيانة بينهما أم لا، لم يعد مهمًّا إثبات براءتها وشرفها وعفّتها، كل هذا غير مهم، المهم الآن، ركوة قهوة والقليل من البزر، وهيّا يا صديقتي لبعض الدّردشة القصيرة، (نميمة عالخفيف). وعلى طريقة "سعيد صالح"، ممثّلًا شخصيّة "مرسي الزّناتي" في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، حين قال: "قاعد أنا وأمي على دودودو، فلانة عملت، وفلانة سوّت، وفي الآخر نقول ملناش دعوة، دعوا الخلق للخالق!".
هل هذه الجلسات عيبٌ فينا؟ هل نحن السلّاخون الذين ننتظر وقوع البقرة؟ ربّما البعض يراها هكذا، فبعض النّاس بطبعهم يوجّهون سلاحهم صوب المستضعفين، ليس لأنّهم الأقوى، بل لأنّهم أُنقذوا من عالم الفضيحة، وما زال كسبهم لصّرة من السّتر يغطّي تكاليف حياتهم. ولكنّي أراها من زاوية مختلفة تمامًا، ففي المسرحيّة ذاتها، هناك مشهد ربّما لم يفشل لحظة في إطلاق قهقهاتنا الممزوجة بالألم، لأنّه ببساطة يمثّل واقعًا عالقًا في كينونتنا الإنسانيّة، حين كسر "مرسي الزّناتي" يده، وقال: "سمعتو إذاعة البي بي سي؟ مرشات عسكريّة وقرآن، وراح المذيع واقف على حيله وقال: مرسي ابن المعلّم الزّناتي اتهزم يا رجالة".
ربّما يكون المشهد مضحكًا، ولكن إذا تعمّقنا في رمزيّته، لوجدناه إسقاطًا للفضائح العسكريّة على هزيمة "مرسي" الحياتيّة، فشله أمام مدرّسته كان بالنّسبة إليه يوازي سقوط دولة وانهزام جيشها أمام العدوّ، وكم من الفضائح العسكريّة وازنت انكساراتنا في حدودنا الدّاخليّة.
وهذا تمامًا ما نقوم به في جلسات (اللألأة) وتبنّي الفضيحة، بغضّ النّظر عن صحّتها، فنحن لا نريد الحقيقة بقدر ما نريد أن نُشعر أنفسنا بالرّضى نتيجة المقارنة. نحن في الحقيقة نطبطب على جراحنا، ونأخذ من الفضيحة حجّة نداري بها مأساتنا.
إذ ليس الهدف متابعة الفضائح بقدر ما هو مقارنة حقيقة محيطنا مع هذه الأخبار، لنيل الرّضى، وربّما لأنّ البعض لا يرى في حياته إلّا الزّوايا السوداويّة، فتأتي الفضيحة الغيريّة لتعكس بعض النّور الذي لم يكن ليراه وحده.
فهل الشّماتة من نصيب المفضوحين؟ ربّما، فالبعض ينتظر أن يرى نظرة الانكسار في عين الإنسان الذي انتهى رصيد السّتر عنده، وليس بالضّرورة بسبب الكره، وإنّما فقط لينظر في المرآة ويقول في نفسه: أنا أفضل منه!

"الفضيحة".. مصطلح في مرآة الزمن
سامر المعاني (كاتب من الأردن)
"الفضائح" هذا المصطلح القديم الجديد، الذي دائما ما يلفت الانتباه وشغف وفضول المعرفة، يتصدّر البيئات المغلقة والأكثر فقرا وجهلا وتعرف الفضائح تلك اللحظات التي تكشف عن عوراتنا وتظهر سوءاتنا، كانت دائمًا موضوعًا مثيرًا للجدل والنقاش في مختلف العصور. من قديم الزمان إلى وقتنا الراهن، ظلت الفضائح تلاحق البشر، وتثير في نفوسهم مشاعر متباينة بين الدهشة والاستنكار والشفقة وأحيانا الحقد والكراهية.
في الماضي، كانت الفضائح تُعتبر أمرًا خطيرًا يمسّ شرف العائلة والمجتمع، وتؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى الطرد من المجتمع أو حتى الانتقام. كانت الفضائح تُخفى وتُقمع، ويُكتم أمرها حتى لا تنتشر وتؤذي سمعة الأفراد والعائلات. لكن مع تقدّم المجتمعات وتغيّر القيم والمعايير، تغيرت طريقة التعامل مع الفضائح.
في وقتنا الراهن، أصبحت الفضائح تُنشر وتُذاع بسرعة فائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتحوّل إلى فضائح عامة يشارك فيها الجميع. لم تعد الفضائح مقتصرة على الطبقات الاجتماعية المعينة، بل أصبحت تشمل جميع فئات المجتمع، من السياسيين والفنانين والكتاب إلى الرياضيين ورجال الأعمال. وأصبحت الفضائح تُنشر وتُذاع دون رقيب أو حسيب، وتؤدي إلى انهيار الكثير من الأقنعة الزائفة والواجهات الاجتماعية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تغيرت طبيعة الفضائح أم أن طريقة التعامل معها هي التي تغيرت؟ هل أصبحنا أكثر انفتاحًا وشفافية أم أننا أصبحنا أكثر انغماسًا في الفضائح والانتهاكات؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ليست سهلة، لكن يمكن القول إن الفضائح ظلت دائمًا جزءًا من الطبيعة البشرية، وما تغيّر هو طريقة تعاملنا معها.
من ناحية أخرى، أثّرت التكنولوجيا الحديثة على طريقة انتشار الفضائح، حيث أصبحت الأخبار تنتشر بسرعة فائقة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل من الصعب السيطرة على انتشار الفضائح أو إخفائها. وأصبحت الفضائح تُنشر وتُذاع دون رقيب أو حسيب، وتؤدي إلى مضاعفات وتأويلات وتصفية حسابات في كثير من الأحيان.
إن الفضائح ظلت دائمًا جزءًا من التاريخ البشري، لكن المهم هو كيفية التعامل معها، وهل نتعلم منها أم أننا سنظل نكرر الأخطاء نفسها دون توقف؟ وهي تختلف مع مرور الوقت من مجتمع إلى آخر ومن ديانة وبيئة إلى أخرى.. فهل الفضيحة تكمن في الخيانة والسرقة والنصب والاغتصاب وغيرها من الجرائم، أم تكمن أيضا في سلوكيات يتغير مفهومها بعامل الزمن والثقافة والمجتمع؟
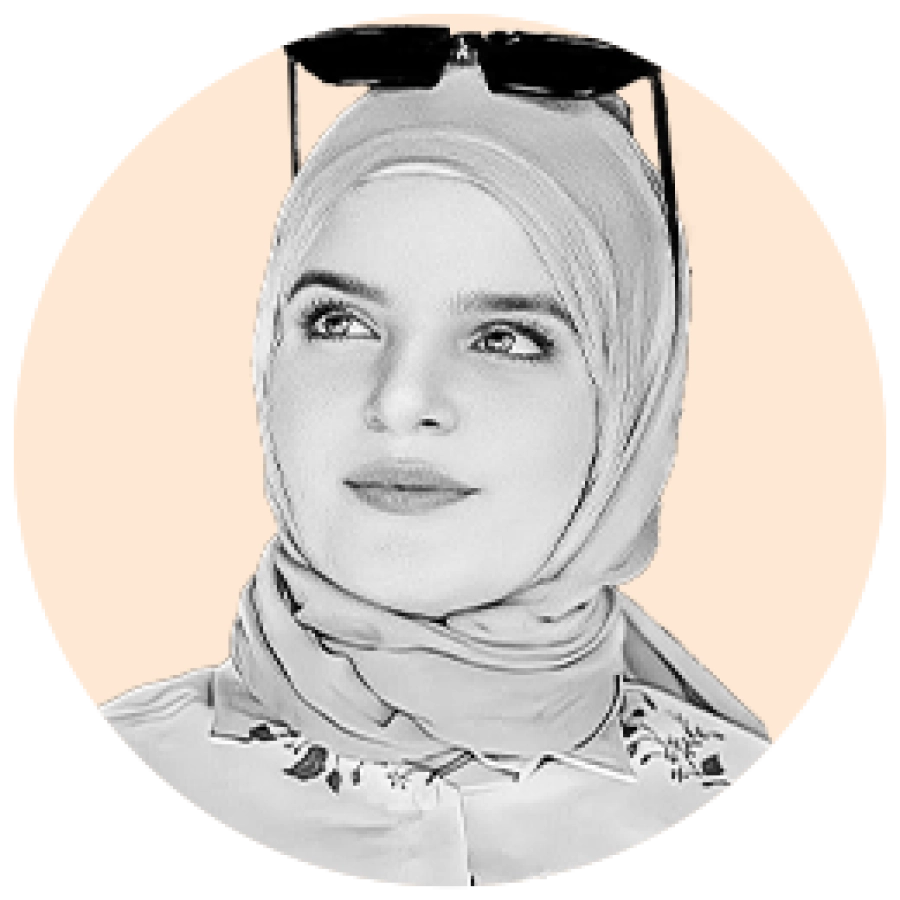
ما بين الانكشاف والسكوت
عدوية موفق الدبس (باحثة وكاتبة سورية - لبنان)
ترتدي ثوبًا أسود، ترفع رأسك بثباتٍ مصطنع، وتشُدّ عقدة الحاجبين كمن يعلن الحرب على الدموع، بنظراتٍ حادّة جامدة لا تسمح لأيّ تحرّكٍ أن يفضحك. لكن أول كلمة عزاء تسقط كسهمٍ في صدرك، فتهتزّ جدران الثبات، وتنهار الدموع لتعلن الهزيمة في معركة التماسك.
أن تقف شامخًا وسط الحضور، تلاحقك أضواء الفلاش كعيونٍ متطفّلة، تلاحقك الأسئلة المحرجة، فتجيب بصوتٍ خافتٍ ثابت، غير أنّ رجفة يديك تفضحك، وتكشف كم من الضعف يختبئ خلف هذا الكبرياء.
تمشي ببرودٍ أمام من تحب، تكون كتمثال صامت، خالٍ من أيّ ردة فعل، لكنّ أول كلمة "كيف الحال؟" تفتح نوافذ القلب المغلقة، فتتسّع حدقتاك، وتتورّد وجنتاك، وتخونك كلّ محاولات التجاهل.
أن تتلقّى الصدمات بوجهٍ ساكن، وتبتسم بتلك الهدوءات المجنونة التي تخدع الجميع، بينما نبرة صوتك المرتجفة تفضحك، وتقول عنك إنك لم تعد تقوى على الاحتمال.
أن تعود إلى المنزل بعد معارك الحياة، مرفوع الرأس، تحمل صمت المنتصرين، فإذا بعناق أمّك ينهار بك، فينكشف داخلك الهشّ، وتبكي كطفلٍ صغيرٍ فقَدَ دربه في ليلٍ طويل.
أن تبوح لأمّك بسرّك، فتعدك أن تدفنه في بئرٍ لا يُدرك قاعه أحد، ثمّ تكتشف أن البئر امتلأ بالأقارب والأحباب، وحين تعاتبها، تبتسم ببراءتها وتقول: "كي يدعوا لك بالخير يا بنيّ".
وأن تحلم - كما حلمنا جميعًا - أنك تسبح في بركة ماءٍ شتوية، دافئ الفراش، مطمئنّ البال، لتستيقظ صباحًا وتجد فراشك منشورًا على شرفة المنزل بعد أن غُسل، فيصبح حديث الجيران والحيّ بأكمله. وحين تواجه أمك، تقول بصدقٍ قاتل: "لم أفضحك، فقط نشرت الفراش ليجفّ".
أن تقصّ شعرك سرًّا لتبدو أجمل، وعندما يسألك الجميع في اجتماعٍ عائلي عن سرّ التغيير، تتوهّج داخلك نشوة الجمال المكتوم، لتأتي أمّك وتقول ببساطة: "لقد سرق المقصّ وقصّ شعره من ورائي!"، فتسقط هيبتك على الأرض وتضحك معهم مضطرا.
أن تأكل علبة الشوكولا كاملة قبل النوم، وتنهض وفمك يرسم شاربًا داكنًا يفضح كلّ لذّتك الصغيرة.
أن يدخل شابٌّ نادمٌ إلى المسجد ليعترف بخطيئته سرًّا، فيتحوّل اعترافه إلى حديث خطبة الجمعة، ويشير إليه الشيخ قائلًا: "حدثني فلان"، فتنهال عليه العيون كالسّياط، فيهرب ولا يعود.
أن تفضحك خطوط عينيك رغم ثبات عمرك، وتعلن للعالم أنك لا تزال واقفًا في الزمن بينما تتغيّر الدنيا حولك.
أن تقفي على الميزان فيفضحك رقمه أنك خنتِ وُعودك ليلاً مع قطعة حلوى.
أن تتشنج أعصابك وتقول بصوتٍ مرتجفٍ: "لست غاضبًا!" بينما كلّ شيءٍ فيك يصرخ بالعكس.
عزيزي القارئ، الانكشاف ليس دائمًا ضعفًا، كما أن السّتر ليس دائمًا نجاة. أحيانًا تفضحنا الحياة لتعلّمنا، وأحيانًا تسترنا لتختبرنا. نفضح الفساد لنحمي الصدق، ونفضح الحب لأننا لا نحتمل كتمانه، ونفضح الفرح لأن البهجة لا تُخبّأ، ونفضح السلام لأنه نادر الوجود.
لكن هناك وجه آخر للانكشاف، وجه الرحمة. أن تستر المؤمن، أن تكتم زلّة من تحب كي لا تجرحه، أن تصمت لأن الفضح قد يؤذي أكثر مما يصلح. بين الانكشاف والسكوت خيطٌ رفيع، من أمسكه بحكمة.. نجا.

أدب الفضائح في ميزان الإسلام
أ. د. صبري فوزي أبو حسين (وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات بجامعة الأزهر - مصر)
يُقال بأن هذا العصر هو عصر القلق، ومن أسباب القلق ما فيه من وسائل رصد الفضائح ونشرها، فلا يكاد الإنسان ينام على فضيحة في مكان ما ومن شخص ما من هذا العالم حتى يستيقظ على فضيحة أخرى في مكان آخر ومن شخص آخر، وهي متنوعة في توجّهها، وفاعلها وضحيّتها، وكأنما الفضائح صارت صناعةً عالمية لها مختبراتها وصُنّاعها، وكأنها صارت نوعًا أدبيًّا رقميًّا تفاعليًّا، تستخدم في عرضه وفي الترويج له كل وسائل التكنولوجيا! يمكن أن نسمّيه (أدب الفضائح).
فما أدب الفضائح؟ وما جذوره؟ وما أنواعه؟ ومن أعلامه؟ وما نماذجه؟ وما مخاطره؟
مفهوم أدب الفضائح
"أدب الفضائح" - كما يقرر الذكاء الاصطناعي - ليس مصطلحًا أدبيًّا متعارفًا عليه، ولكنه يشير إلى نوع من الأدب الذي يتعامل مع الفضائح والانتهاكات الأخلاقية والاجتماعية للكشف عنها وفضحها، وغالبًا ما تكون في شكل قصص أو مقالات أو منشورات فيسيّة أو تغريدات إكسيّة، تكشف جوانب سلبية في المجتمع أو في حياة شخصيات معينة، بهدف لفت الانتباه أو إحداث تأثير إعلامي. وهو لا ينتمي إلى جنس أدبي معين، وأراه أدبًا رقميًّا، تطوّر عمّا كان يُسمّى: الأدب الهابط والأدب الماجن والأدب الرخيص والأدب التجاري، ومقالات الصحافة الصفراء، أو الصحافة الفاضحة، وهي - كما تقرر موسوعة الويكيبديا - صحافة غير مهنية تهدف إلى إثارة الرأي العام لزيادة عدد المبيعات وإشاعة الفضائح مستخدمة المبالغة أو الانحياز، وساعد على نشوئها الناشر والصحفي "ويليام راندولف هيرست" (1863- 1951)، وقد كانت له في كل ناحية من نواحي الولايات المتحدة الأمريكية صحيفة أو مجلة، وانتهج في نشر الأخبار نهجًا مثيرًا، فأظهر الفضائح والجرائم ممّا ساعد على نشوء الصحافة الصفراء. سُميت بـ "الصحافة الصفراء" نظرًا لأنها كانت تُطبَع على أوراق صفراء رخيصة الثمن، وقد تكون الصحف الصفراء يوميّة أو أسبوعية أو شهرية أو دورية.
إن "أدب الفضائح" ليس نوعًا أدبيًّا محدَّدًا، ليس نثرًا، وليس شعرًا وليس سردًا، ولكنه يستعين بتقنيات من كل هذه الأجناس الأدبية، إنه نص كتابي إلكتروني غالبًا، ذو محتوى وقالب أدبي، يركز على الفضائح والعيوب والنقائص والرذائل، سواء كانت أخلاقية، أو سياسية، أو جنسية، أو اجتماعية، أو دينية. ودوافعه عديدة؛ فقد ينبع من الجشع، أو الطمع أو الشهوة، أو إساءة استخدام السلطة، أو التحكم أو التكسب أو الدفاع عن النفس لدى المقهورين، وقد يكون صادرًا عن شواذ ومرضى نفسيين، ويهدف إلى توظيف وسائل الإعلام في بثّه والترويج له لتحقيق أهدافه. وهو ألوان: منه الانتهاك، ومنه النقد الاجتماعي، ومنه الجلد، ومنه الهدم، ومنه التشهير، ومنه السخرية، ومنه التنمّر! إن أديب الفضائح قد يكون ملتزمًا بهدف ما، ومدافعًا عن وجهة نظر معيّنة عن طريق كشف الأخطاء وفضح الانتهاكات والمعاصي من كبائر وصغائر!
وقد توسعت مضامين "أدب الفضائح" ومجالاته، فصارت تغزو كل مجالات الحياة: الإعلام والأدب والفنون والسياسة والرياضة وحتى مؤسسات التربية والتعليم، وقيادات الدعوة والإرشاد والتثقيف.. وفي الحياة اليومية للإنسان عمومًا. وقد أسهمت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في انتعاش الفضائح وسرعة انتشارها دون التثبّت من صدقيّتها. ومما يؤسَف له أن "الجهر بالسوء" صار سمة من أبرز سمات هذا العصر، وإلى وقت قريب كانت المجتمعات، العربية على الخصوص، تحتاط للفضيحة وتحتويها وتُخمدها في مهدها حتى لا يكون لها ضحايا لا ذنب لهم، لا سيما الفضائح في مجال العواطف والعلاقات بين الجنسين، وأما اليوم فكأنما هناك تسابق غير مُعلن لنشر الفضائح وتداولها..
نعم، صارت الفضائح جزءًا من ثقافة الشواذ والمنحرفين والمنحرفات فقط! في هذا العصر الهائج المائج الفاتن، ويُمكن أن نُطلق عليها "الثقافة الفضائحية الشاذة". وهي داءٌ يجب استئصاله؛ لأننا أمّة السّتر والعفو والصفح! فالفكر الفضائحي لا يُمكنه أن يُنتج أدبًا فاعلا.
إن تعبير "أدب الفضائح" فيه جمع بين لفظين متناقضين: "الأدب"، و"الفضائح"، فالأدب مروءة، والأدب احتشام، والأدب التزام، والأدب ستر، والأدب خير، والأدب احترام! والخالد من الآداب هو الآداب الهادفة البانية الشادية المعمّرة التي ترتقي بالناس وتطهّر أعماقهم وحواسّهم.
تطوّر "أدب الفضائح"
بدأ "أدب الفضائح" في قالب "الملهاة" المسرحي الساخر، وهي نوع من الكوميديا يجمع بين التهكّم والسخرية والتصوير الساخر، حيث يستخدم الضحك كأداة نقدية لتسليط الضوء على مواقف أو سلوكيات معينة بطريقة تهكمية. يمكن أن تكون محاكاة لأسلوب فني آخر بقصد السخرية منه، أو تكون هجاءً نقديًّا يهدف إلى تصحيح بعض الأخطاء في طريقة العيش والتفكير، كما يظهر في أعمال مثل أشعار "الحطيئة" والنقائض.
وهو مخترَع في المسرح اليوناني القديم، حيث اشتُهر به "أريستوفانيس" في كتابته مسرحيات ساخرة تتضمن مشاهد ساخرة من الآلهة والبطولات الأسطورية، مثل مسرحية "الضفادع" التي يفضل فيها ديونيسوس أريستوفانيس على يوربيديس. وفي الأدب العربي يُعدّ الهجاء من أقوى أنواع الأدب الساخر في الشعر العربي، وقد برع فيه شعراء مثل "الحطيئة"، حيث يبالغ في الهجاء لتصحيح أخطاء الآخرين. فشبّ محروما مظلوما، لا يجد مددًا من أهله ولا سندا من قومه فاضطر إلى قرض الشعر يجلب به القوت، ويدفع به العدوان، وينقم به لنفسه من بيئةٍ ظلمته، ولعل هذا هو السبب في أنه اشتد في هجاء الناس، ولم يكن يسلم أحدٌ من لسانه فقد هجا أمّه وأباه حتى إنّه هجا نفسه، هجا أمّه فقال:
تنحّي فاقعدي مني بعيدًا -- أراح الله منك العالمينا
ألم أوضح لك البغضاءَ مني -- ولكن لا أخالُكِ تعقلينا
أغربالاً إذا استودعت سرًّا -- وكانونًا على المتحدثينا
جزاك الله شرًّا من عجوز -- ولقاك العقوق من البنينا
حياتكِ ما علمت حياةُ سوء -- وموتُكِ قد يـسرُّ الصالحينا
هجا أبوه، فقال:
فنعم الشيخ أنت لدى المخازي -- وبئس الشيخ أنت لدى المعالي
جمعت اللؤم لا حياك ربي -- وأبواب السفاهة والضلال
هجا نفسه، فقال:
أبت شفتاي اليوم إلا تلكمًّا -- بهجوٍ فما أدري لمن أنا قائله
رأى وجهه في الماء، فقال:
أرى اليوم لي وجهاً فلله خلقه -- فقُبِّح من وجه وقُبِّح حاملهْ
وعندما مات، أوصى أن يعلق هذا على كفنه:
لا أحدٌ ألأم من حطيئهْ -- هجا البنين وهجا المريئهْ
وتطوَّر أدب الفضائح إلى شعر النقائض، وشعر السخرية، والرسائل الهزلية كرسالة التربيع والتدوير للجاحظ، والرسالة الهزلية لابن زيدون، والهجاء السياسي، والهجاء الديني...
الهجاء الخَلقي: يتناول العيوب الجسدية والعاهات البارزة كقِصَر القامة أو العرج أو طول الأنف.. إلخ، ومثالٌ على هذا بعض من هجاء "المتنبي" لـ "كافور الأخشيدي" إذ أنه تعرّض للون بشرته في بعض أبياته:
من علّم الأسود المخصي مكرمةً -- أَقَومه البيض أم أجداده الصيدُ
أم أذنيه بيد النخّاس دامية -- أم قدره وهو بالفلسَين مردودُ
هذا وإن الفحول البيض عاجزةٌ -- عن الجميل فكيف الخصيةُ السودُ
وهجاء "ابن الرومي" لأحدهم، فقد تعرّض لشكل وجهه:
وجهك يا عمرو فيه طولٌ -- وفي وجه الكلاب طولُ
مقابح الكلب فيك طرًّا -- يزول عنها وعنك لا تزولُ
ومن أمثلة الهجاء الكاريكاتوري الذي يُضخم المساوئ بأسلوب فكاهي ويسخر من الشخص المَهجو، وهذا النوع يحمل القارئ على الضحك كقول "أبي بكر اليكي" يهجو أحدهم:
أعد الوضوء إِن نطقت بهِ -- متذكرًا من قبل أَن تنسى
واحفظ ثيابك إن مررت بهِ -- فالظل منه ينجس الشمسا
وهكذا يحضر فن الهجاء في تراثنا، ويتنوّع ويتطوّر حتى نصل إلى هذا البلاء الأدبي الرقمي المُسمّى "أدب الفضائح"!
ومن أعلامه في العصر الحديث الكاتب الفرنسي "بيير كوديرلوس دو لاكلو"، والكاتبة الفرنسية "هيلين سيكسوس"، التي تشدّد في مقولاتها على ضرورة أن تنصرف الكتابة النسائية إلى الجسد، بل والاقتصار عليه، داعية الكاتبات إلى وضع أجسادهن في كتاباتهن، ويمكن أن يضاف إلى الكُتّاب الساخرون مثل يعقوب صنوع، وأحمد رجب، وأحمد مطر، وجلال عامر، ومحمود السعدني، وغيرهم.
الموقف الإسلامي من أدب الفضائح
"أدب الفضائح" ذو أثر نفسي قاسٍ، وهو سلوك لساني عدواني عنيف، وذو أضرار اجتماعيّة مدمِّرة، وهو ليس وليد البيئة المصرية، ولا العربية، ولا الإسلامية، ولا خاصًّا بها، ولكنه ظاهرة عالمية فاشية، توجد في كل مكان ومجتمع وحضارة؛ ففي كل يوم نجد حادثة أو أكثر، في غير بلد، تشير إلى كثرته! وقد زاد خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار فيروس "كورونا".
ونهى الله تعالى عن أنواع السخرية كافة، على مستوى الأفراد والوسائل، في قوله تعالى في سورة الحجرات: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (الحجرات، الآية: 11)، فهذه الآية نهيٌ صريح من الله - سبحانه وتعالى - عن احتقار الناس، والاستهزاء بهم لوجود مرض أو فقر أو أيّ صفة مختلفة أو غير مألوفة. وقد جمعت هذه الآية وسائل الفضائح الشائعة، حيث: التنمّر باللفظ (السخرية)، أو التنمّر بالإيماءات التي توحي إلى الآخرين بالاستهزاء بهم، أو بالنظر أو بالحركة أو بالكلام، وهو (التّهامز، والتّلامز)، أو التنمّر بإطلاق أسماء على بعضنا، يستاؤون منها عندما يستمعون إليها، وهو (التنابز).
وفي الهدي النبوي الشريف تقرير لهذه الأدوية القرآنية؛ فالرسول (صلى الله عليه وسلم) في غير حديث يُبيِّن أن الناس إخوة، متساوون، لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، وقد دعا في حديث جامع إلى ترك الضرر العام قائلاً: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، كما دعا إلى سلامة الناس جميعًا بلا عنصرية أو تمييز، بقوله: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم"، كما قال محبّذًا السلوك الجميل، ومنفّرًا من السلوك القبيح: "أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ حُسْنُ الخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ"؛ فالإسلام يُعلي من قيمة السلام المجتمعي، ويُرشد أتباعه إلى الاتّصاف بكل حسنٍ جميل، والانتهاء عن كل فاحش بذيء، حتى يعمَّ السلامُ البلادَ والعبادَ جميعًا، ويَسلَم كل شيء في الكون من لسان المؤمن ويده.
والتَّنَمُّر الذي وجّه الإسلام إلى إزالته، ليس الجسدي فقط، وإنما وجَّه – كذلك – إلى إزالة الفضائح وطرق التَّنَمُّر النفسي الذي قد يكون أقسى أثرًا وأشد إيلامًا، قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"، كما نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن خداع الناس المُؤدِّي إلى إخافتهم وترويعهم - ولو على سبيل المزاح - بقوله: "لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا"، وقوله: "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ - أي: وَجَّهَ نحوه سلاحًا مازحًا أو جادًا - فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ". كما دعا الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى الحِفاظ على صِحَّة المريض النَّفسية؛ فقال: "لا تُدِيمُوا النَّظرَ إلى المَجْذُومينَ"؛ أي لا تُطيلوا النَّظر إلى مَوَاطن المَرضِ؛ كي لا تتسبّبوا في إيذاء المَريضِ بنظراتكم..
والأنموذج الأعلى في علاج هذا المرض في معاملة الرسول (صلى الله عليه وسلم) التَّنَمُّر الصادر من سيدنا "أبي ذر" حينما سابَّ رجلاً فعيَّره بأمّه، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما أخرجه الإمام البخاري: "يا أبا ذر أَعَيَّرتَه بأمّه؟ إنك امرُؤٌ فيك جاهليةٌ، إخوانُكم خولُكم، جعلهم اللهُ تحت أيديكم، فمَن كان أخوه تحتَ يدِه، فلْيطعمْه مما يأكلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مما يلبسُ، ولا تُكلِّفوهم ما يغلبُهم، فإن كلَّفتُموهم فأَعِينُوهم"؛ ففي هذه المعاملة النبوية حُكمٌ على التَّنَمُّر بالجاهلية، ودعوة إلى الأخوة والمساواة بين الناس أجمعين، بلا تمييز، والإحساس بالضعيف.
الموقف النبوي الشريف من الهجاء
إن المنظور النبوي يوظّف فن الهجاء توظيفًا بنَّاءً، فيجعله جهادًا لسانيًّا، عندما يتوجّه الشاعر المسلم به إلى المشركين وأصحاب الضَّلال والمنكر. يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "اهجوا المشركين بالشعر؛ فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله، والذي نفس محمد بيده، كأنما تنضحونهم بالنبل". فالنبي الكريم لم يجد بُدًّا من الرد على هجاء المشركين الذين لم يتركوا زُورًا أو بهتانا إلا ورَمَوْا به النبي الكريم والمسلمين عامّة، مما حمل الصحابة (رضي الله عنهم) على استئذانه (صلى الله عليه وسلم) في الرد عليهم، فعن "عمار بن ياسر" قال: لما هجانا المشركون شَكَوْنَا ذلك إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فقال: "قُولُوا لَهُمْ كما يقولون لكم"، فلقد رَأَيْتُنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ أَهْلِ المدينة". وذلك لأن الهجاء الشعري يؤثّر في هؤلاء المشركين تأثيرًا شديدًا، مؤديًّا دورًا إعلاميًّا خطيرًا في الحرب النفسية معهم.
وللهجاء في المنظور النبوي حدود، حتى لا يقع أو ينال ممن لا يستحقونه؛ فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "استأذن حسان بن ثابت رسول الله في هجاء المشركين، فقال رسول الله: فكيف بنسبي؟ فقال: لأسلنَّك منهم كما تُسلّ الشَّعرة من العجين". وهذا ينسجم مع التحذير الشديد الذي نصّ عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْماً، إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو قَبِيلَةً مِنْ أَسْرِهَا"؛ فلم يترك الحبل على الغارِبِ، أمام الشاعر المسلم الهاجي خصومَ الإسلام، بل قنَّن له وحدَّ من مَيسمه. فلا بد من الصدق والحق وشرف المعنى وطهارة المبنى، والتركيز على الأعداء المؤذين للإسلام والمسلمين في الهجاء الجهادي. أما ما عدا ذلك من أهجاءٍ ذاتية أو قبَلية أو بين مسلمين، فهي جاهلية مذمومة، إذ "ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء".
رُوي أن "النّجاشي" الشاعر قد هجا "تميم بن أبيّ بن مقبل" وقومه "بني العجلان"، فاستعدوا عليه "عمر بن الخطاب"، فاستنشدهم ما قال فيهم، فقالوا: إنه يقول:
إذا الله عادى أهل لؤم ورقة -- فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل
فقال عمر: إنه دعا، فإن كان مظلومًا استجيب له، وإن كان ظالمًا لم يستجب له، قالوا: إنه يقول:
قُبيّلة لا يغْدِرون بذمة -- ولا يظلمون الناس حبّة خردل
فقال عمر: ليت آل الخطاب كذلك! قالوا: وقد قال:
ولا يردون الماء إلا عشية -- إذا صدر الوُرّاد عن كل منهل
قال عمر: ذلك أقل للِّكاك (الزحام)! قالوا: وقد قال أيضا:
تعافُ الكلابُ الضاريات لحومهم -- وتأكل من كعب وعوف ونهشل
فقال عمر: أجَنّ القوم موتاهم، فلم يضيعوهم! قالوا: وقد قال:
وما سُمِّي العجلان إلا لقيلهمُ -- خذ القعب واحلبْ أيها العبد واعجل
فقال عمر: خير القوم خادمهم، وكلنا عبيد الله!.
ولعلّ في هذا الحوار الذي دار بين رهط بني العجلان وعمر، ما يدلّ على مدى قدرة عمر على فهم الشّعر وتذوّقه وإدراك معانيه وعلمه بمراميه. وعلى الرغم من فقه عمر وفهمه للشعر وتذوّقه له على النحو الذي ذكرنا، إلا أنه بعث إلى حسان بن ثابت والحطيئة - وكان محبوسًا عنده - فسألهما عن شعر النجاشي في تميم بن مقبل ورهطه، فقال حسان مثل قوله في شعر الحطيئة الذي هجا به الزبرقان بن بدر، فهدّد عمر النجاشي، وقال له: إن عدت قطعت لسانك!
وفي ندب عمر الخبراء من الشعراء ما يدلّ على مدى إيمانه بالتخصّص؛ إذ لم يكن ذلك النّدب لعجزه عن البتّ فيما عُرض عليه بل كان سنًّا لقاعدة رشيدة، وهي الرجوع إلى أهل الذِّكر في كل فنٍّ من رجاله المنقطعين له قبل القضاء فيه؛ ليكون ذلك أصحّ للرأي، وآكد في صواب الحكم.
وهكذا نرى إسلامنا الجميل تعاملَ مع الفضيحة والتنمُّر والفضائحيين والمُتَنَمِّرين تعاملاً منهجيًّا شاملاً راقيًّا سديدًا، حبذا لو أحييناه بيننا الآنَ، وما أحوجنا إليه الآن وغدًا!
إن الأدب ينبغي أن يكون ذا رسالة إنسانية نبيلة تعلو به وتجعله في مصاف الكلام الطيب الذي يرفعه الله، والذي هو كالشجرة الطيبة وصدق الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي قال:" إنما الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق فيه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه". وفي رواية: "الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه". وكذا شأن الأدب في كل أشكاله الحديثة والمعاصرة!

قراءة في وجوه المدينة العارية
زينب أمهز (كاتبة وباحثة من لبنان)
في زمنٍ صار فيه الهمسُ جهرًا، والسرُّ مُشاعًا على موائد العيون، غدت الفضيحةُ لغة العصر، تُروى كما تُروى الحكايات، وتُتداول كما تُتداول الأخبار. لم تعد الفضيحة حدثًا عارضًا يُطوى في الصمت، بل تحوّلت إلى مشهدٍ جماهيريٍّ يتغذّى على الفضول ويقتات من الاندهاش، حتّى صارت الثقافةُ الفضائحية وجهًا آخر من وجوه الإنسان الحديث، الممزّق بين حبّ الاستطلاع وادّعاء الطُّهر. وأسهمت التكنولوجيا الحديثة، وخصوصًا وسائلِ التواصلِ الاجتماعي، في جعلها أكثرَ انتشارًا وسرعةً وتأثيرًا، حتّى غدت "الفضيحة" سلعةً رائجةً في سوقِ الاهتماماتِ العامّة.
إنّها ثقافةٌ تُعرّي المجتمع بقدر ما تفضح أفراده، وتكشفُ خفاياه أكثر ممّا تُخفيها، فتغدو الفضيحة مرآةً عاكسةً لوعينا الجمعي، ولسؤالنا الدائم عن الحدود بين الخاصّ والعام، وبين الفضيلة والرغبة في المعرفة.
وإذا نظرنا في التّاريخ، نجد أنّ "الفضيحة" ليست وليدة هذا العصر فحسب، بل لها حضور في تراثنا العربي والإسلامي، وإن اختلفت أشكالها ودوافعها.
ففي الأدب العربي القديم نجد نماذج من الفضيحة الأدبية أو الأخلاقية التي كانت تُنشر في شكل هجاء أو تشهير، كما في قصائد "جرير" و"الفرزدق" و"الأخطل".
وهنا سأورد ما قاله "جرير" في هجاء "الفرزدق":
أعـدّ الله للشـــــــعراء منِّـــــى -- صواعق يُخضعون لها الرقابــا
قرنت العبــــد عبد بنـــــــى نُمير -- مــع القينين إذْ غُلبـــــا وخابــــا
فلا صـــــلّى الإلــــــه على نُمير -- ولا سُقيت قــــبورهم السحابــــا
ولو وُزنت حــــــلوم بنــى نُمير -- على الميزان مـــا وزنت ذبــابـــا
ومع ذلك، كانت تلك "الفضائح" تُروى في سياق أدبي أو أخلاقي يهدف إلى العبرة أو النقد الاجتماعي، ولم تكن تُذاع بنيّة التشهير المجرّد كما هو الحال اليوم.
أمّا اليوم فقد تغيّر المشهد كليًّا؛ إذ لم تعد الفضيحة حدثًا استثنائيًا بل أصبحت جزءًا من المشهد الثّقافيّ والإعلاميّ اليومي، حتّى يمكن القول بوجود "ثقافة فضائحية" متكاملة الأركان: تُصنع الفضيحة وتُدار وتُسوّق كما تُسوّق السلع التجارية. ويقوم الإعلام ووسائل التّواصل الاجتماعي بتغذيتها وتعيد تدويرها بلا توقُف. والجمهور أصبح شريكًا فيها: يشارك في نشرها، ويعلّق عليها، ويصنع رأيه حولها.
إنّ هذه الثقافة الفضائحية ترتكز على قيم جديدة، منها: الشفافية المفرطة، والرغبة في "كشف المستور"، واللُّهاث وراء الإثارة، حتى ولو على حساب الكرامة الإنسانية والحقيقة.
وكما هو حال كلّ شيء في هذه الحياة، هناك إيجابيات وسلبيات لكلّ موضوع، فإذا ما أردنا أن نذكر محاسن الفضائح، نجدها أحيانًا تُسهم في كشف الفساد أو محاسبة المذنبين عندما يعجز القانون أو الإعلام الرسمي عن ذلك. وفي بلدنا لبنان هناك العديد من البرامج التلفزيونية التي تختص بهذه الأمور، وتقوم بفضح المستور عن كثيرٍ من الأمور، وتضعها في متناول الشعب والدولة، لأنها بذلك تكون قد أعطت الشعب وسيلةً للضغط على المسؤولين للقيامِ بدورهم ولردّ المظالم.
أمّا سلبيات الفضائح فهي كثيرة، ولعلّ أبرزها يتجلى في: انتشار الإشاعات وتشويه السمعة دون دليل، وهذا ما نجده في أيّامنا بكثرة، كما نقول بلهجتنا: "عالطالعة وعالنازلة سالفة"، تُلصق تُهم بأشخاص وتؤدّي أحيانًا ليس فقط لتشويه سمعتهم، بل قد تصل إلى تدمير الحياة الخاصّة دون أن نتأكد من صحّة الكلام. وكمثالٍ حيّ في مجتمعاتنا، كم من بيتٍ انهار بسبب الشائعات، وكم من شابٍ أو فتاة توقّفت حياتهم وباتَ الجميع يشير إليهم بإصبع الاتّهام، فقط بسبب كلمة خرجت من فم حاقدٍ أو مغتاظ، كم من موظّفٍ خسِر عمله بسبب غيرة زملائه.. وقد أوردتُ في مقالةٍ سابقة قصّة "ألمي" وما آلت إليه حياتها بسبب فضيحة تسببت بها رفيقاتها وكانت ملفّقة. وإذا نظرتم حولكم ستجدون الكثير من الأمثلة، هذا إن لم تكونوا أنتم أنفسكم ضحايا شائعات مُلفّقة، فلا أحد يسلم منها.
كما تساهم الفضائح في تسطيح الوعي الجمعي وتحويل الناس إلى جمهور متفرّج يبحث عن الإثارة لا الحقيقة، وكل ما يهمّه أن يحصل على أعلى نسبة مشاهدة لإعلانه (ليكون ترند).
وليس ذلك فحسب، بل إنّ الفضائح تقتل روح الرحمة والتسامح في المجتمع، فيصبح الجميع قُضاة، ويتمتّع الجميع بالنزاهة، بينما المفضوح تُسلّ على رقبته سكّين الذبح، والتي قد تكون أحيانًا أرحم من ألسِنة الناس والقلوب القاسية والنفوس اللّئيمة المُتحجّرة.
وهنا، وفيما يخصّ الأدب، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن للفضيحة أن تُنتج أدبًا؟ الجواب: نعم، ولكن بشرط أن تتحوّل من فعلٍ فضائحيٍّ إلى وعيٍ نقدي.
فالأدب الذي يفضح الظلم أو النفاق أو الفساد لا يُعدّ فضيحة بمعناها السلبي، بل هو أدبٌ فضائحيٌّ إيجابيٌّ يكشف المستور من أجل الإصلاح. ومن أمثلة ذلك: روايات "نجيب محفوظ" التي كشفت تناقضات المجتمع، وأعمال "غسان كنفاني" التي عرّت الواقع العربي سياسيًّا وأخلاقيًّا، أو كقصائد "مُظفّر النوّاب" التي تُحاكي الواقع وتواجه العدوان برصاص القلم والكلمة. أو كما جاء في قصيدة الشاعر "محمد حبلص" (أنا شعري) - والتي تناولها الزميل "وحيد حمود" بدراسةٍ نقدية لها - فهي مرآةٌ تعكس وجع غزة وعجز العرب، فغزّة تُذبح، والأعين إلى الشاشات ترنو، لا لتُبصر، بل لتُشيح. كأنّما الدم لا يعنينا، وكأنّ صراخ الأطفال نشازٌ لا يُطرب الآذان المُترفة. ويصوّر فيها الخيانة صمتًا مريبًا، وحيادًا فاضحًا، مقابل بطونٍ تتخم، وأرواحٍ تُستباح. (وهنا أدعوكم إلى قراءتها والتأمل في معانيها، فهي لا تُقرأ فقط، بل تُوجَع بها).
وهنا اسمحوا لي أن أضيف مثالًا واحدًا على ذلك يشرح كيفية الفضيحة الحسنة (كي لا أُطيل عليكم)، يقول "مظفر النوّاب" في قصيدته:
القدس عروس عروبتكم
فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها؟؟
ووقفتم تستمعون وراء الباب لصرخات بكارتها
وسحبتم كل خناجركم
وتنافختم شرفا
وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض
فما أشرفكم
أولاد القحـ.. هل تسكت مغتصبة؟
أولاد القحـ..
لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم
إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم
تتحرك دكة غسل الموتى أما أنتم
لا تهتز لكم قصبة
الآن أعريكم...
.....
تعالوا نتحاكم قدام الصحراء العربية كي تحكم فينا
أعترف الآن أمام الصحراء بأني مبتذل وبذيء
كهزيمتكم يا شرفاء المهزومين
ويا حكام المهزومين
ويا جمهورا مهزوما
ما أوسخنا.. ما أوسخنا.. ما أوسخنا ونكابر
ما أوسخنا
لا أستثني أحدا
أمّا إذا سألتني لماذا يعشق الناس الفضائح؟ فسأُجيبك استنادًا إلى العلم والواقع معًا، إذ يُرجِع علماء النفس والاجتماع هذا العشق إلى عدّة عوامل، منها:
الفضول الفطري وحبّ معرفة الأسرار، ولا يخفى ذلك على أحد، فجميعنا يعلم حشريّة الناس وفضولها في معرفة كشف المستور، كما يستلهم العديد بل الكثير الكثير من الناس مادّةً للتّسلية في نشرِ الاشاعات دون التّحقّق من صحّتها، وأيضًا البعض يصبح لديه شعور بالتفوّق الأخلاقي عند مشاهدة سقوط الآخرين، ومنهم من يستلذ بذلك، خاصّة إذا امتلأ جوفه بالحقد. ولا يمكن أن نغفل عن سبب ضعف الوعي الأخلاقي والإعلامي في التمييز بين الحقيقة والتشهير.
وأنا من وجهة نظري أقول لكم: "لا يمكن إنكار أنّ بعض الفضائح تؤدي دورًا رقابيًّا نافعًا، لكنها حين تتحوّل إلى هوس جماعي، فإنها تنسف القيم الإنسانية من جذورها. وأرفض الفكر الفضائحي الذي يعيش على أخطاء الآخرين ويقتات على أسرارهم، وأؤمن بأن الإصلاح لا يكون بالتشهير، بل بالوعي والنقد المسؤول".
وهكذا، تمضي الفضيحة كظلٍّ طويلٍ يلاحق المجتمعات، تكشف زيفَ أقنعتها حينًا، وتغريها بالبقاء في دائرة الفضول حينًا آخر. إنّ الثقافة الفضائحية ليست مجرّد انحدارٍ أخلاقي أو تسليةٍ عابرة، بل هي مرآةٌ لقلق الإنسان، وصدى لفراغٍ روحيٍّ يبحث عن الامتلاء ولو في سقوط الآخرين. ولعلّ أبلغ ما يمكن أن نفعله أمام هذا المشهد الصاخب، أن نُعيدَ للسترِ معناه، وللخصوصيّة حُرمتها، وللصمتِ هيبتهُ، علّ الإنسان يتذكّر أنّ الفضيحة ليست فيما يُكشَف، بل فيما ضاع من كرامة الإنسان، حين غدا كشفُ الآخر متعةً ومشهدًا للعامّة. إذًا يجب علينا أن نميّز بين الفضيحةِ التي تفضح فسادًا والفضيحة التي تُفسد إنسانًا.

اختراع السلاح.. فضيحة أم دفاع عن النفس؟
بدر شحادة (باحث في الشؤون التاريخية والاستراتيجية من لبنان)
قراءة في أبعاد الردع والدمار
اعتُبر السلاح وسيلةً للدفاع عن الذات وجزءًا من مقوّمات بقاء الجماعات البشرية. لكن التطوّر التكنولوجي الذي مثّلَ انتقالًا من أدواتٍ محليّةٍ ومروّعةٍ (مناجيق وزيوت مغلية ووسائل تعذيب) إلى أسلحةٍ نوويةٍ وانشطاريةٍ وفائقة السرعة يجبرنا على إعادة تقييم أحكامنا الأخلاقية والسياسية.
تسعى هذه المقالة إلى فحص مدى مشروعية هذا التطور وما إذا كان يترتب عليه "فضيحة" أخلاقية عندما يصبح السلاح هدفًا بحدِّ ذاته أو يهدِّد قدرة الكوكب والإنسان على الاستمرار، وذلك عبر استعراض النقاط الآتية:
- التاريخُ المختصر لتطوّر الأسلحة: من الضرورة إلى التفوق التدميري
بدأت البشرية بالأسلحة كوسائل بدائية للدفاع والصيد، ثم استُخدمت كأساليب للغزو والهيمنة. ولكنّ الفرق النوعي الذي يهمّنا هنا أن الأدوات الحديثة - لا سيما القنابل الانشطارية والنووية - لم تعد أدوات عسكرية محصورة الأثر، بل باتت قادرةً على إنتاج تأثيراتٍ مستدامةٍ تفوق الأضرار المادية المباشرة (إشعاع، تلوّث بيئي، آثار صحية ممتدة عبر أجيال). وبالتالي فإن هذا التحوّل يغيّر الإطار الأخلاقي والقانوني لاستخدام السلاح.
- الأسلحة النووية والقدرة التدميرية: حالة هيروشيما كنقطة محورية
إنّ الانفجار النووي التاريخي في هيروشيما (1945) قد مثّل - بلا شك - تحوّلًا في تاريخ الحروب - قدرة تدمير مدينةٍ دفعةً واحدة وموجاتٍ من الوفيات الفورية والمتأخرة - فتقديرات القوة والمتسبّبة في الخسائر أظهرت أن قنبلة هيروشيما كانت في نطاق عشرات الكيلوطنات من مكافئ الـ (TNT)، وأن عدد الوفيات المباشرة وغير المباشرة بحلول نهاية 1945 قد بلغ عشرات الآلاف (تُستعمل أرقام مثل ~140,000 في المراجع الشائعة). هذه الحقائق تضع السؤال التالي: هل مثل هذا السلاح مبررًا دفاعيًا حين تؤدي نتائجه إلى تدمير بشري وبيئي يفوق حدود "التكافؤ" في الحرب؟
إنّ الإجابة العملية لدى معظم أهل السياسة والأمن تقول: "إن السلاح النووي خلق منطقًا للردع"؛ لكن هذا الردع نفسه يحمل مخاطرة الانزلاق إلى دمارٍ شاملٍ أو "شتاء نووي" ذي آثار مناخية عالمية محتملة.
- التكنولوجيات الحديثة: الأسلحة فائقة السرعة والأنظمة الذكية
تُعرّف منظومات "فرط/ فائقة السرعة" (hypersonic) بقدرتها على التحرك بسرعات تفوق (Mach 5)، وتعدُّها بعض الدول محورًا جديدًا للتفوق العسكري. لكنّ تقييم قدرة أيّ سلاح على التدمير لا يعتمد على السرعة وحدها، بل على الرأس والشحنة المتفجرة والتكتيك المستخدم. إضافةً إلى ذلك، التكامل مع أنظمة التوجيه الذكية والذكاء الاصطناعي الذي يزيد من دقة القتل لكنه يثير مشكلة المساءلة الأخلاقية والقانونية في حالات الخطأ أو الانحراف.
- الأبعاد البيئية والصحية للاستخدام والاختبار
لا شكّ أن الأسلحة ذات القدرة التدميرية العالية؛ تترك أثرًا يمتد زمنيًّا: تلوث إشعاعي، وتخريب للنظم الإيكولوجية، وتبعات صحية تمتد إلى أجيال (سرطانات، طفرات جينية، اضطراب سلاسل غذائية). كما أن السباق على تطوير واختبار هذه الأسلحة يستهلك موارد مالية هائلة كان يمكن توجيهها إلى احتياجات بشرية أساسية (صحة، تعليم، بنى تحتية)، ما يطرح سؤال العدالة في تخصيص الموارد الوطنية والدولية.
- الردع مقابل الأخلاق والفضيحة
في النظرية الواقعية للأمن، يُبرّر السلاح كوسيلة لفرض التوازن ومنع الاعتداء. بالمقابل، هناك تيارات نقدية وأخلاقية ترى أن خذا التطور يؤدي إلى خلق أدوات قادرة على الإبادة الجماعية يُعدّ "فضيحةً" أخلاقية وتهديدًا لوجودية النوع البشري. بين هذين القطبين يتوسّط نقاشٌ علمي حول: مدى فاعلية الردع، مخاطر الخطأ الكارثي، قابلية السيطرة على التكنولوجيا، وإمكانية التوصل إلى ضوابط دولية فعّالة.
مقاربة قانونية مقترحة
1. تقنين الاستخدام: تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني وتوضيح حظر أو تقنين استخدام التقنيات التي تُحدث أضرارًا لا متناسبة أو أثرًا بيئيًا طويل الأمد.
2. ضوابط التكنولوجيات الحديثة: اتفاقيات دولية لتنظيم تطوير ونشر منظومات فائقة السرعة والأنظمة الذاتية المسلّحة.
3. الحد من الانتشار النووي: نهج متعدّد الأبعاد يجمع بين عدم الانتشار، وخفض الترسانات، وتأمين الضمانات غير النووية للأمن الإقليمي.
4. حوكمة أخلاقية للبحث والتطوير: آليات وطنية ودولية لتقييم أخلاقي للتقنيات العسكرية قبل تمويلها أو نشرها.
5. تحويل الموارد: برامج إعادة توجيه جزء من الإنفاق العسكري نحو التنمية البشرية في أوقات السلم.
في الختام
لا شكّ أن الأسلحة قد كانت جزءًا من تاريخ البقاء البشري، لكن التحوّل إلى أدواتٍ قادرة على تهديد استمرارية الحياة يضعنا أمام فضيحة أخلاقية وسياسية وبيئية. وبالمقابل فإنّنا لا ننكر الحاجة إلى وسائط دفاعية، ولكن ضرورة وضع قيودٍ قانونية وأخلاقية واضحة على الابتكارات التي تتجاوز حدود القبول الإنساني يجب أن تكون الهاجس والمقصد الأوّل قبل كلّ شيء ضمن هذا الإطار الأخلاقي.

جدار وسبعة رؤوس شيطانيّة
غنى نجيب الشفشق (كاتبة من لبنان)
كنتُ طفلًا شقيًّا وثرثارًا. أُوقدُ نار الفوضى أينما حللتُ، ضيفًا ثقيل الظلّ كنتُ. في المدرسةِ كانوا ينادونني "تيمور ذو الوجه النَّحس"، نحسٌ وقبيحٌ... فوجهي المشاكس أسودٌ مبرقعٌ، كقطعةِ خشبٍ أكلها السُّوس.
لم تكن حياتي عبارة عن لوحة فنِّية هادئة الملامحِ، كانت أسطورة خلَّدها الشّيطان في دفترِ المشاكسات... كأنَّني ولدتُ لأوقدَ النَّار في الهشيمِ!
آهٍ من أمِّي كم أبغضُ ولادتها لي!!!
ولدتُ وأنا أحملُ فوق كتفيَّ سبعة رؤوسٍ شيطانيّة، كلُّ واحدٍ منها بملامح مختلفة... سبعةُ وجوهٍ لي ولسانٌ طويل!
في صبيحة يومٍ شتائيٍّ قارس، كان صفُّ مدرستنا يرقص من زغردةِ البردِ في عظامنا، وبعينينِ سوداوين كبيرتين كنتُ أراقب الجميع حتى سقطتُ سهوًا في شِباكِ نظراتِ أستاذ الأدب و"سميرة"!
العيون مرتبكة والخجلُ بادٍ فوق وجنتيهما ونظراتٌ متقطِّعةٌ تُحيّي ارتعاشةً في الجسدِ... ليست بردًا بل هي نشوةُ العشقِ بين كلماتِ الدَّرسِ.
لم أترك ذلك الحب ينمو سرَّا كالعنقود المخبَّأ خلف أوراق العنبِ، فقط أردتُ العبث، أردتُ أن يشاهد العالم كيف يُعتَصرُ النَّبيذ من دموعِ المحترقين. استيقظت قريتُنا الضَّيقة بأسرارها فجر اليوم التالي على "فضيحة سميرة" ليقرؤوا فوق حائط المدرسة "الأستاذ يعشقُ سميرة".
وسميرة فتاةٌ خجولة طيبة القلبِ هادئة الملامحِ، أصبحت حديث السَّاعة في أفواهِ النَّاس، ينتقل من غرفةِ معيشةٍ إلى غرفةِ طعامٍ ثم إلى جلساتٍ عائلية بنكهاتٍ مختلفةٍ.
بقيَت الجملة مكتوبة فوق الحائط لسنواتٍ بثوبٍ باهت، سافر الأستاذ وتزوجتُ "سميرة" التي تكبرني بخمسة أعوام لأكفّر عن ذنبي، أنا ذو الوجه النَّحس.
واليوم وهي تغفو بالقربِ منِّي أرى ذلك الحائط ممتدًّا بيننا كحاجزٍ لروحين أرهقهما التَّمثيل؛ لا شيء يمكّن من إخفاء الفضيحة، فقط هي تبدِّلُ ملامحها بمساحيقَ جديدة.

هل صار الصمت بطولة في زمن الفضائح؟
يوسف الشمالي (كاتب من لبنان)
منذ أن أكل آدم التفاحة، والبشر لم يتوقفوا عن شهوة المعرفة، لا المعرفة التي تفتح العقول، بل تلك التي تفتح الأبواب الموصدة على حياة الآخرين. وكأن الفضول جزء من جيناتنا الأولى، فكلّ جيل يورّث الجيل الذي بعده حبّ "الفرجة" على السقوط. والناس في مجتمعاتنا حين يسمعون عن زلّة أحدهم، لا يسألون كيف نساعده، بل من الذي صوّر؟ وفي أيّ ساعة؟ وهل الفيديو واضح؟
المفارقة أننا نحفظ عن ظهر قلب الحديث الشريف: "من ستر مؤمنًا ستره الله يوم القيامة"، لكننا نحفظه كما نحفظ النكات: نرويه ونحن نفعل عكسه تمامًا. نُصلّي الظهر وننشر التسريب، نقرأ سورة "النور" ونشاهد الفضيحة ذاتها عشر مرات للتأكد من التفاصيل، ونستغفر بعد أن نشاركها في مجموعة العائلة على "واتساب". نحن قوم لا يخطئون فقط، بل يتلذّذون بخطايا الآخرين كي ينسوا أنفسهم لحظة.
قال "سقراط" ذات يوم: "تكلم حتى أراك"، ولو عاد اليوم لقال: "انشر حتى أراك"، لأن الوجود صار مرهونًا بما يُنشر لا بما يُفكّر. و"ديكارت" الذي بنى فلسفته على "أنا أفكر إذًا أنا موجود"، لو تصفّح "تويتر" لقال يائسًا: "أنا أُفضَح إذًا أنا موجود". فالإنسان لم يعد موجودًا إلا بمقدار ما يُشاهَد، ومن لم يتعرّض بعد لفضيحة رقمية فهو في حكم المجهول.
ولأننا أمّة لا تصنع المعرفة لكنها تجيد التفاعل معها، تحوّلت الفضائح إلى مادة يومية تُقدَّم بحماس يفوق نشرات الأخبار. فالناس اليوم لا يجتمعون على فكرة، بل على سقوط أحدهم. لا يتناقشون في كتاب، بل في مقطع مسرّب. لقد ورثنا من "غوستاف لوبون" عبارته الشهيرة: "الجماهير لا تفكّر، بل تنفعل"، وطبّقناها بأمانة مذهلة: ننفعل بالصوت والصورة قبل أن نفكّر بالرحمة أو بالمنطق.
الفضيحة ليست حدثًا عابرًا، بل تجربة نفسية تترك ندوبًا لا تُرى. المفضوح يعيش في زجاجة من الهمس، يراه الجميع ولا يرى نفسه، يسمع ضحكاتهم حتى في صمته. قد يغلق هاتفه، لكنه لا يستطيع أن يغلق ذاكرة الإنترنت. في الأزمنة القديمة كان الإنسان يهرب من القرية، أما اليوم فحتى إن سافر إلى القطب الشمالي، فإن الفضيحة تلاحقه عبر الـ "واي فاي".
وحدهم المشاهير وجدوا طريقة للتصالح مع هذا الجحيم، بل لتحويله إلى وقود. "أوسكار وايلد"، الذي عاش حياة مليئة بالجدل، قال ساخرًا: "الشيء الوحيد الأسوأ من أن يتحدث الناس عنك، هو ألا يتحدثوا عنك على الإطلاق". ومن حينها صار كثيرون يؤمنون أن الفضيحة طريق مختصر إلى الشهرة. فالفنان الذي كان يحتاج إلى عشر سنوات ليشتهر، يكفيه اليوم أن يرتكب غلطة واحدة تُصوَّر بجودة عالية ليُستضاف بعد يومين في برنامج حواري عنوانه: "أنا والضجة". أما الأدباء، فبعضهم أدرك أن رواية مملوءة بالإيحاءات تُباع أكثر من كتاب جادّ عن الأخلاق أو الفلسفة، وأن الاتهام بالانحراف أحيانًا أكثر فائدة من المديح الأدبي.
وسائل التواصل الاجتماعي لم تخترع الفضيحة، لكنها جعلتها ديمقراطية، متاحة للجميع كما الماء والكهرباء. صار كل مواطن محطة بثّ مباشر، وكل هاتف صحيفة فضائحيّة متنقّلة. وفي هذا العالم، لا فرق بين الصحفي والمغسّل؛ كلاهما "ينشر الغسيل"، لكن واحدًا ينشره بحبر والآخر بالبيكسلات.
لقد تحوّل الشرف إلى رقم، والسمعة إلى إشعار. يُقاس نقاء الإنسان بعدد المتابعين الذين لم يلغوه بعد أول خطأ. ومن ينجو من أول فضيحة يُعتبر "قوي الشخصية"، ومن يعتذر يُتّهم بالتمثيل. ولأننا نعيش في عالم يحكمه "الترند"، فقد صار المعيار الأخلاقي بسيطًا: هل الفيديو وصل إلى المليون مشاهدة أم لا؟
في العالم العربي، حيث تختنق العقول بالممنوعات، صارت الفضيحة وسيلة تنفّس جماعي. نحن لا نجرؤ على نقد الحاكم، فننقد حياة المطرب. لا نتحدث عن السياسة، فنبحث عن صور الممثلة. لا نغيّر واقعنا، بل نُدين من تجرّأ على العيش بطريقته. إننا نُفرّغ قهرنا في الآخرين، ونصنع من الفضائح خبزًا يوميًا نأكله لننسى جوعنا الحقيقي إلى الحرية والكرامة والمعنى.
الطريف أن أكثر من يُدينون الفضيحة، يبدؤون جملهم بعبارة: "أنا ما بحب الحكي، بس والله لازم نحكي الحقيقة!"، ثم يبدؤون رواية تفاصيل لا علاقة لها بالحقيقة. لقد أصبح الستر ضعفًا، والصمت تواطؤًا، والنصيحة في السرّ سذاجة.
ولعل أجمل ما في هذا العصر أنه جعل الفضيلة خيارًا شخصيًا لا شعبويًّا؛ أن تختار الصمت في زمن الكلام المباح هو بطولة، وأن ترفض مشاركة مقطع يدمّر حياة إنسان هو مقاومة. فربما نحتاج إلى إعادة تعريف البطولة لا على أنها قتل التنّين، بل حماية مَن سقط مِن مخالبه.
في النهاية، سيكتشف الجميع أن من يدمن فضائح الآخرين، يكتب سطور فضيحته القادمة بيده. وأننا، نحن الكائنات الفضولية التي تسكن الشاشات، لا نحتاج إلى مزيد من الكاميرات، بل إلى مرآة واحدة نجرؤ أن ننظر فيها دون أن نخاف مما نراه.