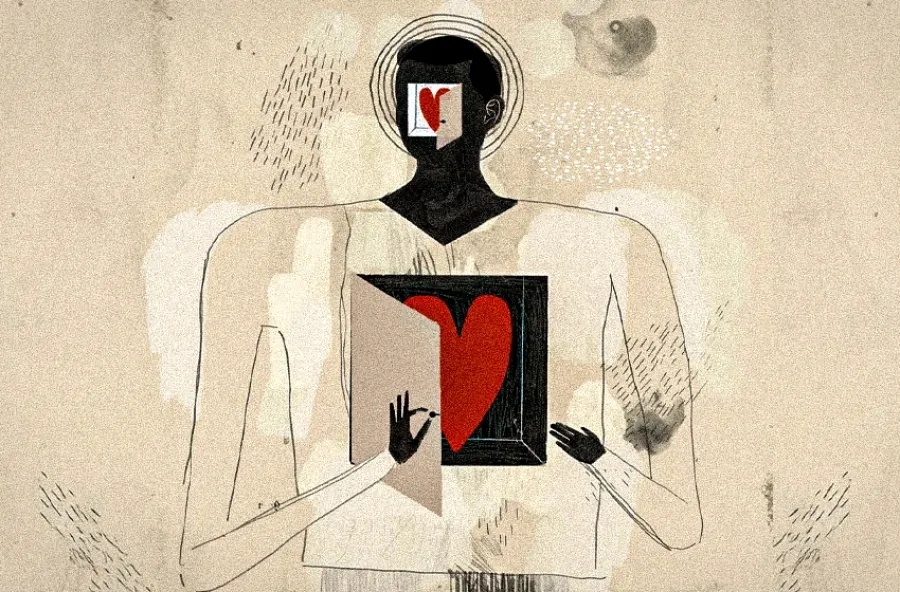"كل كلمة لا تحمل نشاطا معيّنًا هي كلمة فارغة، كلمة ميّتة مدفونة في نوع من المقابر نُسمّيه: القاموس"، هكذا رأى المفكر الجزائري "مالك بن نبي" إلى الكلمات بأنها مجرّد كائنات ميّتة ما لم تتجسّد معانيها في مجال الفعاليّة والجدوى. وما أكثر الكلمات الميّتة في القواميس العربية، بل لعل تلك الكلمات قد تحوّلت إلى عبء عطّل فعالية المثقف العربي، وألبسته ثوبًا ظاهره المعرفة والأدب والفكر، وباطنه هو الجهل ذاته، قال "بن نبي": "الجهل في حقيقته وثنيّة، لأنه لا يغرس أفكارًا، بل يُنصّب أصناما". ولعلنا قادرون على إحصاء الكلمات الحيّة لأنها صارت قليلة، بينما الميّتة فنحن عاجزون عن إحصائها لأنها أضخم من أن تُحصى!
ماذا لو قُمنا بإحصاء الكلمات في قواميس الأدب والفكر والسياسة.. منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 إلى يومنا هذا، وحاولنا أن نستجلي فعاليّتها وجدواها في الرقيّ بالعقل العربي عموما، فإلى أيّ نتيجة يُمكننا أن نصل؟ في الواقع، إن محاولة الإجابة هي مغامرة كبيرة قد تُثير جماهير المثقفين العرب وتدفعهم إلى استحضار تاريخٍ زاخر بالإنتاج الأدبي والفكري والإعلامي لعشرات الآلاف من الأقلام.. لذلك نكتفي بالوقوف عند مقولة زعيم الصهيونية "ثيودور هرتزل" (1860 - 1904)، الذي لم يزر فلسطين في حياته ويُقال بأنه لم يكن يعرف العبرية، قال: "لكي نقيم وطنًا لليهود في فلسطين، يلزمنا الكثير من الضوضاء". واستنادًا إلى هذه الرؤية، أسّست المنظمات الصهيونية، بعد الحرب العالمية الأولى، هيئة إعلامية خاصة سُمّيت: "دائرة الدعاية"، تمّ توظيفها في الترويج للسردية الصهيونية والتغلغل في العقل الغربي وزراعة الأكاذيب فيه..
بالمقابل، ما الذي فعلته جيوش المثقفين العرب على امتداد أكثر من سبعة عقود لخدمة فلسطين والشعب الفلسطيني من خلال مخاطبة العقل الغربي بمختلف لغاته؟ وهل يُمكن مقارنة ما يمتلكه اليهود من مؤسسات إعلامية وفكرية ومراكز دارسات.. في كبريات العواصم والمدن العالمية، مع ما يمتلكه العرب من مؤسسات "شبيهة" تخاطب المجتمعات الغربية وتعمل على التأثير في الرأي العام العالمي؟ بالتأكيد إنه لا يُمكن المقارنة بين ما يُحصى بعشرات الآلاف وما يُحصى بالآحاد (أو العشرات تجاوزًا وتفاؤلًا). ومن المؤسف أن مفكّرين عربًا أفنوا سنين من أعمارهم فأنتجوا كتبًا ودراسات وبحوثا باللغة العربية لتفنيد السردية الصهيونية ومواجهة أكاذيبها، وكأن الإنسان الجزائري البسيط - مثلا - في حاجة إلى من يُبرهن له بأن فلسطين وطنٌ عربي، والكيان الصهيوني هو أداة استعمارية اعتمدت على الأساطير والأكاذيب ليقيم "دولة"!
بالعودة إلى مقولة "مالك بن نبي": "كل كلمة لا تحمل نشاطا معيّنًا هي كلمة فارغة، كلمة ميّتة مدفونة في نوع من المقابر نُسمّيه: القاموس"، يُمكن القول بأن المثقفين العرب يعيشون في القاموس الميّت الذي دُفنت فيه الكلمات الميّتة، والأمل معقودٌ على غزّة لتفجّر الصحوة الفكرية للعقل العربي لعله يتدارك هذه الفجوة الإعلامية الكبرى، ويدعو إلى تأسيس مؤسسات إعلامية وعلمية وبحثية في البلدان الغربية، وإحداث ثقوب صغيرة يتسللون منها إلى العقل الغربي لتصحيح مفاهيمه ورؤاه التي زيّفتها الصهيونية العالمية منذ مطلع القرن العشرين.
يجب على المثقفين العرب أن يصلوا إلى مرحلة المكاشفة والمصارحة ليستثمروا الحرب على غزة في إحداث نهضة إعلامية وفكرية منفتحة على العالم، ليس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، بل من خلال مؤسسات "حقيقية" يُمكنها صناعة الرأي العام العالمي والتأثير فيه. كما يجب عليهم أن يتحرّروا من الانفعالية ويعتنقوا الفعاليّة التي تثمّن دماء الشهداء الفلسطينيين في غزّة.. وإذا ما أفلتت منهم هذه الفرصة التاريخية فلا كلمة تُقال لهم سوى: سلاما.

حين تصير الثقافة آخر قلاع الضوء
بقلم: بن معمر الحاج عيسى
في زمنٍ تتبدّل فيه القيم كما تتبدّل المواسم، وتُقاس فيه الأصوات لا بعمقها بل بضجيجها، تظلّ الثقافة الفعل الأصدق في مقاومة العدم. إنها آخر ما تبقّى لنا من ضوءٍ في هذا الاتساع المظلم، اللغة التي ترفض الانقراض، والذاكرة التي تأبى أن تُختصر في "هاشتاغٍ" أو ومضةٍ عابرة.
في هذا الركام من السرعة والسطحية، تُطلّ الكلمة ككائنٍ نادرٍ يقاوم الاندثار، حاملةً رائحة الكتب القديمة، وأحلام الذين كتبوا ليبقوا. الثقافة ليست ترفًا، ولا ترفيهًا، إنها الفعل الهادئ الذي يُعيد ترتيب الفوضى فينا، والصرخة التي تذكّرنا بأننا بشر لا مجرد مستهلكين في سوقٍ مفتوحٍ على العدم.
نحن في "الأيام نيوز" نؤمن أن الثقافة ليست ظلًا للسياسة، ولا تابعًا للاقتصاد، بل هي جوهرُ الكينونة الإنسانية، وهي المعنى الذي يُعيد للإنسان شكله كلّما كاد يذوب في جدارٍ من الإسمنت والافتراضية. الثقافة، بهذا المعنى، ليست ترفًا لمن يملكون الوقت، بل هي ضرورةٌ لمن يريدون النجاة من فراغ العصر.
في هذا الملف، نفتح نوافذنا على ما تبقّى من أصواتٍ تؤمن بالكلمة، ونستعيد ملامح الحكاية التي كدنا ننساها في زحمة الأخبار العاجلة.
نكتب عن الجمال لا بوصفه رفاهية، بل مقاومة، وعن الفنّ لا بوصفه ديكورًا، بل سؤالًا في وجه الزيف، وعن الفكر لا بوصفه ترفًا نخبويًا، بل سلاحًا يُصوّب نحو الغياب.
هنا، لا نبحث عن ضجيج اللحظة، بل عن أثرها، عن ذلك الوميض الذي يجعل من القصيدة وطنًا، ومن اللوحة ذاكرةً، ومن الرواية شجرةً تثمر في الصمت.
هنا، الثقافة ليست ملحقًا، بل موقفًا. ليست خبرًا عابرًا، بل سؤالًا مفتوحًا في وجه هذا العالم الذي يركض نحو النسيان.

غزة.. سردية لحياة أخرى
بقلم: بختي ضيف الله – الجزائر
ليس من السهل ألّا تتألم وأنت ترى قطعة صغيرة من العالم تنزف دما كل يوم، يخترق سكين غادر جسمها دون موعد، يفرغ غضبه في بطنها ثم ينسلّ ليعود غدا وبعد غد، كأمس وأول أمس؛ كنص مكرر لا يفقه نسقه وسياقه إلا إنسان لا يزال على قيد الحياة، يحتفظ بنبض قلبه، يطلق دموعه الحارة إلى العراء سخية، يشير ببنانه إلى موضع الألم.. إلى غزة.
أيّها الكاتب الإنسان.. آن لك أن تسمع تفاصيل الحكاية من الحجارة وكل الصوامت؛ فستلقي عليك ظلالا وتخط في عالمك الإبداعي سردية جديدة تسير على خطوطها العريضة، مؤمنا بالحق، مصدقا به، مدحضا سردية فرضت عليك من غالب احتل عقلك وفكرك زمنا طويلا فكنتَ من الواهنين الواهمين.
في تلك الأرض المحاصرة، ظلما وعدوانا، عباد يحبون الحياة، يعيشون تفاصيلها كأنهم الخالدون، يدافعون عن أرضهم الطيبة بكل وسيلة بين أيديهم، موقنين بأنهم منتصرون في نهاية الطريق وأنهم الباقون؛ أما رأيت كيف يفرحون في أعراسهم تحت صوت القنابل والطائرات التي سكنت سماءهم، يرقصون ساخرين من هذا العالم الذي يلم يفقه تعريف الزمان والمكان؛ فساعاتهم ودقائقهم طويلة لا يدرك معانيها أحد غيرهم؛ فالحياة شعور بها، والأرض بساط كبير ممتد لا حدود له؛ في ليلة وحيدة يزرع الله في رحم العروس بطلا يرفع الراية من جديد، يجمع أبناء الأرحام الأخرى ليواصل المسير؛ أنظر إلى ذلك الطالب المفاخر بعلومه وهو يناقش رسالته تحت خيمة مقطعة، تعبث بها الريح العاتية كما تعبث بكلماته أمام الحاضرين الذين ابتسموا في وجهه المتطلع إلى غد مشرق بين رماد شوه وجه المدينة.
يمكنك أن تقتبس نصك من وجوه هؤلاء. قد يتهمك المستلَبون بأنك كاتبُ خيال علمي، تقفز بقلمك بين الكواكب المجهولة، تصطحب أشخاصا غير آدميين، لا تنبض قلوبهم مثلنا، أو أنك غرابيّ وعجائبيّ بعيدٌ عن الواقع، تزرع شكا في نفس القارئ يتخطّفه الذهول. أكتب؛ فكل ما هو أمامك واقع.. فلتخرج كلماتُك حيةً ويخرج هؤلاء أحياء من تحت رماد!

طبل خربان ما يطلع نغمة
بقلم: قمر عبد الرحمن
حقيقة المشهد: ضجيج إعلامي، بيانات رنانة، ومبعوثون يتوالدون كما لو كانوا مفاتيح للحل، بينما في الجوهر لا جديد سوى إعادة إنتاج الوهم. هذه المرّة جاء "المندوب السامي" بوجه أمريكي صريح، يحمل في حقيبته وعودًا براقة، لكنه لا يخفي جوهر مهمته: منح ما تبقّى من فلسطين للتنين الصهــيوني، وما لم يستطع أن ينتزعه بالقوة والمجـازر سيُسلَّم له على طبق السياسة الناعمة.
هكذا تُدار المسرحية منذ عقود؛ أسماء تتبدّل، لكن الجوهر واحد: تثبيت الاحتـلال، وتزيين القيد بأشرطة الحرية المزيّفة. وما بين جولات التفاوض ومؤتمرات السلام المزعوم، يتآكل الحق، وتتسع هوّة الجرح. غير أنّ التاريخ لا يرحم، والأرض لا تنسى أبناءها. فكما فشلت المجــازر في اقتلاع الشعب، سيفشل الوكلاء مهما تعددت وجوههم. فلسطين ليست ملفًّا دبلوماسيًّا يُغلق بتوقيع، بل روحٌ حيّة، عصيّة على البيع والتنازل، وستظلّ شاهدة على كلّ طبلٍ خربانٍ لم يُصدر سوى صدى الوهم.

زمن الجراد.. من أسراب الريح إلى مصانع الإبادة
بقلم: عيسى قراقع
في عام 1915، اجتاح الجراد أرض فلسطين في كارثة وثّقتها كتب التاريخ، والوثائق العثمانية، والمذكرات المحلية. جاء الجراد من الشرق، بأجنحةٍ خفيفة تحملها الرياح، ونزل على الأرض كما الغيمة السوداء، أتت أسرابه على كل شيء: السنابل، الأشجار، البساتين، لم يُبقِ للناس ما يأكلونه، ولا للحيوانات ما تعيش عليه. فانتشرت المجاعة، وحلّ المرض، وهبط الموت على البيوت بصمتٍ خانق.
كتب أحد المؤرخين المحليين في مذكراته: "لم نعد نفرّق بين رائحة الخبز ورائحة الجوع، كانت الأيام متشابهة، والجراد لا يغادر". وكتب الجندي "إحسان تورجمان" في يومياته: السماء غامت بلا غيم، حتى خلت أن الليل حل، والنهار انسحب مذعورا، أشجار عارية، وحقول صامتة والمجاعة زحفت بلا صوت ولا طلقة.
لكن وعلى قسوته، لم يكن الجراد عدوًّا واعيًا، لم يكن يحمل مشروعًا، لم يعرف الخرائط ولا الأعراق، لم يُصنع في مختبرات، ولم يُبرمج على قتل الإنسان، كان كارثة بيئية تمرّ، وتترك آثارها، ثم تمضي. أما اليوم، فالجراد عاد، لكن بصورة أخرى، عاد فوق غزة، لا من الطبيعة، بل من مصانع الموت. لا تسيّره الريح، بل العقول الاستعمارية. لا يبحث عن زرع، بل عن لحمٍ بشري. جراد لا يأتي ليأكل، بل ليُبيد، يحمل وعدًا بالتطهير، بالاقتلاع، بالنسيان.
إنه جراد مسلح، بأجنحةٍ من طائرات عمياء، وصواريخ ذكية، وقنابل عنقودية وفراغية وفسفورية، أحالت الأرض إلى رماد، والناس إلى أرقام.
جراد لا يزحف عشوائيًّا، بل يختار أهدافه بعناية: مستشفى هنا، مدرسة هناك، ملجأ للأطفال، أو بيت تؤويه عائلة منذ ثلاثة أجيال.
إنه ليس سربًا من الحشرات، بل فلسفة قتالية، عقل عنصري يرى في غزة حقل اختبار دائم، كل قنبلة تُلقى هناك لا تأتي من فراغ، بل من مشروع طويل: مشروع اقتلاعٍ من الجغرافيا والتاريخ، من الذاكرة والمعنى.
الجراد الحديث ذو القرون الطويلة الفتاكة، لا يرى في الأرض إلا ساحةً للإفناء، وما يستحق الحياة، بالنسبة له، يجب أن يُمحى، لهذا تحولت غزة الى مقبرة ليس للبشر فقط، بل للطبيعة والحياة.
في زمن الحرب العالمية الأولى، كانت الناس تطرد الجراد بالدخان، تحاول إشعال النيران، تدق الأواني لتخيفه. كان هناك مجال للمقاومة، ولو رمزيًّا، أما اليوم، فكيف تخيف قنبلة موجهة بالأقمار الصناعية؟ كيف تطرد سرب طائرات (إف - 16) من السماء؟ كيف تصرخ في وجه صاروخ لا يسمع؟ أو روبوت مفخخ بالمتفجرات، إن الجراد اليوم يحمل نيران جهنم، ليس عابرًا، بل ساكنا في منهجية ونظام الإبادة.
الجراد المسلح يطير فوق غزة بأجنحة من نار وحديد، لا يعيش على الجوع، بل يتغذى على العنصرية والفاشية، إنه مخلوق من أيديولوجيا كريهة متحركة، يؤمن بتفوقه العرقي، يرى في الآخر خطرًا بيولوجيًا يجب تصفيته. وهو لا يأتي فجأة، بل يُخطط له، ويُنتج في مصانع أمريكا وأوروبا، من حضارات عادت إلى عصور الظلام، ونسيت ان تكون إنسانية.
اليوم لا يأتي الجراد من الطبيعة، بل من دولة اسبارطية، دولة الجدران والأبراج والمعسكرات والأسلاك الشائكة، من عقول مشبعة بالانحطاط الاخلاقي والانساني، بالبشاعة والعنصرية، لا يبحث عن مزروعات، بل عن اجسام بشرية.
الجراد الجديد مفترس لحوم لا نبات، يصطاد الأرواح، يصوب بدقة، له عيون صناعية ترى في الليل، وله أدمغة مبرمجة على القتل، يلتهم الاطفال والجثث، يجفف التراب والاثداء ويبعثر الاشلاء، يشرب الدماء ولا ينتج غير الكارثة.
جراد صهيوني أمريكي أوروبي استعماري، معدن مصقول في مصانع الابادة الجماعية، صار طيارًا بلا طيار، صار دبابة وجرافة تهرس أجساد البشر، يرى في غزة مزرعة للموت لا موطنا للناس، جراد يحمل أيديولوجيا الهيمنة، عقيدة الاستئصال، فلسفة النفي الكلي، لا يكتفي بالأرض، بل محو الوجود الفلسطيني ذاته: لغته، ثقافته، هويته، حجارته وأغانيه، وهكذا تحوّلت غزة إلى مسرح موت يراقبه العالم من خلف الزجاج، وإلى حقل تجارب للأسلحة الحديثة، إلى مكانٍ تُختبر فيه حدود الصمت الدولي، ومقاييس التحمل الإنساني.
في زمن الجراد، عندما تساقط فيه التاريخ من بين أصابع القدر كالرمل اليابس، وبينما كانت الشمس تسيل فوق جباه اللاجئين والفلاحين والفقراء، زحفت على فلسطين ثلاثية الدمار: الطاعون والموت المسلح والجراد، لتعيد رسم الأرض بألوان الفناء، ويقال إن السماء اسودت، لا من الدخان وإنما من الأجنحة، وما بين الجراد والطاعون والتشرد والتجويع، والقصف والنسف، كانت ومازالت غزة تنزف، وتدفن أبناءها تحت صمت أشبه بالموت المؤجل.
غزة تلك المدينة التي طالما حملت في اسمها وجعا مختوما بالشمس والملح، لم تكن ساحة فقط، بل ضحية معلقة بين السماء والغبار، ما بين العثمانيين والاحتلال البريطاني والاستعمار الصهيوني، وذاكرة مر عليها الكثير من الغزاة، كانت المدينة تُذبح على مهل، لا بالرصاص فقط، بل بجوع ينهش العظام، ووباء يسرق الانفاس، وجراد يأتي، يبيد الحياة في بذرتها.
الإبادة لم تأت لحظة واحدة، كانت عملية جهنمية مستمرة منذ النكبة، سلاحها: كل ما يميت، لم ترم غزة بالنار فقط، انما بالغياب: غياب القمح، غياب الدواء، غياب المأوى، غياب العدالة، حتى الموت كان يأتي مرهقا، لأنه سئم هو الآخر من التكرار.
كما في زحف الجراد القديم، تبقى فلسطين عصيّة على الفناء. تموت، نعم، لكنها تنهض. يُقصف جسدها، لكن روحها تبقى مشتعلة. لأن الأرض التي أنجبت التاريخ، لا يستطيع الجراد، مهما تسلح، أن يمحوه.
في زمن الجراد، القديم أو الحديث، تبقى غزة نقيض الزوال، تبقى فكرة، والجراد لا يقتل الأفكار.
رغم كل هذا الاجتياح الهائج، رغم هذا الزحف البهيمي، رغم أن دولة الاحتلال تحولت إلى دولة جراد، جيشًا وحكومة ومؤسسات، إعلامًا وقضاء، محاكمَ وسجانين ومستوطنين، ورغم التواطؤ والعجز العالمي بوقف أكبر وأعنف إبادة في التاريخ الإنساني، غزة لم تمت، دفنت أبناءها، بكت كثيرا، لكنها لم تمت، بقيت واقفة.
غزة شاهدة على أن الإنسان، حتى وإن قتل تحت ثلاثية الجراد والطاعون والحرب، يمكنه أن ينهض، لا لأنه أقوى، بل لأنه لا يملك خيارًا آخر سوى الأمل والإرادة.
ما لا يعرفه الجراد، مهما تطوّر سلاحه وتوحشت نيرانه، أن غزة ليست مجرد مكان، وليست مجرد شعبٍ محاصر، غزة فكرة، والفكرة لا تُقصف، هي نبضٌ عنيد، حين يتوقف كل شيء، يظلّ هو ينبض، هي أمٌّ تُنجب تحت الركام، طفلًا يُولد في الظلام، ويصرخ: أنا هنا، هي جدّة تُخرج كسرة خبز من بين الأنقاض وتقول لحفيدها: كُل، ما زلنا أحياء.
في كل بيت مهدوم، حكاية لا تموت. في كل شارع مغبر، خطوات نحو الصمود. وفي كل عين تدمع، وعدٌ بأن من بقي سيحكي لمن يأتي. وإن لم يبق أحد، فستبكي الحجارة وتروي، لأن غزة تكتب تاريخها حتى بالدموع.
كتب الشاعر "عبد اللطيف عقل"، مخاطبًا المجتمع الدولي من ساحة المهد في "بيت لحم" ليلة عيد الميلاد: كيف أعلم حب المسيح، وهذا المكان مزدحم بالجراد المسلح؟ تلاميذ المدارس يطاردون الجراد، في أيديهم الدفاتر والحجارة، وفي عيونهم الرفض.
كم مرة يمكن أن يعود الجراد قبل أن تصبح الحياة مستحيلة؟ ولماذا لم تسقط غزة؟ سؤال يطرحه كل من أرسل الجراد ولم يعد، الإباديون لم يفهموا شيئًا من التاريخ، فالجراد وإن أباد المحاصيل ونشر الموت الأسود والأوبئة، لا يقتل البذور، وإن جرد الأشجار من أوراقها، فالفصل القادم سيأتي. وإن كان هذا زمن الجراد، فلتكن غزة وعد الحياة.

"ياسمين ناصر".. امرأة تطهو فكرةً وتعيد تعريف القوة
بقلم: قمر عبد الرحمن - فلسطين
في زمنٍ تُقصف فيه المدن بالحديد والنار، وتُحاصر الأرواح كما تُحاصر الأرغفة، خرجت امرأةٌ من بين الأواني والملاعق تحمل رايةً لا تُشبه سواها. ليست رايةً من قماشٍ، بل من رغيفٍ طريّ ورائحةٍ تُشبه الحياة. إنها ياسمين ناصر، الطاهية التي حوّلت المطبخ إلى جبهة مــقاومة ناعمة، وجعلت من الوصفة خبزًا للكرامة، ومن الطبق رسالةً لا تقلّ عن الرصاص وقعًا.
ليست مجرد وصفات تُقدم على الطاولة، بل رسائل خفية تُرسل للعالم: أن كل طبق يُصنع بعناية يمكن أن يكون سلاحًا ضدّ اليأس، وأن الإنسان قادر على المقاومة بأبسط الأدوات. في لحظةٍ كان فيها أهل غـزة يصنعون طعامهم من دموع الحنين، تحوّلت ملعقة ياسمين إلى بنـدقية وجلست أمام كاميرتها، تخلط الطحين بالماء، وتقول للعالم: "حتى من العدم، يمكن أن نخلق حياة".
هي لا تطهو طعامًا فحسب، بل تطهو فكرةً... فكلّ وصفة من يديها تُعيد تعريف الإنسانية، وتُذكّرنا أن المــقاومة ليست فقط بـندقية تُطلق النار، بل يدٌ تُشعل نار الطهو كي لا ينام الأطفال جياعًا.
من الطحين "خُلِق" الدجاج… ومن الرحمة وُلدت مــقاومة. حين صنعت وصفات مثل "دجاج الطحين" و"فاصوليا الصبار"، لم تكن تُقدّم مجرد طعام، بل أملًا متجسدًا.
في كل وجبة، تحكي قصة صبر أهل غـزة، وتؤكد أن القليل من الموارد لا يعني القليل من الحياة، وأن الابتكار يمكن أن يكون أقوى من كل الخذلان.
لقد صارت ياسمين في وعي الناس طاهيةً تُقاتل بالرحمة، تُمسك بالمِلعقة كما يُمسك المـقاوم بعزيمته. وفي كل فيديو، في كل ابتسامةٍ منها، هناك همسٌ يقول: "أنتم لستم وحدكم".
ما تصنعه ياسمين ليس طعامًا يُؤكل، بل ذاكرةً تُروى. تكتب بالملح سيرة الشعوب التي لا تموت، وتُعلّمنا أن الإنسانية هي أسمى أشكال المـقاومة، وأن الطهو حين يُصبح فعل حبٍّ صادق، فإنه يهزم الحـرب دون أن يُريق دمًا. وهكذا، من مطبخ صغيرٍ في "عمّان"، تُشعل الشيف "ياسمين ناصر" نارًا لا تُطفئها الرياح؛ نارَ التضامن وجذوة التآزر، وفي رائحة الخبز الذي تُقدّمه، تشمّ غــزة رائحة وطنٍ لا يزال يقاوم بالقلب، والإيمان.

أحلام تُغتال قبل أن تكبر
بقلم: د. منى أبو حمدية - فلسطين
في غزة، الطفولة ليست زمنًا، بل أسطورة تُروى على لسان الريح. هناك يولد الأطفال كما تولد الكواكب من رحم الانفجار، لكنهم لا يكملون دورتهم في مدار البراءة، إذ تتكالب عليهم مجرّات الحديد والنار، فتخطفهم الشظايا كما يخطف الخسوف وجه القمر.
أيّ قدرٍ هذا الذي يزرع النجوم في أعين الصغار، ثم يطفئها قبل أن تُضيء سماء العالم؟ أي يدٍ هذه التي تسرق من الطفل نبوءته،
وتحوّل أحلامه إلى رمادٍ تذروه الرياح؟
أطفال غزة ليسوا مجرد وجوه صغيرة، إنهم أنصافُ آلهة من براءةٍ مصلوبة، يحملون على أكتافهم أسطورة الأرض الأولى، كأنهم آخر سلالةٍ أوكلت إليها السماء حراسة الذاكرة. كل شهيدٍ منهم نجمٌ سقط ليرسم خارطةً جديدة في ليل البشرية.
في أزقة غزة، الأرجوحة ليست لعبة، بل بوابة بين الحياة والموت، والدُمية ليست حكاية، بل شاهد قبرٍ صغير. هناك، تتحوّل الطفولة إلى سفرٍ أبدي، وتصير المدارس معابد مهدمة، تكتب على جدرانها الملائكة: "هنا مرّ أطفالٌ، كانوا يحلمون".
يا غزة، يا أمّ الكواكب، يا رحم النار والملح، أطفالكِ رسلٌ يبعثون من تحت الركام، يحملون على جباههم هالاتٍ من غبار ودم، كأنهم كائناتٌ نورانية أُرسلت لتذكّر الأرض بأن البراءة حين تُذبح، يختلّ ميزان الكون.
ورغم كل هذا الخراب، تظلّ الطفولة فيكِ مثل طائر الفينيق، تحترق ثم تنهض من الرماد. تُبعث من بين الركام لتقول: "لسنا ضحايا العدم، بل بذور الخلود".
غزة - يا أسطورةً مكتوبة بدم الأطفال - ستبقى الطفولة المسلوبة فيكِ مرآةً للكون، تفضح ظلمته، وتعيد رسم نجومه، حتى يولد الغدُ من جديد، ويعود الحلم، لا كذكرى مسروقة، بل كفجرٍ مكتمل يضيء أفق الإنسانية بأسرها.

النزوح قبل الأخير.. حين يغادر القلب أضلعه
بقلم: يسري درويش
ليس الخروج من البيت مجرد انتقال جسد من جدران إلى أخرى، بل هو اقتلاعٌ للذاكرة من جذورها. حين خرجت اليوم من بيتي في غزة، لم أكن أحمل حقيبةً ولا متاعًا يذكر، بل كنت أحمل عمرًا كاملًا مُثقلًا في قلبي. ساعةً بعد ساعة وأنا أتنقل بين الغرف، ألمس الأثاث كما لو كنت أودّعه واحدًا واحدًا: الطاولة التي شهدت أحاديث العائلة، الأريكة التي احتضنت سهراتٍ وأحلامًا، الكتب التي حملتني إلى عوالم أخرى، والبلكونة التي كانت نافذتي إلى السماء والهواء والحرية. لم يكن الأمر تفقدًا للمحتويات بقدر ما كان احتضانًا أخيرًا، محاولةً يائسة لتثبيت كل تفصيلةٍ في ذاكرتي قبل أن يُنتزع مني المكان.
شعرتُ أنني أُجرّد من نفسي قطعةً قطعة، كما لو أن الروح تُنتزع من الجسد بحشرجةٍ دامية لا يسمعها أحد. النجاة؟ يقولون إنها الأهم. لكن أيّ نجاة تلك إذا كانت الروح قد تركتني هناك، معلّقةً على الجدران، ملتصقةً بالأبواب، باقيةً في الهواء الذي لم أعد أتنفسه؟ كل نزوحٍ سابق كان يحمل وعدًا بالعودة، كان يشبه رحلة اضطرارية مؤقتة، كأنك تترك باب البيت مواربًا خلفك على أمل أن تعود قريبًا. أما هذا النزوح، فكان شيئًا آخر؛ كان نزوح القلب من أضلعي. شعرتُ أنني أغادر بلا رجعة، وأن البيت الذي حملني لم يعد قادرًا على حمايتي، وأنني سأبقى طريدًا حتى لو بقيت على قيد الحياة.
المنفى لا يبدأ حين تعبر الحدود، بل حين تُقتلع من بيتك وتُترك معلّقًا في الهواء بلا جذور. اليوم، لم أترك بيتًا من حجارة، بل تركت العمر كلّه، تركت نفسي معلّقة على جدرانٍ أعرف ملمسها أكثر من ملمس يدي.
هذا النزوح ليس مجرد حركة اضطرارية لإنقاذ الجسد، بل هو موتٌ مؤجل، موتٌ يتكرر في كل لحظة تفقد فيها يقين العودة. فما قيمة النجاة إن بقي القلب هناك، مقيمًا في بيتٍ لم يعد بيتًا، ولم يعد مأوى، لكنه سيبقى إلى الأبد موطن الروح التي لا تُعوَّض؟
بين بيت لم يكتمل ولوحة غائبة
في العاشر من يوليو/ جويلية 2023، وقبل أن تشتعل غزة من جديد، استلمت شقتي في البرج الإيطالي الذي أعيد بناؤه بعد أن سُوِّي بالأرض في قصف عام 2014. تسع سنواتٍ كاملة من الانتظار، كأنها عُمر آخر عشته خارج بيتي، حتى جاء اليوم الذي فتحت فيه بابه من جديد.
بدأتُ كأيّ إنسان يحاول أن يعيد بناء حياته من الركام: اشتريت الأثاث قطعة قطعة، واختبرت الألوان والأشكال لتنسجم مع ذوقي ومع روح الشقة. لكن كل ما اقتنيته لم يكن يساوي شيئًا أمام الوعد الأغلى الذي حمله لي صديقي وأخي الفنان الكبير "فتحي غبن": لوحة خاصة يرسمها بيده هديةً للبيت الجديد. كنت أترقبها كما يترقب القلب نبضه، وكنت على يقين أن تلك اللوحة ستكون روح البيت، وأنها أثمن من كل ما جمعت.
وفي الأول من أكتوبر 2023، فتحت باب الشقة لأول مرة كسكن حقيقي، وجلست بين جدرانها التي انتظرتني تسع سنوات. أسبوع واحد فقط عشته هناك، أسبوع واحد لا غير، ثم اندلع الجحيم في السابع من أكتوبر. الحرب اجتاحت كل شيء، والنزوح صار قدرنا من جديد.
لكن المصيبة لم تتوقف عند حدود البيت. فقد تزامن نزوحنا مع تفاقم مرض صديقي الفنان "فتحي غبن"، الذي ظل يصارع الألم محرومًا من السفر والعلاج، حتى رحل شهيدًا. رحيله لم يكن خبرًا عاديًّا، فقد كان يعني أن اللوحة التي وعدني بها، والتي اعتبرتها أثمن قطعة في البيت، لم تصلني ولن تصل أبدا.
اليوم، حين أستعيد المشهد، لا أرى الأثاث ولا الستائر ولا تفاصيل الشقة، بل أرى بيتًا لم يكتمل، ولوحة غابت مع صاحبها، ووعدًا بقي معلقًا في الفراغ. فقدتُ البيت كما فقدتُ الصديق، وكأن الغياب تواطأ عليّ مرتين.
ذلك البيت صار رمزًا لكل ما لا يكتمل في غزة: بيت نُعيد بناءه بعد تسع سنوات من الصبر، فلا نسكنه إلا سبعة أيام قبل أن نُنتزع منه، وصديق يرسم بروحه الحياة، ولا يمهله المرض ولا الحرب أن يُكمل لوحته الأخيرة. وهكذا، تحوّل الحلم إلى ذاكرة، والبيت إلى جرح، واللوحة التي لم تُسلَّم صارت أثمن ما لم أملكه أبدًا.
عيد ميلاد تحت الرماد
يمرّ عيد ميلادي هذا العام كما مرّ العام الماضي: مثقلاً بالمعاناة، مثقلاً بالنزوح، مثقلاً بالبعد عن الأحبّة والأعزاء. لم يعد العمر عندي مجرد أرقام تُضاف إلى السنوات، بل صار محطات من صبر، وجراح، وذاكرة لا تهدأ.
في غزة، حيث لا يعرف اليوم أن يشبه الأمس، وحيث الحياة تتأرجح بين الخوف والنجاة، يأتي العيد بلا كعكة، بلا شموع، بلا أصدقاء يتزاحمون حولي بالتهاني. يأتي صامتًا كأنما يختبرني: هل ما زلت قادرًا أن أحتفل بالحياة وسط كل هذا الخراب؟
أحتفل اليوم بالصمود، بالصبر، بقدرة الروح أن تبقى رغم أن الجسد أنهكته الرحلة الطويلة بين نزوحٍ ونزوح. أحتفل بذكرى أنني ما زلت حيًّا، وما زلت أقاوم، وما زلت أكتب.
قد لا يكون بجانبي أحبتي الذين أفتقدهم، وقد لا أملك رفاهية الفرح كما يفعل الآخرون، لكنني أملك شيئًا أكبر: أملك الإيمان بأن هذه الأيام، مهما طالت، ستمضي. وأن العمر، وإن كان يضاف إليه وجع فوق وجع، ما زال قادرًا أن يحمل بذور أمل صغيرة تنمو في القلب كل عام.
هذا عيد ميلادي الثاني في قلب المعاناة. أكتبه لا كفرح مؤقت، بل كشهادة على أنني، رغم كل شيء، ما زلت موجودًا، وما زلت أنتمي إلى هذه الأرض، وما زلت أنتظر يومًا يعود فيه العيد عيدًا حقيقيًا بين الأحبة.
الملاذ الأخير
لم أفق بعد من ثِقل ما كتبته بالأمس عن عيد ميلادي الثاني تحت الرماد، حتى جاءني اليوم خبر أشد وقعًا: البرج الإيطالي، ملاذي الأخير، لم يعد موجودا.
ذلك البرج لم يكن مجرد بناء أسكنه، بل كان ثمرة صبر تسع سنوات من الانتظار، وكان تعويضًا هشًا عن العمارة الأولى التي دُمّرت. كان بمثابة حائط أمان أعود إليه، ومكانًا احتضن تفاصيل قليلة من أحلام مؤجلة.
رحل البرج اليوم، كما رحلت من قبل بيوت وأحلام وذكريات. رحل وترك في القلب فراغًا أعمق من أي جدار مهدوم. شعور قاسٍ أن تُمحى في لحظة آخر مساحة للطمأنينة، وكأن النزوح لم يكتفِ بأخذ الطرقات، بل جاء هذه المرة ليقتلع الملاذ ذاته.
ومع ذلك، أجدني أعود للكتابة. أعود لأنني لا أملك سواها، ولأنني أؤمن أن ما يهدمونه من حجر لا بد أن يُعوَّض في الروح. يهدمون البيوت، لكنهم لن يهدموا قدرتنا على الحلم، ولن ينتزعوا منّا هذا الإصرار على أن نبحث عن حياة، حتى وسط الركام.

الإنسانيةُ
بقلم: أحمد بشير العيلة
الإنسانيةُ:
أن تحمل روحك مشكاةً لتضيءَ قلوبَ الناس
أن تطردَ كل الظلمات من الأفكار
أن تُمسِك بشعاع الضوء كرمحٍ يطعن صدر الظلم.
الإنسانيةُ:
أن تطلق ضوءَ مشاعرك لتكشف عن صور المأساة
أن تشعر بالعطش إذا عطشوا
والجوعِ إذا جاعوا
والألمِ إذا بُترت أقدام العائد لبلاده
أن تشعرَ بالفزع التاريخي إذا انفجرت أحياءٌ كاملةٌ من أملٍ لا يأتي.
الإنسانيةُ:
أن تحمل علمَ فلسطين على أعلى سارية في الكون
أن تهتف باسم فلسطين كثيرًا في كل صلاة
أن تعرف أنَّ فلسطين ضمير العالم
عنوانٌ كونيٌّ لجماليات البشر الماضين إلى ذروتهم
ترمومتر نقاء الأمم الأبدي
بل ترمومتر الحريةِ في كل زمانٍ ومكان.
الإنسانيةٌ:
أن تحمل في الفجر عصا موسى
وتشق البحر لتعبر بسمائك نحو فلسطين
ادفعْ أشرعةَ أساطيل الحرية بغنائك وبهائك ورجائك.
الإنسانيةُ:
أن تتحرر من غبشٍ أسودَ في عقلك
تُعلن: تحريرَ فلسطين سموّاً للبشرية جمعاء.
الإنسانيةُ:
أن تهدم أصنام الصهيونية في أروقة الأمم المتحدة
أن تحرق نظريات المحتلين بساحاتٍ تصعد بهتافِ فلسطين
أن تحتضن المظلومين بقلبك
أن تغسل روحك بدموع الأطفال الجوعى
أن تُشرق في كل صباحٍ خبزاً لامرأة جائعةٍ من غير ذراع
أن تنثر من أعلى سقفٍ في العالم قمح دعائك في أيدي غزةَ
أن تحفر فوق صخور بلادك اسم فلسطين لترجمة مواجعنا المتحدة
ولتكتب أسماء الشهداء
في كل قواميس العالم.
الإنسانيةُ:
أن تتغنى باسم فلسطينَ
وترقص باسم فلسطين
وتكتب باسم فلسطين
وتنقِّي الأرض من الظلمات
باسم فلسطين

رحلة بين دفتَي "الكتابة بأصابع مبتورة" للدكتور "وائل محيي الدين"
بقلم: وليد الهودلي
لماذا هي رحلة فريدة؟ لأنك تجد فيها الثورة بعنفوانها العالي، وتجد فيها النقد الاجتماعي والسياسي القوي الأمين الجريء، وتجد فيها النزف والألم والجرح الغائر، وفي الوقت نفسه تجد فيها حلاوة اللغة وجمالياتها، رغم أنها تمسك بيد قلبك وتخوض به جبالاً وعرة مليئة بالشوك والصخور العاتية. تجد نفسك في مسار يجمع بين الجمال والمخاطرة.
هذا المعترك المشتبك ذاتيًّا في أعماق النص، والمنتشر على مساحات واسعة، والمحلّق في آفاق بعيدة يصعب حصره بوصف محدد المعالم؛ فأي وصف جامع يستعصي على الإحاطة به، لأن الكتابة عند صاحب هذا النص الملهم والممتع في آن واحد: "نسيج لخيوط كفن، ورحلة نحو المجهول، واستعجال للحَتف السياسي والموت المبكر؛ هي أن تقول لا رغم حلاوة الـ (نعم)، ورغم الأثمان الباهظة التي ستجلبها هذه الـ (لا) المقدسة. إنها المطاردة الساخنة للرذيلة ودعاتها، وللخيانة ورموزها، وللعبث بأرواحنا وأعمارنا... الكتابة مخاض عسير، فحاذر ألّا يكون المولود مباركا".
هذه كلمات يمكن أن نعتبرها نبراسًا أو مقياسًا للكتابة المسؤولة ذات الرسالة والهدف وصناعة الحياة. وهي تضعنا أمام كاتب يستشعر ويئن من ثقل الأمانة وحمل أوزارها، كاتب يدرك تمامًا أن له رسالة سماوية تحفر عميقًا في أعماق النفوس وترسي قواعد حياة عظيمة ومستقبل مشرق حرّ لأمة عظيمة ينتمي إليها بكل حروفه وأفكاره حتى النخاع. وهذا أعظم ما لمسته في هذه الروح القوية الأمينة؛ فهي ذات فرع في السماء وأصل ثابت في الأرض. ثم تأتيك هذه القوة عبر جماليات اللغة وتجليات حلاوة قلّ نظيرها.
بروح نقدية عالية، وبلغته الجميلة الخاصة، تجده مثلاً يوجه سهام نقده: "علّمونا صغاراً أن سقوط التفاحة أدى بنيوتن لاكتشاف قانون الجاذبية. ترى، ألم يدفع سقوط الناس الأخلاقي والاجتماعي إلى اكتشاف قانون الحد من الدونية وضرورة السمو إلى الأعلى؟".
وينتقد ظاهرة عبث السائقين المتهورين بأرواح الناس، حين يأتيها بمشاعر الحزن العميق والأسى القاتل وهو يرينا كيف يلمّلم أشلاء طرية لطفل خطفه الموت من تحت عجلات سائق طائش. وتكون المفاجأة المذهلة عندما يكون هذا الطفل البِكر لأسير يرسم لنا حزنه من خلف القضبان على وفاة بكره. فيبكي ويُبكينا بنصه الباكي حتى الرمق الأخير من دمع العين ونزف القلب.
ويرينا في نصه الجميل كيف تكون الكتابة: "نزف يومي دون عناية مركزة. كثيراً ما تراودني نفسي عن التوقف عن الكتابة، ولكن سرعان ما أنحني لعاصفة المشهد وثورة اللغة وإلحاح اليراع واستغاثات قلب لا يكف عن النشيد... ولهذا سأواصل. سأواصل الكتابة لأمي، وفي ظلالها تستريح الحياة على أمل العبور إلى الآخرة. سأكتب للبحر حيث الشر الكامن فيه، ومن كفيه تنبجس اثنتا عشرة قصيدة وملحمة كل صباح... سأكتب... سأكتب للقدس وهي تحني ضفائرها بالنار والبارود، وتكتحل أعينها بالتاريخ وسورة الإسراء، والبحر المتواري خلف الغيوم".
هنا، في هذه المقطوعة الغنية الثرية، يضع كاتبنا نبراساً للكتاب: من تستهدفون بكتابتكم؟ سجل حافل وميادين مفتوحة؛ فالكُل، بكل أصنافه وأنواعه وأشكاله الملتبسة، بحاجة إلى كتابتكم. وكأنه يريد أن يقول: فلا تتوانوا لحظة عن الكتابة.
ويحكي لنا عن بوح الليل وباحاته الواسعة: "لا تُكره قلمك على الكتابة حتى لا تجتر نصًّا مشوّهًا. كم هي لحوحة نصوص الليل! لا أنت قادر على إسكاتها، ولا هي تستسلم لنوم أو هدوء. فقم أيها المتقلب في الفراش، لتقلع النص وتقلع أوجاعه".
الكتاب غني، ويفتح في الروح مساحات واسعة للتأمل مع الفكرة واليقظة والإضاءة على ما نحن عليه من خرائط عربية يحكي لنا عنها حكايته. ولكن الأجمل أنه، وأنت تقرأ الواقع المرّ، لا تغيب عنك البتة متاع اللغة وسمو روحها، ويجعلك عاشقًا والهًا في رحابها التي أفسحت لهذا القلم الجميل أن يحلّق في سمائها العالية.
نحن في هذا الكتاب بين يدي كاتب رافعي جديد قادر على رفعنا إلى سماء اللغة لنحلّق معه عالياً، أجاد عجينة اللغة وخبز لنا خبزًا لقلوبنا وأرواحنا، أشبع قريحة اللغة من ألفها إلى يائها، وقدّم مع خبزه مائدة عامرة فاخرة. والجميل أنه لا أخال أحداً صاحب ذائقة يستطيع أن يقاوم أية وجبة قادمة، بل في ترقب وانتظار إلى أن يجود علينا من شهد ما يفتح الله عليه في الأيام المقبلة.

"أكتب موتي واقفًا" للشاعر "جواد العقاد".. هوامش الكتابة والحرب
بقلم: بهاء رحال
إن الكتابة فعل ألم، فكيف إن كانت الكتابة وسط حرب الإبادة والتهجير، وبين زخات الرصاص والقذائف، فإن الألم هنا يكون مضاعفًا. ولأن الكتابة عن غزة ليست كما الكتابة من غزة، فإن الصوت القادم من عمق المقتلة له نبرة مختلفة لا تشبه البقية، بيد أن جواد كتب من دون تكلف، ولم يغرق النص بالمجاز الذي يثقل المعنى، ولأن الواقع ثقيل بالجراح فعلًا، فقد عمد "جواد العقاد" إلى أن يطبع قلبه مع كل كلمة، وأن يترك روحه تحرس السطور في سطوع المعنى.
بحفاوة قرأت كتاب "جواد العقاد" الذي لم يسبق أن التقينا من قبل. عرفته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقد سبق أن طالعت نصوصه وأشعاره التي ينشرها عبر المواقع، فهو من الأقلام التي لم تسكت عن الكتابة بفعل ما يحدث، بل ظل ممسكًا بقلمه يكتب ليرصد الواقع ويمنح اللحظة شهادة حية، في محاولة منه لتبقى على قيد النجاة، بحروف ترسم الواقع وتخترق الحصار، لتنجو من ويلات المقتلة.
كل حرف له وقع خاص، وكل كلمة بألف معنى في واقع لا يشبه أيّ واقع، وإبادة تقضم الأيام والساعات كما قضمت البشر والشجر والحجر، وفي غرابة ما يحدث يستنهض "جواد" كل ما هو خاص بلغة العام، والعام بلغة الخاص في مشاهد تروي الآلام كما تروي الأحلام، وقصائد تبعث الحياة رغم شظايا الموت، وسرد ينير الوقت في ظلمة الحاضر. إنها مفارقة تبدو عصية على الفهم، في ظاهرها نصُ موت مؤجل، وفي عمقها حياة تستعد لتغسل وجه المدينة من غبار الحرب.
ولأن غزة استثناء فكل قلم يخرج منها استثناء، ولأن هذا الاستثناء تجلي الروح في محاولة البقاء، بنقاء الفكرة التي تنهض من زحمة الموت، صرخة ونشيد حياة، ومعنى لا يحيد، ولا يستتر بمرادفات عدم اللحظة الراهنة وعدمية المواقف الخجولة.
إن ما قدّمه "جواد" في نصوصه من سردية تحمل عذابات الواقع وتعقيدات الظرف والزمان، منحه هذا التفرّد بأن يكون مختلفًا لا يشبه البقية؛ فالكتابة من غزة إعجازُ حبرٍ تدفّق، وقلمٌ تقدّم، وصوتٌ علا مخترقًا الحصار، قام من بين الرماد، وقفز على صهيل المسافة، ليكتب ملحمة الموت والحياة في زمن الإبادة.
"أكتب موتي واقفًا"، صدر قبل شهر من هذا العام عن "دار الشروق للنشر والتوزيع" للكاتب "جواد العقاد" الذي لا يزال يطارد النزوح وعذابات حرب الإبادة في غزة حتى اليوم.

قلب صغير.. بطولة كبيرة
بقلم: لما عواد
في عالم يزدحم بالصور المتكررة عن البطولة، حيث تُرسم ملامح الأبطال عادة بالدرع أو السلاح أو الخطابات الرنانة، في غزة شكل آخر للبطولة، أنقى وأصدق. صغار السن، أبطال لم يختاروا المعركة، ولم يختاروا الصراع، ولم يحملوا سلاحا، ولا راية، ولم يكتبوا خطابا، ومع ذلك أصبحوا رمزا للصمود الإنساني، أطفال غزة.
هؤلاء الصغار فقدوا ما لا يُفقد عادة في عمر الطفولة، بيتا يؤويهم، سريرا يحضن نومهم، مدرسة تفتح لهم باب المستقبل، أو حتى والدا كان يمسك بيدهم في طريق السوق. بعضهم فقد أطرافه، وبعضهم فقد عائلته كاملة، لكنهم لم يفقدوا قدرتهم على أن يكوّنوا حياة تمشي وسط الموت.
في ابتسامة طفل يرسم شمسا على دفتر مهترئ، وفي ضحكة قصيرة تخرج من قلب يعرف معنى الفقد، تتجسد بطولة لا يعرفها العالم إلا نادرا.
إن بطولة أطفال غزة ليست بطولة لحظة، بل بطولة يومية تتكرر مع كل شروق شمس فوق أنقاض المدينة. الطفولة في غزة ليست مجرد عمر أو مرحلة، بل اختبار للبقاء والإنسانية، ويُقرأ معنى عميق للبطولة.
إن البطولة الحقيقية ليست في الانتصار على عدو، بل في الانتصار على اليأس، في الاستمرار، في الابتسامة رغم الألم، في القدرة على اللعب والحلم، وأن تظل قادرا على الحلم بعد أن يُسلب منك كل شيء، هذه بطولة لا يحتملها الكبار.
الرسالة التي يوجهها هؤلاء الأطفال إلى العالم أكبر من أي خطاب سياسي أو إنساني، الصمود اليومي أقوى من أي قوة خارقة.
أطفال غزة هم أبطال الإنسانية، لأنهم يمثلون أصدق تعريف للصمود هو أن تبقى طفلا رغم أن العالم يصر أن يسرق منك طفولتك.
أطفال غزة هم أبطال بلا درع ولا سلاح، لكنهم يحملون أعمق المعاني الإنسانية: الصمود، والأمل والقدرة على أن يكون للطفولة مكان حتى في أصعب البيئات. إنهم يعلّموننا أن البطولة ليست بالقدرة على الانتصار على الآخرين، بل بالقدرة على الانتصار على اليأس والفقدان والظروف القاسية، وأن تبقى حيا بالقلب والروح رغم كل ما فقدته الحياة من حولك.
أطفال غزة ليسوا مجرد ضحايا أو أرقاما إحصائية، بل رمز حي للإنسانية التي تصمد وتقاوم، وتجعل من الصغير قادرا على أن يكون أعظم من أي عدو أو محنة.
أطفال غزة.. وجوه صغيرة تحمل ذاكرة أكبر من أعمارها. فقدوا البيوت، فقدوا الأحلام البسيطة، وفقد بعضهم حتى القدرة على الحركة، لكنهم لم يفقدوا تلك اللمعة في العيون.
يضحكون رغم الغبار، يرسمون رغم الخراب، ويعلمون العالم أن البطولة ليست في امتلاك القوة، بل في القدرة على البقاء إنسانا بعد كل هذا الفقدان.
هم أبطالنا الحقيقيون، لأنهم علمونا أن القلب الصغير قد يهزم أكبر آلة حرب، وأن البراءة قادرة على أن تصمد في وجه أقسى قسوة.
أطفال غزة: "أبطال بلا درع".

همسٌ فلسطيني
الشاعرة: نهى شحادة عودة (ياسمينة عكا)
ننكبُّ على دَثرِ الذكريات
بين نكبةٍ ولجوء
يهمسُ الفلسطينيُّ:
لا يليق بك أيّها المُبْعد
أن تجمع شجَنَك هنا أو هناك
شوارِعُك مَنكوبةٌ
مَلامحُك يغزوها الوَهن
جُرحك لا يلتئم
روحك مُهدَّدة بالقتل
وأيُّ قتلٍ
القتلُ المُنمَّقُ
شهقةٌ شهقةٌ
فقد يَتلوه فقدٌ
تُخبِرك الجدرانُ
بألَّا تجمع صُوَرَك ولا أوْراقك
لا تُغنِّي لِزُقاقٍ
لا تَمرّ مِن مكانٍ
ستغدو غريبًا
ستتآمر عليك جميعُ المدائن
أنا لم أكُنْ طيفًا
ولا عابِر سبيلٍ
كنتُ أريد أن أكون مُمتلِئًا
بِوَجَعي وفَرَحي
فلا شاهد قبرٍ.. تستطيع
أحْرُفه أن تحتوي ألَمِي
ولا قيامةً تَليق بكلِّ هذا التَّعَب
أريدُ اللّقاءَ الأخيرَ على صِبْغته الإنسانية
أخافُ أنْ تُبتَر لي يدٌ
أو حتى إصْبع
أنا يا الله خُلِقتُ تحت مَرمى السِّلاح
لم تُفِدني جميعُ الأدْعيةِ
ولا أصواتُ المآذنِ
ولا التَّنظيماتُ السِّياسِيّة
ولا التّنديداتُ..
فمَنْ أوْهَمَهُمْ بِتَركِ العلمِ
وأنَّ بالتَّهليلِ والتَّسْبيحِ
ننتصرُ على العدوِّ
وبِحَيَّ على الفَلَاحِ
لا الوطنُ تمكَّنْتُ من رؤيَتِه
لم تُنقِذْنِي الأماكنُ
والصَّلوات
لم أتركْ شَعْري مَسدولًا
ولا تعلَّمْتُ هوى الطُّرُقات
أريدُ ضفيرةً مَعجونةً بِنَسيمِ الملائكةِ
بِتَهْليلِ المُؤمنين
ورغيفِ خبزٍ لمْ يَمتلئْ بالدَّمِ
فكَمْ أكرهُ تَنكيسَ الرَّايات
أنا يا الله
أرجوكَ موتًا طبيعيًّا
دُون لَمْلمَتِي مِن الفَجوات
قَتلوا كلَّ شيءٍ فينا
ولم تَزلْ تَتوالى علينا النَّكباتُ
أنا يا الله.. وُلِدتُ
وكلُّ البَنادقِ مُصوَّبةٌ نحو قَلبِي
كلُّ الشِّعاراتِ
كلُّ الأبْواقِ
والأسْلحةِ الكَرتونِيَّةِ
وعلى جِنسيَّتِي تُلْصَق جميعُ الاتِّهاماتِ
عُمرِي تَأرْجَح بِكَفِّ عِفْريتٍ
والأملُ يَغُطُّ ثم يذهبُ
في سُباتٍ
وأنا عربيَّةٌ
لا الأملَ مَلَّ ولا مَالَ
ولا مِلْتُ إلى الخذْلانِ
أن يَمشِي في دَربي بِراحَتِه
ولا لِخَيْبةٍ تَطيرُ في مَلَكوتِها
أنْ تأتي على فُؤادي
وبه تَحُطُّ
يا وَجَعَ الأماكِنِ
الذِّكريات
القلوب المُهتَرِئة
تَفيض دَمعتِي
ولا الحزنُ في هذا القلب يُقْتَلُ
اخْتلطَت الأرضُ بين مِسْكٍ وتَكبيرٍ
بين دَمٍ
ومِن الجُثَثِ الكثير
بين أطْرافٍ سماوِيّةٍ
وشعائر وتَهْليل
أنا يا الله
أنْزفُ مِن كلِّ مَداخل الرُّوح
فلا جِنَان هنا
لا نَهر نُوعَد به
ولو آلافُ الدِّماءِ الطَّاهرةِ
بها تَوَضَّأتُ
أنا قُرْبانٌ لا يُقْبَل ولا يَرجِع أدراجَه
فلا أؤْخَذ بِمِنَصَّاتِ الحُضورِ
أريدُهُ عُمْرًا ولو طَفِيفًا
أن يكون أُسْطورِيًّا
فلا الموتُ يَنْفِينِي
ولا الحياةُ تَصالَحْتُ يومًا معها
ولا كنتُ ما أحِبُّ أنْ أَكون

نرجس الذاكرة
بقلم: سماحه حسون
يا أيُّها الصمتُ الممدودُ على أفواهِنا...
كفَى ما سَلبتَ منّا صِغارَ الحُلم،
فَإنّ في الجُرحِ بَقيّةَ وَردٍ،
وإنّ في القلبِ مَساحةً ما زالتْ تُقاوِمُ الانتفاء.
سَنبقى نُطاردُ أطيافَنا،
نَغزِلُ خُيوطَ الغَدِ من أهدابِ المُعذَّبين،
ونُقيمُ صَلاةَ الصّبرِ في عَينِ أمٍّ،
عَلقَتْ صورتُها على جدارِ بيتٍ مُهدّم،
تُخبِّئُ خلفَ الشقوقِ بقايا ضحكةٍ،
وأسماءَ أطفالٍ لَم يَكبَروا بعد.
فلا الرِّجزُ يُطفئُنا،
ولا القدَرُ يَسلبُنا عُنقَ الأغنية.
إنّا على العَهدِ باقون،
نَرتقُ الذاكرةَ بالخيطِ الأوّلِ من الحُب،
ونُنزِلُ المطرَ من جُفونِنا،
حتى تُورِقَ الأرضُ مَجدداً،
ويَنمو النرجسُ في كَفِّ الوطن
كما يَنمو القلبُ في كَفِّ الأمل.

"أطفال شاتيلا".. حين تتحوّل الذاكرة إلى جرحٍ وراثي
بقلم: أحمد دخيل
قلّبت اليوتيوب ليلة الأمس، باحثًا عن الأخبار، فاقترح عليّ مشكورًا فيلم "أطفال شاتيلا"، قد يكون الاقتراح متربطًا بذكرى المجزرة الشهيرة صبرا وشاتيلا، التي حدثت قبل ثلاثة وأربعين عاما.
من يشاهد فيلم "مي مصري" "أطفال شاتيلا" (1998)، يخرج بانطباع مزدوج: أنك أمام عمل وثائقي، وأمام مرثية شخصية في آنٍ واحد. ليس سهلًا أن تُمسك الكاميرا ندبةً وتتركها تنزف أمامنا، لكن هذا بالضبط ما فعلته مصري وهي تعيدنا إلى المخيم بعد ستة عشر عامًا من المجزرة.
الفيلم لا يلهث وراء صور الدم، ولا يفرّ من فخّ الاستعطاف. إنّه يبني لغته على النقيض: صمت طويل، لقطة مقرّبة، عين تتهرّب من المواجهة، صوت يتردّد قبل أن يكتمل. هذه التفاصيل الصغيرة تُنشئ أثرًا أكبر من أي خطاب سياسي مباشر.
حين ينكسر الكلام، تدرك أنّ الذاكرة أقوى من اللغة. ما يجعل الفيلم مختلفًا هو أنه لا يعرض الضحية كشخصية مسطّحة. لكل ناجٍ حكايته: من فقد أمّه، من حمل صورة الجثث كذكرى أولى في طفولته، من لم يفهم الصراخ إلا بعدما شبّ. لا يوجد "شاهد نموذجي"، بل فسيفساء من التجارب الفردية التي تشكّل، مجتمعة، لوحةً لجرح جماعي.
غير أنّ السؤال الذي يطلّ فجأة من بين المشاهد هو: لماذا الآن؟ والجواب الذي يقترحه الفيلم أعمق من مجرد استعادة للتاريخ. الناجون صاروا شبابًا ثم آباءً، والصدمة لم تتوقف عند حدودهم. كأنّها دمٌ عاطفي ينتقل في الأسرة، فيصحو الابن على خوفٍ لم يعشه، أو يحمل غضبًا لا يعرف مصدره. هنا يتجاوز الوثائقي كونه شهادة عن الماضي، ليصير بحثًا في انتقال الرعب كإرث غير معلن.
على المستوى الجمالي، تعاملت "مصري" مع الكاميرا كرفيق أكثر منها كأداة مراقبة. لم تكن العين محايدة، ولا متطفلة، بل أقرب إلى شخص يجلس أمام الناجي، ينتظر منه أن ينهار أو يسكت. هذه الحميمية هي ما يرفع الفيلم من مجرد مادة تسجيلية إلى تجربة مواجهة.
أخيرًا، يبدو "أطفال شاتيلا" أكثر من فيلم عن 1982. إنه تحذير عن حاضرٍ مهدّد بأن يبقى أسيرًا لذاك الماضي. بل يمكن قراءته اليوم كتمهيد لذاكرة أخرى تتكوّن في غزة: أطفال سيكبرون ليصيروا شهودًا على مذبحة لم يختاروها.
وكما لم يتوقف جرح صبرا وشاتيلا عند لحظته، لن يتوقف جرح غزة عند شاشات الأخبار.

أوراق الحكايا المنسيّة
بقلم: أسمى وزوز
كما في أواخر الفصول المارّة على ذاكرة المنعطف السّنديانيّ التي تترك عنده همس الطّرقات وهي تحضن أوراق الحكايا المنسيّة، يعود أيلول. يعود بشجن الرّوح للخطى التي كانت هنا قبل أيلول الأخير، نعود إلى حنين الحقائب التي خبّأت صورهم ذات سنين، وخَرْبَش السّفر أثر خطاهم يوم كان الرّيح من هنا يمرّ.
أيلول بداية النّهايات، ونهاية البداية، وآخر الكلمات المنسيّة، وبداية عمر الخريف الذي نقف فيه بين مهبّ ذاكرة القلب وشريان النّسيان أو التّناسي، بين خطى العمر الذي مضى دون أن يكترث لعُمرٍ سيأتي أو رحل منذ سنين. أيلول حبّ المدى، ومدى الأعوام التي تركت الرّوح معلّقةً على سيقان التَين التي سرقت التّغافي في زمن الأوغاد.
ما هذا الصّخب الذي يتركه عبور المدن الخاوية فينا، وما بال أيلول الذي نصحو فيه على هذيان شرايين الحياة يوم تقرع الطّبول؟ ما بالنا في أيلول نخطّ البداية ونحن بوهم النّهايات معترفون. ما بالنا يسكننا البحر والأفق السّرمديّ ولعنة المصير؟ ما بالنا نأكل تراب الذّكرى، ونحن بقبضتها نتوه. ما بالنا بهذا التّناقض الذي يبني من الرّمل أسوار الزّمن الأبدي؟ وَلِمَ نخفي اعترافاتنا المتعبَة من البوح وثرثرة العمر العصّيّة على قارعات المنعطف الأيلولي؟
فها أنت يا أيلول، من رحلتك الطّويلة تعود بين سنديان الذّكريات ويباس العشب، فقد عدتَ؛ لتمنحني بعضًا من حبٍّ وسكون. أعدني يا أيلول، أعدني لصدى صوت العمر الآخر الذي كان قبل الموت بمكانٍ وزمانٍ أبعد من عمر الرّيح فيك. أعدني؛ لأكتب رواية الفصول بعد عبورها الأخير.
(اللوحة للفنان علي عبد العال)
خيمة وعتمة لا تنتهي
بقلم: عبد السلام عطاري
أُروّضُ الرّياح لتهدأ، تهدأ
فهذا الشّتاء قاسٍ،
والبرد لا يعرف الجسد الطريّ
أجسادهم بلور الرّمل كان
والخيام ممزقة تندب الصّوت،
الصّوت الذي كتمته الحناجر الباردة،
الباردة على مصاطبِ الأمم
فلا صراخ يأتي بالمطر،
ولا بسقفِ ألواح الحديد الصّدِئ
والمطر الذي يُطفئ الشّوق للشّمس الغائبة
الشّمس التي غابت في البئرِ المكسورةِ،
ولا دلاءَ ترفع الدُّعاء من لُجفِ عتمةٍ لا تنتهي،
أضيئي بعينكِ ليَطلّ ما ظلَّ من نهار
أضيئي، كي يرى طفل الخيمة عالم السُّوء
ويُطفئ الضّوء على الخيبةِ ويُشعل في العتمةِ النّار.

خريف آخر
بقلم: غدير حميدان الزبون - فلسطين
أيّها الزمان، أيّها العجوز الذي لا يشبع، أيّها الصامت الذي يسمع كلّ صرخة في قلب الأرض، وكلّ أنينٍ على وجه الحجر، وكلّ دمعةٍ تسقط على سنابلنا كما المطر. أما ارتويتَ بعدُ من دموعنا التي انهمرت على حجارةٍ لا تلين؟ أما مللتَ من حصاد أعمارنا، كأنّك منجلٌ لا يكلّ، أو عاصفة لا تهدأ؟ أما ضجّت منك الساعات، وتصدّعت منك الدهور، وقد أخذت من سنابلنا ما لم تأخذه يدٌ ولا ريحٌ ولا طوفان؟
أيّها الخريف الذي يمدّ أصابعه اليابسة إلى جذورنا، متى تكفّ عن صبغ الشجر بلون الغياب؟ ومتى تدع لطيورنا أعشاشها، ولأنهارنا مجاريها، ولأطفالنا ضحكاتهم التي تلمع مثل نجومٍ فوق خرائب الليل؟ ومتى تتوقف عن خطف الشمس من سمائنا، وعن إسكات الريح بين الجبال، عن قصف أحلامنا قبل أن تولد؟
إنّنا هنا، على حافة الخريف، نحمل في أعماقنا قصص الأرض، وقصص الطلائع الأولى التي شقت طريقها في الحقول، وفي البيارات، وفي البيوت القديمة.
نحن الذين خرجوا من العتمة حاملين شعلة الإيمان والصبر الذي يسطع مثل الشمس بعد غيابها الطويل.
ونحن الذين علّمنا كفّ الدمار أنّ الحياة لا تُقاس بالأيام، بل بالثبات أمام السقوط، وبالقدرة على زرع الأمل وسط الرماد، وبالإصرار على المضي رغم كلّ العواصف.
لكنّا - وإن توالت علينا الفصول، وتكسّرت على صدورنا الرياح - لا ننحني إلّا في سجودٍ للواحد القهّار، ولا نعرف الهزيمة إلّا في عيون الطغاة، أولئك الذين يظنّون أنّ الشمس يمكن أن تُؤسر، وأنّ القمر يُساق بالأغلال، وأنّ الأرض تُباع كسلعةٍ في أسواق الغزاة.
خريف آخر؟ فليكن! نحن أبناء الينابيع الأولى، نحن الذين شربوا من دم الطلعة الحمراء لشقائق النعمان، نحن الذين ورثوا من أجدادهم صلابة الصخر في جبال القدس، وغناء البحر في يافا، وصبر الزيتون في جبال الجليل، ورائحة البرتقال في بيارات غزة.
ألسنا نحن الذين خرجوا من ليلٍ طويل كالسيوف المسلولة؟
ألسنا الذين حملوا في قلوبهم نارَ مريم العذراء، ودم يوسف المسفوك ظلمًا، وصوت داود وهو ينشد مزاميره بين جدران التاريخ؟
ألسنا الذين عانقوا جراحهم حتى صار الجرح وسامًا، والوسام راية، والراية وطنًا يولد فينا كل صباح؟
أيّها الخريف، إنك وهمٌ أمام خلودنا، فكلّ ورقة تسقط من شجرة ليمون في غزة، تُنبت في الجليل غصنًا جديدًا، وكلّ قمرٍ يُطفأ فوق نابلس، يُوقد في عكا مصباحًا أبديًا. وكلّ بيتٍ يُهدم في القدس، يُبنى في أرواحنا بيتًا أوسع من السماوات.
نحن ملحمةٌ لا تنتهي، نحن القصيدة التي لم يكتبها شاعرٌ واحد، بل كتبتها الأمهات بدموعهن، وكتبها الشهداء بأنفاسهم الأخيرة، وكتبها الأطفال بضحكاتهم بين الركام.
نحن الحكاية التي تُروى في كلّ جيل، والنداء الذي يعلو في كلّ مئذنةٍ وجرس، والظلّ الذي يمشي مع كل عاشقٍ وحالمٍ وحارسٍ للأمل.
وقد صدق الوعد الذي جاء في التنزيل الحكيم: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (سورة القصص: 5)
نحن الذين تعانقنا مع التراب حتى صار التراب جلدًا لنا، ومع السماء حتى صارت السماء أوطانًا لنا، ومع الريح حتى صارت الريح بشائرَ لنا.
خريف آخر؟ لا بأس! فبعد كلّ خريفٍ يولد ربيعٌ عنيد، وبعد كلّ انطفاءٍ يشتعل قنديلٌ من دمنا، وبعد كلّ شهيدٍ تنهض ألفُ حياة. لن نترك الأرض، ولن نخون العهد، لأنّنا لسنا عابرين في الكلام العابر، بل نحن الكلام الذي يُعيد للكون معناه، والقصيدة الثائرة على الطغاة.
امضِ أيّها الخريف بما شئت، فليس لك فينا موطئ قدم. نحن عناقيد خلود، نحن موكب أساطير، نحن ظلال الأبطال الذين يمشون بيننا، يوقظون فينا مناديل العائدين، ويدقّون على أبواب الغد بأناشيد العودة.
وأمّا نحن، فسننسجُ النور من خيوط الشمس، ونرسمُ بالأخضر والأبيض والأسود والأحمر أغاني الصمود، وجلاجل العودة. نهيمُ بأرضنا في رياح الخريف ونستظلُّ بأحلامنا. نفوحُ بالحروف، ونرشفُ من أنفاس الوطن، ونزرعُ البقاء في كلّ فجوة، وفي كلّ دربٍ، وفي كلّ قلبٍ.
هنا فلسطين، هنا صدى القلوب، هنا نحن باقون، ولا زلنا نحلم، ونحملُ العلم، يرفرفُ فوق الزمن، فوق الرماد، فوق كلّ غياب. نخطُّ الحياة، ونحتضن الروح، نغني المستقبل، وننسج الحرية كلّ يومٍ من جديد.

غزة تسير نحو البحر
بقلم: سامي عوض الله البيتجالي
يا بحرُ أينَ مدينةٌ
عَشَقتْ بشاطئك الوقوفا؟
كانتْ تزوركَ في الصباحِ
وتستحمُّ بموجكِ العالي
وكنتَ بها شغوفا
كيف اختفتْ تحت الرمادِ
ولم تعد؟
لا سقفَ ظلَّ ولا رصيفا
لاذتْ إلى شطآنكِ الباكي
فلا تعصفْ بها
وكنْ يا بحرُ سجّاناً شريفا
واحبس سياطَ الريحِ
حتى ينصبوا خيْم النزوحِ
ويستعيدوا أُلْفةَ الأمواج
إذ أمنوا إليكَ
فكن لهم جاراً لطيفا
وارسلْ عليهم، حين يغفوا ساعةً،
مَطَرَاً خفيفا
يا بحرُ قد وقفوا على الميناء
ينتظرون ان تأتي السفينةُ
لا لتحملهمْ الى المدنِ البعيدةٍ
بل لتحملها إليهم
في تّوَحُّدِهم
ويزدادوا صفوفا
يا بحرُ انت الثابتُ الازليُّ
والصحراءُ خلفي
والرمالُ طبيعةٌ
فيها التبدلُّ والسرابُ
فلا وثيقَ ولا مُنيفا
ما بين غربٍ مُبحرٍ
فد شاءَ ان يدنو
وشرقٍ واقفٍ ينأى
تسير خطايَ نحو البحرِ
تنشدهُ وقوفا!

من نحن؟
بقلم: د. إيهاب بسيسو
-1 -
تنقصني نافذة واحدة
بحجم سماء صافية
أطل منها على تضاريس العالم...
دون طنين "الكواد كابتر"
الصاخب في رأسي...
تنقصني يد مكتملة
بكف وخمس أصابع
غير مهشمة...
ألوح بها لشاطئ من ضوء
في خلايا المخيلة
هو اليابسة...
ينقصني صباح واحد
(صباح واحد فقط)
من صدى طفولة قرب البحر...
لأرتق ما تبقى
من ملامح وجهي المهترئ
بين شحوب الوقت
وذاكرتي الممزقة...
- 2 -
عزيزي نيتشه،
أعلم أن الموت
حالة جسدية مؤقتة
لن تعيق ذهنك الحي
في الفضاء السرمدي
عن متابعة التفكير
في علامات الوجود
وطبيعة الانسان
الملاصقة للعدم...
غير أنني ولسبب مجهول
بعد سماع نشرة أخبار جديدة
عن الإبادة المتدحرجة
كرة من نار
في رؤوسنا المنتفخة
بقش الخيبات...
أتساءل بفضول
كهل من تعب
بين أنياب مذبحة:
من نحن؟
- 3 -
أروّض الخيبة
كي لا تندفع ذئبًا
في لحمي...
وأكره الليل "الأسخريوطي"
الذي يتقدم طوابير الجنود...
وأنصت على مدار الصخب
لإيقاع الجنازة في دمي
انتظاراً لبزوغ القيامة...
- 4 -
القوارض التي اعتادت
تمزيق لحم الجثث
في الكوابيس...
القوارض التي اكتسبت
مهارة القفز بين الأنقاض...
تضخمت في الفراغ الرمادي
لتصبح بحجم أجساد بشرية
ببدلات داكنة
وأربطة عنق
وحدقات من رصاص
يقطر دما...
- 5 -
حلمت ذات ليلة
بأن طائر الدوري
الذي اعتاد الغناء
على أفرع شجرة السرو
في حديقة البيت...
قد صار وجبة غامضة
في صحن عشاء جنرال
من صخب...
وعندما استيقظت...
وجدت يَديَّ
قد صارتا ظلالاً هامدة
لجناحين من رماد...

سيف الحق
بقلم: مبين كيوان
سأصمت
ربما شهرا وأكثرْ
وصبري لن يطول كما يُقدّر
سآتي صارخاً
من جوف قهر
كبركانٍ بنيرانٍ تفجَّرْ
حذارِ حذارِ من سخطي
فإني
أحطِّمُ كلَّ جبّارٍ تكبَّرْ
أنا ابنُ الأرضِ
لي فيها جذورٌ
بها أبقى
ومنها لن أُهجّر
رباطي سيفُ حقٍّ لا يُجارى
وحرفي شعلة
كالشمس يظهر
سأمضي والحروفُ تحوم خلفي
ومن حولي
بها غضبٌ وتزأرْ
سأمحو الليلَ إن ثارت حروفي
وأزرعُ في الدجى
فجراً تحرر

لعنة قدر
بقلم: خالد صافي - غزة
لعنة قدر تجرفنا
في فيافي التيه
مسالك الدجى الحالكة
لهاث عطش
في متاهات السراب
لا شيء سوى
صدى النحيب
على امتداد الشاطئ
وشاح الحداد
على أرصفة الطرقات
هياكل جوعى
نهارا تفترش دروب
تكية عدس
وفي الليل تسكن مزق الخيام
لقمة الخبز مبعثرة
بين الدماء والرمال
لا مكان لنعل
في الأقدام الحافية
لا ملابس
تدثر السيقان العارية
كل من يخطو
متعب العينين
من حمم الموت العاتية
تناثر الحلم الصغير
وراء غياهب وحجب
من غبار الرماد
وتنحى الفجر عن صهوة اللحظة
نحو البعيد البعيد

من صبرا إلى غزة.. الصورة تتحدث
بقلم: مصعب عيسى
أيلول ذاك الموسم الأصفر يوقد في الذاكرة أنينا جمعيا.. خريفا من دم ورماد ومقصلة للموت المتنقل لا يتوقف. تأخذ إذنا بالإعدام... فيصاب الجسد المطعون بدوار البحر القريب من كل مذبحة ومن كل جريمة... بحر من الحبر في فوهة الوقت يتجمد مداده الكحلي على رمل الشاطئ.
في الجوار صليبنا الأزلي يتربص برائحة البرتقال... وسط الساحة تتبعثر الكلمات في تلك النار الموقدة مذ... أضرم هسيسها الأول في تاريخ الأرض بأكملها... وصلت مفردة الحزن الى فم الاختناق فأصيبت بالخذلان... راحت حروف الإلياذة تتشكل من طين وسراب تستجمع كل قوافي الشعر العربي لتنسج شطرا يفي بالمجزرة...لكن عبثا حاولت الكلمات ...
ثمة لغة مهزومة.. مكتملة النقصان تدور حول الدمية الخشبية.. حول جواري السلطان.. لغة كاملة مخصية أصيبت بحمى التعدي والاعتداء فراحت كل الاسماء تحمل ضدها.. وحتى الأفعال بين عرب وأعراب، وعرض وأعرض، ومستوطن حل امتعته على الثرى.. فأحل له المنطق الدولي احتلالنا وإحلالنا.. وتحليل هويتنا.. بماء النار. ثمة وطن اعرابي معتل بالضاد.. وطن مضاد للأمل.. ومصاب بالأضداد.
وما زالت تستعر النار في الجسد المصلوب على دفتي التاريخ.. من أوقد هذي النيران منذ زمن هو ذاك "الأسخريوطي" الناقم على اليسوع الفلسطيني.. تقنع بالإسفلت وبالفولاذ وتهادى رويدا رويدا في خطوته يتكئ على رقاع اتقن حرفتها وتحريفها واحتراف تيهها المزعوم... بين رمال الارض وسرابها الموهوم... من علاه فوق تراب الأرض... من اعطاه هذا الوهم... حمل لغة الأعراب وطلاسم الأحبار ثم جاب الصخر بالواد... ونقش سفرا من وهم أوهمهم أنهم شعب الله المختار... فأصبحنا شعب الله المحتار مذ دخلت حروف التعدي والمعتدي... إلى أزقة تاريخنا والكتاب..
راحت النار تبتلع التاريخ أثرا تلو أثر... وشاهدا إثر شاهد أينما وطأ لهيبها... إحالته إلى رماد.. (ثمة معضلة أن تلتهم النار التاريخ).
من يخسر تاريخه، يخسر الجغرافية، وما بينهما من سحاب.. أترانا نحرق تاريخنا بأيدينا وأيادي المحتلين.
على شاشة التلفاز بث حي ومباشر... لحريق يضرم في مدينة بلغت ضربا عميقا في التاريخ يقدر بخمسة آلاف عام قبل الميلاد على يد وهم عمره سبعة وسبعون عاما وقبائل مأجورة تصب النفط على النيران!
ألا يوجد في محاريبها قطرة ماء.. لكربلاء العصر.. ونبي صاح الليلة ملئ السماء؟
في المدينة حي يُسمّى "صبرا"، يتربع جنوب التاريخ الذي يشهد محرقة حية... "صبرا" شاهدة وشهيدة على المأساة المتسعة مذ حاك المحتل خيوط اللعبة.. وأصدر أمر اعتقال بحق الفكرة فوأد الحرف المقاوم.. وصادر الحبر السري، ولفق للعالم كذب الدولة المفتعلة... صبرا في غزة اليوم جريحة تعيد ذاكرة الدم النازف على أسلفت المخيم هناك شمال الفردوس العائم على جذر يبوس... وساق النكبة.
تبكي غزة في صبرا، ونبكي مجزرة تلو الأخرى.. وذاكرة تولد دما ورصاصا.. بين مخيم صبرا وغزة برزخ من الذاكرة الملتهبة يبلغ ثلاثمائة كيلومتر من الدم المسفوك على طول الطريق الواصلة... يلزمك نظريا ساعات بالحافلة وبضعة أيام سيرا على الأقدام. لكن في معادلات النكبة يلزمنا مثلث رأسه في بيروت وقاعدته في غزة ونضرب وتد الأرض بمعمقها.. نصل إلى ناتج مفاده أن الطريق الواصل بينهما يوازي الطريق من مسقط الى طنجة... ومساحة للجغرافية المتآكلة... وتاريخ يتهالك... لن يعلو ارتفاعه إلا بالمقاومة.
غزة تاريخ يتساءل عن شكل السفك القادم.. ولون المقصلة التالية. ورائحة الجسد المتفسخ في الأرض العارية إلا من يدين إحداها تخيط الصبر دعاء، وتناجي الله بترتيلة عشق كنعانية.. وصلاة استسقاء للفرح القادم.. أتراه يأتي حقا!!
ويد أخرى تراكم الرماد التاريخي فوق أصابعها.. وابيضت من رمل المجزرة.. تفرك إصبعا بالآخر تولد دفئا باطن... تتزايد دورة الإصبعين فيمتد من الخنصر للسبابة.. وتزيد حرارة الدم في اليد المدفونة.. يواصل فعل الضغط بين الأرض واليد... هناك لوحظ وهج من عمق الرماد يضيء... تستعر النار في الجسد البارد... يولد من رحم الرماد طائر.. يحفظ للتاريخ وصاياه.. يربت على كتف الأرض الموجوعة... فتحمر وجنتاها ويطيب ثراها... وتقبل ثغر حبيبها، وهي تعد له وسادة من جذر ورصاص.. وتقرأ عليه نصا لدليلة... ودلال... وسناء.. وسطرا من تاريخ بقاء... أنت الأرض الثكلى بالتاريخ.. أنت الجغرافيا.. وأنت السحاب.. هذي وصية جدّك الأول من يبوس... إلى إيلياء... وتلك حمامات تحمل أرواحا تحوم على المجزرة.. لا وقت للحزن.. لا وقت للرثاء... انهض... وقاتل.

رسوم على جدار..
بقلم: عمر حمش
القذائف..
قطاراتُ سماءٍ؛ تنفلتُ عن قضبانها، تموجُ قبيل الانفجارِ، ومن بعده لحظاتُ سكونٍ تقطعُ أنفاسنا.
نحملقُ فقط، من بعد أن كنّا نميد، ونخمّن مَن الذين هوت عليهم السقوف..
أصحو، وأغمضُ من حولي صغار، ومن خلفي عرباتُ الإسعافِ، وخشبٌ يقومُ من خلف دواب.. يَصّرُّ، ويزحفُ بالجثث المهتزّة.
مَن يُسعفُ الذين صاروا تحت الردم؟
وأغرقُ في الصّغار، وفي جدارٍ يقابلني.
كلما اهتزّ؛ قشّرُ دهانه، ليصنعَ وحوشا، وخرائط.
يرتجفُ الأصغرُ:
أنت خائف يا جدي.
أنا أصيرُ ذُبابة.
قشورُ الجدارِ تستحلبُ أمّي..
تقطُرها في قطرةٍ، ويشهقُ قلبي.
ترفع جبهتها عن سجادةِ صلاةِ، وتشهرُ كفّيها، وعيناها ترسلانِ دمعا، يتتبع ولولة الكونِ.
الأبواقُ تصرخُ، والأسواطُ تحثُّ البهائم، وفي حضني بقايا أطفال..
أنا أيضا طفلٌ:
أمّي!
خطوطُ الجدارِ كلابٌ، تراوغُ حواف الخرائط.. أمّي تسكب تعويذةً، وتُميلُ كتفا، يسدلُ شَعرا، ويرسم وجها.
ماذا تصنعين يا أمي؟
هو!
أتفحصُ الشارب المشذّبَ تحت العينين الغامقتين.. الكفّ المتثنية تسندُ الجبهةَ المائلة، وفي الأخرى قلم.
هو، أي والله.
يبتسم: عرفتني؟
أقول: وكيف صرتَ غسان كنفاني؟
يقوم أبي، وغسان؛ اثنين في واحدٍ.. يرجمانِ جيش الكلاب، ثمّ يلاحقان شخصا يجري.
يستديرُ أبي، وغسان؛ اثنين في واحدٍ.. يصرخان:
عرفته؟
جوفي الذي صاح:
أبو الخيزران..
ويأتي انفجار..
يأتي؛ وأمّي من على السجادةِ تومئ، ويتفسّخُ الجدارُ.. تتناثر الرسومُ، وينداحُ أبي، وتهوي أمّي، وفي زاويةٍ؛ علَقَ قليلا غسان..
أنا بلا اتزانٍ؛ أرقبُ تهاويَ النثار..
في السقفِ؛ الكلابُ تلوكُ لحما..
معهم أبو الخيزران كان هناك يُزمجرُ، ويرفع فكّيه، ويقهقه.

قدرٌ بَيِّنٌ في البيان
شعر: سائد أبو عبيد
سَيسَّاقطُ الماءُ عمَّا قريبٍ
يُباغِتُ ما حمَلتْ وردةٌ مِن رَمادٍ على رأْسِها
وينهرُ عن جيدِها سَطوةَ النَّارِ..
ما قدْ تَمسَّدَ من حبلِ آهاتِها في الدُّخانْ
سيسَّاقطُ الماءُ فوقَ مَساماتِها..
خاشِعًا نحو سَاقٍ تَهِمُّ على فَركِ خَطوتِهَا..
في اسْتدارةِ مِشيَتِها النَّرجسيَّةْ
سيسَّاقطُ الماءُ في هُدبِها
فوقَ مِنديلِها
قربَ مِشكاتِها
في عُيونِ المرايا التي ما اكتحلنَ بها!
بعدمَا قد طَّغى في العيونِ الرَّمادْ
سَيسَّاقطُ الماءُ في زهرِنا
مَنْ يراهُ!
ومن يُبصِرُ النَّزفَ في الوردِ!
في مِعصَمِ البيتِ، آخرَ ما قد تبقّى لهُ في المكانْ!
ومن يسأَلُ اللهَ عن صُوَرٍ في التَّلاشيَ قد غبنَ حشدًا
فإنَّ الملاحمَ يأْكُلنَنا في الدُّخانْ
ومن يسألُ اللهَ عنَّا جميعًا
وعن موتِنا والغيابِ السَّحيقِ، السَّحيقِ!
وعن قدرٍ بيِّنٍ في البيانْ!

ألم الجوع
بقلم: رمزي نادر
أطفاله جياع لم يقو على سماع صرخات بطونهم والنظر إلى وجوهم الشاحبة فهرب ليصطدم بوالدته المسنة مرتطما بعظامها البارزة لشدة هزالها فسقط على الأرض من شدة الفزع ليجد نفسه بجوار والده المسن الملقي على فراشه ممسكا بطنه من شدة الجوع زحف، ليجد نفسه على باب خيمته واجدا جيرانه يعدون لحق بهم إلى حيث تقف شاحنات تحمل أكياس الدقيق.
ونظر إلى مشهد كأنه يوم الحشر، لكن صورة أطفاله دفعته لاختراق الصفوف وكأن قوة خفية سرت في جسده الهزيل، فصعد على متن الشاحنة واحتضن كيس دقيق كمن وجد حبيبا بعد طول غياب. لكن القدر لم يرد لجوع عياله ومعاناته أن تنتهي نظر إلى قدمه، فوجد دخانا يتصاعد منها، ولم تعد قادرة على حمله فسقط عن الشاحنة وما زال يحتضن الدقيق وينظر إلى الناس سائلا المساعدة، ولكن الناس كأنما أصابها الصمم، توسل توسل وصرخ ولم يجد مجيبا. وفجأة انحنى أحدهم نحوه فظن أن أحدهم تحركت نخوته لكنه فوجئ أنه يسحب كيس الدقيق الذي ظل متشبث به ولم يعد لديه من القوة للتمسك به فصرخ قهرا وألما.
ولم تقف صدمته عند هذا الحد فهناك من فتش جيوبه لعله يجد فيها ما يخطف من مال أو هاتف وكأنه في غابة من الوحوش التي تخلت عن إنسانيتها. وبعد طول معاناة وفقدان الأمل في إيجاد من يمد له يد العون صرخ على سائق الشاحنة أرجوك ساعدني وغاب عن الوعي ليصحو على باب المستشفى والسائق يسلمه بأنه قد فارق الحياة، يقول الشاب: التجربة كانت مؤلمة جدا لكن ليس ألم الجرح أو الرصاصة ولكن ألم الحال الذي أصبحنا عليه. القصة ليست خيالا، صاحبها حي يرزق في بداية رحلة المعاناة مع العلاج، تاركا خلفه أبناءه الجياع.

هل يرانا الله؟
بقلم: آلاء القطراوي - غزة
أتأمّل هذا الخرابَ الكبير، البيوت المدمرة، النساء الثكالى، الأرامل، اليتامى، المقهورين، المشردين، النازحين، الجوعى، العطاشى، المغلوبين على أمرهم، وأسأل: هل يراهم الله؟
أنظر إلى البيوت المقصوفة، المدارس المهدومة، المستشفيات المحروقة، الشوارع المجرفة، وأسأل: هل يراها الله؟
أنظر إلى الأطفال العالقين تحت الركام، يقف رجال الدفاع المدني عاجزين أمام إخراجهم فيموتون اختناقاً وأسأل: هل يراهم الله؟
أنظر إلى الذين لا يجدون قوت يومهم، يبيتون جوعى ويستيقظون جوعى، إلى النازحين الذين تكسرت عظامهم من النوم على الأرض، وتفتقت جلودهم من حر الشمس، وقرص البعوض، وتقطعت أوتار عضلاتهم من حمل الحطب ودلاء الماء، وأسأل هل يراهم الله؟
أنظر إلى الجرحى الذين يئنون لا يجدون أدوية، إلى الذين بترت أطرافهم فلا يستطيعون الحركة، يستصرخون للحصول على تحويلة طبيّة تعيد لهم الأمل، وأسأل: هل يراهم الله؟
الحقيقة، نعم الله عز وجل يرى كلَّ هذا، إنّه يرانا فهو المحيط بنا، وإن ظننا أنّ الاحتلال المتجبر هو الذي يحيط بنا بدباباته من البر وبوارجه الحربية من البحر وطائراته من السماء، لكن الحقيقة في الآية القرآنية "وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ" (البروج، الآية: 20)، يعني إحاطة العدوّ هي إحاطة جزئية قاصرة مؤقتة فانية، بينما إحاطة الله عز وجل هي الإحاطة الكلية الحقيقية الكاملة السرمدية الدائمة، دائماً هنالك عناية إلهية وإحاطة لا تبصرها بتقديركَ البشريّ، لكنَّ الإحاطة الإلهية ممدودة وغير منقطعة، وإذا أتيح لي أن أرسم قطاع غزة، فسأرسم حول خارطته دائرة كبيرة، وأكتب عليها
(الإحاطة الإلهية)، والمسلم سبحان الله لا يحتاج شاهداً على أنَّ الله يرى كلَّ هذا، ذلك أنَّ جزئية أنَّ الله يرى، ذُكِرَتْ بهذه الصيغة، مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في سورة العلق " أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ" (الآية: 14)، وحين بحثتُ عن تفسير هذه الآية، وجدت بأنّ الله أنزلها في "أبي جهل"، حين كان ينهى سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) عن عبادة ربه والصلاة له، فأراد الله عز وجل أن يقول لأبي جهل ألا تعلم بأنني أراك وأرى أفعالك المشينة هذه وظلمك وتجاوزك عليّ وعلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكأنّ إثبات (أنَّ الله يرى) ليست للمسلم، لأن المسلمَ الحقَّ لا يشكُّ في مسألة هل الله يرى حاله أم لا، أمّا الكافر فيشكّ، ولذلك نزلت الآية بهذه الصيغة مع أبي جهل لكفره، وكأنها جاءت لزجره وتخويفه من رؤية الله له، لكن لِعَظَمِ هذا الابتلاء بغزّة، لا بأس أن يتذكّرَ المسلمُ أنَّ الله يرى حاله، وأن يسألَ: "هل يراني الله؟"، ويجيب على سؤاله، ويصرخ بأعلى صوته في نزوحه وجوعه وألمه ونزفه وصبره: :الله يراني، أنت يا الله تراني، يكفيني أنك تراني، وإن أغمضت الكاميرات عيونها عني، وإن أغمض مجلس الأمن عيونه عني، وإن أغمض الحقوقيون الكاذبون عيونهم عني، وإنْ ظلَّ هذا العالمُ أعمى أمام إبادتي، أنت تراني، مالكي ومالكهم ومالك هذا الكون".
حين يملؤك ذلك الإحساس، وتعلم أنَّ الله بصيرٌ بك، وسميعٌ لك، ومحيطٌ بك، يهوّن عليكَ مشقّةَ السؤال، والبحث عن الإجابة، فتدرك في لحظةٍ أنّك لا يجبُ أنْ تكونَ مثل أبو جهل أعمى عن رؤية الله لك، بل يجب أن تكون مسلماً حقّاً كما علّمك الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم)، فالمؤمن الحقيقي يرى بنور الله كما وصفه المصطفى (صلى الله عليه وسلم) حين قال: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله"، فحين تتحقق بهذا الإيمان العالي، تبدأ ترى بنور الله عز وجل، فترى الألطاف الإلهية في أقسى الابتلاءات، حينما ترى الشهداء تراهم فائزين أحياء قد نالوا خير الدنيا والآخرة، يضحكون، يستقبلهم سيدنا محمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، ينتظرون أن يشعر الذين لم يزالوا في الحياة الدنيا بأنهم في أفضل حال وأن يتوقفوا عن الحسرة عليهم، ترى البيت الذي انهدم كالسفينة التي ثقبها سيدنا الخضر (عليه السلام) في سورة الكهف، فيغدو في كل حجر وقع خير وأجر وعلو وجبر وعوض ينتظر صاحبه، يرى القدم التي انبترت قد سبقت صاحبها تعدو في الجنة وتنتظره هناك، تصبح ترى الأشياء على حقيقتها، فتتأمل الدنيا في معناها الحقيقي فأصلها من الدنو والتدني، يظنُّ الذي يعيش في داخل غزّة بأنه مظلوم محروم محسور، لكن مَن يعلم الحقيقة الكاملة؟ علّ الرحمة الإلهية كلها تنصب على من يعيش في غزة واللطف العظيم وهو لا يعلم، وعلّ الذي هو خارج غزة في العذاب ومنقطع عن فيوضات المدد والرحمة التي لا تنسكب مثلما تنسكب في غزة لخصوصية الشهداء والصبر والاحتساب، وربما حين نقف يوم القيامة، سيتمنى أهل الأرض لو كانوا معنا، لعِظَمِ الأجرِ عندَ ربنا الحكيم العدل الحق، وسبحان الله أتأملُ كثيراً حالَ أهل بدر، 313 رجلاً غيّر الله بهم مجرى التاريخ، وأعزّ بهم الإسلام، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، معناه أنّه ما ضرّكم ما فعلتم بعد ذلك يا أهل بدر، وكأنّ الرحمة والمغفرة التي تنزّلتْ على أهل بدر، سترافقهم إلى آخر نَفَسٍ في حياتهم، معنى عظيم ومخصوص، ولم يكن لأحد غيرهم، وهذه الخصوصية منتقاة، لا يصطفي المرء نفسه، إنّما الاصطفاء إلهيٌّ بحت، قياسًا على خصوصية الشهداء في قوله تعالى: "وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ" (آل عمران، الآية: 140)، فكما يتخذ الله الشهداء ويصطفيهم، أيضًا يصطفي الصابرين، ويصطفي المهتدين، ويصطفي المتقين، ويصطفي الذين يرون بنوره.
يا أهل غزّة علّ الله نظر إلينا نظرةَ رحمةٍ فلا يضرّنا ما فعلنَا بعد هذا الابتلاء العظيم، علّ الله يرحمُنا بهذا الابتلاء العظيم، ويدرأُ عنا سوءًا أعظم ظاهرًا وباطنًا، ونحن لا نعلم ذلك. علَّ الله يريد أن يكافئنا مكافأة عظيمة لا تتوقّعها عقولنا فكان اختبارنا عظيما هكذا، يُعزّينا أنَّ الدنيا اختبارٌ، وأنّها لا تساوي عند مالكها جناحَ بعوضة، فكيفَ تكونُ ثقيلةً عند المملوك؟ فالصبرَ الصبر، فإنَّ مع العسر يسرا، إنَّ مع العسر يسرا، ويكفينا أنَّ الله يرى، وكلّ شيءٍ عنده بمقدار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ريح الوحل
بقلم: أسمى وزوز
لا أَحدَ آتٍ إلى هنا
لا أحدَ ماضٍ من هناك
فراغٌ يبتلع فراغ
ودوار تيهٍ
يلتهمنا في كلّ مكان
هذه هي السّاقية
التي لا تلد الماء
وتطحننا بلا اكتراثٍ
فقد اعتادت الأوامر
في محاكم الاستئناف
واعتادت شنق الأحلام
على بوابات السّراب
ولا ترى نوّار اللّوز
وليس هناك سوى
وحل الطّرقات
وصرخة فراغٍ
يوجع من فراغ
والرّيح يضرب بالخيام
وابتلاع الآه
اعتاده الموجوع
وصرخاتٌ تدوّي
على مسامع الزّمان
وتيهٌ يقهر من تيه
وركضٌ على جمرات الطّرقات
فما أبشع ضحك المتفرّجين
على أحزان المغتالين
بصدى الزّمن
الذي لا يوصف بزمان
أوّاه يا زمن الأوغاد
لو كانت الكرامة
ما كنتَ هنا
ولا هناك
ولا مضيتَ
على مرأى الخطى
ولا خططتَ بيديك
خريطة الذّل والهوان
ولكن ما كانت هذه
ولا كنتَ أنت
ولكن، هو ذاك الوحل
الذي طال وطال

عن الحرب وأشياء لا تُنسى
بقلم: محمد الأشقر
أشرب من زجاجة مكسورة
لعلي أعرف طعم تمزق الأمعاء العطشى للحياة.
جلست قرب باب خيمة
ونظرت في السماء لم أر أحداً في الأفق؛
سوى صوت طائرة من فرط تمرسها ظننتها غيمة ماطرة.
أعطيت نصف وجهي للريح
والنصف الآخر سرقته مخالب الوقت
لكنني أرى وجهي كاملاً؛
كلما رأيت وجه الحقيقة يكذبني
ويصدق خوفي وعجزي.
كنت أظنني لن أقابل قاتلي
حتى رأيت كيس الدقيق فاغرًا فاه
كوحش صامت يلتهم جوعي.
أنام على جنبي الذي يدعي الراحة؛
فتسخر مني جثتي التي نهشتها الحرب
وملايين الديدان الجوعى
أما الكلاب فتواصل النباح داخل رأسي.
كلما أشعلت سيجارة
يُخيفني خيط دخانها؛ فلا دليل على وجود الرفاق.
الشوارع لا تحمل الأكفان..
لا مشيعين للفراق.. لا جنازات للبكاء
ولن ترى وطناً أكبر من جحيم هذه المدينة.
هاجروا..
لم يتركوا خبراً للرحيل
كانوا يسطرون بقاءهم على ماء البحر
كيف زاحموا رحيلهم بالبقاء؟!
ستموت غدا أو بعد غد
لربما عندما تهمس لك الحياة بنقيضها
وتدس سمها في بقايا العمر؛
أو عندما تمل المصادفة من نجاتك السخيفة.
إذا انتهت الحرب
لن أزور أحدًا.. وأحد لن يزورني
فلا شهود على حياة تقدم طاعتها لموتٍ صامت.

أوامر إخلاء عسكرية..
بقلم: ناصر رباح
الوسائد أم وعاء الطبخ..
جرة الغاز أم جواز السفر..
ما تبقى من نقود أم هوية؟
شفرة الحلاقة أم القميص الهدية..
قطرة العين أم علبة الشاي..
العائلة أم صورة العائلة..
ماذا معك ستحمل في النزهة العاجلة؟
وماذا ستترك لسارقي الذكريات؟
هكذا.. يدفعُكَ اللهُ في التجربة،
ينفجر الدم في الأسئلة،
تفور القهوة التي ليست على النار،
على حرقة الاختيار،
تعبرك الخناجر صاعدة نازلة،
ماذا يقول أب يجر بيتًا وعائلة؟
ماذا يقول باب ليد أسرَّت له بالوداع؟
ماذا تقول شرفة فارغة للشرفة المقابلة؟
البيوت تلال من الملح ذوبها القهر.
والشوارع، لم تعد شوارعَ،
شجرًا يشبه الغائبين يلوحون باليد الذابلة،
والنازحون يفركون أصابع الحربِ الطويلةِ،
الطويلةُ مثل ساعةٍ معطلة.
وخلفهم يركض جيش بلا هوية،
جراد معدني تائه،
ومهزلة.

"إبراهيم طوقان" وغزة.. البقية التي لا يجب أن تضيع
بقلم: وسام زغبر (عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين)
عندما نتحدث عن الشعر الفلسطيني، لا يمكن تجاهل صوت "إبراهيم طوقان"، الشاعر الذي حوّل الكلمات إلى سلاح ضد النسيان والإبادة، وجعل من الحرف الفلسطيني مشعلًا يضيء في ظلام الشتات والاحتلال. "طوقان" لم يكتب شعرًا للزينة أو للتسلية، بل كتب للشعب والذاكرة والوطن، ولقد كان وعيه الوطني متقداً حتى في أبسط الأبيات.
من أبرز أبياته التي تحمل رسالة خالدة: "في يدينا بقية من بلاد، فاستريحوا كي لا تضيع البقية".
هذا البيت اليوم يتردد في أزقّة غزة المحاصرة، بعد عامين على حرب أكتوبر 2023 الهمجية، التي حاولت محو كل أثر للوجود الفلسطيني. "البقية" هنا ليست مجرد تراب أو حدود، بل هوية شعب، ذاكرة أمّة، وأطفال لم يعرفوا حياة طبيعية بعد. إنه تحذير ملحّ: كل لحظة من الصمت الدولي أو التخاذل يمكن أن تكون بداية لفقدان ما تبقى من الوطن والكرامة. غزة، بصمودها الأسطوري، أصبحت تجسيدًا حيًّا لما قصده "طوقان". رغم القصف والدمار والحصار، ما زالت المدينة تمسك بالبقية من بلادها وكرامتها الوطنية، ترفض الانكسار، وتعيد تأكيد أن الفلسطينيين مستمرون في نضالهم من أجل حقوقهم. البيت الشعري يتحول اليوم إلى شعار عملي: حماية البقية مسؤولية جماعية، والفعل لا يقتصر على الكلام، بل يمتد إلى المقاومة والصمود والتوثيق والمواجهة السياسية.
كما أن "طوقان" يذكرنا بأن فلسطين ليست مجرد مساحة جغرافية، بل كيان حي في وجدان شعب لا يعرف الاستسلام. في ظل استمرار العدوان ومحاولات محو الهوية، تظل كلماته مرشدًا وصرخة صامتة لكل فلسطيني: حافظوا على ما تبقى من بلادكم، فالبقية هي كل شيء.
ختامًا، بعد عامين على حرب أكتوبر الهمجية، يظل "إبراهيم طوقان" صوتًا حيًّا لكل من يؤمن أن الاستسلام ليس خيارًا، وأن البقية مسؤولية وواجب وحق. غزة اليوم ليست مجرد مدينة، بل رمز للبقية التي لا يجوز أن تضيع.

حكايات من يوميات الحرب.. النرجس لا يموت
بقلم: شحدة درغام
امتدت رحلته لساعات طويلة، يحمل على كتفه قليلًا من المتاع، وخلفه أطفاله الصغار يلهثون بتعب، وزوجته الحامل في شهرها السادس تتعثر بأنفاسها المنهكة. تركوا خلفهم كل شيء: بيتهم، حارتهم، وذكرياتهم المعلّقة على جدران لم تعد قائمة.
بحثوا عن مساحة أرض فارغة ليقيموا عليها خيمة تحميهم من شمس النهار وبرد الليل، لكنهم ما وجدوا إلا فراغًا ممتلئًا بالخيام؛ كأن الأرض أنبتتها فجأة. ضاقت المساحات بالنازحين، وتكسّر الأمل على صخرة الواقع القاسي.
ساروا حتى وصلوا شاطئ البحر. توقفت الزوجة، وضعت يدها المرتجفة على كتف زوجها، وقالت بصوت واهن:
- يا ابن الحلال، خلينا ننصب خيمتنا على شاطئ البحر… ما عاد فينا نمشي أكثر.
التفت إليها، فبدت كلماتها له كطوق نجاة بعد تيه طويل. أنزل حمله عن كتفه، وبدأ مع أطفاله وزوجته يجمعون ما لديهم من خيش وقطع نايلون وقماش وقليلًا من الخشب المهشم ليقيموا خيمتهم. وحين انتهوا، جلس الأب عند باب الخيمة، وجهه نحو البحر، وقدماه العاريتان تغوصان في الرمل، ورذاذ الموج يبلل ملامحه. أغمض عينيه، واستسلم لغفوة قصيرة، كأنها فسحة من التعب.
لكن موجة باغتته، أيقظته حين لامست قدميه. فتح عينيه، وتمتم بصوت بالكاد يُسمع:
- حتى أنت أيها البحر، ألا تتركني وشأني؟
ردّ عليه البحر، بصوت يشبه الاعتذار:
- أنا لم أؤذك… هكذا أنا، مدّ وجزر. كل ما فيّ حركة وحياة. أنا الخير كله.
قال الرجل وهو يتنهد:
- اقتربت منك طلبًا للسكينة، فلم أجد ملجأ إلا قربك بعد أن أرهقني الترحال والنزوح. كل ما أحمله تنهيدة لا تنتهي.
اقتربت موجة، كأن البحر يمدّ يده ليمسح عن رأسه غبار التعب، وهمس له:
- لا تيأس… ستمضي هذه الأيام الصعبة، وستعود كما كنت. أنت مثل النرجس: يذبل حينًا، لكنه يعود ليزهر من جديد. لا يموت لأنه متجذّر في الأرض.
النرجس الذي تعرفه ليس زهرة عابرة؛ إنه ينمو على شاطئي متحديًا ملوحة التربة، رافعًا رأسه في وجه الرياح، ثابتًا كأنه وُلد ليعلّم الناس الصبر. يذبل حين يثقل عليه الشتاء، لكنه ما يلبث أن ينهض من جديد، صادقًا في حضوره، لا يخون الأرض التي احتضنته.
ثم علا صوت البحر، كأنه يخاطب كل خيام النازحين المبعثرة على امتداد الشاطئ:
- كم من غزّيين مرّوا أمامي! كم من عابرين مشوا على شاطئي! كلهم مضوا، وأنا بقيت شاهدًا على رحيلهم. أنتم الباقون وستبقون معي كالنرجس، أنتم لا تفنون… ستعودون لتزهروا من جديد.
جلس الرجل صامتًا، وقد اغرورقت عيناه بالدمع. شعر للحظة أن البحر ليس ماءً فحسب، بل ذاكرة كبرى، تلفظ كل العابرين والغزاة وتردد سرًّا لا ينطفئ: النرجس لا يموت.