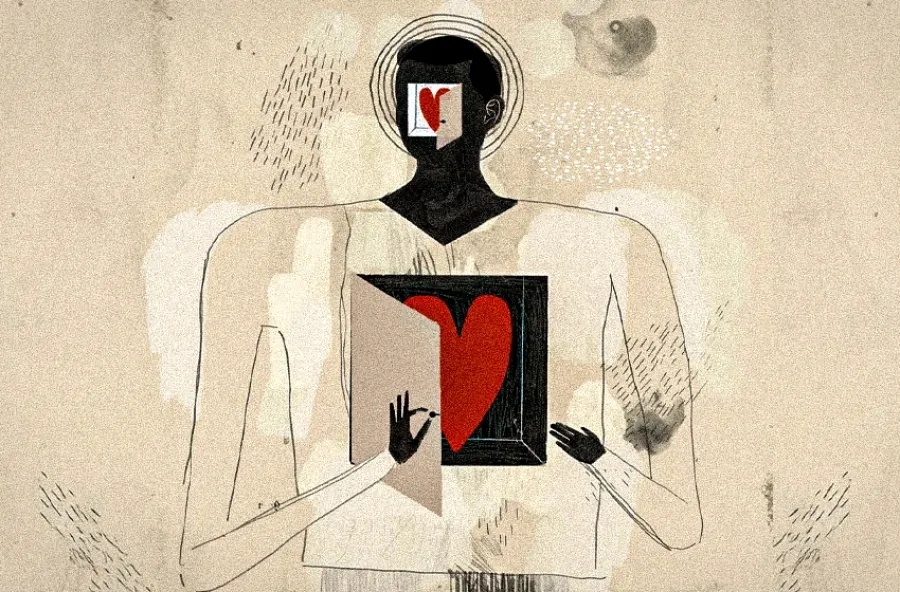"العقل السليم في الجسم السليم".. شعارٌ شهير، كثيرا ما يُرفع في المؤسسات التربوية والتعليمية والرياضية، وهو ينطوي على معانٍ تربط بين التوازن العقلي والصحة الجسدية وممارسة الرياضة، لتأمين القدرة على الاستمتاع بالحياة. ولكن، كيف يفهم هذا الشعار، "ذوو الاحتياجات الخاصة" الذين حُرموا من نِعمة الحركة أو الحواس الخمس؟ وما الذي يشعرون به حينما يسمعون أو يرون هذا الشعار مرفوعا في بيئات مختلفة، يُفترض أن تحتويهم وتحترم وجودهم وعواطفهم، ولا تُشعِرهم بأنهم على هامش الحياة؟
لا ندري كيف تحوّلت عبارةٌ أطلقها الشاعر اليوناني "ميليتوس" (624 - 546 قبل الميلاد) إلى شعارٍ (رياضي) تداولته المجتمعات في كل أنحاء المعمورة؟ كل ما ندركه هو أن القرون التي رُفع فيها هذا الشعار تمثّل جزءًا من تاريخ الظلم الذي تحمّله "ذوو الاحتياجات الخاصة" عبر العصور. ونشير إلى أن عبارة "العقل السليم في الجسم السليم" تُنسب أيضًا إلى الشاعر الروماني "جوفينال" (عاش في أواخر القرن الأول وبدايات القرن الثاني الميلادي)، وله قصيدة هجائية وردت فيها هذه العبارة الظالمة!
قد يعتبر "ذوو الاحتياجات الخاصة" أن الحياة ظلمتهم، وهي دومًا ظالمة بمنطق البشر، ولكنها عادلة بمنطقها الخاص، لأنها شأنٌ إلهيٌّ لا دخل للإنسان فيه، فلا أحد يمتلك حق اختيار شكله ولونه وانتمائه وحالته الجسدية والمادية وغيرها من الأمور الأخرى!
ولعل الظلم الأكبر والأخطر، الذي تحمّله ويتحمّله "ذوو الاحتياجات الخاصة"، هو ظلم البشر (الأصحّاء جسديًّا وعقليًّا)، من خلال إغداق مشاعر الشفقة عليهم، سواء كانت شفقة صادقة أو مفتعلة، والتعامل معهم وكأنهم جنسٌ بشري مختلفٌ، أو هم استثناء بشري، ليس لهم حق المشاركة في صناعة الحياة أو التأثير فيها.. حتى في مجالات الأدب والثقافة، تم التعامل معهم باعتبارهم موضوعًا يكتب عنه "الأصحاء" أو يُنتجون حوله الأفلام والأعمال الفنيّة!
وإذا ما تصفّحنا كتاب التاريخ الإنساني، عبر مختلف العصور، سنجد عظماء في مختلف مجالات الحياة، أسهموا في الحضارة الإنسانية، وقدّموا إنجازات عُظمى في العلوم والأفكار.. ووصلوا حتى إلى رئاسة الدّول. ونتمنى أن يقوم كل بلدٍ في هذا العالم بإنجاز كاتب يجمع عظماءه من فئة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، ثم يُؤسَّس مرصد عالمي من تلك الكتب يُمكن استثماره في تقديم نماذج إنسانية يقتدي بها "الأصحاء" وتكون مصدر فخر واعتزاز يحرّر "ذوي الاحتياجات الخاصة" من ظلم البشر والحياة على حدّ السواء.
في سياق هذه الأفكار، توجّهت جريدة "الأيام نيوز" إلى نخبة من الكُتّاب الأفاضل بهذه الرسالة: "ذوو الهمم" أو "ذوو الاحتياجات الخاصة" فئات اجتماعية لها الحق في المعرفة والأدب والاطلاع، بل لها الحق أن يتوجّه إليها أدبٌ خاص في موضوعاته وحتى مصطلحاته، من أجل تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، ومنحهم الثقة والشعور بوزنهم الإنساني في بيئاتهم المجتمعية والتعليمية والثقافية..
تتعدّد احتياجاتهم بحسب نوع "الإعاقة"، وقد انطلقت موجات من الكتب الناطقة أو الصوتية التي تستجيب لاحتياجات مَن فقدوا نعمة البصر أو الذين لا يستطيع تقليب صفحات الكتاب مثلا، غير أن الكتب الناطقة يختارها "الأصحّاء" ولا تخضع إلى رغبات القراءة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة..
ومن المهم التساؤل حول مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأدب والثقافة؟ وهل أَولى الكُتّاب والأدباء عناية بهذه الفئة؟ وهل هناك ضرورة لتخصيص أدب أطفال خاص بهذه الفئة تركّز على موضوعات معيّنة وتستعمل قواميس تحترم مشاعرهم؟ وهل من المُجدي الكتابة إلى هذه الفئة المحرومة وليس الكتابة عنها فقط، وما مدى مسؤولية الكُتّاب والأدباء في ذلك؟
عزيزي القارئ، لم أحدّثك عن نماذج من عباقرة وعلماء وأدباء ينتمون إلى "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وكانت لهم أدوار عُظمى في تغيير مجرى التاريخ والدّفع بعجلة الحضارة الإنسانية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تطوّر ورقي، فقد تركت إضاءة هذه الزوايا إلى مقالات الكُتّاب في هذا الملف. ولم أحدّثك عن "الإعاقة"، مهما كان نوعها، بأنها ابتلاءٌ من الله، ودليل على محبّته للمُبتلى، فأيّ نعمة وفوز أعظم من هذه النعمة والفوز؟ ودعني أهمسك في أذنك، عزيزي القارئ" بأن حياة الإنسان هي رحلةٌ للبحث عن معنى الحياة ذاتها، والمحظوظ مَن يُمهله القدر لحظات قبل الغرغرة ليُدرك ذلك المعنى.. ولعل الذين أدركوا المعنى قد تمنّوا لو أنهم كانوا من "ذوي الاحتياجات الخاصة".
عزيزي القارئ، حاول ولو مرّةً واحدةً أن تتقمّص حالة من حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، في الشعور ورؤية الحياة وأثر التعامل.. وبعدها حاول أن تعدّل مفردات قاموسك اليومي، فلا يجب أن يتضمّن كلمات قد تبدو لك عادية ولكنها مثل الرصاصة عندما تصل إلى "ذوي الاحتياجات الخاصة".. وأدعوك، وأنت في حالة التقمّص، إلى تأمّل ذلك الشّعار: "العقل السليم في الجسم السليم".

حلم كبير.. قراءة كلمة صغيرة!
آسيا عباس (باحثة وكاتبة من لبنان)
كنت أراه شاردًا، نعم، كان شاردًا، كما لو أن الكون برمّته، تحوّل إلى نقطة، أو ربّما كلمة، من يعرف!؟
كان هناك، يجلس في ليالي الشتاء أمام نافذة مشرّعة بوجه ريحٍ عنيدة بالكاد تهدأ، والصّواعق تضرب الدنيا، وهي نائمة غير آبهةٍ بشيء، شخيرها واصل إلى غرفة نومي. وكانت تشبهه، تمامًا كما ظننته، لكنّ الكتاب لم يفارق يديه يومًا، ولا أعرف لماذا!
"أحمد، أنا اسمي أحمد، حبّذا لو أستطيع نطق هذه الكلمات، بصوت مبحوح كعصفور حزين ولو لم يسمعني أحد، تخيّلوا، أحلم أن أحكي بصوت عالٍ، أو بهمس، لا همّ لي، أتمنى لو أستطيع أن أنطق كلمة، كلمة واحدة فقط، بإمكانها أن تنقذني..".
لا أعرف إن كان هذا ما يدور في باله، لكن كلما رأيته شاردًا كغصنٍ وحيدٍ أمام نافذة، يخطر لي أنه يتمنى هذه الأمنية. أعتقد أنّه كان يربّيها من صغره، وها هي تشيخ، ولم تتحقق، ربما ولن..
كنتُ صغيرة جدًّا، أصغر من أن أفهم ماذا تعني كلمة الصّم، والبكم، لكن كنت أسأل الله دائمًا بعينين حزينتين، وقلبٍ بريء مثل أيّ شيء لم تلمسه يد الإنسان، لمَ عليّ أن أبكي كلما ذهبَت أمنيتي إلى السماء ولم تأتِ؟ هكذا، ذهابًا بلا رجعة! خشيت في صغري أن يكون الله لا يحبّ الأطفال، فتمنّيت أن أكبر، وأنا أردّد ذات الطّلب: "أن أسمع صوت أحدهم." وغفوت وأنا أحلم بسماع كلمة.. كلمة منه فقط.
كان التّاريخ يغنّي حينها لحن الفرح، كنّا في التّاسع من يناير/ جانفي في العام 2024. لقد كانت ليلة جميلة جدًّا، للمرة الأولى أسمع صوته الضخم، سمعته في منامي، وبكيت.. وأمطرت الدنيا، أمطرت كثيرًا حينها، لا أزال أذكر.
يومها، عرفُت أن الله يحبّني أكثر من أيّ وقت مضى.
كنت أترك أولاد الحيّ يضربون أقدامهم على الأرض كي يرَوا الدّوائر التي شكّلتها الأمطار، ولا أحد يأبه للألم الذي يسبّبونه لها، وأذهب إليه بوجهٍ يريد أن يعرف كلّ شيء، فضولي كان يسبقني مثل الغيم، ويجرّني لأجدني أتلصّص عليه من جانب الباب - وأعرف أنه لن يسمعني حتى لو فتحته وخبطته بكلّ قوّة، لكنّ شيئًا طفوليًّا بي، كان يدفعني لئلّا أزعجه - واضعةً يدًا على المقبض، والأخرى على عينيّ، إن استدار، غطّيت وجهي كأنّه لن يستطيع بهذه الحركة رؤيتي، هههه، كم كنّا مجانين!
ابتسامته في كلّ مرّة.. كنت أظن بها أنّه يقرأ، كانت تثير الحماسة بداخلي، لكنّني لا أفقه لغة الإشارة بعد، غير أنّي لن أستطيع النّوم إن لم أعرف سببها، ولم أجد حلًّا سوى أن أسأل أمّي الحزينة، عن سرّ ابتسامته.. وأخبرتني...
ذُهلت، حقًا ذُهلت، "أحمد" أميٌّ، لكنّه يحبّ الثقافة كما لو أنّها به، خُلقَت ملتصقة بجلده، ويضحك ربّما على سخرية قدره، أو ربّما لأنّه استطاع تخيّل قراءة كلمة ما.
جلست أفكر مثل فتاة في بداية تشكّل وعيها، وأسأل: لماذا لا تتحقّق كلّ الأحلام؟ أليس من حقّه أن يعرف ما صوت صفحات الكتاب التي تتقلّب بين كفيه كطفلٍ صغير؟ أليس من حقّه أن يبكي على حزن مكتوب، ويفرح على نكتة كتبها أحدهم؟ ويقرأ أمام الناس بصوت جهوري يملأ الدنيا، ثم حين ينتهي، يصفّق الجميع له؟ أليس من المؤلم ألّا يعرف الأصم والأبكم صوت التّصفيقات؟ ثمّ، أليس من حقّه أيضًا أن يسمع صوت الرعد الذي يشاطره وحدته طوال الوقت؟ تراه هل يعرف صوت المطر؟!
آه، رأسي يؤلمني كلّما حمّلتُه أسئلة تثقل ظهره...
كَبر "أحمد"، وكبرتُ أنا، وحدها النافذة لم تكبر، بقي الكتاب الوحيد في يديه منذ الصغر، يتمنّى أن ينتهي من قراءة صاحبه، ويُرَدّ إلى رفّ المكتبة، وأنا في سرّي أقول: "لم أكن أعرف أبدًا أن حلم أحمد الكبير، أن يقرأ كلمة، كلمة واحدة، ولو كانت صغيرة..".

وحيد حمّود (كاتب من لبنان)
مراهقة ما بعد الوفاة بستة أشهر!
أكّدت الدّراسات العلميّة أنّ عمر المراهقة عند الرّجل الشّرقي ينتهي بعد وفاته بستّة أشهر، هذا وقد رأى مصدرٌ رفيع المستوى من المؤرّخين وعلماء النفس أنّ مراهقة الرجل "باقية وتتمدّد" مثل شعار "داعش"، حتّى بعد موته، مستشهدين ببيت شعرٍ للشاعر الأموي الأشهر، "جميل بن معمّر"، أو كما يُدعى "جميل بثينة"، حيث قال واصفًا حبّه الأسطوريّ لـ"بثينة بنت حيّان":
يَهواكِ ما عِشتُ الفُؤادُ فَإِن أَمُت -- يَتبَع صَدايَ صَداكِ بَينَ الأَقبُرِ
إن فتّشنا في جوارير معتقداتنا، سنجد العجب، إذ إنّنا في حقيقة الأمر لا نميّز بين الإنسان السويّ والإنسان فاقد الأهليّة النفسيّة. لا أتحدّث هنا عن الذين يحيون في المصحّات العقليّة ومراكز التأهيل النفسي، بل أتحدّث عن الفارّين الذين يحيون بيننا، وأخصّ بالذكر من تمتدّ مراهقتهم إلى ما بعد موتهم، مثل "جميل بثينة" الذي ذكرناه، أولئك الذين ينظرون إلى العمر على أنّه مجرّد رقم، فتفضحهم قحّة صدورهم، والبلغم المتغلغل في رئاتهم، والصبغة التي تعلو ما تبقّى من شعر رؤوسهم.
الآن أسألكم: هل نظرتم بعين الواقعيّة إلى من هم حولكم؟ حدّقوا جيّدًا وعَرّوا الأفعال لا الأقوال، فإنّ أشهر قادة الحروب هم خطباء من الصنف الأوّل ولكنّهم أُصيبوا بجنون العظمة، وقد أطاحت بهم هذه العلّة رغم جبروتهم، وهنا أطرح السؤال: هل المصابون بجنون العظمة أسوياء، في حين أنّ المحرومين من نعمة البصر أو نعمة السمع أو المشي أو مرضى التوحّد هم أناس درجة ثانية؟
حسنًا، الآن أريد أن أضع بين أيديكم فكرةً، اعجنوها بماء التأمّل وأنصتوا لها: من هم ذوي الهمم؟ أو دعوني أقولها كما يلفظها الكثيرون "المعوقون"؟ من هم هؤلاء؟ انظروا حولكم، ربما يكون أحد أفراد أسرتكم، أو أحد جيرانكم، أو شخصًا تعرفونه، أو إنسانًا مرّ أمامكم في حفلة الحياة، اسألوا أنفسكم عنهم، ولكن تذكّروا أنّ الحياة الصحيّة الطبيعيّة فخّ، ولا أحد يعلم بما قد يصيبه بعد لحظةٍ من الآن، هذا إن دلّ على شيءٍ فإنّما يدلّ على أنّنا أسوياء صحيًّا إلى أجلٍ غير معلوم، وقد تصيب أيًّا منّا إعاقة فتُخرجه كما الكثيرين من مهنة العيش بشكله السابق.
هل تشعرون بالشفقة؟ هل تعلمون أنّ شعور الشفقة هو أسوأ شعور ممكن أن يمنحه إنسان لأخيه الإنسان؟ لماذا نشفق على المختلف عنّا؟ هل تعلمون أنّ مريض التوحّد يُشفق علينا هو الآخر؟ هل فكّرتم أن تكونوا مكانه ليوم كامل، هل فكّرتم أن تصمتوا مجبرين ليوم؟ أو أن تغمضوا أعينكم كُرهًا ليوم؟ أو أن تجلسوا على مقعدٍ متحرّك ليوم؟
إنّ المختلف عنّا لديه عالمه الخاص الذي يرى من خلاله أنّنا بشرٌ نحيا لنأكل ونشرب وننام فقط، إنّه يرانا غير فاعلين ولذلك هو غير قادرٍ على الاندماج فينا، يرانا غريبين عنه، ونظنّ كلّ الظنّ أنّه الغريب عنّا، ويزيد الشرخ بيننا وبينه.
فلنفكّر مليًّا بضرورة إعادة صياغة التعريفات التي نشأنا عليها، فالاختلاف سمة الكون، وإن تشابهنا كلّنا لصارت الحياة مملّة. تخيّلوا أنّ الجميع يريد أن يكتب فقط، حسنًا من سيقرأ؟ ألن تكون كتاباتنا عبثيّةً ومن دون جدوى؟
فلنفكّر في المختلف عنّا من باب الشراكة لا من باب الشفقة، فلكلّ مختلفٍ عالمه المختلف، وهذه العوالم على تناقضاتها تصنع الحياة السويّة.
عَودٌ على بَدء، هل نشفق على المُقعَد والضرير والأصم والأبكم أم نشفق على من يرى الناس من منظار المصلحة فقط؟ هل ننظر إلى هؤلاء ونقول: الحمد لله الذي عافانا ممّا ابتلاهم به، ونصفّق للأرعن والكذّاب والمتملّق والغشّاش والمضطرب نفسيّا وعاطفيّا لأنّه يسمع ويرى ويمشي بيننا الخيلاء فقط؟ أليس حريًّا بنا أن نصنّف الإعاقات النفسيّة إعاقاتٍ يجب الحذر منها والمطالبة بتأهيلها في مراكز، عِوَض أن نترك أصحاب الإعاقات الجسدية على الهامش؟
من نحن؟ هل اصطفانا الله لأنّ إعاقةً ما تجاوزتنا وذهبت إلى غيرنا؟ من نحن إن لم نشارك الآخر ما يشعر وما يفكّر ونجعله صانعًا لقرار حياته؟ نحن في حقيقة الأمر ديكتاتوريون، لا نقبل الآخر إلّا وفق ما نريد له أن يكون، إن وقعنا في الحبّ نريد أن نجعل من الآخر نسخةً من "كاتالوج" أحلامنا المليئة بالعُقد، ثمّ حين يصبح كما نريده نملّ منه، كما ملّ "بيجماليون" من امرأته التي نحتها كما يريد.
والآن هيّا بنا نلقي نظرةً إلى عالم الأدب والعلوم، كان "نجيب محفوظ"، الروائي المصري الحائز على جائزة نوبل، يجلس مثل فتً مطيع في حضرة عميد الأدب العربي "طه حسين"، رغم أنّ طه حسين كان قد فقد نظره، لكنّ بصيرته ظلّت حادّة فأرغمت الكون بأسره على احترامه.
ومن زاويةٍ أخرى، فاز عالم الفيزياء الشهير الراحل "ستيفن هوكنغ" بعدّة جوائز عالمية رغم شلله الذي أقعده على كرسيّ متحرّك منذ كان في سن الثانية والعشرين، ومن الجدير ذكره أنّ هذا العالِم رفض دعوةً "إسرائيليّة" لتكريمه بوسام "بنجامين فرانكلين" تنديدًا بما يقوم به هذا الكيان من اعتداءات وشيطنات بحقّ أهل فلسطين، وهنا يمكن أن نسلّط الضوء على أمرٍ بالغ الأهميّة وهو أنّ الإعاقة العقليّة والفكريّة أخطر بكثير من الإعاقة الجسديّة، فكم من سويٍّ بنظرنا باع الأرض والعرض والقضايا من أجل لا شيء؟
الأمثلة كثيرة، ولو قرّرنا الخوض في مجال العلم والأدب لوجدنا العجب، وكلّ ما سنجده سيأخذنا إلى حقيقةٍ واحدة مفادُها أنّ الأرض بما رحُبت خُلقت من الاختلاف، الليل لا يشبه النهار، والشمس لا ينبغي لها أن تعانق القمر، والأسوياء هم الذين يعرفون أنّ كلّ حيّ هو شريك فاعل وفعّال وليست الشفقة هي التي تنصر ذوي الهمم، بل إمساك يدهم والمضي في الدرب معهم وبهم، فكما نراهم يرونا.

عدوية موفق الدبس (باحثة وكاتبة سورية - لبنان)
"أمل" وفسحة الأمل..
في السادس والعشرين من حزيران/ جوان، سنة ألفين وستة، همس والدي لي ولإخوتي بصوتٍ مفعمٍ بالفرح أنّه ذاهب إلى المستشفى ليُحضر لنا شقيقًا جديدًا، وطلب من جدّتي أن تمكث معنا تلك الليلة. وفي صباح اليوم التالي، عاد والدي حاملًا بين يديه طفلًا صغيرًا، يرتدي ثوبًا أزرق، يعلو وجهه غضبٌ طفولي، رغم أنّه كان مغمض العينين.
- سألناه بشوق: "أين أمّي؟".
- فابتسم ابتسامةً متعبة وقال: "ستأتي بعد يومين".
مرّ اليومان، وجاءت أمّي.. لكن ليست كما خرجت. أتت على كرسيٍّ معدنيٍّ بأربعة دواليب. يومها تمنّيت أن يشتري لي والدي واحدًا مثله، فتحقّقت تلك الأمنية اللعينة، لكن لأمّي.
قال لنا والدي بصوتٍ مكسورٍ مملوءٍ بالحمد: "أمّكم لم تعد كما كانت، أصبحت تحتاج إلى معاملةٍ خاصّة، وأشياءٍ خاصّة".
تساءلت أختي الكبرى، وكانت تكبرني بأربع سنوات: "وإلى متى؟".
أجاب بصوتٍ متقطّعٍ بينه وبين كلّ كلمة تنهيدة حمد: "إلى الأبد... الحمد لله، إلى الأبد".
لم أكن أفهم ما معنى "شيء خاص". لكنني أدركت مع الوقت أنّ "الخاص" لا يعني التميّز كما يُقال، بل يعني الانفصال عن العالم العادي.
أمي كان لها مكان خاصّ تتحرّك فيه، كرسيّ خاصّ، حمّام خاصّ، لباس خاصّ، وكلّ شيءٍ خاص. كنت أراها وهي تحاول أن تبتسم رغم الألم، وأرى والدي يحملها بين ذراعيه صعودًا ونزولًا من الدرج ليُراجع الطبيب.
كنتُ صغيرةً أظنّها لعبة، فأطلب منه أن يحملني مثلها، من دون أن أدرك أنّ اللعبة التي تمنّيتها كانت حياةً كاملة من الصبر. ومع مرور الأيام، أدركت أن أمي أحسنت الاختيار في شريك حياتها، كما أحسن هو الاختيار فيها. هو صبَر بحمدٍ واحتساب، وهي صبرت حين بدأ معها من الصفر، وظلّ الصفر يكبر حتى صار بيتًا مملوءًا بالمحبة. لكن الطبيب كان في كل مرة يقول: "لا أمل يا أمل... الشلل كامل في الساقين".
كلمة واحدة قلبت حياة كاملة، خطأ طبي صغير جعلها بين ليلةٍ وضحاها عاجزة عن السير، أسيرة الأشياء "الخاصّة".
ثم حدثت المعجزة... بعد ستة أشهرٍ من الصبر والدعاء والدموع، عادت أمي إلى المشي، ورمت الكرسيّ ذي الأربعة دواليب، وكسرت قيد الأشياء "الخاصّة". حينها فقط فهمت ماذا يعني أن تكون إنسانًا عاديًا ثم تستيقظ ذات صباح لتصبح "خاصًّا".
الكثير من أصحاب الهمم وُلدوا وهم يحتاجون إلى أجهزة تساعدهم على السمع أو البصر أو الحركة. لكن ماذا عن أولئك الذين مثل أمي؟ أولئك الذين كانوا يعيشون حياةً عادية، ثم فجأة يسقطون في هاوية العجز دون مقدمات؟
هذا ما حدث في حرب "البيجر" على لبنان، حين أصبح كثيرون بين ليلة وضحاها من ذوي الهمم؛ فقدوا أطرافهم، أو بصرهم، أو أصواتهم، أو حتى القدرة على الحلم.
وما يحدث اليوم في غزة الحبيبة أبلغ مثال عن شعب بأكمله أصبح "خاصًّا"، فقدَ جزءًا من جسده، أو من روحه، أو من بيته، أو من طفولته. لكن، من قال إن كفة الميزان لا تميل؟
نحن "الأكثر" عددًا، لكننا ربما "الأقل" وعيًا. نحن الذين نرى ولا نبصر، نسمع ولا نعي، نعيش بكامل الجسد ونصف الروح. نحن الذين نحتاج إلى كتيّبٍ بحروف نافرةٍ كي نقرأ الحقيقة، وإلى جهاز سمعٍ لندرك الصوت الصادق وسط ضجيج الكذب، وإلى كرسيٍّ يسير بنا نحو الدرب الصحيح، وإلى أطرافٍ ترفع راية النصر لا راية الخضوع.
لكن يا للعجب، بدل أن نُقيم للإنسان مكانته، نفرش السجّاد الأحمر للسياسيين، وننسى أن نضع منحدرًا بسيطًا يمكّن صاحب كرسيٍّ متحرّكٍ من الدخول إلى قاعةٍ رسمية! نسينا أنّ من يجلس على الكرسيّ لم يختر مصيره، وأنّ من يمشي عليه اليوم قد يجلس عليه غدًا.
نشتري نظاراتٍ شمسية باهظة الثمن، ونترك من يعيش في ظلمة عينيه يحلم بأن يلمس حروفًا نافرة ليقرأ سطرًا من كتاب. نقيم المهرجانات بمكبّرات صوتٍ ضخمةٍ لأجل خطبٍ جوفاء، بينما هناك من لا يسمع شيئًا من الدنيا سوى الصمت. وإن وُجدت أماكن أو أدوات "خاصة"، فهي باهظة الثمن، كأنّ القدر فرض على من خُلق مختلفًا أن يدفع ضريبة اختلافه.
في قانون الحياة السوداء: أن تكون "خاصًّا" يعني أن تُحاسَب على شيءٍ لم تختره، وأن يُقاس وجودك بسعرك، لا بقلبك ولا بإنسانيتك.

يوسف الشمالي (كاتب من لبنان)
ذوو الهمم.. أبطال لا تكتمل قصة الإنسانية بدونهم
في ظلّ التحوّلات المتسارعة التي يعيشها العالم المعاصر، تتقدّم قضية ذوي الهمم إلى الواجهة بوصفها امتحانًا حقيقيًّا لمدى إنسانية المجتمعات ورقيّها. فالمجتمع الذي يُقصي المختلفين أو يتعامل معهم بعين الشفقة لا بعين النديّة، يبقى مجتمعًا عاجزًا عن إدراك عمق الإنسان، وعن فهم القيمة الكاملة للثقافة والمعرفة بوصفهما حقًّا لا امتيازًا. إنّ ذوي الهمم، وهم من اعتاد البعض تسميّتهم بـ"ذوي الاحتياجات الخاصة"، يشكّلون طيفًا واسعًا من الطاقات الإنسانية الكامنة، التي تحتاج فقط إلى من يؤمن بها ويمنحها الفرصة للتعبير والمشاركة والإبداع.
الأدب، وهو الذاكرة الحسّاسة للإنسانية، لم يكن يومًا بعيدًا عن القضايا التي تمسّ الإنسان في ضعفه وقوّته معًا. ومع ذلك، فإنّ حضور ذوي الهمم في الأدب العربي والعالمي لا يزال حضورًا خجولًا، أو مقصورًا على نماذج رمزية تُستعمل لتجسيد العجز أو الألم، أكثر مما تُستعمل لتجسيد الإرادة والخلق. فغالبًا ما يظهر الأعمى في القصص بوصفه حكيمًا يرى ببصيرته ما لا يراه المبصرون، أو يظهر المُقعَد كرمز للجمود، أو الأصمّ كرمز للعزلة، من غير أن يُمنح هؤلاء مساحة الحياة اليومية العادية التي يعيشها أيّ إنسان، ولا أن يُقدَّموا بوصفهم أبطالًا إيجابيين متعدّدي الأبعاد.
ولئن كان للأدب وظيفة جمالية، فإن له أيضًا وظيفة إنسانية، تتجلى في إعادة الاعتبار لمن حُرموا من أدوات التعبير. فالكتابة عن ذوي الهمم لا ينبغي أن تكون مجرّد ممارسة تعاطفيّة، بل فعلًا نقديًّا يخلخل صورة "الاختلاف" الراسخة في الوعي الجمعي. إنهم لا يحتاجون إلى أدب يتحدّث عنهم من الخارج، بل إلى أدب يتوجّه إليهم، ويخاطب وجدانهم واحتياجاتهم الخاصة، بلغة تحترم خصوصيتهم وتحفّز قدرتهم على المشاركة في فعل المعرفة ذاته.
من هنا تبرز أهمية التفكير في أدبٍ موجّهٍ إلى ذوي الهمم، لا بوصفه ترفًا ثقافيًّا، بل بوصفه ضرورة أخلاقية وتربوية. فكما للطفل أدبه الذي يُراعي عالمه الإدراكي والنفسي، ينبغي أن يكون لذوي الهمم أدبٌ يأخذ في الاعتبار طبيعة إعاقتهم، ويستعمل مفردات وصورًا لا تثير فيهم الشعور بالنقص أو الشفقة، بل تدعم ثقتهم بذواتهم وتشجّعهم على الخلق والمبادرة. فالكتابة الموجّهة إلى من فقد بصره مثلًا، يجب أن تُصاغ بطريقة تتيح له تذوّق الصورة السمعية والإيقاع الداخلي للنص، في حين أن الكتابة لمن يعانون صعوبات حركية أو إدراكية تحتاج إلى قوالب تفاعلية وأدوات سمعية وبصرية تتلاءم مع قدراتهم.
وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة خطوات إيجابية على هذا الصعيد، تمثّلت في انتشار الكتب الناطقة والمكتبات السمعية والبصرية، التي فتحت أبواب المعرفة أمام فئاتٍ كانت محرومة من القراءة. غير أنّ الإشكال لا يزال قائمًا في أن معظم هذه الكتب يُختار محتواها من قِبل "الأصحّاء"، من دون استشارة القرّاء الذين خُلقت لأجلهم، وكأننا نعيد إنتاج العلاقة نفسها بين المركز والهامش. فالواجب لا يقف عند تحويل النصوص إلى صوت، بل يتعدّاه إلى مشاركة ذوي الهمم أنفسهم في صناعة المعرفة، سواء عبر اقتراح الموضوعات، أو المساهمة في التأليف، أو إنتاج محتوى يُعبّر عن رؤيتهم وتجربتهم.
إنّ حضور ذوي الهمم في الثقافة لا يتحقق إلاّ بالانتقال من منطق "التمثيل" إلى منطق "المشاركة". فحين نكتب عنهم فقط، نُبقيهم موضوعًا للتأمل أو للشفقة، لكن حين نكتب لهم وبهم، نفتح أمامهم أفق الفعل والمبادرة والإبداع. وهنا تتضاعف مسؤولية الأدباء والكتّاب الذين يمتلكون الكلمة وحرارة التأثير، إذ تقع على عاتقهم مهمة تغيير الوعي الجمعي تجاه الإعاقة، وتقديمها بوصفها اختلافًا إنسانيًا لا ينتقص من القيمة، بل يُثري التنوع البشري.
فالأدب الذي يحتضن المختلف هو الأدب الذي يتّسع للعالم كله. وهو لا يكتفي بأن يُعرّف ذوي الهمم إلى اللغة، بل يعرّف المجتمع بأسره إلى إنسانيته من جديد. ومن هنا تتجلى أهمية إدماج ذوي الهمم في المشاريع الثقافية والتعليمية، لا بوصفهم متلقين فقط، بل شركاء في صناعة الفكر والإبداع. فحين يُتاح لهم أن يقرأوا ويكتبوا ويعبّروا، يصبح الأدب وسيلة للشفاء والتمكين معًا، وتتحوّل الثقافة إلى جسرٍ يربط التجارب الإنسانية المختلفة بدل أن يفصل بينها.
إنّ مسؤولية الأدب تجاه ذوي الهمم ليست خيارًا جانبيًّا، بل جزءًا من مسؤولية الإنسان تجاه ذاته. فبقدر ما نمنح الكلمة لمن لا يُسمَع صوتهم، نرتقي بالمعنى وبالضمير. وحين يجد ذوو الهمم أنفسهم في النصوص، لا كرموزٍ للعجز، بل ككائناتٍ كاملة الإرادة والحق، يصبح الأدب فعل حياةٍ حقيقي، لا مجرّد لعبة لغوية أو ترف ثقافي.

سعاد عبد القادر القصير (باحثة وكاتبة من لبنان)
إذا كنت موافقا.. اُرمش بعينك!
كان يرمش بعينيه كلّما نطقَت الحرف الذي يبحث عنه بين حروف الكلمة، وعند كلّ حرف تُعيد الأبجديّة من البداية حتى يعطيها الأمر بالتّوقف والكتابة برمشة عين، وهكذا حتى تنتهي الكلمة، فالجملة، فالكتاب. انطلاقة من نقطة الصّفر تُعاد 130000 مرّة، عدد حروف الرواية الذهبيّة.
"جان دومينيك بوبي"، الرّوائيّ الفرنسيّ الذي أصيب بجلطة دماغيّة، أو ما يُسمّى بمتلازمة المنحبس، في العام 1955، تسبّبت بشلل كامل في جسده إلّا جفنه الأيسر، ربّما البعض، أو العديد، أو حتى ربّما غالبيّة الناس حينها، قالوا: مسكين قد انقلب عليه دولاب الحياة، كيف سيتحمّل؟ وربّما كنت سأكون واحدة منهم، فالنّاس عادة تأخذها العاطفة بعيدًا عن الحكمة، ووعيها إجمالًا محدود أمام السّر الإلهيّ، وكم تكون قاتلة، في بعض الأوقات، ذبذبات قلّة الحيلة التي تنفث ريحها الصّرصر لتعصف في جسد ينهار وروح تتآكل. رغم أنّه بقي محافظًا على وعيه، وهذه بحدّ ذاتها نعمة، ولكن قد يرى للبعض أنّه لو فقد وعيه لكان أخفّ قهرًا على حياته التي انهارت أمامه وهو جالس في سرير مستشفى، عاجز عن أيّ نوع من أنواع الحركة، منحبس في جسد ثقيل، غارق في أعماق اللّاحركة.
أو هذا ما رآه البعض، ولكن ليس هو، في الحقيقة المُصاب عادة ما يكون أكثر ذكاءً وقوّة من المتفرّجين على المأساة، تتملّكه رؤية جديدة للحياة، ويُبصر من عتمة واقعه نورًا يخترق انهياره لينتشله إلى بعدٍ حياتيٍّ آخر، بمعنى مبسّط هو يحاول التّأقلم مع واقعه الجديد من خلال فتح باب جديد من أبواب الحياة لم يكن ليعبر منه لولا الظروف المتحكّمة به. وهو بالفعل وازن بين ما فقد وما بقي لديه، ليكتشف أنّه ما زال يمتلك العقل والجفن الأيسر، وممرّضة متمرّسة في عملها، معجبة بموهبته، ونحمد الله على هذا، فكيف تحوّلت بصيرته لتشمل هذه الأمور وتربطها ببعضها؟
قدرته على التخيّل فاقت قدرته على طبيعيّة الواقع، حتى وصل به الأمر إلى امتلاك قدرة تمييز صوت جناح فراشة وقفت على شرفة غرفته، وهذا ليس بالشيء الذي يصل إلى مستواه التّركيزي أيّ إنسان مجبول بزحمة الحياة بالمعنى الطبيعي.
صوت فراشة وجسد شبه ميّت، وفكرة، وكأنّه جال في خاطره أن يقول لمرافقته: اجلسي بجانبي، وحضّري دفترًا وقلمًا، وسجّلي بأناملك الحيّة آخر رواية تُطلق سراحها روحي الحرّة ويستسلم لمرادها جسدي السّجين. أتخيّل الممرّضة أمامه، تفهم حديثه بصمت، وهي مدهوشة، مُساقة، مستسلمة لهذا الجنون، برضى، وتفاني، وموافقة مطلقة. أتراها أكثر جنونًا منه؟
أ.. رَمشة، أ- ب- ت... ل.. رَمشة، أ- ب-... ف.. رَمشة، وهكذا حتى انطلقت فراشة الرّواية في فضائها المضيء، ولمع بريق أجنحتها في كنف الغطّاس الغارق في عمق فراشه، وتحقّقت النّبوءة الأدبيّة: "بذلة الغوص والفراشة"، رواية اختصرت فلسفته وصبره بين الألم والأمل. من منّا يمتلك هذا الصّبر؟ هل منكم من يفقد صبره لمجرّد تخيّل الحدث؟
يقولون: "الضّربة يلي ما بتقتلك بتقويك"، وربّما يكون "جان" مثالًا حيًّا لهذا القول، بقدر ما قوَّته هذه الضّربة، بقدر ما أبدع في الرّواية الخاتمة لأعماله، فهل نتخّذه مثالًا نحتذي به في حياتنا؟
وأكاد أجزم أنّ هذا السّؤال وضع البعض أمام بؤرة من التّحليلات أنّه يعيش في بلد أجنبي، وتلك بلاد تحترم الإنسان وتدعم أصحاب الكفاءات مهما كانت حالتهم.. ويبدؤون بناء جدار من الطّوب أمام عروبتنا المظلومة، المكسورة على باب التسوّل الإنساني.
لهؤلاء، اقتربوا لأوشوش سرًّا في آذانكم، ولا تخبروا أحدًا من المؤمنين بالقوّة الروحيّة، اقتربوا أكثر، هل تعلمون أنّ "طه حسين" كان فاقدًا للبصر منذ أن أتمّ الأربع سنوات من عمره؟ وهو ابن البيئة العربيّة، لم تعقه، لم تتبرّأ منه، فكفانا رمي التّهم في الوقت الذي نمتلك بأيدينا طاقة التّصميم.
نعم، ليست المشكلة في أصحاب المشكلات الجسديّة، ولكن المشكلة تكمن في أصحاب النّفوس المريضة، هؤلاء الذين كلّما حُلّت عقدة أمامهم، عقدوا أخرى، وندبوا!

شوقية عروق منصور (كاتبة من فلسطين)
أنا مختلف إذًا أنا موجود
كانوا يعلموننا في المدرسة "كل ذي عاهة جبار"، ولكن عندما نزلنا إلى الواقع وجدنا أن المجتمع يعاقب المختلف، ويؤكد له أن لا قيمة له، فالقيمة للجسد الجميل الذي يؤدي واجبته دون عراقيل أو دون مساعدة الآخرين. حتى لو كان العقل صغيرا، سخيفا، أو عاطلاً عن العطاء أو مؤذيا للمجتمع.
ودائما يكون التساؤل: هل "ذوو الاحتياجات الخاصة" ينالون العناية اللازمة والواجبة من قِبل السلطات والحكومات، بعيدا عن نظرات المجتمع؟ هناك التفاوت الكبير بين المجتمعات من تخصيص الميزانيات إلى الرعاية النفسية والجسدية وتوفير الآليات اللازمة أو الأطقم النفسية اللازمة لمثل هذه الحالات.
نحن نشعر بالغيرة من المجتمعات الغربية التي تحرص على الاهتمام، مثلا:
- توفير الراتب الشهري.
- بتوفير مرافق خاص للمساعدة.
- توفير سيارات خاصة للمعاقين والمصابين بالشلل، ودفع الحكومات للمساهمة بشراء هذه السيارات. وجعل ذوي الاحتياجات الخاصة جزءًا من المجتمع المشارك في الشارع.
- توفير مصاعد كهربائية، ومواقف خاصة للسيارات، وفرض غرامة على كل سيارة عادية تقف في المكان المخصص لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الاهتمام بتوفير أطر دراسية وجامعية، وتحفيز الطلبة على الانتساب للجامعات والمؤسسات الثقافية.
- توفير الكتب الصوتية حتى يسمعها أصحاب الاعاقات البصرية والحركية.
- دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الموجودة في الدولة، وعدم الاعتراض من أيّ طرفـ، بل جعل أماكن مخصصة في المؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة.
- تشجيع وسائل الاعلام على إبراز الوجوه والشخصيات التي تعاني من إعاقات، بل دفعهم ليدخلوا إلى المدارس والمؤسسات الثقافية للتكلم عن تجاربهم الحياتية.
- تشجيع الأطر السينمائية والتلفزيونية على نشر قصص التحدي. لنتذكّر مثلاً فيلم "رجل المطر" (Rain Man) من بطولة "توم كروز" و"داستن هوفمان" وكيف كانت شخصية هذا الأخير الذي يُعدّ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبيّن من خلال العلاقة اليومية أنه عبقري، وكم من العباقرة بيننا - إذا استثنينا عميد الأدب العربي "طه حسين" نال الأهمية العلمية؟ للأسف، عندنا في وسائل الاعلام خاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة قد تُستغل في التسوّل أو البقاء في مهنة غير مناسبة لتأمين المعاش، عدا عن نظرات الشفقة عليهم.
- السخرية، والأمثلة العربية التي تدعو إلى تهميش "ذوي الاحتياجات الخاصة"، حتى أن رعايتهم تصبح عبئا على عائلاتهم.
- الفتيات أو النساء اللواتي يعانين من مشكلات أو إعاقات.. أو يتم وضعهن في قائمة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، تصبح حياتهن جحيمًا بسبب نظرة المجتمع لهن. والأدهى أنهن يدخلن في عالم الابتعاد عن تأسيس العائلة، لأنهن في نظر المجتمع لا يملكن مقومات الحياة الأسرية. وبذلك يتم عزلهن وابتعادهن بسبب أن المجتمع ينظر إلى الجسم السليم فقط.
- حتى اليوم لم نجد امرأة عربية عصرية - آمل أن أكون مخطئة - مثل "هيلين كلير" تتحدى وتتفوّق ويصبح لها الشأن الكبير وتصبح مثالاً إنسانيا عالميا.
- من الأهمية أن يكون رجلاً أو امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة وزيرًا أو مسؤولاً، لأن العقل والثقافة والمقدرة لا تقتصر على أصحاء الجسم فقط.
عالم "ذوي الاحتياجات الخاصة" فيه الدموع والانتظار والتحدي والضعف والقلق والخوف من الغد، فيه التمني والحلم والعيون التي تنظر برجاء. فيه جميع الأحاسيس المكبوتة التي تخاف من الانطلاق. فيه المشاعر التي تنتظر ولادة الفرح.
لكن عالم "ذوي الاحتياجات الخاصة" قريب قرب الدمعة من العين. قريب وبعيد. قريب لأصحاب الشأن من الآباء والأمّهات، وبعيد عن المسؤولين الذين لا يهتمون ولا يحاولون توفير الميزانيات والخدمات الواجبة.
"ذوي الاحتياجات الخاصة" هم الأرقام الصعبة في عالم ينظر إليهم من ثقب باب الأجسام الرشيقة.

د. بسيم عبد العظيم عبد القادر (شاعر وناقد أكاديمي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب ـ جامعة المنوفية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد كتاب مصر)
حقوق ذوي الهمم في الأدب والثقافة والحياة
إنّ "ذوي الهمم" أو ما يُعرف بـ"ذوي الاحتياجات الخاصة" هم شريحة إنسانية نبيلة تشكّل جزءًا أصيلاً من نسيج المجتمع، لا تقلّ عن غيرها قدرةً على الإبداع والعطاء حين تتاح لها الفرص الملائمة، ولقد أكّد الفكر الإنساني والإسلامي على كرامة الإنسان بغضِّ النظر عن حالته الجسدية أو النفسية، فكلُّ إنسان له حقُّ الحياة الكريمة، وحقُّ المعرفة، وحقّ المشاركة في بناء الحضارة.
الحق في المعرفة والثقافة
المعرفة هي حقٌّ إنسانيٌّ شامل، لا يختصُّ بفئة دون أخرى، وهي التي تصنع وعي الإنسان وقدرته على الاندماج في العالم، وقد كانت القاعدة الإسلامية الخالدة: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"، نداءً شاملاً لا يُقصي أحدًا، ومن هنا، فإنَّ حرمان ذوي الهمم من وسائل المعرفة الحديثة يُعدّ نوعًا من الإقصاء الثقافي، لأنَّ المعرفة ليست ترفًا بل ضرورة للوجود الإنساني.
لقد ظهرت في العقود الأخيرة مبادرات رائدة لتقريب المعرفة إلى هذه الفئة، مثل الكتب الناطقة للمكفوفين، والبرامج الإلكترونية الموجّهة لذوي الإعاقات الحركية أو السمعية، غير أنّها تظلّ في أغلب الأحيان محدودة أو مختارة من منظور "الأسوياء"، وليست نابعة من حاجات ذوي الهمم ورغباتهم الثقافية الحقيقية، فالحق في المعرفة لا يتحقق بتوفير المادة فقط، بل بإشراك المستفيد في صياغة هذه المادة ومحتواها.
ذوو الهمم في الأدب
يتعامل الأدب، في جوهره، مع الإنسان في ضعفه وقوته، في ألمه وأمله، في بحثه عن المعنى، ومن ثمّ فإنّ الأدب الحقيقي يجب أن يفتح قلبه لتجارب ذوي الهمم، سواء بالكتابة عنهم أو لهم.
لقد تناول الأدب العربي والعالمي شخصيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل "طه حسين" الذي تجاوز فقدان البصر ليصبح "عميد الأدب العربي"، و"هيلين كيلر" التي أصبحت رمزًا عالميًا للإرادة الإنسانية، ولكنّ الإشكال لا يزال قائمًا: فالأدب العربي نادرًا ما يوجّه إنتاجه إليهم مباشرة، ليجعلهم قرَّاء لا موضوعات فقط.
إننا بحاجة إلى أدبٍ يُراعي طبيعة هذه الفئات في اللغة والأسلوب والمضمون، أدبٍ يمنحهم الأمل والثقة بالذات، ويحتفي بقدراتهم لا بعجزهم، ويرى فيهم طاقة خلّاقة يمكن أن تضيء المجتمع.
وقد خصصت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إحدى جوائزها السنوية للكتاب من ذوي الهمم تشجيعا لهم على الإبداع الأدبي.
كما دأبت الهيئة العامة لقصور الثقافة بجمهورية مصر العربية على عقد مؤتمر سنوي يتناول أدب ذوي الإعاقة.
كما قام المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم أسبوع شباب الجامعات لذوي الهمم، وقد استضافته جامعة المنوفية منذ خمسة أعوام تقريبا، وكنتُ من بين مُحكّمي الإبداع الشعري لذوي الهمم كما كتبتُ أنشودة ليفتتح بها فعاليات الأسبوع، والحق أني بحثت عنها فلم أتمكّن من العثور عليها.
أدب الأطفال لذوي الهمم
تُعدُّ الطفولة المرحلة الأهم في بناء الشخصية، ومن هنا تأتي أهمية تخصيص أدبٍ موجّهٍ لأطفال ذوي الهمم، فهذا الأدب يجب أن يُصاغ بلغةٍ مشجِّعةٍ غير مشفقة، وأن يُقدِّم أبطالًا من ذوي الهمم ينجحون ويتفوَّقون رغم التحديات، كما ينبغي أن تُختار المفردات بعناية، وأن تُراعى فيها الجوانب النفسية لتجنّب الإيحاء بالعجز أو الدونية.
إنَّ وجود مكتبات صوتية وبصرية بلغةٍ مُبسَّطة ورسومٍ مُعبِّرة يُعدُّ ركيزةً لتمكين هؤلاء الأطفال من التفاعل مع عالم الأدب، فيتعلّموا التعبير عن أنفسهم، ويكتشفوا مواهبهم، ويؤمنوا بأنّهم جزءٌ فاعل من المجتمع الثقافي.
مسؤولية الكُتّاب والمثقفين
تقع على عاتق الأدباء والمفكرين مسؤولية أخلاقية وثقافية تجاه ذوي الهمم، فليس المطلوب الكتابة عنهم فحسب، بل الكتابة لهم وبمشاركتهم، فعليهم أن ينقلوا صوتهم ومعاناتهم وأحلامهم إلى النصّ، وأن يسعوا إلى إنتاج أدبٍ شاملٍ يُعيد تعريف "القدرة" و"الاختلاف" بمعناهما الإنساني الرحب، كما يجب أن تُدمج قضاياهم في المناهج الدراسية والمهرجانات الثقافية والمنتديات الأدبية، وقد أنشئت المدارس الخاصة بذوي الهمم على اختلاف أنواعهم من مبصرين أو صم وبكم، كما خُصّصت لهم برامج جامعية لتخريج مُعلّميهم في كليات التربية وفي كليات التربية النوعية وفي كليات الطفولة المبكرة، ومن الأساتذة الذين كتبوا في ذلك صديقي الدكتور "محمود عسران" فقد كتب: القصص والحكايات لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2022، وأتبعه بفن كتابة القصة وروايتها لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2023.
إنَّ الأدب والمعرفة والثقافة ليست حكرًا على فئة من الناس، بل هي فضاءٌ إنسانيّ مفتوحٌ للجميع، وذوو الهمم ليسوا "آخرين" في الهامش، بل هم في قلب المشهد الإنساني بما يملكون من عزيمة وإرادة، ومن واجبنا جميعًا - كتّابًا، ومؤسساتٍ ثقافية، ومجتمعاتٍ تعليمية - أن نكسر حواجز الصمت والعزلة، وأن نمنحهم حقّهم الكامل في المعرفة والإبداع والمشاركة، ليصبح الأدب بحقٍّ أداةً للدمج، لا مرآةً للعجز.
ذوو الإعاقة عند الفلاسفة الغربيين قديما وحديثا
منذ فجر الفكر الإنساني، شكّل سؤال الكمال والنقص، والصحة والمرض، والجسد والروح، محورًا أساسيا في تفكير الفلاسفة الغربيين، وضمن هذا الإطار، تبلورت رؤى متباينة حول ذوي الإعاقة، بين الإقصاء والتمييز في العصور القديمة، والاعتراف بالكرامة الإنسانية والحقوق في الفلسفة الحديثة والمعاصرة.
أولاً: الفلاسفة القدماء ونظرة النقص الطبيعي
في الفلسفة اليونانية القديمة، كان الإنسان المثالي هو مَن يجمع بين الجمال الجسدي والفضيلة العقلية، ولذا رأى أفلاطون في جمهوريته أنَّ المجتمع الفاضل لا بد أن يقوم على القوة والعقل، واعتبر أنَّ مَن لا يملكون الجسد القوي أو القدرات العقلية الكاملة لا يمكنهم المشاركة في حراسة الدولة أو حكمها.
أما أرسطو فقد ذهب أبعد حين وصف ذوي الإعاقات العقلية بأنَّهم "ناقصو الإنسانية"، لأنهم - بحسب نظره - لا يملكون القدرة على ممارسة العقل العملي الذي يميز الإنسان عن الحيوان.
وقد انعكست هذه الرؤية في المجتمع الإغريقي الذي مجّد الجسد السليم في الألعاب الأولمبية والفنون والنحت، فكان ذوو الإعاقة يُنظر إليهم نظرة دونية، بوصفهم خارجين عن أنموذج "الإنسان الكامل".
ثانيًّا: الرؤية المسيحية في العصور الوسطى
مع بزوغ المسيحية، تغيّر المنظور الأخلاقي جذريًّا، فقد أكّد القديس أوغسطين والقديس توما الأكويني أنَّ الإعاقة لا تمسُّ كرامة الإنسان، لأنَّها جزء من امتحان إلهي يختبر به الله صبر عباده، وأنَّ الرحمة والشفقة والعدل واجبة تجاههم.
ومع ذلك، ظلَّت الإعاقة تُفسَّر أحيانًا كعلامة على الخطيئة أو كعقوبة سماوية، مما أبقى النظرة الاجتماعية محصورة بين الرحمة والعزلة، دون إدماج حقيقي في الحياة العامة.
ثالثًا: عصر النهضة والفكر الإنساني
في عصر النهضة، ومع بروز النزعة الإنسانية التي مجَّدت قدرات الإنسان وإمكاناته، بدأ بعض المفكرين، مثل "ميشيل دي مونتين"، يدعون إلى إعادة النظر في مفهوم "الطبيعي" و"الناقص"، مؤكدين أنَّ النقص الجسدي لا يعني بالضرورة نقصًا في القيمة أو الوعي أو الأخلاق.
كما رأى "فرنسيس بيكون" أنَّ العلم والتربية قادران على تعويض العجز الطبيعي، وأنَّ المجتمع العادل هو الذي يوفّر لذوي الإعاقة فرص النماء والمعرفة.
رابعًا: فلاسفة الحداثة والحقوق الإنسانية
مع ظهور فلسفة التنوير في القرن الثامن عشر، خصوصًا مع "جان جاك روسو" و"إيمانويل كانط"، تحوَّل النظر إلى الإنسان بوصفه كائنًا عاقلاً له كرامة مطلقة، فرأى "كانط" أنَّ الكرامة الإنسانية لا تُقاس بالجسد، بل بحرية الإرادة، ومن ثم فكل إنسان - مهما كان جسده - يستحق الاحترام المطلق.
كما دافع "جون لوك" و"جون ستيوارت" مل عن المساواة أمام القانون، مؤسِّسين بذلك لفكرة العدالة الاجتماعية التي ستتطور لاحقًا في فلسفات الحقوق المدنية.
خامسًا: الفلسفة المعاصرة وفكر الجسد المختلف
في القرن العشرين، برزت فلسفاتٌ جديدةٌ أعادت تعريف الإعاقة من منظور اجتماعي وثقافي، فقد ناقشت "سيمون دو بوفوار" و"ميشيل فوكو" و"إيمانويل ليفيناس" مسألة "الآخر المختلف"، معتبرين أنَّ المجتمع هو الذي يخلق الإعاقة عندما يضع معايير قسرية للجسد السوي.
وفي العقود الأخيرة، قدَّمت الفيلسوفة الأمريكية "مارثا نوسباوم" إطارًا أخلاقيًّا شاملاً لحقوق ذوي الإعاقة، في سياق ما سمَّته "قدرات الإنسان"، مؤكدة أنَّ العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا حين يُتاح لكل إنسان - مهما كانت إعاقته - أن يطوّر قدراته ويعيش حياة كريمة.
كما دعا "ريتشارد رورتي" و"أمارتيا سن" إلى فهم الإعاقة بوصفها قضية حرية وعدالة اجتماعية وليست مجرد حالة طبية.
لقد انتقل الفكر الغربي من رؤية الإعاقة كـ"نقص" يجب إخفاؤه أو استبعاده، إلى اعتبارها اختلافًا إنسانيًّا مشروعًا يستحق الاعتراف والتمكين، وبذلك، لم تعد الفلسفة الحديثة تبحث في كيف يمكن "تصحيح" الجسد، بل في كيف يمكن إعادة بناء المجتمع ليكون أكثر عدلاً وشمولاً لكل أجساد البشر وأرواحهم.
ذوو الإعاقة عند الفلاسفة المسلمين قديما وحديثا
إنَّ الفلاسفة المسلمين لم ينظروا إلى الإنسان من زاوية النقص الجسدي أو العاهة العضوية، بل من زاوية القدرة العقلية والروحية التي تميّزه، ومن ثمَّ تجاوزوا النظرة السطحية التي كانت شائعة في بعض الثقافات القديمة، حيث كان يُنظر إلى المعاق نظرة دونية أو يُقصى من الحياة العامة.
لقد قدّم الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية رؤية إنسانية راقية لذوي الإعاقة، تستمدّ أصولها من القرآن الكريم والسنة النبوية، اللذين جعلا الكرامة الإنسانية ثابتة لا تُمَسُّ، بغض النظر عن الشكل أو القدرة البدنية.
أولاً: الفلاسفة المسلمون في العصور القديمة
تناول فلاسفة الإسلام مسألة الكمال والنقص من منظور عقلي وأخلاقي وروحي، لا جسدي، ومن أبرزهم:
1. الفارابي (ت 339هـ): في كتابه المدينة الفاضلة يرى أنَّ قيمة الإنسان في عقله وعمله، لا في بدنه، فالذي يُحسنُ استعمال عقله ويُسهم في بناء المدينة الفاضلة هو إنسان كامل، حتى لو كان ناقص الجسد، وبهذا جعل الفارابي معيار الكمال إنسانيًّا هو الفضيلة والمعرفة لا القوة الجسدية.
2. ابن سينا (ت 428هـ): يفرّق ابن سينا في الشفاء بين النقص الطبيعي والنقص الإرادي، ويؤكد أنَّ الإعاقة لا تمسُّ جوهر النفس الناطقة التي تظلُّ قادرة على التفكير والمعرفة، ومن ثمَّ يمكن للمعاق أن يكون عالمًا أو فيلسوفًا ما دامت قواه العقلية سليمة، ويرى أنَّ الإعاقة ابتلاءٌ إلهيٌّ يمكن أن يكون سببًا في ترقية النفس إذا صبرت واحتسبت.
3. الغزالي (ت 505هـ): في إحياء علوم الدين وميزان العمل، يؤكد الغزالي أنَّ الله تعالى لا يُحاسب الناس على ما لا يقدرون عليه، وأنَّ نقص البدن لا يُنقص من الكرامة ولا من إمكان الوصول إلى السعادة الأخروية، لأنَّ معيار التفاضل هو التقوى والعمل الصالح.
4. ابن رشد (ت 595هـ): ينظر ابن رشد نظرة عقلانية حين يربط الإعاقة بمسائل الطبيعة والتكوين، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أنَّ المجتمع مسؤول عن تربية الجميع وإتاحة الفرصة لكل إنسان بحسب طاقته، فهو يرى أنَّ العدالة تقتضي تمكين المعاق من المشاركة في الحياة الفكرية والاجتماعية ما دام يملك القدرة.
ثانيًّا: الفكر الفلسفي الإسلامي الحديث
في العصر الحديث، تأثّر الفلاسفة والمفكرون المسلمون بالمفاهيم الحقوقية العالمية، لكنهم حافظوا على الجذر الإنساني الإسلامي الذي يربط بين العدالة والرحمة والتكافؤ.
ومن أبرز الاتجاهات الحديثة:
1. محمد إقبال (1877- 1938): نظر إلى الإنسان بوصفه "خليفة الله في الأرض"، واعتبر أنَّ القوة الحقيقية ليست في البدن بل في إرادة الروح. والإعاقة الجسدية في نظره لا تحدّ من الإبداع، بل قد تكون باعثاً على التحدي والسموّ.
2. مصطفى عبد الرازق (1885 - 1947): في دراسته للفكر الإسلامي، أكّد أنَّ العدالة الاجتماعية تقتضي تسوية الفرص التعليمية والمهنية، وأنَّ المجتمع الإسلامي مطالب بأن يزيل الحواجز التي تعوق ذوي الإعاقة عن الاندماج الكامل في الحياة العامة.
3. مالك بن نبي (1905 - 1973): تحدّث عن "فاعلية الإنسان" وربطها بالعقل والإرادة، لا بالبدن، وذهب إلى أنَّ الإعاقة الحقيقية هي تعطيل الفكر والإرادة، لا ضعف الجسد، داعياً إلى تهيئة بيئة ثقافية تُبرز طاقات المعاقين وتُسهم في نهضة الأمة.
الفكر المعاصر وحقوق الإنسان في الإسلام
تبنّت المؤسسات الفكرية والفقهية في العقود الأخيرة رؤية تقوم على الدمج والمشاركة، مستندة إلى مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل والكرامة الإنسانية، وبرزت فتاوى واجتهادات تدعو إلى تمكين ذوي الإعاقة في العمل والتعليم والقيادة، بل والمشاركة في الفنون والآداب.
لقد أثبت الفلاسفة المسلمون، قديمًا وحديثًا، أنَّ الإسلام يملك رؤية فلسفية إنسانية متقدمة تجاه ذوي الإعاقة؛ رؤية تجعلهم جزءاً فاعلاً من المجتمع، لا عبئًا عليه، وهي رؤية تقوم على تكريم الإنسان بما هو إنسان، وعلى أنَّ الجسد وسيلة، بينما القيمة العليا في العقل والخلق والعمل، ومن ثمّ يمكن القول إنّ الفلسفة الإسلامية قد سبقت الفلسفات الغربية الحديثة في تأصيل الكرامة الإنسانية الشاملة، وفي اعتبار الإعاقة اختلافاً في القدرات لا نقصاً في الإنسانية.
ذوو الهمم في التراث العالمي: من الهامش إلى مركز الإنسانية
كان الإنسان عبر العصور محور الفكر والفن والأدب، غير أنَّ فئات منه ظلت طويلاً على هامش الاهتمام الإنساني، ومنهم ذوو الهمم (ذوو الاحتياجات الخاصة)، الذين شكّلوا رغم معاناتهم مصدر إلهام وقوة في التراث العالمي، إذ تحوَّلوا من رموز للشفقة إلى رموز للتحدي والإبداع.
1. في الحضارات القديمة:
في الحضارة اليونانية القديمة، لم يكن الاعتراف بالاختلاف الجسدي أو العقلي مقبولاً على نحو واسع؛ إذ نظر الإغريق إلى القوة والكمال الجسدي كرمز للجمال، فكانت الإعاقة أحيانًا تُقابل بالنّبذ، ومع ذلك يظهر في بعض الأساطير الإغريقية ما يعبِّر عن احترام الحكمة الخارجة من المعاناة، مثل شخصية "إيفستوس" (إله الحدادة الأعرج)، الذي صنع الأسلحة للآلهة وأبدع في فنه رغم إعاقته.
أما في الحضارة الصينية القديمة، فقد نظر "كونفوشيوس" إلى الإنسان من زاوية الفضيلة لا الجسد، فاعتبر أنَّ قيمة الإنسان في أخلاقه وسلوكه، لا في شكله أو قوته البدنية، وهو ما مَثَّل تحوّلاً فلسفيًّا عميقًا في فهم الإنسانية.
وفي الموروث الديني اليهودي والمسيحي، نجد العطف والرحمة تجاه المرضى وذوي العاهات قيمةً أساسية، كما في قصة شفاء الأعمى والأبرص في "العهد الجديد"، التي تمجِّد الرحمة الإلهية وتعيد للإنسان المختلف كرامته.
2. في الفكر العربي والإسلامي
أعلى الإسلام من شأن ذوي الهمم، فساوى بينهم وبين سائر الناس في الكرامة والتكليف والحقوق، إذ يقول الله تعالى: "لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ" (النور: 61).
وقد تجلَّت هذه الرؤية في السيرة النبوية؛ حيث اتخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) عبد الله بن أم مكتوم - وهو أعمى - مؤذّنًا وإمامًا في الصلاة، وكان يستخلفه على المدينة في غيابه. فغدت الإعاقة في الفكر الإسلامي دافعاً للبذل لا عائقاً دون الفاعلية.
3. في الأدب الأوروبي
شهد الأدب الأوروبي منذ عصر النهضة تحوّلاً في النظرة إلى ذوي الهمم، حيث أصبحت الإعاقة موضوعًا إنسانياً عميقاً يُعبِّر عن الصراع بين الضعف والإرادة.
ففي رواية "أحدب نوتردام" لفيكتور هوغو، يصبح الأحدب رمزًا للجمال الداخلي والإخلاص في عالم قاسٍ لا يرى إلا المظاهر، وفي رواية "قصة مدينتين" لتشارلز ديكنز، تتجلى الرؤية الاجتماعية لذوي الهمم باعتبارهم ضحايا النظام الطبقي، لكنها تبرز أيضاً قيم التضحية والإصرار.
4. في التراث الإنساني الحديث
في العصر الحديث، تحولت الإعاقة إلى "قضية حقوق إنسان" تتصدر المواثيق الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، التي أكدت أنَّ المجتمع الإنساني لا يكتمل إلا باحتضان جميع أفراده، وأنَّ الدمج والتعليم والثقافة والإبداع هي وسائل تحقيق المساواة.
ومن الرموز العالمية البارزة "هيلين كيلر"، التي تحدّت الصمم والعمى لتصبح كاتبة ومحاضِرة تدافع عن حقوق الإنسان، و"ستيفن هوكينغ" الذي أصبح أحد أعظم علماء الفيزياء رغم إصابته بالشلل التام، فكانا معًا شاهدين على أنَّ الإعاقة لا تحدّ من الفكر ولا من الخيال.
إنَّ تراث الإنسانية في النظر إلى ذوي الهمم هو مرآة لتطور الوعي البشري، فحين كانت القوة المادية هي المقياس، عانى المختلفون التهميش، وحين أصبح العقل والضمير مقياس القيمة، تبوّأ ذوو الهمم مكانتهم في قلب الفكر الإنساني.
وهكذا أصبحوا، في التراث العالمي، رموزًا للإرادة والتجاوز والإبداع، يذكّرون البشرية بأن الكمال ليس في الجسد، بل في القدرة على النهوض رغم الألم.
ذوو الهمم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة
يُعدّ الاهتمام بذوي الهمم من القيم الإنسانية العليا التي أولاها الإسلام عناية فائقة، انطلاقًا من رؤيةٍ توحيدية تُكرّم الإنسان لكونه إنسانًا، لا لجسده أو قدراته الجسدية أو العقلية، بل لجوهره الإنساني وطاقته على الإبداع والعطاء.
أولاً: ذوو الهمم في القرآن الكريم
جاء القرآن الكريم مكرِّمًا الإنسان في عمومه: ﴿وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: 70). وهذا التكريم يشمل جميع البشر على اختلاف قدراتهم، فلا فضل لإنسان على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح، وقد تناول القرآن الكريم قضايا ذوي الهمم بإشارات دقيقة ومضامين سامية، تُبرز أنهم جزءٌ من المجتمع لهم حق المشاركة والاحترام.
ومن أبرز الأمثلة قصة عبد الله بن أم مكتوم (رضي الله عنه)، التي وردت في قوله تعالى: "عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ (1) أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ" (عبس، الآية: 1 - 2)، وفيها توجيه إلهي عظيم يُرسي مبدأ المساواة ويُعلِّم الأمّة أنَّ معيار الكرامة ليس في الهيئة أو البصر، بل في القلوب العامرة بالإيمان، وقد صار ابن أم مكتوم مؤذّنًا للنبي (صلى الله عليه وسلم)، ووليَ بعض المهام في المدينة حين يغيب الرسول، وهو ما يدل على الثقة بقدراته ومكانته.
كذلك أشار القرآن إلى فئة أصحاب الأعذار الذين لم يشاركوا في الجهاد لعجزٍ أو مرض: ﴿لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (الفتح: 17)، وفي هذه الآية اعتراف بحقوقهم وتخفيف التكليف عنهم، دون أن ينتقص ذلك من أجرهم أو مكانتهم.
ثانيًّا: ذوو الهمم في السنة النبوية المطهّرة
كانت السنة النبوية التطبيق العملي للرحمة الإلهية، فقد عامل الرسول (صلى الله عليه وسلم) ذوي الهمم بعظيم الرفق، وكان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يُجلس ذوي الهمم في مجالسه ويكلّفهم بمهام تناسب قدراتهم، كما فعل مع "ابن أم مكتوم" الذي قال له: "يا ابن أم مكتوم، أنت رجل ضرير، ولكنك مأذون لك في الأذان"، كما قال (صلى الله عليه وسلم): "إنما تُنصرون وتُرزقون بضعفائكم" (رواه أبو داود)، وفي هذا الحديث بيان لقيمة هؤلاء في ميزان السماء، فهم مصدر بركة للأمة بما يحملونه من صبر وصدق وتوكّل.
ثالثاً: تقدير ذوي الهمم وإبراز مواهبهم
إنَّ الإسلام لا ينظر إلى ذوي الهمم نظرة شفقة، بل نظرة تكامل وعدالة، وقد قدّم التاريخ الإسلامي نماذج مضيئة: فابن أم مكتوم مؤذّن النبي صلى الله عليه وسلم ومشارك في بعض الغزوات، وعطاء بن أبي رباح الفقيه الأعمى الذي كان من كبار علماء مكة، والأحنف بن قيس الذي كان أعرج، لكنه كان من دهاة العرب وحكمائهم، وهؤلاء وغيرهم أثبتوا أنَّ العزيمة الصادقة تتجاوز حدود الجسد.
وفي ضوء ذلك، يجب على المجتمعات الإسلامية اليوم أن تسير على النهج النبوي في تمكين ذوي الهمم عبر: توفير التعليم المتكافئ والفرص الوظيفية، واستثمار مواهبهم في المجالات العلمية والفنية والأدبية، ترسيخ ثقافة الاحترام لا الشفقة، والتكريم لا التهميش.
لقد أسس القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة رؤيةً متكاملة لدمج ذوي الهمم في المجتمع، تقوم على الكرامة والمساواة وإتاحة الفرص. وما أحوجنا اليوم إلى تفعيل هذه المبادئ، وإبراز قصص نجاحهم كنماذج تحتذى، ليظل الإسلام دين الرحمة والعدل والإنسانية.
تمثيلات ذوي الهمم في التراث العربي: قراءة في النصوص والمناهج
يُعَدُّ موضوع ذوي الهمم في التراث العربي من القضايا التي تجمع بين البعد الإنساني والبعد الثقافي؛ إذ تشكِّل نظرة المجتمع العربي القديم إلى المختلف جسديًّا أو حسيًّا مرآةً لموقفه من الإنسان في جوهره، فالأدب العربي منذ الجاهلية لم يكن غافلًا عن أولئك الذين عانوا من الإعاقة، بل جعل منهم رموزًا للعزم، والذكاء، والفطنة، وصاغ من تجاربهم مادة أدبية غنية بالدلالات الأخلاقية والاجتماعية.
أولًا: المضمون العام في كتب التراث
يأتي كتاب الجاحظ "البرصان والعرجان والعميان والحولان" في طليعة المؤلفات التي أنصفت ذوي الهمم في الأدب العربي. فقد تناول الجاحظ فئاتٍ من أصحاب الإعاقات الجسدية بوصفهم بشرًا كاملي الكرامة، وسعى إلى تبيين أن العيب في الجسد لا يَنقُص من قدر الإنسان أو من فطنته، بل قد يكون محفِّزًا للإبداع والتفوّق. استخدم "الجاحظ" أسلوب السخرية الرفيعة، والنماذج التاريخية، والقصص الواقعية ليبرهن أن العاهة لا تعني العجز.
وفي المقابل، وردت إشارات أخرى متفرّقة في كتب السير والأخبار، مثل "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني، و"عيون الأخبار" لابن قتيبة، إذ يُذكر الشعراء والعلماء من ذوي الإعاقات ضمن تراجم الكبار، من غير أن يُتَّخذ عجزهم سببًا للانتقاص منهم، بل يُذكَر غالبًا مقرونًا بالصبر والتميز العقلي.
أما في المجال الديني والفقهي، فقد تناول الفقهاء والمفسرون موضوع الإعاقة من زاويتين: الأولى تشريعية تتعلق بحقوق ذوي العاهات في الميراث، والزواج، والجهاد، والشهادة، والثانية أخلاقية تؤكد تكريم الإنسان مطلقًا كما في قوله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" (الإسراء، الآية: 70)، وكما ورد في السنة من أحاديث تُوصي برعاية الضعفاء، ومن هنا تفرّعت في العصور اللاحقة دراسات فقهية واجتماعية حول رعاية المكفوفين، وبناء دور للمعاقين، وتخصيص أوقاف لهم.
ثانيًّا: المنهج الأدبي في دراسة الظاهرة
اعتمد "الجاحظ" ومن تبعه في معالجة موضوع ذوي الهمم المنهج الوصفي السردي، إذ جمع الأخبار والحكايات التي تُبرِز تناقضات المجتمع في نظرته إلى المختلف جسديًّا، وصاغها في قالب يجمع بين الجدّ والهزل. كما أظهر منهجه نزعة عقلانية تبتعد عن التصنيف السلبي، وتُقرُّ بتنوُّع الخلق بوصفه سنة إلهية.
وفي الدراسات المعاصرة، اتجه الباحثون إلى إعادة قراءة هذه النصوص وفق منهج دراسات الإعاقة الحديثة (Disability Studies)، الذي يركّز على البنية الثقافية للوصم الاجتماعي أكثر من التركيز على العجز البيولوجي. وقد أعاد هذا المنهج الاعتبار لكتابات التراث العربي، بوصفها محاولات مبكرة لتفكيك المفهوم الضيق "للكمال" الجسدي، وإعادة تعريف القوة والضعف ضمن منظومة إنسانية أرحب.
ثالثًا: المضمون الأخلاقي والإنساني
تكشف نصوص التراث العربي عن حسٍّ إنساني رفيع في التعامل مع أصحاب الإعاقات، فقد روى الشعراء قصائد في مدح العزيمة والصبر، كما في أبيات الأعشى وبشار بن برد، اللذين مثّلا أنموذجين للشاعر الكفيف القادر على تحدي عجزه بالحكمة والفكر، كما امتدح المتصوّفة فكرة "نقص الجسد" بوصفها علامة على كمال الروح، فعدُّوا البلاء وسيلة للتطهر والسمو.
وتحمل هذه النصوص دلالات اجتماعية مهمة؛ فهي تكشف عن أنَّ التراث العربي لم يكن في جوهره تراثًا إقصائيًّا، بل احتضن المختلف وجعل له مكانة رمزية، سواء في مجلس العلم أو في ساحة الشعر أو في كتب النثر.
رابعًا: مقارنة مع الدراسات الحديثة
في ضوء المقاربات التاريخية الحديثة، مثل كتاب "سارة سكالنجه" (Disability in the Ottoman Arab World)، نجد أنَّ مفهوم الإعاقة في التراث العربي كان مرنًا، ولم يُصَغ في قالبٍ واحد، فالاختلاف الجسدي لم يكن يُحدّد قيمة الإنسان بقدر ما كانت تحددها مكانته العلمية أو خُلُقه، وتؤكد الدراسات المعاصرة أنَّ المجتمع الإسلامي المبكر، بخلاف بعض المجتمعات الغربية الوسيطة، لم يربط الإعاقة بالخطيئة، بل بالابتلاء الإلهي الذي يُقابَل بالصبر والرضا.
إنّ دراسة ذوي الهمم في التراث العربي تكشف عن مزيجٍ فريد من النزعة العقلانية عند "الجاحظ"، والرحمة الشرعية في الفكر الفقهي، والرمزية الروحية في الأدب الصوفي، والنزعة الاجتماعية في السير والتراجم.
وهذا التعدد المنهجي يجعل من الموضوع ميدانًا خصبًا للباحثين في الأدب، والاجتماع، والدين، والأنثروبولوجيا الثقافية.
يُظهر التراث العربي بجلاء أنّ الهمَّة لا تُقاس بسلامة الجسد، بل بقدرة العقل والإرادة. ومن ثمّ، فإنَّ إعادة قراءة هذا التراث في ضوء النظريات الحديثة لا تُعيد فقط الاعتبار إلى ذوي الهمم في الماضي، بل تفتح أفقًا ثقافيًّا جديدًا لترسيخ قيم المساواة والتنوّع في الحاضر.
ذوو الهمم في الأدب العربي منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحديث
من أرفع القيم التي أولاها الأدب العربي اهتمامًا كبيرًا قيمة الهمّة، فهي عنوان القوة والإرادة والإصرار على تحقيق الهدف، مهما تعاظمت الصعاب. والهمة في المفهوم العربي ليست مجرد نشاط عابر، بل هي طاقة روحية وأخلاقية تدفع الإنسان إلى معالي الأمور وتقيه من دناياها، لذا، احتفى الأدب العربي - شعرًا ونثرًا - بذوي الهمم، سواء أكانوا من الأبطال والمحاربين، أم من العلماء والمبدعين، أم من ذوي الإعاقة الذين تجاوزوا حدود الجسد بإرادة الروح.
الهمة في العصر الجاهلي
كان العربي في الجاهلية يعتز بالبطولة، ويقيس قدر الإنسان بمدى شجاعته وكرمه وعلو همته، فالشعر الجاهلي زاخر بصور الهمة والإقدام، كقول عنترة بن شداد:
لا تَسقِني ماءَ الحَياةِ بِذِلَّةٍ -- بَل فَاِسقِني بِالعِزِّ كَأسَ الحَنظَلِ
ماءُ الحَياةِ بِذِلَّةٍ كَجَهَنَّم -- وَجَهَنَّم بِالعِزِّ أَطيَبُ مَنزِلِ
وهذا يجسّد روح الهمّة، إذ يفضل الشاعر الموت عزيزًا على حياةٍ يكسوها الذل، كما نجد في شعر "طرفة بن العبد" و"زهير بن أبي سلمى" إشارات إلى كرامة النفس وعلو الإرادة، مما يؤكد أنَّ الهمة كانت معيار الشرف والمجد في المجتمع الجاهلي.
وقد انتهى الباحث "عبد الله متولي عبده" من رسالته للدكتوراه في الأدب الجاهلي تحت إشرافنا بالاشتراك مع أ. د. "محمود الفوي" عن ذوي الإعاقة في الشعر الجاهلي منذ شهور قليلة، وكانت بعنوان: "ملامح الانكسار في نتاج شعراء الجاهلية"، وانتهى إلى أثر الإعاقة في الشعر عند ثلاثة شعراء يمثلون نماذج مختلفة من الإعاقة، وهم امرؤ القيس واشتهر بالعنة، وعنترة وقد وصم بالعبودية، وعامر بن الطفيل الذي كان عقيما، وأن هؤلاء الشعراء استعلوا على مظاهر النقص فيهم وحوّلوها إلى قوة مادية ومعنوية برزت في نتاجهم الشعري، وجدير بالذكر أنَّ "عبد الله" يعد من المبصرين، وقد جاهد حتى حصل على الدكتوراه في الادب العربي.
ذوو الهمم في صدر الإسلام
الإسلام يجعل الهمة في طاعة الله وخدمة الناس أعلى المراتب، فرفع شأن ذوي العزائم، واعتبر الصبر والثبات في مواجهة البلاء من علامات الإيمان الراسخ، وتجلَّت هذه الروح في شعر حسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة الذين مجّدوا المجاهدين والمرابطين وأصحاب الإرادة القوية.
الهمة في العصرين الأموي والعباسي
في هذين العصرين، ازدهرت الحضارة الإسلامية، فكانت الهمة مقرونة بطلب العلم والمعرفة، فكتب الأدباء عن العلماء والزهاد وأصحاب الطموح الفكري والعلمي. وفي الشعر، نجد أبا الطيب المتنبي يقول:
ولم أرَ في عيوبِ الناسِ شيئًا -- كنقصِ القادرينَ على التمامِ
فهو يرى أن قمة العيب أن يقدر المرء على بلوغ المجد ولا يسعى إليه، وهي خلاصة فلسفة الهمة، كما عبّر المتنبي عن قمة هذه الروح بقوله الشهير:
إذا غامرتَ في شرفٍ مرومٍ -- فلا تقنع بما دونَ النجومِ
فطعم الموت في أمر حقير -- كطعم الموت في أمر عظيم
فالمتنبي هو شاعر الهمة بامتياز، لا يعرف السكون ولا الرضا بالقليل، وقد أصبحت أبياته مدرسة في التحفيز والطموح والإصرار.
ذوو الهمم في الأدب الأندلسي
في بيئةٍ تميّزت بالتنوع الثقافي والجمال الحضاري، عبّر الأدب الأندلسي عن همة الحفاظ على الهوية والعلم والفن رغم الاضطرابات السياسية.
فنجد "ابن زيدون" في نفيه وصبره مثالًا للعزيمة، ونجد "لسان الدين بن الخطيب" يجسد روح المثقف الذي لا يلين أمام المحن، إذ يقول:
مَن رامَ وصلَ المجدِ لم يَتَخَشَّعِ -- فالمجدُ لا يُعطى لِمَن لَم يَخضَعِ
ذوو الهمم في العصر الحديث
في العصور الحديثة، اكتسب مفهوم "ذوي الهمم" بُعدًا إنسانيًا أوسع، فصار يشمل أصحاب الإرادة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمبدعين الذين تحدّوا القيود المادية والاجتماعية.
نجد في الأدب العربي الحديث شخصيات مثل "طه حسين"، الذي فقد بصره لكنه أضاء عقول الأمة بكُتبه وأفكاره، وأصبح رمزًا خالدًا للهمة التي لا تعرف المستحيل. ونجد "الرافعي" أديب العربية الفذ يتغلب على الصمم ويبهرنا بتراثه الرائع شعرا ونثرا وبحثا ونقدا أدبيا، ولـ "مصطفى صادق الرافعي" رؤيته الفلسفية للألم والمرض، يقول: من لم يتجرّع مرارة الألم؛ لا يمكنه أن يصف مدى قسوته، ومن حُرم الشعور بآلام الآخرين؛ لن يتمكّن من التعبير عن محنتهم ومعاناتهم، وهذا الذي أخفق في إخراج نفسه من محنة آلامه، كيف له أن يبسط يد العون لغيره ممَّن يكابدون الصراع مع الآلام والأحزان؟!
وكذلك "الصاوي شعلان" الذي تعلم الفارسية وترجم "رباعيات الخيام" مع أنه كان مبصرا، وأستاذنا الدكتور "مصطفى الصاوي الجويني" يرحمه الله، وكان أعجوبة في مناقشاته للرسائل العلمية.
وقد عاشرتُ منذ أكثر من أربعة عقود ثلة من المبصرين كان يقودهم صديقي المرحوم الدكتور "إبراهيم محمود سليمان" يرحمه الله، وكانوا غاية في قوة العزيمة والظرف ومنهم من صار شاعرا كبيرا وأستاذا للفلسفة مثل الشاعر الدكتور "صلاح عبد الله" يرحمه الله.
وظلّ ذوو الهمم عبر العصور العربية أنموذجًا يُحتذى في الإصرار والعطاء، سواء أكانوا فرسانًا في ميادين الحرب، أو علماء في محراب الفكر، أو أصحاب إعاقات جسدية تغلبوا عليها بروح عظيمة.
إنَّ الأدب العربي - منذ الجاهلية حتى اليوم - قدّم صورًا خالدة لعلو الهمة، ليؤكد أن الإنسان لا يُقاس بقوته البدنية، بل بعزيمته، ولا بثرائه، بل بقدر ما يملك من إرادة تُحركه نحو الخير والجمال.
حقوق ذوي الهمم والاهتمام بهم في العصر الحديث
يُعدُّ الاهتمام بذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) من أبرز مظاهر الوعي الإنساني والاجتماعي في العصر الحديث، إذ أصبحت قضاياهم جزءًا من منظومة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان التي تُنادي بها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
فقد شهدت العقود الأخيرة تطوّرًا كبيرًا في النظرة إلى ذوي الهمم، حيث انتقل الاهتمام بهم من مرحلة الشفقة والرعاية إلى مرحلة التمكين والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
فقد أكدت الدراسات الاجتماعية والحقوقية أنَّ ذوي الهمم يمتلكون طاقاتٍ ومواهب يمكن أن تسهم بفاعلية في التنمية إذا أُتيح لهم التعليم والعمل والتأهيل المناسب، ولذلك، تبنّت معظم الدول برامج لإدماجهم في التعليم العام وسوق العمل، وتوفير بيئات مناسبة تُمكّنهم من ممارسة حياتهم باستقلال وكرامة.
وقد أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم في ظل رؤية "الجمهورية الجديدة"، فصدر قانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو من أكثر القوانين شمولًا في العالم العربي، وهذا القانون كفل لهم حقوقًا في مجالات التعليم والصحة والعمل والثقافة والمشاركة السياسية، كما ألزم المؤسسات بتوفير التيسيرات المناسبة لضمان وصولهم إلى الخدمات.
كما أعلنت الدولة عام 2018 عامًا لذوي الهمم، وأُنشئت مؤسسات خاصة برعايتهم، منها:
- المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
- برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعمهم ماديًا ومعنويًا.
- مبادرة "قادرون باختلاف" التي تُعقد سنويًّا برعاية رئيس الجمهورية لتكريم النماذج المتميزة منهم في مجالات التعليم والرياضة والفن.
وفي مجال التعليم، تم إدماج ذوي الهمم في المدارس والجامعات، وتوفير مترجمي لغة الإشارة والمناهج المطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين، في حين وفّرت وزارة الشباب والرياضة برامج خاصة لتأهيلهم بدنيًا ونفسيًا.
وأنا أقوم بتدريس اللغة العربية لذوي الهمم في بعض الأقسام التي تناسبهم بكلية الآداب، وأجد منهم ومن ذويهم جدًّا واجتهادا وحرصا على التعليم قد يفوق الطلاب العاديين.
وقد امتد الاهتمام بحقوق ذوي الهمم إلى مختلف الدول العربية، حيث تم تأسيس الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع ذوي الإعاقة عام 1998، الذي يعمل على تنسيق الجهود بين الدول وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل والتعليم والتشغيل.
كما وضعت معظم الدول العربية خططًا وطنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2008.
وشهدت المنطقة العربية بروز شخصيات من ذوي الهمم في مجالات الأدب والفن والرياضة، مثل الرياضيين المشاركين في دورات "البارالمبياد"، والكتّاب الذين تجاوزوا إعاقتهم بالإبداع والإصرار.
الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية
أدركت الأمم المتحدة منذ منتصف القرن العشرين أهمية صون كرامة ذوي الهمم، فأصدرت العديد من القرارات والمواثيق، أهمها:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي نصّ على المساواة وعدم التمييز.
- إعلان حقوق المعاقين (1975) الذي أكد حقهم في الحياة الكريمة والتعليم والعمل.
- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، التي تُعد الوثيقة الأممية الأشمل في هذا المجال، وتنصّ على حقهم في المشاركة الكاملة في جميع مناحي الحياة.
كما أنَّ منظمات الأمم المتحدة مثل "اليونيسف" و"اليونسكو" و"منظمة العمل الدولية" و"منظمة الصحة العالمية"، تتعاون في برامج تستهدف دمج الأطفال ذوي الهمم في التعليم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيا.
الرؤية الإنسانية الشاملة
إنَّ الاهتمام بذوي الهمم ليس فقط واجبًا قانونيًّا أو إنسانيًّا، بل هو استثمار في الإنسان نفسه، فحين تُمنح هذه الفئة حقوقها وتُصان كرامتها، تُثري المجتمع بتجاربها وقدرتها على التحدي والإبداع.
ومن هنا، تتحوّل المجتمعات إلى بيئات دامجة، تنظر إلى الإنسان بوصفه قيمة لا تقل عن غيره في الكفاءة والكرامة، مهما كانت ظروفه البدنية أو النفسية.
لقد قطع العالم العربي شوطًا كبيرًا في حماية حقوق ذوي الهمم والاهتمام بهم، لكن الطريق لا يزال مفتوحًا لتعزيز دمجهم الكامل في التعليم والعمل والإبداع الثقافي.
أما الأمم المتحدة ومنظماتها، فقد أرست الأسس القانونية والإنسانية التي تضمن لهم مكانهم اللائق بين أفراد المجتمع الإنساني.
إنَّ قضية ذوي الهمم اليوم هي قضية حضارة وضمير، تُقاس بها إنسانية الأمم وتقدّمها، وتُختبر فيها قدرتها على بناء عالمٍ يتّسع للجميع دون تمييز أو إقصاء.

سحر قلاوون (كاتبة من لبنان)
"أوجي" ليس بطلا عاديا
في بداية المرحلة التي أصبحت فيها قارئة نهمة، تلتهم الكتب التهاما ولا تشعر بالشبع، وقعت عيناي صدفة على رواية تحمل عنوان "أعجوبة"، وقد رأيت على غلافها وجه صبي صغير ينظر إليّ كما لو أنه يدعوني للتعرف على قصته والغوص في أعماقها.
فما كان مني إلا أن قمت بتحميل الرواية ومن ثمّ بدأت بقراءتها، صفحةً تلو الأخرى، والدهشة حاضرة إلى جانبي، فكم كانت رواية "أعجوبة" مليئة بالجمال والحكمة والعبر، وكم أثّرت فيّ!
ولا بد لي أن أعترف بأنني في كثير من الأحيان وجدت نفسي أبكي، وليس ذلك شفقة مني على وضع "أوجي" أو حزني بسبب المواقف التي تعرّض لها ذلك الصبي الصغير، بل لأن أحداث القصة وتفاصيلها قد لامست قلبي بشكل خاص جعلني أتفاعل معها بشكل كبير، فقد فرحت لفرح "أوجي"، وحزنت لحزنه، وكم تألمّت في كل مرة خاب فيها أمله.
وإن كنتم تتساءلون عن هوية "أوجي" أو ما الذي يميزه؟ فسأخبركم بأنه صبي ولد بتشوّهات خلقيّة في وجهه، ما جعل والداه يعطيانه الدروس في المنزل أوّلا، ولكن بعد عدة سنوات قرّرَا إرساله إلى المدرسة التي سيواجه فيها مشاكل عديدة ومن أبرزها التنمّر.
لكن لماذا يتنمّر التلاميذ على طفل يشبههم في الكثير من الأشياء ويختلف عنهم في أشياء أخرى؟! ولماذا لم يتقبلوه بينهم؟!
لعل هذه الأسئلة لن تجد لنفسها إجابات بسهولة، فنحن اليوم نجد التنمّر منتشرًا بشكل مخيف، خاصة في المدارس، فربما يتعرض التلميذ إلى التنمّر بسبب طوله أو وزنه أو صوته.
إذ تتعدد الأسباب التي تجعل التلاميذ يتنمّرون على تلاميذ آخرين، ولكن النتيجة واحدة: تلميذ يتعرض إلى التنمّر، يشعر بالوحدة، يخاف الذهاب إلى المدرسة لأنه يعلم ما ينتظره هناك، يحس بأن كل من حوله يكرهونه ويتساءل عن ذنبه ويتمنى لو كان بإمكانه الاختفاء بدل التواجد بينهم.
وبالعودة إلى "أوجي"، لم يكن وضعه سهلا أبدا، فلقد بكى في كثير من الأحيان، وتمنى عدم الذهاب إلى المدرسة في أحيان أخرى، لكنه رغم ذلك استطاع النجاح في المدرسة وكسب أصدقاء وقد علمني أن لا شيء يأتينا بسهولة، فعلينا بالصبر. قد يصرخ تلميذ في وجه "أوجي" فجأة، قائلا له: يا معاق، وكم هذا أمر بشع!
فالإعاقة هي أن تكون عديم المشاعر اتجاه الآخرين، ألا تحترم من حولك وألا تراعي ظروفهم وأحوالهم، وأن تكون أنانيا، غيورا وحقودا ولا تشبع من النميمة والكذب والافتراء على هذا وذاك.
أما من لديه مشكلة ما، سواء وجدت منذ ولادته أم لاحقا، فهو إنسان مثلي ومثلك، بل ربما يكون أفضل منا بكثير، إنه من أصحاب القدرات الخاصة المبهرة، فكم من شخص لا يستطيع المشي لكنه يرسم لوحات رائعة، وكم من شخص خسر يدًا لكنه كتب باليد الأخرى كتابات عظيمة تستحق نيل أهم الجوائز، وكم من شخص فقد بصره لكنه لم يتوقف على رؤية مستقبل مشرق له!
"أوجي" ليس بطلا عاديا، بل هو رمز للعزيمة التي لا تموت والمحبة التي لا تنتهي والصدق الذي يوصل صاحبه إلى أهم النجاحات، فلقد نجحت مؤلفة رواية "أعجوبة" بالتعبير عن أصحاب القدرات الخاصة بأفضل شكل ممكن.
وعلى كل كاتب ألا يتجاهلهم، بل عليه أن يبحث عنهم وعن حكاياتهم، لأن الحكايات العظيمة تستحق أن تُروى.

صمت رغم ضجيج العالم
غنى نجيب الشفشق (كاتبة من لبنان)
وسط صخب الحياة وضجيج الفكر، بين حروفٍ تتعانقُ بدفءِ المعنى وأُخرى تنزلق بانسيابيَّةٍ فوق نعومة الورق ورقَّته. ثمَّة أناس تقرأ ببصيرتها وآخرون يلمسون الحرف بأرواحِهم ويتحسَّسون المعنى في جوارحهم. أُولئك تصبح الكتابة لهم نافذة مفتوحة تُطِلُّ على شواطئ من خيالات، تحملهم أمواجها إلى أبعد نقطةٍ من الحلم.
هم ليسوا قطعة منسيَّة في لعبة "البازل" أو لونًا رماديًّا في لوحةِ فنَّانٍ يرسمُ خريف عمرهم، هم حدائق مثمرة وموسمُ قِطافٍ واعد.
لكلٍّ منهم طريقته في صعود سلَّم الإبداع، ربَّما أحدهم يتسلَّقه بِعَصا إيمانِه، يتوكّأ عليها كلَّما مال به برجُ أحلامه، فيستندُ على الوثوق الكلّي بقدرتِه وإرادته.. بذاته.. بأنَّه لم يُخلق عبثًّا بل له قصَّة يجب إتمامها حتى النهاية. فيها يكون البطل والكاتب، يعبر منعطفاتها كما يشاء ويقرِّر، بيده مفاتيح النجاح وفي صدرِه يحمل شغف الوصولِ. وآخر يعرِجُ بنفسه في رسائل شوقٍ نحو هدفِه يجرجر ثوب أحلامِه في كل خطوةٍ يخطو فيها.
لأُولئك ذوي الهِمم بصمات ملوَّنة أيضًا، آثارٌ فوق رملِ الحياة، و"شخبطات" عنيفة فوق وجهها تصرخ بنظريَّة البقاء. البقاء نعم، ليس على هامشها كملاحظةٍ كُتبت ثمَّ مُحيت بل في وسط الصَّفحة!
هم قضيَّة يجب الاستماع إليها وموضعُ فخرٍ يجب أن يُحتذى به.
لطالما سمعنا بالمنحدرات ووعورتها، لكن ثمَّةَ منحدرات نحو العِلم.. نحو المعرفة والثَّقافة.. فلماذا لا تصلح تلك المنحدرات في الأدب لترتقي بذوي الهِمَمِ نحو قمَّة المعرفة والثَّقافة؟
هل نحن في زمن تجارة الحرف؟ أم أصبحنا في عصر احتكارِ الكلمةِ وبيعها لمن أجاد النُّطق والسَّمع؟ وهل كل من قرأ فَقِهَ ووجد ضالَّته وخَلاصهُ؟
الذين يقرؤون في عقولهم ويتتبَّعون الحرف في قلوبهم، هم أكثر جدارة في الفهم واصطياد المغزى من غيرهم السّالمين. إنَّهم شركاء لنا في الحلمِ وليسوا قصَّة مأساويَّة مثيرة للشفقةِ!
أدب ذوي الهمم.. وسرُّ الكتابة
ليس الكاتب ملكًا متوَّجًا في برجه العاجيِّ، إنَّما هو خادمُ القرَّاء وحارس أوجاعهم. وعليه أن يسير في شوارعهم وأحيائهم، أن يعيش تفاصيل يوميَّاتهم ويتحسَّس الألم النَّابع من عيونِهم.
ليكتب عن ذوي الهمم، لا بدَّ له أن يتناول من صحنِ حكاياتهم ويشربَ من كؤوس عذاباتهم. ليكتبَهم لا ليكتبَ عنهم!!... ليصرخ بصوتهم لا أن يقلِّدهم. أن يبني من أدبه قرية صغيرة تضمَّهم وأحلامهم في بيوتٍ تطمئنهم أنَّهم قطعة من هذا الكون ولهم وزنهم فيه.
هم نجومٌ متلألئة في أحضانِ الفضاء، وللنجوم أسرار، منها ما يكشف نوره مع تبدُّل ثوب السَّماء، ومنها ما ينتظر أن ينسكب اللون الأسود فوق وسادة العالم. ولكنهم يملكون رؤوسًا كبيرة تضجُّ بالفكر والأحلام، لا ينامون باكرًا إلَّا عندما تشرق شمس أمنياتهم من وراء غيمِ الشِّتاءِات الطويلة. يأنسُ الأدبُ بهم، بقصَصِهم ورؤاهم.. فيشعرونَ بأنَّ العالم لمَّا يزل في سريرِ الأمانِ وهم جزء منه.
لنخيطَ لهم من كلماتنا وسائد حتى يطمئنُّوا، فتهدأ قلوبهم الصغيرة المتخمة من أوجاع "قضيَّة وجودهم".

ردوان كريم (كاتب من الجزائر)
حين تنتصر الإرادة على قيود الجسد!
من الحكمة ألا نحاول تغطية الشمس بأصابع أيدينا، ما لم نجرّب شيئًا لا يمكننا وصف ألمه، وكل وصفٍ لما نراه ونسمعه لا يرقى إلى ما يعيشه غيرنا من وجع. تنقطع الكهرباء لحظةً، تنطفئ الإنارة، فنتمسّك بالجدران والأثاث بحثًا عن شمعة أو أيّ إنارة أخرى تُضيء المنزل، وتُنير لنا الدنيا من حولنا، فأعيننا تأبى العتمة ولو للحظة. لكن ماذا عن الذي يعيش حياته كلّها في ظلمة، سواد يملأ عالمه، والنور لا يأتي إلا من خياله، من باطن عقله، ومن أعماق قلبه؟!
والأمر نفسه مع المقعَد؛ فرغم وجود الكراسي المتحرّكة، لا يسير حيث يريد، ولا يمارس الرياضة التي يحب، ولا يستطيع ركوب سيارة الأجرة الصينية الضيّقة للانتقال إلى عمله، ويصعب عليه أداء عملٍ يتطلّب نشاطًا وحركة. وماذا عن الأبكم الذي لا يقدر على التعبير عمّا يختلج في صدره وما يدور في عقله؟ لا يُفصح عن غضبٍ ولا عن فرحٍ بسهولة كما نفعل نحن، ومع ذلك "حتى عندما لا نملك خيارًا، يبقى لدينا خيار كيف نكون في تلك الحالة" كما يقول المفكّر والفيلسوف الوجودي "جان بول سارتر".
عندما تكون الحالة المورفولوجية أو الفيزيولوجية أو البيولوجية فيها عطبٌ ما، يجب أن تكون النفسية مليئة بالإرادة والرغبة في الانتصار عليها، وأن تكون الشخصية قوية، وحتى إن لم تكن كذلك، نُدرّبها على القوّة. الحياة في كثير من الأحيان تبدو عبثية، والعبث كما وصفه "ألبير كامو" في كتابه "أسطورة سيزيف": "ينشأ من هذا التواجه بين النداء الإنساني وصمت العالم غير المعقول"، فهذه الطبيعة التي ننتمي إليها لا تهتمّ لوجودنا، ولا لوفاتنا، ولا لمرضنا، ولا تسمع صراخ ألمنا ولا أحزاننا، لا يهمّها إن كنّا سعداء أم نتوجّع؛ فهي موجودة منذ الأزل، مستمرّة لا تتوقّف مع توقف نبض قلب أحدنا، ولا تواسي أحدًا في محنته.
الحياة تشبه مضمار السباق، والنجاح الحقيقي هو أن تكون بين المتسابقين. لا يهم الفوز بقدر ما يهم أن تستمرّ وألا تتوقّف. بعضنا يخوض سباق حواجز، وهؤلاء كي يصلوا إلى خطّ النهاية عليهم تخطّي العقبات، لكن السباق والمضمار يبقيان هما نفسيهما. فإذا كانت الحواجز هي الإعاقة أو علّة جسدية، فإن الروح التي تملك الإرادة والعزيمة تبقى حرّة لا يقيّدها شيء، لأنها بلا عظم ولا لحم ولا حواس، وهي القوّة التي لا تخضع لقوانين الفيزياء ولا للمحسوس.
"المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، أبناؤنا فلذات أكبادنا وصنّاع سعادتنا، أطفالنا الذين يزيّنون الوجود من حولنا. نودّ دائمًا تربيتهم أحسن تربية، ومنحهم أرقى الأخلاق وأجود التعليم، واختيار أفضل مأكل ومشرب لهم. نريد أن نراهم في أحسن موضع، ونعمل جاهدين لتوفير كل ما نستطيع. فإذا قدّر الله أن يكون أحد أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يجب أن نعامله على أنه مختلف أو معوَّق، بل نشرح له أنه كاملٌ ومميّز بطريقته الخاصة. {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (التين، الآية: 4)، أي إن الله وهبه كل الإمكانات والصفات والمواصفات التي يحتاجها ليحقّق أحلامه ويصل إلى أهدافٍ ممكنة في إطار حالته. وعليه أن يعرف نفسه حقّ المعرفة، ولا يتأثّر بما يقوله الناس عن إعاقته، ولا يهتمّ بأوصافهم له، ولا يكترث بأحكام صادرة عن صغار العقول الذين يُصغّرونه ويقزّمونه إلى حدود إعاقته التي وُلد بها أو أصيب بها بعد مرض أو حادث. عليه أن يتعلّم منذ الصغر أن الإعاقة ليست عيبًا، بل العيب فيمن يراها كذلك. فإذا اجتهد في الدراسة وتعلّم ما يعود عليه بالنفع، وتدرّب على مهنة أو حرفة تمنعه من الجوع والعوز، فلا يجب أن يُنظَر إليه بعين الشفقة أو العطف أو النظرة الدونية، ولا أن يشعر هو بالنقص أو يُحتقر، بل يجب أن يكون محترمًا مهابًا ذا شأن وقيمة في المجتمع وحيثما حضر. أمّا إذا كانت العلّة تمسّ العقل، فيقع عاتق الاهتمام كاملًا على من حوله من الأقربين.
إرادة لا تُهزم.. وأدب يمنح صوتا للصامتين
نحن مجتمع لا يقرأ - وحتى لا نعمّم - نقول إن الجزء الأكبر من تركيبة مجتمعنا لا يقرأ. وإن كانت تجارة الورق مربحة في كل أنحاء العالم، نجد مكتباتنا تُغلق واحدةً بعد أخرى لانقطاع مُرتاديها. وإن أردنا تعويد أبنائنا على القراءة، فعلينا أن نكون القدوة. وحتى لو تشابهت المكتبات ووجدنا فيها غالبًا الكتب القليلة نفسها، قد تمتدّ يد طفلٍ إلى كتابٍ مصوّر ليقرأ ويتعلّم، لكن هناك من لا تستطيع يداه تقليب الصفحات. هناك طفلٌ كفيف تتوق نفسه إلى سماع قصة عن بطلٍ يشبهه، لا بطل "شُفي" فصار سعيدًا. هؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا مجرد أرقام في إحصائيات، إنهم قرّاء محرومون من أبسط حقوقهم: الحق في أدبٍ يخاطبهم، يفهمهم، ويبني عالمهم، لا أدب يُكتَب عنهم فحسب.
"أبو عمرو عثمان بن بحر"، الشهير بـ "الجاحظ"، أديب عربي كان من كبار أئمّة الأدب في العصر العباسي، كان ثَمَّ نتوءٌ واضحٌ في حدقتيه فلُقّب بالحدقي، وسُمّي بالجاحظ، مثلما كانت لديه بعض الإعاقات الجسدية الأخرى. كتب كتابًا عنوانه "البرصان والعرجان والعميان والحولان" يُعدّ دراسة رائدة عن ذوي الهمم، حيث تناولهم بمنهجٍ معظِّمٍ ومقدِّر، وسلّط الضوء على شخصيات بارزة حقّقت السيادة والنجاح رغم إعاقاتها. يؤكد الكتاب أن احترام ذوي الهمم هو جزء أصيل من التراث الحضاري العربي، وليس فكرة حديثة، مدعّمًا ذلك بنماذج أدبية قديمة ومعاصرة اعتزّ أصحابها بإعاقاتهم بل وفاخروا بها. كما قدّم الكتاب تحليلًا مفصّلًا للإعاقات وردًّا على منتقصي حقوق هذه الفئة.
وتأتي قصة عميد الأدب العربي "طه حسين" كأبرز مثال على تجسيد هذه الرؤية، حيث حوّل فقدان بصره في طفولته إلى محفّزٍ للإبداع، فحفظ القرآن صغيرًا، وابتنى مسيرة أكاديمية أسطورية توّجها بكونه أول حاصل على دكتوراه من الجامعة المصرية ثم من السوربون في باريس، ليخلّف إرثًا أدبيًّا وفكريًّا خالدًا يثبت أن القيادة والتميّز هما اختيار الإرادة، وليسا حكرًا على أحد. تميّز أسلوب "طه حسين" بالوضوح والسلاسة، ودافع عن اللغة العربية الفصحى ورفض الدعوات لاستبدالها بالعامية أو إلغاء الإعراب. ورأى أن النحو القديم معقّد ويحتاج إلى التبسيط وإحياء روحه ليخدم جمال العربية ويُعيد قوّة الأدب. كما دعا إلى تطبيق منهج العلم الحديث، وتحرير الفكر والأدب من المسلّمات الخاطئة، واستخدام منهج الشكّ الديكارتي القائم على البحث والمنطق والاستقراء في النقد والتحليل. وقد أحدثت نظرته للأدب تغييرًا جذريًا في كتابة الأدب العربي المعاصر.
أصدر الكاتبان "لوسي وجيمس كاتشبول" - وهما من ذوي الإعاقة - قائمة مختارة تضمّ 20 كتابًا متميّزًا عن الإعاقة، كُتبت جميعًا بأقلام مؤلفين من ذوي الهمم. وجاءت هذه المبادرة ردًّا على النمط السائد في الأدب الذي غالبًا ما يستغل الإعاقة كأداة درامية، حيث تؤكد القائمة أن الكُتّاب من ذوي الإعاقة هم الأقدر على تقديم تمثيلٍ أصيل وتجارب حقيقية.
تنوّعت القائمة بين الروايات والمذكرات والقصص المصوّرة والكتب النثرية، موجّهة إلى جميع الفئات العمرية. وتميّزت الأعمال المختارة بتقديم منظور داخلي صادق، مثل رواية (El Deafo) شبه السيرة الذاتية عن الصمم، ومذكرات (A Face for Picasso) التي تتحدّى مفاهيم الجمال التقليدية، ورواية (Sick Kids in Love) التي تقدّم قصة حب مبتهجة للمراهقين المرضى بعيدًا عن النهايات المأساوية.
كما ضمّت القائمة أعمالًا بارزة مثل (Disability Visibility) التي تجمع أصواتًا متنوعة من مجتمع ذوي الإعاقة، و(Being Heumann) التي توثّق مسيرة الناشطة الحقوقية "جوديث هيومان". وتؤكد هذه المجموعة الأدبية المختارة على أهمية تمثيل أصحاب التجربة الحقيقية في صياغة السرد الأدبي حول الإعاقة، مع تقديم قراءات ثرية تتراوح بين الواقعية والخيالية، والجدية والمرحة.
أبطال صنعهم التحدّي.. وأناروا للعالم دربا
كم من بطلٍ يستحقّ الإشادة والذِّكر، ويكون مصدر إلهامٍ لغيره، سواء لمن يشبهه أو لمن يملك كل المقوّمات الجسدية والصحية ويدّعي صعوبة الظروف. لقد تحدّى الكثير من المشاهير والشخصيات الكبيرة الإعاقة، آمنوا بأفكارهم وأحلامهم، وسعوا لتحقيقها، فبَقِيَت أسماؤهم عالقة في الأذهان.
ومن بين الأشخاص الذين لا يمكن نسيانهم، هناك الشاب "علي مسعودي"، السباح الجزائري الذي تُوّج بطلًا في مسابقات سباحة المعوقين ما بين 2008 و2012، إضافة إلى ألقاب أخرى، فضلًا عن ممارسته للرسم التشكيلي.
كم من شخصٍ غلبته الإعاقة جسدًا، لكنه لم يسمح لها أن تُقيّده روحًا وطموحًا، فصار قدوةً ومصدر إلهامٍ للأجيال. من بين هؤلاء يبرز اسم "إبراهيم طيّب"، ذلك الفنان الكفيف الذي لم يمنعه فقدان البصر من أن يكون أحد أعمدة الموسيقى القبائلية في الجزائر. بموهبته الفذّة وإصراره، هزم الظلام وأثبت أن الإرادة أقوى من العجز.
وفي عالم السياسة، يبرز "فرانكلين روزفلت"، الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، وأول من انتُخب لأربع ولايات متتالية حتى وفاته سنة 1945، ورغم إصابته بالشلل في سن التاسعة والثلاثين، قاد بلاده لتجاوز الكساد الاقتصادي العالمي، وساهم في الانتصار على النازية.
أما في سماء الأدب، فيتألّق اسم "مصطفى صادق الرافعي"، السوريّ الأصل المصريّ المولد، وأحد أمراء النثر الفني في القرن العشرين. فقد سَمِعَه مرضٌ عضال، لكنه عوّضه بنبوغ مذهل، حتى حفظ نهج البلاغة قبل العشرين، واشتهر بجزالة لغته وقوة بيانه، ولُقّب بـ "معجزة الأدب العربي".
وفي مجال العلوم، يقف "ستيفن هوكينغ" مثالًا خارقًا للصبر والإبداع؛ إذ أصيب بمرض نادر سبّب له شللًا تدريجيًّا حتى فقد القدرة على الحركة والنطق، ومع ذلك تحدّى توقّعات الأطباء الذين قالوا إنه لن يعيش أكثر من عامين، فتحوّل إلى أحد أعظم علماء الفيزياء في التاريخ.
وفي الموسيقى، يظلّ "لودفيغ فان بيتهوفن" رمزًا للعبقرية؛ فقد ابتكر موسيقى رومانسية عميقة تهزّ المشاعر وتفوق جمال اللوحات التشكيلية. ورغم إصابته بالصمم، لم يتوقّف عن التأليف، فخلّد اسمه بمقطوعات خالدة مثل "سوناتا ضوء القمر" و"السيمفونية البطولية".
أما "فريدا كاهلو"، الفنانة المكسيكية العالمية، فقد عانت من شلل الأطفال ثم من آلام جسدية قاسية، لكنها حوّلت الألم إلى لوحات ملهمة جعلتها من أشهر الرسامات في العالم.
وفي عالم الابتكار، يسطع "توماس إديسون"، صاحب أكثر من ألف براءة اختراع، ومن بينها المصباح الكهربائي. ورغم صعوبته في التعلّم وعدم قدرته على القراءة حتى سنّ الثانية عشرة، أصبحت أفكاره حجر الأساس للحضارة الحديثة.
ومن مضمار الرياضة، تبرز "مارلا رونيان"، أول عدّاءة كفيفة تشارك في أولمبياد سيدني عام 2000، فهزمت إعاقتها وحقّقت بطولات محلية ودولية، لتصبح من أشهر الرياضيات الأميركيات.
كما يُلهمنا الفنان الإيراني "جهان بخش صادقي"، الذي أصيب بالشلل الكلي ولزم الفراش، لكنه أبدع بريشته حتى صار من أشهر الرسامين. وقد منحه دعم أصدقائه دافعًا لاكتشاف أعماقه ومواصلة العطاء الفني.
هؤلاء وغيرهم يثبتون أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد، بل في الاستسلام، وأن العظمة تولد من التحدي، والإرادة، والإيمان بالذات.
الإعاقة الوحيدة هي فقدان الشغف والرغبة في تحقيق هدفٍ يكون مشروع حياة. الإعاقة الوحيدة هي أن تندب حظك، وتستسلم للظروف وتنسى غايتك. الإعاقة الوحيدة هي ألا تفعل شيئًا. قُم، وانفضْ الغبار عن أحلامك، وافعل ما أنت قادرٌ عليه.

ذوو الهمم.. من الكتابة عنهم إلى الكتابة لهم
وفاء داري (كاتبة وباحثة من فلسطين)
هل يصبح الأدب أقلّ صدقًا حين نعرّف مُبدعه؟ هل تُلغى قيمة النصّ حين نعلم بخلفية كاتبه الاجتماعية أو الجسدية أو جنس مُبدعه؟ أهو ذكر أم أنثى؟ الفكرة التي تحملها الحداثة الأدبية أن النصّ يتجاوز المؤلف ويقيم علاقته المباشرة بالقارئ صحيحة ومهمّة كمنهج نقدي ضد العنصرية والتمييز. لكنّها لا تكفي وحدها لتصحيح مآلات التمثيل. المطالبة بتسمية جنس أدبي خاص بذوي الهمم ليست مسألة تفريق أو عزلة؛ بل هي فعل (سياسي – ثقافي) يهدف إلى مواجهة صمت الهامش: تسمية تمنح الموارد، والمنابر، والبرامج النقدية والتربوية التي تحتاجها هذه التجارب لتصبح جزءًا مرئيًّا من الأدب العام. بعبارة أخرى، الاسم هنا أداة تمكين تفكك هيمنة مركزية (الجسد الكامل) في الخطاب الثقافي، ولا يلغي مبدأ المساواة بل يرسّخه على مستوى الفعل النقدي والإنتاجي. إنّنا لا نريد (أدبًا معزولًا)، بل جسورًا تجعل من أدب ذوي الهمم مكوّنًا أساسيًّا في نسيج الأدب المعاصر متساويًّا في الوجود، مميزًا في الاعتراف، وقادرًا على إغناء الخيال الجمعي.
من هذا المنطلق، يُعدّ حضور "ذوي الهمم" في الفضاء الثقافي والأدبي أحد المؤشرات الجوهرية على نضج الوعي الإنساني داخل المجتمعات، إذ لا يمكن لأيّ مشروع ثقافي أن يدّعي شموليّته ما لم يمنح هذه الفئة موقعًا فاعلًا في حقول الإبداع والمعرفة. فالحق في الأدب والمعرفة ليس امتيازًا، بل هو حقّ إنساني أصيل يوازي حقّ الحياة والكرامة.
لقد ظلّ "ذوو الهمم"حاضرين في الأدب أكثر بوصفهم موضوعًا يُكتب عنه، لا فئة يُكتب لها أو تُمنح فرصة التعبير عن ذاتها. وغالبًا ما قُدّموا في السرد والشعر كرموز للمعاناة أو الاستثناء، لا كأفراد يمتلكون طاقة فكرية وجمالية قادرة على إثراء المشهد الثقافي. إنّ هذه النظرة المجتزأة حوّلت الأدب إلى مرآة ناقصة، وأبقت فئة واسعة خارج دائرة الفعل الإبداعي. تتطلّب الكتابة لذوي الهمم إعادة صياغة العلاقة بين اللغة والإنسان، إذ يجب أن تُبنى على الاحترام لا الشفقة، وعلى التمكين لا التوصيف. فالأدب الموجَّه لهم لا يعني التبسيط، بل الوعي بكرامة المتلقي واختلاف تجربته. وهنا تبرز أهمية أدب الأطفال الخاص بذوي الهمم، بوصفه أداة تربوية لبناء خيال يتقبّل الآخر منذ الطفولة، ويقدّم الإعاقة لا كعجز بل كاختلاف خلاّق.
إنّ اللغة نفسها مدخل أساسي لهذا الوعي. لقد تجاوز الزمن مصطلحات مثل "معاق" أو "قعيد"، نحو تعابير أكثر إنسانية مثل "ذوي الهمم" و"ذوي الاحتياجات الخاصة". ليست هذه مجرّد موضة لغوية، بل تحوّل أخلاقي في إدراك أثر الكلمة على الكرامة الإنسانية. فاللغة كائن حي يتطوّر مع تطوّر القيم، واختيار المصطلح ليس فعلاً لغويًا فحسب، بل موقفًا حضاريًّا وأخلاقيًّا. نحن لا نمحو الألفاظ القديمة، بل نعيد النظر في وقعها وسياقها، لأن الكلمة في النهاية تُشكّل الوعي والسلوك.
لقد شهدت الساحة الأدبية مبادرات مهمة لتكريس هذا الوعي، مثل "ندوة اليوم السابع الثقافية" (القدس) التي دأبت على استضافة كتّاب من ذوي الهمم ومناقشة أعمالهم. ومن النماذج اللافتة تجربة الأديب الفلسطيني "فادي بديع أبو شقارة"، صاحب رواية "رهين الجسد"، التي حوّل فيها قيوده الجسدية إلى أجنحة للإبداع، مقدّمًا نصًّا وجوديًّا عميقًا عن الحرية الداخلية ومقاومة الجسد بالعقل والإرادة. في روايته، يتحوّل القيد إلى طاقة للكتابة، والضحك إلى شكل من أشكال المقاومة، إذ يواجه البطل عجز الجسد بسخرية ذكية ووعي فلسفي يجعلان الألم جزءًا من المعنى لا نقيضًا له.
وفي السياق ذاته، نجد رواية "أحلام القعيد سليم" للكاتب الفلسطيني "نافذ الرفاعي"، التي تطرح تجربة بطلٍ يواجه الشلل والفقر بتحويل الإعاقة إلى فعل مقاومة. تستحضر الرواية رموزًا دينية وتاريخية لتعميق دلالة الصعود الروحي رغم ثقل الجسد، فـ"سليم" الذي يحمل اسمه مفارقة السلامة والعجز، يجسّد الحلم الإنساني بالتحرّر من القيود المادية نحو فضاء أوسع من الأمل والمعنى. ورغم بعض الملاحظات التقنية في السرد، تبقى الرواية شهادة إنسانية على قدرة الأدب على إعادة تعريف الحرية في وجه الضعف والعزلة.
هذه النماذج، وغيرها، تؤكد أن أدب ذوي الهمم ليس أدبًا هامشيًّا أو موازيًّا، بل أدبا إنسانيا بامتياز، يعيد التذكير بأن الإبداع فعل مقاومة ضد الصمت والتهميش. هو أدب يُعلي من شأن التجربة، ويمنح الصوت لمن حُرموا من المنبر. إنه يوسّع مفهوم البطولة من الجسد القوي إلى الإرادة القوية، ومن الشكل الكامل إلى الروح الكاملة.
إن مسؤولية الكتّاب والنقّاد اليوم تتجاوز التعاطف العابر، لتتحوّل إلى فعل ثقافي حقيقي: دعم المبدعين من ذوي الهمم، وإتاحة المنابر لهم، والاعتراف بإبداعهم كجزء أصيل من المشهد الأدبي. فالمجتمع الذي لا يسمع أصوات جميع أفراده، يبقى ناقص الإنسانية مهما بلغ من كمال الشكل.
يبقى أدب ذوي الهمم مساحة أخلاقية وجمالية تُذكّرنا بأن الكلمة يمكن أن تُعيد بناء العالم، وأن الكتابة ليست ترفًا فنيًّا، بل شهادة إنسانية على شجاعة الوجود.

بدر شحادة (باحث في الشؤون التاريخية والاستراتيجية من لبنان)
"الإعاقة السويّة" بين الجنون والإجرام
من الحالات النادرة في مذهبي الكتابيّ أن أغوصَ في بحر التشابيه والاستعارات، غير أنّ موضوع الإعاقة العقليّة شدّني إليه بلا هوادة، ودفعني إلى تناوله لا عند ذوي الاحتياجات الخاصة، بل عند الإنسان الذي يدّعي الذكاء والبعد والتخطيط الاستراتيجي.
فالعقل، وإن بدا سويًّا في مظهره، قد يكون مُعاقًا في جوهره. وهنا يكمن ما أُحبّ أن أسمّيه "الإعاقة السويّة"؛ تلك التي تتخفّى تحت قناعِ الاتزان، لكنها في حقيقتها عطبٌ في الضمير، وانقطاعٌ في حبل الإنسانية.
وهكذا هو "نتنياهو"؛ حار العلماء والنفسيّون والسياسيّون: أهو معاقٌ عقليًّا أم مجرمٌ من الدرجة الأولى؟
بين "الإعاقة السويّة" والإجرام خيطٌ رفيعٌ يُسمّى "الإنسانيّة"، وإن انقطعَ، سقطَ الإنسانُ في هاوية الوحشية وهو يظنّ نفسه عاقلًا.
الحروبُ على الأرض، وما تحمله من مصالحَ اقتصاديةٍ وعقائدَ عقليةٍ تبنّاها البشر عبر التاريخ، كانت دائمًا جزءًا من طبيعتهم في سعيهم إلى البقاء: للخير والشر، للدعوة أو لوقف الظلم. غير أنّها عبر الزمن، شهدت مجازرَ وتنكيلًا وتقتيلًا، تشهد عليها الذاكرة الإنسانية منذ روما إلى غزّة.
وما يهمّ القارئ اليوم هو ما يراه بعين الحقيقة: عقلية "نتنياهو"، التي قتلت مئات الآلاف، ودمّرت المستشفيات، وقصفت الأطفال، واتهمت الرُّضّع بأنهم تهديدٌ للأمن القوميّ، واعتبرت الطعام جريمةً تستحق العقاب! فأيُّ قشرةٍ دماغيةٍ يمكن أن تُبرّر ذلك؟ أهي تلفٌ في الفطرة، أم سقوطٌ أخلاقيّ متوارث؟
إنّ التاريخَ يُسعفنا في المقارنة، فـ"كاليغولا"، قيصر روما الذي لم يتجاوز حكمُه أربع سنوات قبل أن يُغتال على يد شعبه وهو في مطلع الثلاثينيات من عمره، كان مثالًا بارزًا على اختلال القشرة الدماغية لدى الحاكم.
فقد أثبتت دراسات حديثة أنّ النبيذ الروماني كان يُحضَّر في قدرٍ من الرصاص، فيمتزج السمّ بالمشروب، ويُحدث تلفًا عصبيًّا يؤثّر في السلوك والاتزان العقليّ.
ويُعتقد أن كاليغولا، الذي أصيب بمرضٍ حادّ غيّر شخصيّته، قد تعرّض لتلك التأثيرات، فتحوّل من حاكمٍ متّزنٍ إلى طاغيةٍ مهووسٍ بسلطةٍ تظنّ نفسها إلهًا.
لقد اعتبر "كاليغولا" أنّ "إله البحر" يتحدّاه، فأمر بقتل آلاف النساء والأطفال ورماهم في لجّته.
وكان يُعدّ الموائد ويدعو كبار الشخصيّات، ثم يُعدم المحكومين أمامهم بدمٍ بارد، دون أن يرتجف له جفن.. ويذهب إلى مقابلة زوجاتهم دون رادع!!
فهل "نتنياهو" نسخةٌ عصريةٌ من ذلك الجنون القديم؟ هل ضُربت قشرة الدماغ لديه كما ضُربت عند "كاليغولا"؟ أم أنّ طبيعته الإجراميّة منذ الولادة تحمل في جوفها تلك الإعاقة السويّة التي تتزيّن بالعقل لتُخفي خلفها سقوط الإنسانيّة؟